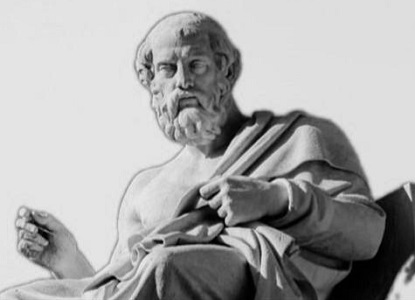صحيفة المثقف
قراء في كتاب محمد أركون: نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية
 "المقارنة هي أساس الأشياء ومن لا يُقارن لا يعرف وستظل نظرته ضيقة للأمور ومحصورة بنطاق تراثه ودينه فقط"
"المقارنة هي أساس الأشياء ومن لا يُقارن لا يعرف وستظل نظرته ضيقة للأمور ومحصورة بنطاق تراثه ودينه فقط"
محمد أركون (نحو تايخ مقارن للأديان التوحيدية، ص283)
يتألف الكتاب من ستة فصول:
الأول: المسألة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، والثاني: التفكير في الفضاء التاريخي المتوسطي، والفصل الثالث جاء بعنوان الوسطاء الثقافيون الثلاثة، فيما كان الفصل الرابع عن: صورة الآخر: التشكيل المتبادل لصورة الإسلام والغرب، أما الخامس فقد تحدث به أركون عن علاقته بيواكيم مبارك ولويس ماسنيون، بينما كان الفصل السادس والأخير عبارة عن مقابلتين مع أركون.
ملاحظات توضيحية حول الكتاب أهما:
ـ أهمية الكتاب: يُعد الكتاب من مؤلفات أركون المتأخرة. فقد نُشر بعد وفاته بعام، وفيه سعي من أركون لتنشيط المنهج المقارن في كتاباتنا ومتبنياتنا بعد غيابه الطويل والمفقود إلى حد كبير في مؤسساتنا الأكاديمية وفي حياتنا الاجتماعية والثقافية.
ـ إنه يخلو من نظرية واحدة متماسكة، ويحمل دعوة إلى تبني منهج مقارن بين الأديان، ولربما يتبادر إلى قارئ العنوان أن محمد أركون سينشأ نظرية أو رؤية واضحة للمقارنة بين الأديان، ولكن شيء من ذلك لم يكن واضحاً، بقدر ما كان الكتاب عبارة عن مجموع أبحاث أو أوراق تحاول أن تعقد مقارنة بين فعاليات نظرية وتأملية قام بها بعض مفكري الأديان التوحيدية الثلاث، من أجل تقريب وجهات النظر بين الديانات المتنافسة. وهو في هذا الكتاب يدعو لتبني المنهج المقارن ولا يعقد مقارنة بين الأديان، لذلك حمل العنوان في بدايته كلمة نحو، وهي تعني سعي من الكاتب ودعوة مبنية على المتمنى بأن تكون قراءتنا للدين الذي وُجِدنا عليه وفيه ليست قراءة عاطفية وجدانية بقدر ماهي قراءة عقلية نقدية تاريخية، قائمة على أساس مقارنة معطيات دين سماوي بمعطيات دين سماوي وتوحيدي أخر، وأحياناً مقارنة الدين السماوي بأديان وضعية وأيديولوجية لعلنا نستطيع بناء نظرة موضوعية عن معتقداتنا ومعتقدات الآخرين.
ـ ظهر لي أن الكتاب هو مجموعة من الأبحاث المتفرقة التي كتبها محمد أركون في مناسبات مختلفة، ولكن عن موضوعات تكاد تجتمع في هم واحد هو الدعوة لتبني المنهج العقلاني النقدي التاريخي المستفيد من معطيات المناهج المعاصرة، الأنثربولوجية والسيميائية واللغوية (الدلالية) والتفكيكية والبنيوية ومدرسة الحوليات الفرنسية.
ـ يحمل الكاتب بين ثناياه أحلام الرومانسيين والطوباويين الذين يريدون أن يجمعوا المتناقضات ويجعلوها تحت خيمة ما سُميَ بالنزعة الإنسانية التي بدأها الغرب في نقده لحضارته ومارس ما يناقضه في التعامل مع حضارة الإسلام. وفي الوقت نفسه كان الإسلاميون المتطرفون عامل مساعدة في إبعاد الإسلام عن نزوعه الحضاري في التسامح متفقين في ذلك مع الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت البلدان العربية منذ أواساط القرن العشرين، وهذا بيَن في إدراك أركون لأحوال الغرب هذه وتصرفاته وأحول الشرق وتصرفات دعاته.
ـ لم يظهر لي أركون في هذا الكتاب وغيره من كتاباته الأخرى أنه يميل إلى التأليف الأكاديمي المتماسك والسستماتيكي ما عدا أطروحته للدكتوراه حول "نزعة الأنسنة في القرن الرابع الهجري: جيل مسكويه والتوحيدي أنموذجاً.
ـ نستطيع القول ان أركون في كل كتاباته هو مفكر مفاهيمي من طراز خاص، ولم يكن مفكراً تأملياً تجريدياً. ولربما يعترض معترض أن المفاهيم ما هي إلا من عالم التصورات والتأملات والتجريدات. نقول نعم، المفاهيم هي كذلك، لكن ما يميز مفاهيم أركون أن لها مصداق من الواقع وهي لا تسبح في فضاء التجريد وليست بمعزل عن الواقع المعاش، وهي ميزة تُحسب له لا عليه، لأن في إنتاجه للمفاهيم سعي جاد لكي يُساعد المفكرين في تسليح أنفسهم بعُدة مافهيمية تجعلهم قادرين على فهم وتفسير الواقع ومتغيراته.
ـ يحاول أركون جاهداً أن يستفيد من مجموعة كبيرة من الإتجاهات الفكرية والفسفية والأنثربولوجية الغربية والنفسية والتاريخية واللغوية، محاولاً تبيئتها ونقلها من مجالها التداولي الغربي إلى المجال التداولي العربي الإسلامي. فضلا عن ذلك فهو يحاول أن يقرأ التراث العربي الإسلامي في ضوء تبيئته للمناهج والمفاهيم الغربية المعاصرة، معتقداً بأن الحضارة العربية والإسلامية أكثر إتصال زماني ومكاني وثقافي مع الحضارة الغربية وليس مع حضارت الشرق الأخرى لا سيما الصينية والهندية واليابانية. وفي هذا الرأي رد على أطروحة هنتنجتون صاحب كاتب "صدام الحضارات". فأركون يسعى جاهداً لتعريف الغرب بالشرق، وتعريف الشرق بالغرب، لقناعته أنهما لا زالا لم يعرف بعضهما البعض، فما عرفه الغرب عن الشرق أنه روحاني وهذا ما أيدته كتابات المستشرقين، وما عرفه الشرق عن الغرب أنه مادي، وهذا تصور دفعت بإتجاهه حركات الإسلام الراديكالية وحتى الحركات الصوفية. وكلا النظرتين مرتبط بالتصور الأسكولائي القرووسطي.
لذلك نجد في هذا الكتاب تأكيد من أركون على تلاقح الثقافات وتلاقيها لا سيما في إستشهاده بكتابات مسكوية والتوحيدي، أو في تأكيده على أهمية فلسفة ابن رشد بطابعها العقلاني والتلقي الإيجابي الغربي لفلسفته، لا سيما فلسفة تلميذه المسيحي توما الأكويني وتلميذه اليهودي غير المباشر الذي عكف على دراسة فلسفته إبن ميمون الذي حسبه مصطفى عبدالرازق على الفلاسفة المسلمين لشدة تأثره بعلم الكلام والفلسفة الإسلاميين، ودمجه بين معطيات الحضارة الإسلامية واليهودية، كونه ينقد دينه وكأنه فيلسوف مسلم.
تبنى أركون في كتابه هذا آراء (ريمون لول 1233ـ 1316)[2] في المقارنة بين الأديان وعدم تحيزه للديانة المسيحية التي ينتمي إليها في مقابل الديانة الإسلامية التي يحاول أن يقرأها قراءة عقلانية وليست عاطفية وجدانية، محاولا وضعها في خط متواز مع ديانته.
ظهر سعي أركون هذا أكثر وضوحاً في إظهار إعجابه بأستاذه لويس ماسنيون (1883ـ 1962).
وكان أكثر إنجذاباً للطف وحيوية تلميذ ماسنيون القس المسيحي الشرقي (يواكيم مبارك 1924ـ 1995)[3] الذي أفنى الكثير من عمره البحثي في دراسة القرآن، لا سيما في أطروحته للدكتوراه "ابراهيم في القرآن الكريم". قضى عمره مدافعاً عن بلده لبنان والقضية الفلسطينية.
في الفصل الأول يركز أركون على مفهوم الدين الحق، فمشكلة الأديان جميعاً أنها تنظر إلى ما جاءت به على أنه الدين الحق، وبالتالى فالأخلاق، والقانون الشرعي، واللاهوت السياسي، جميعها أشياء تندرج داخل الإطار الشامل للدين الحق، بمعنى أنه لا يوجد دين من الأديان جميعها إلَا ونظر أصحابه له بقدسية على أنه دين الحق الأوحد، وهذا هو منظور القرون الوسطى الذي بقيت وجهة نظره سائدة لا سيما في الإسلام إلى يومنا هذا. أما في المسيحية فتخلصت منه بحكم إتساع حركة التنوير منذ القرن السابع عشر وأوجها في القرن السابع عشر(ص93). لكن تبقى الحقيقة واحدة بالنسبة للأصوليين في كل الديانات فكل واحد منهم يجد الحقيقة متمثلة في دينه، فالحقيقة يهودية بالنسبة لليهودي، ومسيحية بالنسبة للمسيحي، ولا يختلف المسلم عنهما في النظر إلى دينه على أنه دين الحق. (ص185)
إن واحدة من أهم مشاكل العرب والمسلمين هي إختفاء الثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي منذ عهد مسكويه منذ ألف عام، فلم يعد أحد يهتم بالأخلاق كعلم.(ص96) الأمر الذي ترتب عليه إنتصار الخط الديني للأخلاق على الخط الفلسفي لها. في مقابل إنتصار الخط الفلسفي للأخلاق في أوربا على الخط الديني لها وإنتشار عقل التنوير الذي فكك العقل اللاهوتي وعقلية القرون الوسطى، وسيادة العلمانية كنمط عيش للإنسانية. هذا الأمر الذي كان مترافقاً عندهم مع الثورات العلمية والتكنولوجية.(ص101).
إن إختفاء الثقافة الأخلاقية ببعدها الفلسفي والصراع بين (العلوم الدينية) و(العلوم العقلية) وإنتهاء العلوم العقلية ووصفها بالدخيلة (ص193) أدى إلى إختفاء التعددية العقائدية التي كان يتحلى بها التراث العربي الإسلامي لا سيما في القرن الرابع الهجري. وبالتالي إنتشار الأصولية وغياب الحوار المبتغى بين الأديان وهو إن كان موجوداً، فهو بروتوكلي لا يهتم مؤمنوا الأديان المشاركين فيه بالمعرفة العلمية النقدية المتعلقة بالدين وكثيراً ما تتقدم يقينياتهم وعقائدهم الإيمانية على المعرفة العقلانية وبراهينها. (ينظر: ص110)
تطورت أزمة المسألة الأخلاقية بعد ظهور أنظمة الإستقلال التي سيطرت على كل مقدرات الدولة، وإستمرت في تأميم الدين لصالحها، تلك الخطوة التي إبتدأها الأمويون في تراثنا العربي الإسلامي، ولكنها إتسعت مع هذه الأنظمة التي إستطاعت أن تشمل جميع المواطنين بالمراقبة البوليسية حيثما كانوا على وجه الأرض، وبتأميم الدين تمت تصفية العقل وإفساده. بمعنى أنه لا يحق له أن يطرح أي سؤال على صحة "الأرثذوكسية الدينية" أو كيفية تشكلها التاريخي، فهي تفرض نفسها وكأنها مقدسة ومعصومة كلياً. (ص111) وهذا الأمر دفع بإتجاه غياب التجربة الشخصية لمعانقة المطلق الإلهي، ويعني بها أركون تلك التجربة المستنبطة في الداخل بإختيار شخصي محض ومن دون إكراه أو قسر. إنها تجربة مستنبطة من قبل كل ذات إنسانية في تحريها المخلص عن معنى الوجود. ولكن التدين السائد اليوم هو إستعراضي، سطحي، أكثر مما هو روحاني حر. (ص112).
في ظل ظروف مثل هذه يرى أركون أنه من المستحيل تصور وجود ذروة أخلاقية لا تُنتهك. لماذا؟ لأن الآليات المؤسساتية السائدة لا تسمح لها بالإنبثاق وممارسة عملها بشكل طبيعي ودائم. وعندئذ لا يعود موجوداً من الدين من الناحية الاجتماعية والسياسية إلا مظهره الخادع. (ص113)، لذلك نلاحظ سيادة التعصب الأعمى والفهم الخاطئ للدين أصبح يشكل مشكلة، بل هو المشكلة، فقد تحول الدين إلى سياسة محضة عند المتطرفين إلى أداة للتطرف يستخدمه المتطرفون لحلية القتل ويدعون للتمسك بفهمه الأحادي كي يكون سلاحاً بيدهم لإحتكار السلطة بإسم الدين وممارسة العنف الشرعي الذي جعلنا نفقد بعده الأخلاقي، فغابت مقولة "إنما جئتُ لأتمم مكارم الأخلاق" ليحضر حديث الذبح "لقد جئتكم بالذبح" لإثبات وتكريس نزعة الإقصاء الكامنة في التوجه الديني الراديكالي وتغييب نزعة التسامح الديني الذي أيدته آيات السماء "من شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر"، لا لتثبيت صدقية ولاء الراديكاليين في الإنتماء للاسلام، إنما هو سعي منهم لإثبات حضورهم وتأثيرهم وفاعليتهم في تغيير نمط العيش المشترك ليكونوا هم القيمين على أمور الدين والمحتكرين للحقيقة الدينية، الأمر الذي جعل الدي يفقد كثيراً من بريقه الورحي المُتسامي وبناء تصور عن الدين بعيد كل البعد عن طموح الأنبياء في الوصول لمجتمع أخلاقي يكون العقل أداته في التعامل مع الطبيعة ومحاولة إكتشافها، والقلب نبض العقل وضميره الأخلاقي والإحيائي حينما يجنح نحو الإنغماس بالملذات.
شارك الغرب في بلورة هذا التصور للدين الأرثذوكسي بخصومتهم المستمرة للإسلام. إذ يعتقد أركون أن الغرب صنع له عدواً جديداً بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي وإنتصار المنظومة الرأسمالية على المنظومة الاشتراكية. و"كأن الغرب لا يستطيع أن يعيش من دون عدو تاريخي يقف في مواجهته" (ص116)، فصنعت ثنائية جديدة بديلة عن ثنائية (الرأسمالية ـ الإشتراكية) وهي ثنائية (القيم الكونية) متمثلة بالغرب و(البربرية الجديدة) أو (الإرهاب) متمثلا بالعرب والمسلمين. أو محور الخير الذي يمثله الغرب (!!) ومحور الشر الذي يمثله العرب والمسلمون (!!). وكأنها عودة لصراع الأديان بوصف كل واحد منها يمثل الدين الحق وكل مُخالف على باطل، خالد في جهنم وبئس المصير(!!).
إن الخروج من هذا المأزق هو الذي يترافق ويتزامن مع خروج الغرب نفسه من "السياج الدوغمائي" المغلق للروح والفكر، مثلما ينبغي على العرب والمسلمين الخروج من "السياج الدوغمائي" المغلق للدين، الذي وضعوا أنفسهم به مُبتعدين عن معطيات عصري الحداثة وما بعد الحداثة. (ينظر: ص238)
للخروج من هذا الصراع الذي وضعنا أنفسنا به وقوَلبنا الآخر به، يقترح أركون تأسيس (علم ما فوق الأخلاق) وهذا العلم مهمته التساؤل بشكل دائم اليوم عن المضامين والمنشأ التاريخي والاجتماعي والعقائدي والبراغماتي العملي والأنثربولوجي للمبادئ والقيم المتغيرة التي نخلع عليها المشروعية، وهذا يعني أن أركون يدعو إلى أخلاق كونية تنطبق على جميع البشر تتجاوز نطاق الدفاع عن أخلاق الجماعة بوصفها أخلاقاً مطلقة. (ص145)
يُقارب أركون بين (الأدب الفلسفي) الذي ظهر في القرن الرابع الهجري وبين النزعة الإنسانية التي ظهرت في أوربا في عصر النهضة، ويجد أن مفهوم الأدب اليوم إختلف عما كان عليه في القرن الرابع الهجري، فهو اليوم يعني الشعر والأدب بينما في السابق ـ كما يعتقد أركون ـ كان مُساوياً للنزعة الإنسانية التي ظهرت في أوربا. فالأدب كان يعني عند العرب المسلمين الاهتمام بآداب اللياقة، والفضائل، والميزات الشخصية، والثقافة الراقية التي لا بد منها من أجل التوصل إلى مجتمع المتأدبين، والمؤلفين المشهورين بكتاباتهم ومعيناتهم وخبراتهم. ثم جاء "الأدب الفلسفي" لكي ينضاف إلى كل هذه الآداب السلوكية والحياة الفكرية والروحية. وعندئذ أصبح الأدب يعني ما سوف تعنيه كلمة النزعة الإنسانية النهضوية في أوربا. (ينظر: ص146ـ147) هذا التصور إستنبطه أركون من كتابات مسكويه والتوحيدي.
يحاول أركون هنا أن يؤكد أن همه في تأكيده على أهمية ما قدمه مسكويه والتوحيدي لم يكن لغرض العودة للماضي والإكتفاء به، وإن كانت هذه العودة ضرورية ومفيدة. ولكن مشاكل الحاضر لا تُحل عن طريق الماضي، لذلك كانت مهمته معرفة سبب نسيان الفكر الأخلاقي النقدي داخل السياقات الإسلامية ثم تصفيته. ومن ثم الكشف عن مشروطية إمكانية الخروج من النزعة التبجيلية المسيطرة على العرب والمسلمين اليوم، وكذلك ضرورة الخروج من النضال الحركي السياسي الإنفعالي بُغية المساهمة في نجاح البحوث العلمية عن التراث ونقل المعارف الجديدة. (ص151)
إن ما يريده أركون هو الدراسة العلمية للدين، ومن ثم نقد العقل الديني التقليدي عن طريق تطبيق المنهجية التاريخية المستفيدة من علوم الأنثربولوجيا ومناهجيات التأويل والسيمياء والألسنية. فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى تحديث الإسلام لا أسلمة التحديث. (ينظر: ص197وص198وص202)
تكمن محاولة أركون النقدية للعقل الديني في التمييز بين المصحف أو ما يسميه " المدونة الرسمية الناجزة " = المصحف الذي دونه الخليفة الال عُثمان إبن عفان و "النص الشفهي" الذي لفظه النبي محمد = القرآن، ومحاولة الإقتراب منه ومن معانيه الأصلية لا المعاني الحافة أو ما يسميه "آثار المعنى"، وهي محاولة منه رغم إستفادتها من المناهجيات المعاصرة إلَا أنها أقرب إلى حدس الصوفي تجاه الكلام الشفهي الذي تحول إلى نص مغلق. وهو سعي يريد منه أركون التمييز بين: الكلام الموحى به، والخطاب الشفهي الأولي، الذي ألقاه النبي على أسماع صحابته، والمصحف. (ينظر: ص204ـ ص205) إذن يحاول أركون أن يكشف عن المسافة الغائبة بين كلام الوحي المُعطى بوصفه كلام شفوي وبين النص المكتوب بوصفه مدونة رسمية مُغلقة. وهذا الرأي عنده ينطبق على جميع الديانات السماوية.
الفصل الثاني من الكتاب يقوم على سؤال حول سوسيولوجيا الإخفاق بالنسبة لنا نحن العرب وسوسيولوجيا النجاح بالنسبة للغرب؟ ولماذا كلما فشلنا تقدم الغرب؟ ففي الوقت الذي غادرتنا فيه الفلسفة مع محنة ابن رشد نجد الغرب بدأ بالنجاح؟ ولماذا كانت اللغة العربية هي لغة العلم والمعرفة مع ابن رشد في القرن الثالث عشر وصارت في القرن نفسه لغة اللاتين هي لغة العلم والمعرفة؟ محاولا الاستفادة مما طرحه المفكر الإسباني ريمون لول الذي ألَف كتاباً ضخماً بعنوان (كتاب التأمل في الله). ما يُميز لول في هذا الكتاب هو قيامه بمقارنة حرة بين أديان التوحيد الثلاث من دون أن ينتصر لدينه بشكل مسبق على الدينين الآخرين. (ص243) ولو كُنَا نُريد الإستفادة من هكذا أطروحات لما تقاطعنا مع حداثتنا في العصور الوسطى متمثلة بالفلسفة الإسلامية ومعطياتها أولا، ولما إستمرت مقاطعتنا لمعطيات الحداثة الأوربية في زمننا هذا. وبقيت تحضر عندنا وبشكل دائم القراءة التبجيلية، الشعاراتية، الأسطورية، الأيديولوجية، للماضي غير مهتمين بالقراءة النقدية لهذا الماضي وعندما حاول علي عبدالرزق وطه حسين ووُجهوا برد فعل عنيف من حُرَاس الأرثذوكسية. (ص249) الذين كرسوا كتابة التاريخ الطائفي أو القومي والأسطوري، وتأييد تلك النظرة التبجيلية لكل طائفة أو قومية تنظر إلى نفسها وكأنها الجماعة المختارة. (ينظر: ص263)
يُشبه أركون محاولته للمقارنة بين الأديان بمحاولة ريمون لول في القرن الثالث عشر، وهي محاولة قائمة على فتح وتفكيك الملفات الكبرى التي لا يقبل حُرَاس الأرثذوكسية الإقتراب منها. (ينظر: ص253)
بمعنى تبنينا للنقد الذاتي، يتبعه النقد الذاتي لأمريكا والغرب والسياسة الخارجية التي يتبعانها تجاه الإسلام والعرب لما في هذه السياسة من تجني على الإسلام والعرب. وهذا النقد الذاتي هو الشرط الضروري الذي لا بد منه لكي ننتقل إلى سياسة أخرى في المنطقة: سياسة تحررية أو محررة للجميع قائمة على التقريب بين هذه الدول من أجل طي صفحة الماضي. (ينظر: ص259)
الفصل الثالث: تركز البحث في الوسطاء الثلاثة بين الديانات: ابن رشد: في الإسلام، ابن ميمون: في الديانة اليهودية، وتوما الأكويني: في الديانة المسيحية. (يُنظر: ص267)
يؤيد أركون على ضرورة العودة لهذا الماضي "اليهودي والمسيحي والإسلامي" في حال إمكانية الإفادة منه في تفهم "برادايم" = "أنموذج" التفاعل بين الأديان التوحيدية الثلاثة. (ص269) ومحاولة ترميم العلاقة بين الديانات السماوية الثلاث لإصلاح وإزالة سوء التفاهمات والعداوات بينها بالعودة إلى ثلاث نماذج كانوا يمثلون تمثيلاً عالياً وكبيراً الأديان التوحيدية الثلاثة، وهم الفلاسفة الذين ذكرناهم، وهذه العودة لأعمال هؤلاء المفكرين الثلاثة تمكنه من القيام بالمسارات التالية:
1ـ تُتيح له تفهم كيفية إشتغال العقل داخل ما سماه الفضاء الجغرافي التاريخي المتوسطي الممتد من إيران إلى أوربا مع الإشتمال على أفريقيا الشمالية وتركيا الحالية.
2ـ أعمال المؤلفين الثلاثة هؤلاء تُتيح لأركون فهم كيفية حصول عملية التداخل أو التفاعل المفهومي والأبستيمولوجي بين نصوص الفكر الإغريقي من جهة، ونصوص الإعتقاد الإيماني التوحيدي بنسخه الثلاثة من جهة أخرى. كيف حصلت عملية التوفيق بين الفلسفة الاغريقية والديانة التوحيدية، أي بين العقل والدين؟.
3ـ دراسة أسباب فشل ونجاح هؤلاء المفكرين داخل أديانهم الثلاثة. وهذا ما دعاه أركون بعلم اجتماع الفشل والنجاح لفكر ما في بيئة ما وزمن ما.
4ـ محاولة الخروج من التأريخ الأسطوري المتعصب دينياً وقومياً، عبر الإستفادة من آراء هؤلاء المفكرين الثلاثة. (ص272)
ما يربط بين المفكرين الثلاثة هو سعيهم لإستكشاف العلاقة بين الإيمان والعقل وحاولتهم التوفيق بين العقل والنقل، أو بين الفلسفة والشريعة، بما يحفظ للعقل حضور بوصفه هبة إلهية، وبما يحفظ للدين هيبته وبعد المُتسامي وإن كان "جميعهم يؤمنون بأولوية الدين على العقل، فكانوا مشغولين بالتوفيق بين العقل والدين" (ص276)، وإستخدام التأويل في فهم الوحي أو تفسيره، وهذا ما فعله ابن رشد في كتابه "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الإتصال" وابن ميمون في كتابه "دلالة الحائرين"، والشيء نفسه فعله توما الأكويني في كتابه "الخلاصة اللاهوتية".
إن حضور ابن ميمون وتوما الأكويني وإستمرار إعادة إكتشاف بعض ما يمكن توظيفه من فلسفتيهما العقلانية في ثقافة مجتمعيهما، وغياب فلسفة ابن رشد وعدم إستحضارها أو إستحضار روءاها وأهدافها وإستمرار محاربتها في ثقافة مجتمعنا، هو الذي ساعد في إنشار الفقه الظلامي والتربية الدينية السلفية السائدة التي أنتجت أشخاصاً مثل ابن لادن والزرقاوي وغيرهما...(ينظر: ص293ـ294) وهذه الأمور مجتمعة والإنسياق لها والقناعة بها جعلت التعليم في الجامعات تعليماً شكلياً، فلم تكن ولا زالت لا توجد مكتبات حقيقية ولا بُنى تحتية لإستيعاب الطلاب ولا حتى إيجاد فرق بحث علمي بالمعنى الحقيقي للكلمة. بما يعني إنخفاض مستوى التعليم إذا لم نقل تراجعه، فبقينا تابعين للغرب في علومنا، نفتخر بالدراسة في جامعاتهم، نبحث عن إعتراف منهم بصلاحية ما نقدمه من بحوث علمية. (ينظر: ص289) لذلك غابت عنا الدراسة العلمية النقدية للظاهرة الدينية لأن ما ذكرناه ساعد في بناء قاعدة اجتماعية رافضة لمثل هذا النوع من التفكير، ومن يريد ممارسة هذا الشكل من التفكير النقدي عليه أن يختار أوربا ملاذاً له لكي يعبر بحرية عما يريد، بمعنى آخر ضيق فضاء الحرية إذا لم نقل غيابه. (ص290) حتى صارت الفلسفة بوصفها تعبيراً عن التفكير الحر الناقد في عقول كثير من العامة وحتى النخب الدينية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تساوي الزندقة وفقاً لقاعدة "من تمنطق فقد تزندق".
خاتمة هذا الفصل كانت طوباوية إلى حد بعيد، وهي توحيد الفضاء المتوسطي الذي مزقته الصراعات الدينية والسياسية على مر القرون. وهو نفسه يرى أن هذا الرأي "طوباوي إلى درجة لا يخطر على بال مؤرخي الفكر والأديان في كلا العالمين الشرقي والغربي، أو في كلتا الضفتين" (ص302ـ 303)!! وعلامة التعجب من عندنا، فكيف يمكن تلتقي أجيال إنغلقت على ذاتها وعلى تراثها نظرت إلى فكرها الديني أو الاجتماعي على أنه يمثل الحقيقة المطلقة؟ لا أعتقد أن الاستشهاد بأمثلة معتدلة والمقارنة وبين الحال الذي وصلنا له اليوم ممكن أن يسعف في التلاقي بين حضارتين متطاحنتين على طول تاريخ بين غالب ومغلوب، وإن كان هذا أمل لا ينبغي تركه، وهذا واحد من أحلام أركون.
الفصل الرابع: يدور حول صورة الآخر: التشكيل المتبادل لصورة الإسلام الغرب، يبدأ أركون بالإستشهاد بنصوص من الكتب المقدسة للديانات السماوية الثلاثة، تشير إلى أهمية الحفاظ على العلاقة التوافقية مع الآخر حتى وإن كان مغايراً لنا في الدين والملة. ومن ثم يستشهد بنصوص من الفلسفة الأوربية (كانت، سارتر، هوسيرل، إيمانويل ليفناس، وبول ريكور)، (ص315ـ 316) ولا نعرف سبب إستبعاده لنصوص من الفلسفة الإسلامية.
بعد كل اشارات أركون لآرثذوكسية الآخر وآرثذوكسية الأنا وتطرفهما، نجده يُخصص الفصل الخامس للبحث عن فضاء للتلاقي، عبر دعوته لبلورة لاهوت جديد أو فلسفة جديدة تقبل منذ البداية أن تهضم بعض التساؤلات التي ضعها، وهي:
1ـ هل يمكن القبول بمشروعية حرب غير متكافئة من أجل تحقيق أهداف قومية، أو على حساب نفي الآخر؟
2ـ هل يمكن ان نسمح بأن ينتشر على الصعيد العلمي شيئان سيئان لا يمكن إحتمالهما، وأقصد بهما الإرهاب والعنف؟
3ـ هل يمكن للتراث المهتم بالآخر والمبلور داخل الفضاء التاريخي المعروف باسم الغرب أن يستمر في الاعلان عن كونية قيمه من دون أن يدمج إلزامات المسؤولية الفكرية والأخلاقية تجاه الآخر؟ (المسلم المنظور له على أنه الشر المطلق).
4ـ هذا السؤال موجه للعرب والمسلمين الذين يغذون العنف عن طريق التلاعب بالمفهوم اللاهوتي ـ السياسي المدعو بـ "الجهاد" (ينظر: ص321ـ322)
إن العنف هو إلان واضح لإلغاء كرامة الإنسان لما فيه من إعتداء صارخ وفاضح على إنسانية الإنسان وتأكيد لطغان البعد الغريزي بطابعه الحيواني على البعد العقلاني في التكوين الإنساني والسيطرة عليه والتحم فيه.
كان هناك سببان سياسيان برأي أركون ساعدا في إستمرار العنف في مجتمعاتنا العربية ، الأول: الأنظمة التي تشكلت بعد عام 1950، والثاني: عنفوان الدول القومية الأوربية وأمريكا التي لا تريد أن تتخلص من عنجهيتها وشوفينيتها، وإستمرارها في النظر إلى بُلداننا بوصفا الأضعف والأكثر تخلفاً، فضلا عن إحتقار الجاليات العربية والمسلمة في هذه البلدان والنظر إليها على أنا على أنها الآخر المُحتقر والمنبوذ، مثال على ذلك إنتفاضة الضواحي الفقيرة الواقعة على هامش المدن الفرنسية. على ألَا ننسى دعم هذه الدول لأسرائيل في حربها مع العرب. (ينظر: 323ـ 324)
المشكلة أن جميع أصحاب الديانات يمارسون التبجيل الإسقاطي العاطفي على ديانتهم فيما يتعلق في العلاقة مع الآخر، فهم يسقطون على الأزمنة القديمة أفكاراً حديثة لم تعرفها وما كان بالإمكان أن تعرفها، وهذا هو معنى الإسقاط أو المغالطة التاريخية. (ص333)
في ضوء نزعة أركون الإنسانية التي تقترب كثيراً من أحلام الطوباويين، نراه يحلم بالحل لإمكانية الإعتراف بالآخر ممكنة في حال أن في حال تمثلنا لفلسفة بول ريكور في النظرإلى "الذات كأنها آخر"، فما دمنا لا نعامل الآخر وكأنه ذات، أي كأنه مثلنا، لا يمكن أن توجد نزعة إنسانية. بمعنى أن يتحول الآخر إلى ذات، أو الذات إلى آخر، لكي يحصل التناغم والإنسجام في المجتمع والعالم كله. (ص337)
ينبغي العلم ان الغرب، بسبب تفوقه، لا يستطيع حتى الآن أن يعامل الآخرين كذات لهم نفس الكرامة والحقوق. والأصوليون في الجهة الإسلامية لا يستطيعون إحترام الآخرين المختلفين دينياً أو مذهبياً لأنهم معتبرون أنجاساً وكفاراً بسبب عدم إعتناقهم الدين الحق كما يفهمونه. (ص340)
يختم أركون الفصل بإشارة مهمة حول دور الغرب في إنتشار ظاهرة العنف وإنتقالها من الحدث العارض إلى الحدث البنيوي المنتظم والمستمر. لذلك يعتقد ـ أركون ـ أنه لولا إنتصار العقل "التلفزي ـ الألكتروني ـ العلمي" في جهة الغرب، وهو آخر تجليات العقل الوضعي المادي الحديث. لما إستطاع الإرهابي توسعة معلوماتهم وسهلت قدرتهم على شراء وإستخدام وتنفيذ برامجه ومشاريعه التفجيرية. (ص341)
الفصل الخامس: كان للحديث عن يواكيم مبارك وأستاذه لويس ماسنيون، والإختيار لهذين الشخصيتين لم يكن إعتباطياً، فكلاهما يدينان بالديان المسيحية، أحدهما من مسيحيي الغرب وهو ماسنيون والآخر من مسيحيي الشرق وهو يواكيم مبارك وقد كان الأخير من أهم تلامذة ماسنيون. وهما مثالان لعلاقة الأستاذ بتلميذه على الرغم من اختلاف ثقافة كل منهما وإن كان كلاهما مسيحي ولكن ماسنيون من الغرب ويواكيم من الشرق، ولكن التلمذة كما يراها أركون لا ترتبط بالمكان ولا بالزمان ولكن بالهموم المشتركة. فقد كان توما الأكويني تلميذاً لابن رشد ولم تقف إختلاف ثقافتيهما عائقاً أمام التلمذة، ولا حتى اختلاف الديانة.
وواضح أن هذين المفكرين المسيحيين يشكلان جزءً من إسناد محمد أركون الروحي ومرجعيته الفكرية، فيواكيم مبارك كان "هو بالذات ذا نزعة إنسانية حقيقية" كان إحدى حلقات الإسناد الفكري للنزعة الإنسانية التي يتمسك بها أركون، فقد "كان رجلاً رائعاً وإنساناً حقيقياً". (ينظر: ص348 وص349) ومن كل ذلك كان أركون مشغولاً بكيفية خروج الفكر المسيحي الوسيط من سياجه الدوغمائي وبقاء الفكر الإسلامي مُغرقاً في دوغمائيته، "فالفكر المسيحي يتقدم ويتجدد ويُغير لاهوته القديم، فيما الفكر الإسلامي يبقى جامداً، أو حتى يعود إلى الوراء". (ص355) وكان يعتقد بخطر الفكر السلفي الذي يتبنى الموقف الإصلاحي عن طريق العودة إلى السلف الصالح، لأنه ينظردائماً إلى الوراء ويظل متعلقاً بلا كلل أو ملل بتلك اللحظة الأسطورية التدشينية لتاريخ الإسلام. إنه يظل محكوماً بذلك التاريخ المقدس الذي يتعالى على التاريخ الأرضي ويفسد علاقتنا به. (ص355)
في هذا الفصل ينتقد أركون أساتذته الذين درسوه في الجزائر من الفرنسيين المؤمنين بسياسة الفرنسة والذين كانوا دائمي الإنتقاد للإسلام ولنبيه، فضلا عن إنتقاده لأساتذة مسلمين درسوه لأنهم كانوا يدرسونه بطريقة تلقينية إجترارية موروثة عن عصور الإنحطاط الأولى. (ص363) وهو ينتقد عجرفة جميع هؤلاء مقارنة بماسنيون "الشيخ الرائع" بعبارة جاك بيرك (1910ـ 1995). (ص365) الذي كان "يُريد أن ينصف الإسلام ويُعيد إليه إعتباره". وتعاطفه مع الفقراء والمعدمين ونقده للمسيحية التبشيرية الظافرة الغربية "التجارية والمادية الإلحادية المحضة" وكان أركون يأخذ على ماسنيون اغراقه في الاعتقاد الديني، لأن ذلك قد يكون على حساب ممارسة العقل النقدي. (ص366)
الفصل الخامس: يدور حول مقابلتين مع محمد أركون.
المقابلة الأولى: إبتدأت بالنزعة الإنسانية ذات التعبير العربي ونسيانها. أشار أركون لإهتمامه بالمعرفة الإنسانية بمعزل عن التجريد والضياع في غياهب الميتافيزيقا أو لغو الكلام. وهذه المعرفة بوصفه ولدت في مجتمع عربي وإسلامي وعاشت في مجتمع أوربي.
حاول أن يهتم بالإسلام ومعرفته وإستكشافه بشكل علمي وتاريخي دقيق، ومحاولة الاهتمام باللامفكر فيه فيه في ثقافتنا. إذ يقول: كان لوجودي في فرنسا الأثر المهم في محاولة الكشف عنه ومحاولتي البحث عن الإنسان ودوره وأهميته في ثقافتنا العربية والإسلامية، ولذلك كتبت الدكتوراه عن "النزعة الإنسانية في القرن الربع الهجري" مستخدماً المناهج الغربية، مبتدءاً بالمنهج الوصفي والدرارسة التحليلية ـ النقدية ـ التفكيكية. (ص380)
ينعى أركون نفسه في هذا الحوار وكل ما كتبه لأنه لن ولم يلق آذاناً صاغية، لأن الساحة محتلة إما من قبل أصحاب الخطاب الديني الرسمي وإما من قبل اصحاب الخطاب الأصولي السياسي العنيف. فكل خطاب آخر ممنوع إما بحجة التغريب والغزو الفكري وإما بحجة الكفر والخروج عن الإسلام. (ص383) ولأن خطاب أركون يعتمد المنهجية التاريخية أو الاجتماعية السوسيولوجية أو الألسنية أو الأنثربولوجية النقدية لدراسة الاعتقاد الديني متمثلاً بالإسلام والشعائر التي تعبر عنه، لذلك نجد جماعات الإسلام السياسي و مشاركيهم من فقهاء السلطة يرفضون مثل هكذا رؤية نقدية وعلمية للإسلام. (يبنظر: ص385)
يتسائل أركون عن العلاقة بين إسلام الأمس متمثلاً بالفارابي وابن سينا ومسكويه والتوحيدي وابن رشد وابن عربي وبين إسلام اليوم؟ فيجيب إن اسلام اليوم "منغلق، متخلف" لأنه يأخذ من نفايات الحداثة الإستهلاكية السطحية ويترك الجوانب التحريرية الهائلة للحداثة الفكرية والعقلية والابداعية، وهي مكتسبات أصبحت كونية اليوم، لكننا لانعبأ بها. (ص386)
مشكلة المسلم أنه لم يتسائل عن المكانة المعرفية للقرآن. ولا يتسائل عن الكيفية التي تشكل فيها القانون الوضعي المدعو الفقه. فأصبحنا نحيطه بهالة من القدسية متنتاسين أنه من وضع البشر وهو مفهوم مختلف عن الشريعة. ولا أحد يتسائل عن استقلالية القضاء عن السلطة السياسية. ولم يُطرح سؤال عن مصادرة الدين الإسلامي وتأميمه من قبل السلطة السياسية منذ أيام معاوية ابن ابي سفيان وحتى هذه اللحظة.(ص386)
المقابلة الثانية: دارت حول ماهية النزعة الإنسانية التي يقصدها أركون، وكنا قد أشرنا إلى أنه يقصد بها بالتحديد رؤى الفلاسفة المسلمين وبالأخص مسكويه والتوحيدي وتتويج هذه النزعة في أطروحات ابن رشد ودفاعه عن العقلانية.
يؤكد أركون على انفتاح العقل الفلسفي في هذه المرحلة على العقل الديني على الرغم من مهاجمة العقل الديني للعقل الفلسفي وإدانته المستمرة له. (ص409)
يُرجع أركون أسباب نشوء هذه النزعة لوجود طبقة اجتماعية مؤلفة من التجار الأغنياء ومنفتحة على الثقافة الجديدة وترعاها وتدعمها مادياً. مؤكداً أن الفعالية التجارية تُحبذ التفكيك التأملي الحر وتشجع عليه، كما تُشجع على المعرفة الابتكارية والعقلانية النقدية. مؤيداً قوله هذا بدعم البرجوازية الغربية الأوربية لمثل هكذا نوع من التفكير في عصر النهضة. مع علمه بهشاشة وصغر الطبقة البرجوازية (التجارية) في عالمنا العربي الإسلامي في ذلك الوقت (ص411) ومع غياب هذه الطبقة وهيمنة القوة الأوربية على التبادلات التجارية، بدأ الإسلام الشعبي للطرق الصوفية بالانتصار على الإسلام العالم (المثقف) الذي كان يسمح بحصول مناضرات خصبة بين الفكر الفلسفي والفكر اللاهوتي إبان العصر الذهبي. (ص411) أما الذي يجري اليوم على يد دعاة السلفية فإنهم يدعونا إلى أسلمة الحداثة وليس إلى تحديث الإسلام. (ص416)
د. علي المرهج - استاذ فلسفة
..................
[1]ـ محمد أركون: نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت ـ لبنان، ط1، 2011عدد صفحات الكتاب 432 صفحة من القطع الكبير، صادر عن دار الساقي ببيروت بطبعته الأولى لعام 2011م. قدم له المترجم بـ 81 صفحة للتعريف بمؤلف الكتاب ومشروعه الفكري وأهمية الكتاب والتعريف بمحتوياته.
[2]ـ مفكر مسيحي كاثوليكي ماروني، أتقن اللغة العربية وقرأ الكير من كتب التصوف الإسلامي.
[3]ـ مفكر لاهوتي لبناني مسيحي مُتخصص في العلوم الإسلامية والعربية ومهتم بتنشيط الحوار المسيحي الإسلامي، تخرج من جامعة باريس، كانت أطروحته للدكتوراه بعنوان"إبراهيم في القرآن الكريم".كان من المؤمنين بالتعددية الدينية لأنها السبيل الوحيد للعيش المشترك.