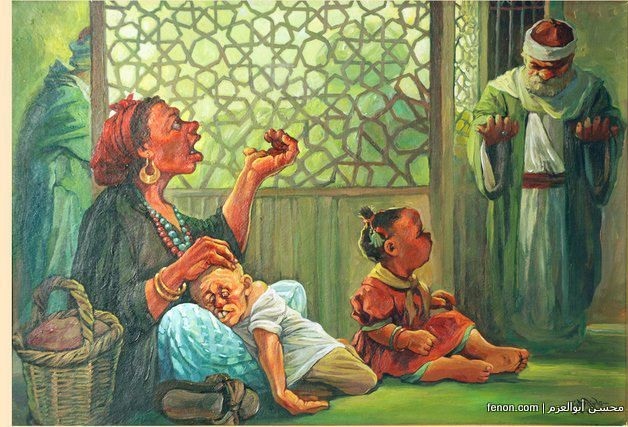صحيفة المثقف
فلسفة الصفات الإلهية عند الغزالي
 "بين صفات الله وصفات الخلق
"بين صفات الله وصفات الخلق
ما بين ذاته العزيز وذواتهم".. (الغزالي)
تظهر معضلة الصفات حالما يصبح الموصوف معيارا لأوصافه، أو أن تصبح الأوصاف أسلوب الكشف عما في مضامينها من قيمة وغايات عملية. وبهذا المعنى، فإنها تكشف في آن واحد عن تعمق "المعارف الكمية"، وعن الطابع العملي لغاياتها النهائية. وليس مصادفة أن تظهر مسألة الصفات الإلهية في بداية نشوء الخلافة، ومن بعدها قضايا الذات الإلهية. وذلك لأنها كانت من الناحية التاريخية والعملية المقدمة الضرورية لاختبار العلم والعمل في صراعات الأمة الآخذة في التجزئة. فإذا كانت الذات الإلهية هي المحور الأولي والنهائي لإسلام الدعوة والرسالة، فإن الصفات الإلهية هي الميدان الأول لتجلياتها العديدة في رؤى الفرق والمذاهب ومواجهاتها في مجال الموقف من العقل والنقل. وبهذا تكون مسألة الصفات الإلهية هي نفسها مسألة الذات الإلهية بأبعادها الاجتماعية. إذ لم تعن قضية الصفات الإلهية، من الناحية التاريخية، سوى قضية الذات الإنسانية وصفاتها المثالية. أنها تعكس تجارب التاريخ المثالية، مما ألزمها بالضرورة تجزئة الإلهي والإنساني كمعايير لرؤية الذات الانسانية "العليا" و"الدنيا"، و"السماوية" و"الأرضية"، والفاضلة والمرذولة. أما نموذجها اللاهوتي فهو وحدة العبودية والربوبية، أو الإنسان والله. وبهذا المعنى ليست علاقة الذات بالصفات، سوى علاقة الأنا بذاتها أو صفاتها. وهي الإشكالية التي أثارت في تقاليد الإسلام السابقة للغزالي حوار وجدل هو هي، وهي هو، وهو لا هي، وما إذا كانت الصفات هي الذات، أو ما إذا كانت غيرها، أي ما إذا تتطابق الصفات مع الذات أو لا ومشتقاتها غير المتناهية. وهي الإشكالات التي أثارتها صيرورة التجزئة غير المتناهية في الوجود الاجتماعي الثقافي للأمة الاسلامية.
فقد أدى ذوبان الذات الوحدانية في فعل الفتح الإسلامي، باعتباره توحيدا جديدا للشعوب والأمم في عبودية الله والخلافة، إلى ظهور تجلياتها في صفاتها المفترضة من قوة واقتدار، وجبروت وملك. مما استثار في مجرى تطوره وحدة المنظومات الكلامية وخلافاتها. وليس مصادفة أن تظهر في أول مراحل الخلافات الفكرية السياسية عن الصفات الإلهية مسألة الكلام والقِدَم. فهي الصفات التي تعبّر في رمزيتها عن التاريخ والمطلق، والتي عادة ما تداعب قوى الخيال السلطوي والأخلاقي. لهذا كان بإمكان رجال الورع الإسلامي الأوائل أن يصرخوا بوجه السلطة متحدين إياها، بأن الله لم يكلم موسى تكليما ولا اتخذ ابراهيم خليلا، وأن تكبّر السلطة في صلاة العيد بذبحها من قال بذلك، كما لو انها تنحر ضحيتها ككبش فداء أمام محراب سلطتها السياسية.
إن هذا الصدام الذي حدد مواجهة قوى الخيال السلطوي والأخلاقي هو نفسه القائم في كيفية رؤية الوحدة الحقيقية وراء الذات الإلهية وصفاتها. فإذا كان الموقف الأولي من الصفات هو محاولة التعبير عن قيمة الوحدة المطلقة في الذات الإلهية لحالها، باعتبارها نموذجا كاملا ومتكاملا بذاته للأخلاق الإسلامية ووحدتها في الأمة، فإن نحرها أمام محراب السياسة لم يعد من حيث رمزيته السياسية سوى استبداد السلطة في التمتع بحرية الكلام بالكلام المطلق. وقد أخذ يتقاسم الجميع ضرورة هذه الحرية، بعد أن تحولت إلى إشكاليات اللاهوت السياسي. وبعد إرجاعها إلى مصادرها الأولية في الكتاب والسنّة أتخذت هيئة الأفكار المجردة. آنذاك كان بإمكانها أن تتمتع بحرية التأمل الساحر لما في إشكالات الأزل والأبد، وأن تبقى في الوقت نفسه في حيز خضوعها المباشر لتقاليد الكلام في تصوراته عن الذات والصفات والأفعال، باعتبارها الوحدة اللاهوتية لتجارب الثقافة الإسلامية في وعيها الديني والسياسي والأخلاقي.
وحالما تحولت قضايا الذات والصفات والأفعال إلى مشكلات قائمة بحد ذاتها، فإنها تكون قد صنعت عالمها الفكرى الخاص بها. مما حولها بالتالي إلى الميدان الأكثر حساسية في جدل الكلام وتحديده لهوية الذات الإلهية وإشكالاتها الروحية والأخلاقية. وأدى مجمل هذه العملية إلى أن تكف قضايا الصفات عن أن تكون قضايا ميتافيزيقية خالصة. بمعنى انتقالها من واقع الصراعات السياسية إلى ميدان الميتافيزيق الديني، ومنه إلى تأملات الكلام والفلسفة. ومن ثم رجوعها إلى تحليل الواقع الاجتماعي السياسي الأخلاقي. ولم يشذ الغزالي عن حصيلة هذه التقاليد اللاهوتية والفلسفية. على العكس!، انه سعى لربطها ولكن من خلال تطوره النظري واستعمالاته الشخصية في ميادين المعرفة. أنها عكست مراحل تطوره، وبالتالي مواقفه منها استنادا إلى اسسها العقلية وتقاليدها النظرية السابقة، كما هو جلي في ما اسماه بعقائد العوام وتطابقها شبه الكلي في (إحياء علوم الدين) مع ما سبق وأن وضعه في (الاقتصاد في الاعتقاد).
فقد تناول، شأنه في مواقفه من الذات الإلهية، قضية الصفات للمرة الأولى في (تهافت الفلاسفة). حينما أخذ على الفلاسفة المسلمين حججهم المثيرة للجدل عما دعاه بصفات الصانع. فقد أدى فكر الفلاسفة في نهاية المطاف، كما استنتج الغزالي، إلى نفي صفات الصانع (الله). وليس مصادفة أن يناقش أساسا قضايا الإرادة الإلهية والعلم الإلهي، باعتبارها القضايا الجوهرية لعلم الكلام أيضا، في مواقفه من الصفات. فهما يشكلان الوحدة الداخلية للصفات الإلهية الإسلامية كما بلورتها تقاليد علم الكلام. لهذا حاول في معرض انتقاده لآراء الفلاسفة بهذا الصدد إظهار تناقضها الداخلي. ويبدو ذلك بجلاء في جدله معهم حول مسائل الحدث والقِدَم في العالم. إذ لم ير في آرائهم الأرسطية الافلاطونية سوى تأويلات تفتقد لمنطقها الداخلي. وأوصله ذلك إلى استنتاج يقول، بأن حدوث العالم لا يتنافى مع القدرة الإلهية القديمة. وانه لا مانع من أن يراد الشيء في الوقت الذي يحدث فيه إذا كان مرادا بالإرادة القديمة. أما نفي هذه الفكرة من جانب الفلاسفة، فمبني على مجرد "الاستبعاد والتمثيل بعزمنا وإرادتنا"[1]، وقياس الإرادة الإلهية (القديمة) بالمعيار الإنساني (الحادث). بينما لا يمكن للإرادة الحادثة (الإنسانية) مضاهاة الإرادة القديمة (الإلهية). إذ ليست الإرادة من حيث هي صفة سوى تميز الشيء عن مثله، ولولا أن هذا شأنها لوقع الاكتفاء بالقدرة الإلهية[2]. فكل ما في الوجود، وُجِدَ بالإرادة الإلهية من حيث وجوده، وبالصيغة التي وجد فيها، وفي المكان الذي وجد فيه. فالإرادة الإلهية هي شكل تجلي القدرة القديمة. وأن كون الله قديما قادرا لا يمتنع عليه الفعل أبدا إن أراده. أما التناقضات الممكنة هنا فهي نتاج الالتباس والوهم لا غير. ولهذا السبب أيضا حاول في دفاعه عن فكرة الصفات الإلهية إظهار ما في أفكار الفلاسفة من تهافت في تناولها لعلاقة الفاعل والمفعول، والسبب والمسبب. فالفعل بالنسبة للغزالي، مرتبط بالحيوان فقط. أما عندما نسمي الجماد فاعلا، كما في قولنا "الحجر يهوي" فعلى سبيل المجاز. ذلك يعني انه حاول ربط الفعل بالإرادة، ومن خلالها بالعلم. فالإرادة تحتوي بالضرورة على العلم، تماما بالقدر الذي يتضمن على الفعل. وبالتالي فإن الفعل الحقيقي هو الفعل المرتبط بالإرادة والمحدد بها. لاسيما وأنها الصيغة التي يحددها أيضا منطق العقل واللغة. لهذا كتب يقول، بأن من "ألقى إنسانا في النار فمات، يقال هو القاتل دون النار". فاللغة والعرف والعقل تصف الإنسان بالقاتل، مع أن النار هي القاتلة. كل ذلك يدل على أن "الفاعل من يصدر منه الفعل من إرادته. فإذا لم يكن مريدا عندهم ولا مختارا لفعل العالِم، لم يكن صانعا ولا فاعلا إلا بالمجاز"[3]. وطبق هذا الموقف أيضا تجاه صفة العِلم من خلال ربطه الذات بالصفات. إذ لا يعني سلب الصفات بالنسبة للغزالي توكيدا للوحدانية بقدر ما يؤدي إلى نفي حقيقتها. لهذا شدد على أن أدلة الفلاسفة عن واجب الوجود ونفي الكثرة عنه لا دليل لها. إنها تقدم الدليل الدال على قطع التسلسل فقط. أما فكرة "الوجود الأول البسيط"، فإنها تقود في نهاية المطاف إلى دليل نفي الصفات[4].
لقد أدرك الغزالي تعقيدات مسألة الصفات الإلهية، وحيرة العقل فيها. إلا أن جدله الأول سار في اتجاه نقد آراء ومواقف الفكر الفلسفي وعقليته المنطقية في تناول هذه القضية. بحيث جعله ذلك يستغرب لا حيرة العقل في الصفات الإلهية، بل اعجاب الفلاسفة بأدلتهم مع ما فيها من التناقض[5]. أما ذخيرة (تهافت الفلاسفة) الفكرية الجدلية بهذا الصدد، فقد شكلت مادة ومقدمة الصياغة الإيجابية لما وضعه للمرة الأولى في (الاقتصاد في الاعتقاد).
فعندما تناول الصفات السبع في تسلسلها الكلامي التقليدي، فإنه جدولها في كل من القدرة والعلم والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ومعنى القادر انه محدث العالم، لأن العالَم محكّم، مرتّب، متقن، منظوم، مشتمل على انواع من العجائب والآيات. وإن العقل يحكم في رؤيته الظاهرة والباطنة على ما فيه من أحكام وترتيب. غير أن العالم ليس قديماً قدم الذات[6]. أما إشكالية القدرة والقدم والفعل الحادث، فقد حلها على اساس حله لمفهوم الإرادة. فللقدرة علاقة بالمقدورات (الممكنات). وأن الإمكان ما لانهاية له، والقدرة واسعة لكل ذلك. فهو يردد هنا مضمون جدله المعارض لفكرة الفلاسفة عن عدم حدوث المادة. فالإمكان وصف للمادة، والمادة لا يكون لها مادة فلا يمكن بالتالي أن تحدث. إذ لو حدثت لكان إمكان وجودها سابقا على وجودها. وكان الإمكان قائما بنفسه غير مضاف إلى شيء، مع انه وصف اضافي لا يعقل أن يكون قائما بنفسه. ولا يمكن أن يقال "إن معنى الإمكان يرجع إلى كونه مقدورا وكون القديم قادرا عليه" لأننا لا نعرف كون الشيء مقدورا إلا بكونه ممكنا. فنقول هو مقدور لأنه ممكن، وليس بمقدور لأنه ليس بممكن. فإن كان قولنا هو ممكن يرجع إلى انه مقدور، فكأننا قلنا هو مقدور لأنه مقدور، وليس بمقدور لأنه ليس بمقدور. وهو تعريف الشيء بنفسه، أو تحصيل حاصل[7]. فالإمكانية في نهاية المطاف، ما هي إلا جزء من "قضاء العقل"، أي ما قدّر العقل وجوده، وإلا فإنه مستحيل. وينطبق هذا بالقدر نفسه على العدم. وبالتالي فإن قضية الممكن والمستحيل والعدم هي قضايا عقلية.
أما صفة العالِم فمعناها إن الله عالم بجميع الموجودات والمعدومات. فالموجودات منقسمة إما إلى قديم كذاته وصفاته، وبالتالي فهو بذاته عالمٌ وبصفاته، وإما إلى ما هو حادث (الموجودات)، أي انه عالم بغيره. وليس لعلم الله نهاية بفعل لا نهائية الممكنات التي يخلقها بإرادته. إذ الموجودات في الحال، كما يقول الغزالي، و"إن كانت متناهية فالممكنات في الاستقبال غير متناهية"[8].
أما صفة الحياة فمعناها انه حي وهو معلوم بالضرورة. في حين أن الإرادة تعني إن الله مريد لأفعاله. وذلك لأن الفعل الصادر منه مختص بضروب من الجواز لا يتميز بعضها من البعض إلا بمرّجح. ولا تكفي ذاته للترجيح لأن نسبة الذات إلى الضدين واحدة، فما الذي خصص أحد الضدين بالوقوع في حال دون حال؟ وينطبق هذا على القدرة أيضا. بمعنى انها كالذات لا تلغى فيه. إذ نسبة القدرة إلى الضدين واحدة. كذلك الحال بالنسبة للعلم. وذلك لأن كل ما هو ممكن الوجود في ذات علم الله واحد من حيث الإحاطة. آنذاك تكون الإرادة للتعين علة، ويكون العلم متعلقا به تابعا له غير مؤثر فيه[9]، أي أن الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت بها، فميزتها عن اضدادها المماثلة لها. وبالتالي لا معنى للسؤال عن أسباب هذا التميز وأسراره، لأن معارضتها شبيهة بقول القائل "لِمَ اوجب العلم انكشاف العلوم؟ إذ لا معنى للعلم إلا ما اوجب انكشاف العلوم"[10]. فالإرادة متعلقة بجميع الحادثات من حيث انه أظهر أن كل حادث مخترع بقدرته. وكل مخترع بالقدرة محتاج إلى إرادة تصرف القدرة إلى المقدور وتخصصها به. فكل مقدور مراد وكل حادث مقدور وكل حادث مراد. والشر والكفر والمعصية حوادث فهي اذاً لا محالة مرادة[11].
أما صفات السمع والبصر فمعناها ما أراد الشرع وما ورد فيه قوله "وهو السميع البصير". غير أن الغزالي حاول أن يعطي لها طابعا عقليا من خلال إدراجها في اطار التنزيه العام على أساس فكرة "ليس كمثله شيء"[12].
أما أساس صفة الكلام فيقوم في أن "صانع العالم متكلم". لكن ليس بمعنى الكلام الإنساني. فالإنسان يسعى متكلما باعتبارين، الأول باعتبار الصوت والحرف، والثاني باعتبار النفس. وإذا كان الغزالي قد جعل من حديث النفس ما يمكنه أن يكون مثالا ملموسا للكلام الإلهي انطلاقا من تراث الجدل الفكري حول هذه القضية القائل بأن كلام النفس الإنساني هو مجرد قوة مفكرة تستند إلى لفظ الحروف وترتيب المعاني، والذي حاول كشفه من خلال بلورته مضمون "الأمر الالهي". فمقصود الكلام هنا هو العلم والإرادة والقدرة. فالأمر هو دلالة على أن في النفس طلب فعل المأمور. وعلى هذا يقاس النهي وسائر الأقسام الأخرى من الكلام. إذ لا يعقل أمر آخر خارج عن هذه الجملة. فبعضها محال عليه كالأصوات، وبعضها موجودة لله كالإرادة والعلم والقدرة. فإن قول السيد لغلامه "قم!" يدل على معنى. والمعنى المدلول عليه في نفسه هو كلام. فالطلب الذي قام بنفسه دل عليه لفظ الأمر عليه، هو كلام وهو غير إرادة القيام[13]. انه سعى لإزالة التشبيه. لهذا حاول تأويل الفكرة القرآنية في تكليم الله موسى، بالصيغة التي ألغى فيها الصوت (المادي). وانطلق فيموقفه هذا من أن السمع هو نوع من الإدراك. وبالتالي لا يمكن الاجابة عن السؤال المتعلق بكيفية إدراك حلاوة السكر إلا بأن يقال ينبغي أن يذاق، كذلك الحال بالنسبة لتكليم موسى. لهذا اكد في مجرى تناوله قضية القرآن باعتباره معجزة الله، من أن كلامه مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، مقروء بالألسنة، وإن الكاغد والحبر والكتابة والحروف والأصوات كلها حادثة، لأنها أجسام وأعراض في أجسام. فكلام الله القديم هو المدلول لا ذات الدليل. مثلما نقول كلمة النار ولا تحرقنا[14].
إن هذه الصيغة "الإيجابية" التي ردّ فيها على آراء الفلاسفة عن الصفات ما هي في الواقع سوى النموذج التوليفي لتقاليد اللاهوت الإسلامي العقلاني في مواقفه من الذات والصفات. وهو الذي يفسر سرّ بقائها وحيويتها في (إحياء علوم الدين) كعقائد للعوام. فهو يعيد هنا بصورة مختصرة ومغايرة لجدل الإفحام، المكونات الجوهرية لإبداع الكلام الإسلامي عن الصفات الإلهية، باعتبارها عقائد تخدم وحدة الكلّ الروحي الإسلامي. فالقادر معناه هو الذي لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم. وهو المتفرد بالخلق والاختراع، المتوحد بالإيجاد والإبداع[15].
أما العالِم فمعناه انه عالِم بجميع المعلومات، محيط بما يجرى في تخوم الأرض إلى أعالي السموات، يعلَم كل شيء بعِلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به، لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال[16]. وأن دليل إحاطة علمه بجميع الموجودات هو وجودها في المخلوقات وترتيبها. إذ أننا نلاحظ الترتيب في كل شيء، بما في ذلك في "أحقر الموجودات". وهو دليل العلم بكيفية الترتيب[17]. أما قِدَم علمه فيعني انه لم يزل عالما بذاته وصفاته ما يحدث من مخلوقاته، أي حصولها مكشوفة له بالعلم الأزلي تماما كما أن معرفتنا بوصول زيد غدا لا يعني تجدد المعرفة والعلم في حالة وصوله[18].
أما كونه حيًا فدليله أن من يثبت علمه وقدرته يثبت بالضرورة حياته[19]. في حين إن معنى كونه مريدا هو إرادته للكائنات وتدبيره للحادثات. فلا يجرى في الملك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدره وحكمة مشيئته. فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وإن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته، ولم يزل كذلك موصوفا بها، مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوُجِدَت في أوقاتها كما أرادها في أزله من غير تقدم ولا تأخر. بل وقعت على وفق علمه. بمعنى أن الله مريد لأفعاله. إذ لا وجود إلا وهو مستند إلى مشيئته وصادر عن إرادته. فهو المبدئ والمعيد والفعال لما يريد (الشيء وضده). والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة. فلا بد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين. ولو أغني العلم عن الإرادة في تخصيص المعلوم حتى يقال له إنما وجد في الوقت الذي سبق بوجوده، لجاز أن يغني عن القدرة حتى يقال وجد بغير قدرة لأنه سبق العلم بوجوده فيه[20]. فإرادته قديمة وهي في القِدَمِ تعلقت بأحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها على وفق سبق العلم الأزلي[21].
أما كونه سميعا بصيرا فيعني انه يرى ويسمع ولا يغرب عن سمعه مسموع وإن خفى، ولا يغيب عن بصره مرئي وإن دقّ. يرى من غير حدقة وأجفان ويسمع من غير اصمخة وآذان، كما يعلم بغير قلب ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة. إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق[22]. سميع بصير، وكيف لا والسمع والبصر كمال لا محالة وليس بنقص؟ فكيف يكون المخلوق اكمل من الخالق والمصنوع أسنى وأتم من الصانع؟ وكيف تعتدل القسمة مهما وقع النقص في جهته والكمال في خلقه وصنعته، وكيف يعقل فاعلا بلا جارحة وعالما بلا قلب ودماغ، فليعقل كونه بصيرا بلا حدقة سميعا بلا أذن، إذ لا فرق بينهما[23].
أما كلامه فمعناه انه متكلم، آمر، ناه، واعد بكلام أزلي قديم بذاته لا يشبه كلام الخلق. فليس بصوت يحدث من خلال انسلال هواه. وإن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله. وإن القرآن مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ بالقلوب. وانه مع ذلك قديم قائم بذات الله لا يقبل النفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق[24]. ولا يعني انه إلهاً متكلما بكلام سوى انه وصف قائم بذاته. ليس بصوت ولا حرف، بل لا يشبه كلامه كلام الخلق. فكلام الله مقروء بالألسنة محفوظ بالقلوب مكتوب بالمصاحف، من غير حلول ذات الكلام فيها كعقل كون السموات والأرض مرئي في مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحلّ ذات السموات والأرض في الحدقة، أو ككلمة النار في القلب و على الورق دون أن تحرقهما[25].
ميثم الجنابي
......................
[1] الغزالي: تهافت الفلاسفة، ص98.
[2] الغزالي: تهافت الفلاسفة، ص102.
[3] الغزالي: تهافت الفلاسفة، ص137.
[4] الغزالي: تهافت الفلاسفة، ص191.
[5] الغزالي: تهافت الفلاسفة، ص205.
[6] الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص39.
[7] الغزالي: تهافت الفلاسفة، ص119.
[8] الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص47.
[9] الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص48.
[10] الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص50.
[11] الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص51.
[12] الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص52-53.
[13] الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص56.
[14] الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص58.
[15] الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص90.
[16] الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص90.
[17] الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص108.
[18] الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص110.
[19] الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص108-109.
[20] الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص109.
[21] الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص110.
[22] الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص91.
[23] الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص109.
[24] الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص91.
[25] الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص109.