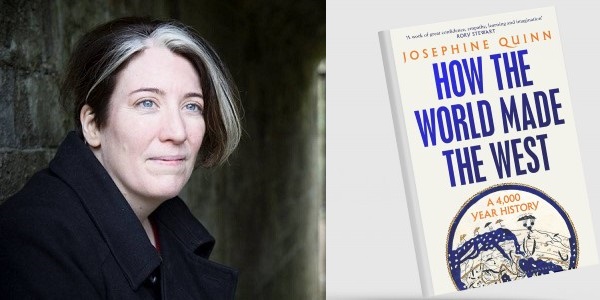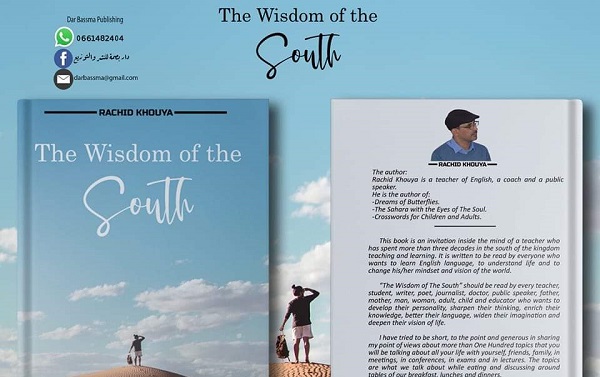أقلام فكرية
سامي عبد العال: في غياب الفلسفةِ، ماذا تفعل الثقافةُ؟ (1)
 إشكال جديد
إشكال جديد
ضمن حدُود الفكر الغربي المعاصر، أضحت الفلسفةُ مشكلةً بالنسبة إلى ذاتها. حَدَثَ ما يمكن تسميته بالـ" تُخْمةٌ الفلسفيةٌ "، نظراً لتضخُم Inflation صور العقل واتجاهاته المتناقضة من جهةٍ ولصور تفكيكه والهجوم عليه من جهةٍ أخرى. لقد جرت عملياتُ نقدٍ جذري لبنية العقل من جميع الفلسفات حول شيء باتَ مُراوغاً وغيرَ معين. ما هذا الشيء المسمى بالعقل تحديداً؟ ما طبيعته؟ وكيف يُمارس دوره وسط التقدم التقني والمعرفي المُذهل؟.. وجميعها ظلت اسئلةً حائرةً لا تجد أدنى إجابات شافية لها.
على أثر هذا النقد، ظهرت مصطلحات شتى: العقل التقني، العقل الاستعاري، العقل الجسدي (المجسدَّن)، العقل ما بعد الديني، العقل العلماني، العقل التَّواصُلي وأخير العقل التأويلي والعقل الافتراضي (الحاسوبي). جاء العقلُّ كأنَّه (ثعبان أسطوري) يلتهمُ ما يقابله من رؤى ومذاهبٍ، بقدرته الفذة على انشاء الأنطولوجيات الفكرية واستعمالها عبر مجالات الحياة.
وكأنَّما الفلسفة- بوصفها نتاجاً للعقل- قد افترضت حُضورَها الطاغي دون سواها من خلال حضور موضوعاتها. ليتمَّ بذلك تجريد الحياة - برأي نيتشه - من طاقتها الحيوية لصالح مبدأ أو قانون أو آلية فكريةٍ ما هي السائدة فوق أي شيء آخر. وقد عبر عن تلك المسألة بوضوح تيارُ ما بعد الحداثة في أكثر من سياقٍ على سبيل المثال: جان بودريار (الاعلام والاقتصاد) وفرانسوا ليوتار (المعرفة والكتابة) وامبرتو ايكو (الأدب والسيميوطيقا) وأنطوني نيجري (السياسة والعولمة) وجياني فاتيمو (الفلسفة والأيديولوجيا) وجودث بتلر (النسوية والفلسفة) وسلافوي جيجك (السينما والفكر والواقع الافتراضي).
وإذا كان الوضعُ الفلسفي هكذا خلال مشاهده الأخيرة غربيَّاً، فإنَّه يختلف عن غياب الفلسفة في مجتمعاتٍ لا تعبأ بـ (إمكانياتها) مثل المجتمعات العربية والشرقية حتى. هاهنا بالتحديد يمثل الغيابُ (ظاهرةً ثقافيةً) عميقةَ الجذور، وهو غياب ضخم يترك فراغاً بحجم الثقافة ذاتها. لأنَّ كل غياب من هذا النوع الكبير يعد سؤالَ فكرٍ بالدرجة الأولى، سؤال حول محدداته العامة التي هي من جنس البدائل الثقافية التي تأخذ مكانه. وليس الغياب سؤالاً ميتافيزيقياً ولا لاهوتياً ولا مذهبياً ولا أيديولوجياً. وإنْ كانت جوانب كهذه قد تتواطَّأ لإهماله وإقصائه بحكم تكوين الثقافة تاريخياً وطابعها الغالب.
الفلسفة لدينا نحن العرب تمثلُّ مصدرَ ازعاجٍ ثقافياً بحسب ما يُقال في الخطابات اليومية مثل الأقوال الشائعة: " بَطَّل سفسطةً.."، " تكلَّمْ في الموضوع مباشرةً دون لف ودوران ودون فلسفةٍ.."، ".. " نعوذ بالله من الفلسفة ومن زلل القول والفعل.."،.. " من تمنطق فقد تزندق". وهي عباراتٍ متداولة تصدُّ إرادة كل من يفكِّر بشكلٍّ مختلفٍ. إنها عبارات تصمت- رغم بنية كلامها العام- كهسيس الليل دون إبداء الأسباب والتبريرات. ويغدو الإسكات- في غياب الفاعل الواضح - تدخُلاً جمعياً خشناً لمنع الآراء والأسئلة الخاصة. فيكون الردُ المتوقَّع من كل متحدث في هذا الإطار: (هو السؤال حُرم..).
أي هلَ كان السؤال ممنوعاً من الأساس، هل السؤال حرام وتمَّ تحريمه بفعل فاعل لا نعرفه؟، حتى أننا لا نستطيع التكلم فيما نريد!! ولذلك من الأفضل أيا هذا المتسائل – وفقاً للتوجُّه الثقافي العام - ألَّا تسأل حول الموضوعات والقضايا المسكون عنها بعد الآن. وأن تقبل ما سيقال لك بأريحية تامة، مجبراً أم غير مجبر.. فليست تلك هي المسألة، لكن المسألة أن تكون مستقبلاً ومتلقياً وكفى وأن تمتثل للحالة السائدة. فالتحريم المشار إليه هنا تحريم ثقافي، لكنه قفز عن أصله الديني ليمثل قطعاً تجاه مُساءلة المناخ العام ونقده.
الفلسفة قدرة تساؤلية نقدية لاستعمال إمكانيات العقل في كافة قضايا الإنسان، أي اختبار مدى عقلانية العقل ونتاجاته. إنَّها تتخطى النظر الاعتيادي إلى إدارة طاقات الفكر بأدوات الحوار والمناقشات والفهم وضروب الأسئلة البعيدة. وهي بذلك النشاط تقنية إنسانية متفردة في صقل الفكر وتوسيع آفاقه انتظاراً للمستقبل، انتظارٌ يليق بانفتاح الإنسان وحريته المبدعة. ولا تجد الفلسفة مجالاً سوى تحرير تلك الآفاق مما يحجبها أو يوظفها لأسباب خاصةٍ. فهي لا تخدم سوى العقل وتعيد النظر تجاه مساراته وحركته الحيوية باستمرار. حتى لو كانت الخطوة الآتية هي تخليصه من نتاجاته الفكرية، إذا تسرطنت بالخرافة والتقاليد والأيديولوجيات والتوجهات المغلقة. فالتفلسف عندئذ أداة انفتاح للتفكير ضد موروثات العقل لو تكلَّست على أشكال بعينها.
وهكذا فإنَّ كلَّ (غيابٍ للتفلسف) يطرحُ بديلاً من جسد الثقافة ضمن أشكالٍّ تابعةٍ لنمطها الحاكم. وقد يكون البديلُ سياسياً أو دينياً أو شعبوياً أو تراثياً أو رؤى للكون والحياة. وفي أحيان أخرى يترك الغياب فراغاً بتداعياته الممتلئة (أي بإيجاد بدائل مشوَّهة تقوم بالدور نفسه). مما يُحدِث " ثُقباً أسود " يمتصُ ثراءَ الحياةِ ويشغل الوعي الجمعي بأمور تافهة. فالمساحة المتروكة مشاعاً بين المجالات المختلفة– كبديل للفلسفة- تظل نهباً لعقائد وآراء غامضة وممارسات خطابية تحجب قدرات العقل. وخاصة أن الفكر الإنساني ما لم يجد ترجمةً لقدراته الابداعية يظل قيد التصورات الجارية واضعاً سلطته ضد التغيير (ببساطة يصبح الفكر دجما dogmatism- الجهل المقدس بعبارة أوليفييه روا).
في هذا السياق، تتجاوز (مسألة الغياب) أيَّة اشارة لأهمية الفلسفة والشرح لمكانتها، وما إذا كانت علاقتُّها المنشودة بالمعارف العلمية قويةً أم لا. مسألة غياب الفلسفة لا تتفق حتى مع منحى كهذا كما تتداول أفكاره اليوم، ولا كما تأخذ وقتاً من المماحكات بين الإنكار والإثبات دون طائلٍ!! إنَّ التفلسف ليس شعاراً كشعارات المراحل التاريخية أو السياسية من باب التحقيب الزمني.. ولن يكون التفلسف كذلك ضرباً من سياسات اللغة. إنَّه " وعيٌّ مغاير " خارج كلِّ أُطر فكرية تُحجِّم قدراتنا على التفكير، حتى بالنسبة لتلك التي يُطرح فيها كاستفهامٍ حول ذاته.
سؤال الفكر
لعلَّ "غياب الفلسفة" مشكلةٌ تخصُ سؤال الفكر العام وطاقاته حين تنشغل بملء الغياب الحاصل عن طريق معارف وأفكار أخرى. إذ تحاول الأخيرةُ - دون جدوى- رتق هذا الثقب الأسود غير القابل للاحتواء في المجتمعات بسهولة. لأنَّ غياب التفلسف يرسم- أو هكذا يُفترض- فضاءات فكرية متعدّيةً بدلالتها نحو مجالات أكثر عمومية. فمن قلب الأزمة الثقافية لدى العرب الآن تُثار على سبيل المثال أزمات فكرية بوصفها خارج السيطرة، وأنَّه يصعب معالجتها على نحو جذري وأنَّ هذه الرؤية أو تلك غائمة لدى أغلب النخب وأن تخطيطاً للمستقبل في مجالات كثيرة غير واضح المعالم. وقد تصبح المجالات ذاتها مضماراً للتخبط وضيق الأفق وظهور الأزمات ولاسيما مع تحولات السياسة نتيجة ما سُمى مؤخراً بالثورات العربية. وأحياناً قد تُستدعى إشكاليات الفكر كأعراض مشوَّهةٍ حين نحاول تجديد الخطاب الديني أو مناقشة قضاياه.
إذن الأسئلة الرئيسة التي يجب طرحها فلسفياً كالتالي: كيف نفكر، وبأيَّة أسسٍ نمارس التفكير؟ هل ستقول الفلسفة شيئاً مختلفاً في المجال العام عن باقي الإنشطة الأخرى؟! كيف نجرب إنسانيتنا المميزة لنا في حدود العالم الراهن؟!..لا لنطرح ماذا يُراد للفلسفة أنْ تكون إزاء هذا الموقف أو ذاك، إنما قد يكون الأمر لمعرفة ماذا سيحدث في غيابها تحديداً؟ مما يعني أنَّ الفلسفة فاعلةٌ، سواء أكانت تحضر زمنها أم تَغيْب عن المشهد (= بالأدق تُغْيَّب).
عندئذ تعد الفلسفة ظاهرةً أساسيةً تأتي وتروح عبر مجتمعات قد تلفُظها نتيجة الظروف التاريخية والثقافية غير المواتية. وقد تمثل الفلسفة حالة عبور طارئ نحو معانٍ أخرى على جوانب التاريخ كما حدث مع بعض الأفكار الفلسفية حول الإنسان والإله والعالم، ولكنها في كل الأحوال تشير إلى معانٍ أصيلة للحياة لم تُكتشف بعد. وتُظهِر ماذا هناك في مجتمعاتٍ كهذه من عدم مواكبة العصر وتراجع الإبداع واجترار الموروثات التقليدية.
يُؤكد ديكارت في غير مرةٍ إنَّ " أعظم خير يمكن أنْ تقدمه ثقافةٌ ما لأية أمة من الأمم هو أنْ يكون فيها فلاسفة حقيقيون ".. فهل نضب الخيرُ ببعض المجتمعات حال غياب فلاسفتها؟ ولنلاحظ أنَّ ديكارت طرح الخير كإطار أخلاقي تمهيداً لولادة الفلسفة فكرياً. أي أنَّ الأخلاقيات الفكرية قد تكون مدخلاً لثقافة مغايرة لو كانت ثمة بيئة ملائمة لولادة التفلسف. فالشر كل الشر يكمن في انعدام التفكير الحر والخير كل الخير يجري في الإبداع العقلي. ففضائل القوة الكامنة فينا بلغة نيتشه تحرر الإنسان من عبوديته للتقاليد الرثة. وقد تكون سبباً لتدمير المجتمعات وقتل الآخر باسم الإله كما رأينا لدى جماعات الإرهاب الديني.
لكن ستظل القضية الشائكة هي: كيف تنهض (أو تنكص) الثقافة بإنتاج هذا الصنف النادر من (التكوين العقلي الحر)؟
لعل القضية السابقة ليست قضية خاصةً بنوعة من البشر كما أشرت. فلا نتجادل عادة في مثبل هذه الحالات حول: ما إذا كانت هناك فلسفة من عدمها أم لا؟ كما لو كانت عملية التفلسف نعمة لاهوتية تُعطيها سلطةٌ مقدسة أو تُمنح تلقائياً دون مقدمات!! ولا يجب أن نطرح فكرة تعريفات الفلسفة- كما يؤيد البعض- بوصفها مسلمات خارج ظروف الإنسان. أتصور أن القضية اللافتة للنظر هي: ماذا تفعل الثقافة في حالة إهمال التفلسف؟ وكيف ستفعل بهذا الاهمال مع وجود البدائل؟ وهل الثقافة نفسها أسهمت في عملية الغياب، وبأي معنى وبأي شكل سيكون غياباً؟ على طريقة العبارة الدارجة: " إنْ غاب القِطُ إلعب يا فار"،.. إذن بأي أفقٍ تستعيد ثقافةٌ ما (حيوانيتها) داخل المجتمع باعتبار الفلسفة فناً لترويض الحيوان البشري وترجمة قدراته النسقية؟!
ذلك الأمر الشائك مهم للأسباب الآتية:
1- تتطلب الفلسفة معالجةً جديدةً ارتباطاً بنمط التفكير العام الآخر دائماً (خارج التفضيلات الشخصية وخارج أنماط السلطة الغالبة)، فكل فلسفة هي ضرب من ضروب الوجه الآخر للحياة والفكر.
2- لا ينبغي ربط التفلسف بهباتٍ اجتماعيةٍ أو سياسيةٍ إنْ توافرت (تحت مراقبة السلطة والنخب أو القوى) سيكون موجوداً هذا النوع من الفكر بشكلٍّ خاص. لأن بعض الآراء ترى في الفلسفة هبةً سياسةً أو غيرها من بعض الإنظمة الحاكمة أمام المثقفين أو المشتغلين بالفكر.
3- الفلسفة ليست ديناً ولا معتقداً ولن تكون، ولكنها نشاط إنساني ضروري لدرجة كونها تبلغ مُؤشراً لما يحدد سمات الحياة الجارية. فالفلسفة تعبر بلا شكٍ عن السمات الكلية لنمط الثقافة وكذلك لما يتميز به الوعي.
4- الفلسفة (وجوداً وغياباً) كاشفةٌ على نحو كليٍّ أكثر من كونها مبحثاً فرعياً قيد الدراسة والمعرفة.
5- آثار التفلسف - بالسلب أو الإيجاب - تترك فراغاً شاغراً في مجالات التفكير العام. بالسلب لأنَّها قد لا تجد مكاناً عبر الثقافة. وبالإيجاب لأنَّها تفتح آفاقاً وتفترض رؤى مبتكرة، وتتطلب مزيداً منها بحسب التطورات.
6- ثمة أهمية للاعتناء بنشأة الفلسفة ثقافياً في المجتمعات المختلفة: كيف كانت في ميلادها اليوناني والعربي؟ وكيف صارت، وإلى ماذا تحولت في عصور تاليةٍ؟ والأهم كيف ستنشأ بطرائق جديدة أو مختلفة في ثقافة ما بعيداً عن موطنها الأصلي؟
7- الفلسفة ليست وسيطاً لشيءٍ آخر كأنْ تخدم السياسات أو التقاليد الجارية أو العلوم. وإن تمَّ ذلك، فهي تتنكر لذاتها ولما تفعله قبل أي شيء آخر.
8- بالمقابل لا تستطيع المجتمعات أن تجيب عن تساؤلاتها (ما المجتمع، ما الحقيقية، ما التاريخ؟) دون الوقوع في فخ الاستقطاب تجاه الأفكار الغالبة. ورغم ذلك لا تكف المجتمعات عن إشغال مساحتها (هذا الفضاء) بخطابات جانبية. كحال خطابات السلطة عندما تأخذ مكان الفكر وتتحدث باسمه.
9- الفلسفة تاريخياً- من جانب آخر- ممكن أنْ تُدَّجن، وقد تنطق بلسان مرجعيةٍ ما كالفلسفات اللاهوتية أو الفلسفات ذات الطابع الأيديولوجي. غير أنها تصبح مسخاً كالبهلوان، بقدر ما يضع مساحيق وألواناً يُضحك الجمهور ويثير روح السخرية لديهم. لكنه يلامس بحركة السخرية نقدَ أحوالهم وإضحاكهم حتى البكاء إزاء أوضاعٍ بعينها (المفارقات الساخرة كما يقول هنري برجسون في كتابه عن الضحك).
10- في غياب الفلسفة هناك مشكلات (الإسفاف الفكري) وتشوُّه الرؤى وانتشار العنف والارهاب والانغلاق الثقافي والانتفاخ المزيف تزامنا مع الاستبداد والقمع السياسيين والاجتماعيين. مشكلات ثقافية تلوي عنق الفلسفة، وتحدد المواقف منها وتقع بالعمق من فضاءٍ بإمكان التفلسف أن يُعرِّي أسسه.
فعل الثقافة
بالمقابل فإنَّ كملة " تفعل" الواردة في التساؤل (ماذا تفعل الثقافة؟!) تفتح مجالاً لأثر الثقافة بعيد الأمد. وهو فعل يختلف عن أجناس الأفعال الجزئية المعروفة عادة. لأنَّ الثقافة إيقاع كلي لرؤى الحياة ولرمزية المعاني التي تحدد سلطة الأفكار والتقاليد. فالثقافة نوع من ممارسة التكرار الزمني فيما يدفع الأنشطة الإنسانية وفق (تاريخ وتراث) بعينهما.
والأمر قريب من طريقة ممارسة الكتابة على صفحات الكمبيوتر. ففي هذه الكتابة الافتراضية ليست المسافات البيضاء بين السطور والفقرات والجمل والهوامش عدماً خالصاً ولا هي سالبة (غير محسوبةٍ)، بل تعد جزءاً لا يتجزأ من آليات الكتابة ذاتها رغم أنها مساحة بيضاء. إنها نوع من الكتابة بالفعل باعتبارها إجراءً معبراً عن معانٍ ما داخل النصوص المكتوبة. وعندما نعالج تنظيم الكلمات والحروف والجمل من جهة التوزيع والتخطيط والتدبيج، تؤثر كل مسافة بين الكلمات والسطور والفقرات في النص المكتوب أو في الرسوم من جانب الحركة والتوزيع الفضائي للكلمات والأشكال كما لو كانت هناك كتابة تماماً في هذا الفراغ. وتلك اللعبة الخفية والقائمة على فاعلية المسافات والزمن هي الطريقة الأساسية لعمل الثقافة في المجتمعات الإنسانية.
إنَّ جوهر الثقافة يكمن في هذا الكل الذي ينتشر هنا وهناك، إذ يغطي (يبرر- يقنن- يمارس- يرمز – يعطي دلالة- يضمن معنى) لكل الأفعال والأفكار، أي أنَّه عبارة عن تحرك نوعي بدلالته العامة ويعطيها شكلاً ومضموناً تبعاً لتوجهات الثقافة. ولهذا فالسؤال المشار إليه (ماذا تفعل الثقافة؟!) سؤال حدثي eventual (وقائعي)، لكونه قابلاً للحدوث اليومي من واقع الواقع المعيش، ولأنه مشبع بدفقات وأخيلة ورواسب ثقافية ضمن التفاصيل الجزئية. وهي أغلبها أشياء جارية دون الوعي المباشر بمستويات الحياة الفورية. بمعنى أن أي فعل ثقافي راهن هو تأويلٌّ زمني لأصولها البعيدة، تأويل سلطوي بالضرورة وإلاَّ لما استطاعت أن تحكم نمط الاعتقاد السائد.
لا يفوتنا في هذا الإطار أنَّ كلمة الثقافة بحروفها العربية تعنى " الشحذ والتبرية". ثقف (شحذ) الرمحَ جعله حاداً ونافذا حال إطلاقه. وثقَّف حدَّ السكين جعله ماضياً وقاطعاً. وتلك العملية بها أربع نقاط:
- القدرة العامة على ترويض شيء ما سابق على الشحذ والتهيئة.
- إدخال ممكنات تالية من خلال الإعداد لما هو قادم.
- صقل الأدوات الفكرية والحسية للإنسان عبر إمكانيات الكل الثقافي.
- التثقيف عنف ليس أقل من انقلابه على نفسه بأسلوب ملتوٍ في جوانب أخرى من الحياة.
ويعني ذلك أنَّ لنظام الثقافة أربعة معالم في ضوء النقاط السابقة:
أ- الإلحاح: وهو بمثابة الدوافع الثقافية والمبررات التي تبدو مقبولة ومتواصلة لدى الفعل. فكل ثقافة تعطي فاعليها مبرراً للإلحاح على ما يمارسون، وتبدو كما لو كانت نوعاً من المعاودة والإصرار على وجوه معينة دون ملل.
ب- التكرار: لأنَّ الثقافة من الخفاءِ بمكان لدرجة الظهور حيثما تريد والاختباء صمتاً متى ارادت في الأنشطة والظواهر البديلة.
ت- الإشباع: وهو عدم الشعور بالنقص والاريحية النفسية والفكرية حالما ينهمك الناس في ممارسات عامة أو خاصة. وتلك السمة تملأ جوانب الثقافات بكل المعالم الأساسية التي تميزها.
ث- الهيمنة: وهي خاصية تكفل ممارسة - يجب أنْ- تتسق مقدماتها لتضمن إلحاحاً على ما تريد. وأخطر أنواع الهيمنة هي الهيمنة الرمزية التي تتسلل إلى اللاوعي وتخاطب رغبات الجماهير وغرائزها.
ج- التأثير: حيث تظهر الثقافة في خفائها عن طريق الآثار التي تتركها على ممارسيها وأصحاب الفعل فيها على نحو واسع، بل لا تترك أدنى فرجد ولا مساحة دون هذهع الأثار القصوى.
هنا ثمة اعتراضٌ لنيتشه قد يردده البعض: أنَّ الحرية التلقائية (أصالة الحرية) الكامنة في طبيعتنا الإنسانية تسقط في هذا المستنقع الثقافي، فيرتكس الإنسان أخلاقياً، أي يخضع هذا الكائن الحر طبيعياً لنسق القيم بثمن فادح، ثمن فقدان حيويته البكر الطليقة. تلك التي لن تُستعاد إلاَّ بتعرية جذور التشوه بأسمائه المختلفة.
يري نيتشه أنَّها لعبة الحياة حين تستعيض دفقها الأصلي في أنماط بديلة من الخنوع والاستعباد. لكن ماذا لو بدا انتظار الاستعاضة افرازاً لحيوانيةٍ مقلوبةٍ. فالأصل البري (البربري- الهمجي) لا يذهب بعيداً، لا يموت دون عودة. هو يرفل محبوساً في " سِوار من عقيق " اسمه المجتمع.
وقد يتحول " السوارُ الناعم" إلى قيدٍ دامٍ مع حالة الأنومي anomy برأي إميل دوركايم (اي الفوضى المعيارية والقيمية). فالمجتمعات دون التماسك المعياري تغدو وضعاً مزرياً من التخبط. لا توضيح لذلك إلاَّ فقدان بوصلة الأهداف العليا للجماعة البشرية في أي عصر من العصور. ويستمر المجتمع كحزمة (أناوات مفككة) بلا مجالٍّ عام. فكلُّ أنا مسكون بشواش عارمٍ يتسمّع أصداءه الراهنة دون التحسب للنتائج البعيدة.
علينا من ثم َّ أنْ نطرح قضية غياب الفلسفة بهذا الشكل المغاير. لأنَّ الفلسفة تتيح حفراً حول الأسس التي يستند إليها نمط تفكيرنا إزاء قضايا الحياة والعالم والماوراء والدين والاعتقاد. فقد يكون أساساً بارزاً (كالأساس الديني أو الاقتصادي أو الميتافيزيقي) كما في فلسفات الدين والاقتصاد والاجتماع. وربما يكون خفياً متروكاً لأنشطة اجتماعية وأخلاقية ومعرفية أخرى. وفي كل تلك الأحوال، ليست الفلسفة (ترفاً ثقافية) كما توجد على الأرفف وعلى ألسنة بعض النخب المثقوبة بالمصطلحات والعبارات الدارجة فلسفياً. وهي أهم من أن تترك لبعض المتعالمين الذين يعتبرون أنفسم فلاسفة مجاناً دون إسهام حقيقي.
وكأنَّ لقب الفيلسوف مجرد ريشة في هواءٍ فارغ يصفر داخل أدمغة هؤلاء التافهين على صفحات التواصل الاجتماعي وتحت العناوين البراقة داخل الجامعات والصحف والبرامج الإعلامية. وقد يبلغ الهوس بأحدهم بإطلاق اللقب على نفسه بينما لا يحمل إلاَّ جمجمة صدئة. وتلك الألقاب الفلسفية باتت ظاهرةً وقحة زادت مشاهد غياب الفلسفة سخريةً ما بعدها سخرية، وحولت التفلسف إلى مودات إعلامية يتشبث بها من يتوقح أمام كل المعايير ليس أكثر، وربما حولته إلى نوعٍ من (التندر الشعبوي) عندما ينقلب الكلام إلى نكاية فاضحةٍ في كل ما هو أصيل. فيطلق على هذا الشخص النكرة فكرياً أو ذلك لقب فيلسوف. والثقافة في هذا الاتجاه تعمل عمل السيرك الذي يثير حماس أحد اللاعبين للقيام بحركات بهلونية أمام الجماهير لإضحاك كل من يعي ماذا يحدث.
د. سامي عبد العال