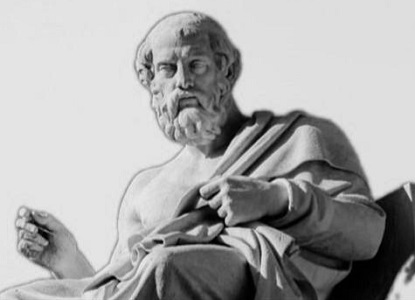أقلام فكرية
الخطاب السلفي والحداثة في عالمنا العربي

إذا كانت السلفيّة في خطابنا الإسلاميّ تشكل موقفاً فكريّاًّ ومنهجياً يدعو إلى فهم الكتاب والسنة وفقاً لفهم سلف هذه الأمّة لهما، والأخذ بأحكام الكتاب والسنة، وبنهج وعمل النبي وصحابته، والتابعين، وتابعي التابعين باعتباره يمثل نهج الإسلام الصحيح عندهم، والابتعاد عن كل المدخلات الغريبة عن روح الإسلام وتعاليمه، وعن كل ما أجمع عليه هذا السلف...
فإن الحداثة في سياقها العام هي تحديث وتجديد ما هو قديم في حياتنا ولم يعد قادر على مواكبة تطور الحياة وتجددها. وهو مصطلح يبرز كثيراً في المجال الثقافيّ والفكريّ موضوع دراستنا هذه.
وللنظر في قضيّة الخطاب السلفيّ وموقفه من الحداثة نقول: منذ أن أصدر الخليفة العباسيّ "المتوكل" عام (232) للهجرة، أوامره لرجال الدين بترك العقل والتوجه نحو النقل، مع فرض عقوبات صارمة أقرتها محاكم للتفتيش، شُكلت لمن يخالف هذه الأوامر، لم يعد هناك مجال تحت مظلة الخلافة الإسلاميّة في المشرق العربيّ منذ ذلك الوقت لأي نشاط فكريّ عقلانيّ خارج فهم النص الدينيّ المقدس للقوى السلفيّة التي فسرت وأولت هذا النص وفقاً لرؤيتها، وبما يخدم مصالحها ومصالح أسيادها من القوى الحاكمة. فعلى أساس هذا الموقف الفكريّ الجموديّ توقف الاجتهاد العقلانيّ من جهة، وتوقف الاشتغال فكريّاً على العلوم الأخرى (الوضعيّة) التي تناولها فلاسفة ما قبل مرسوم الخليفة المتوكل من جهة ثانيّة، واقتصر العمل الفكريّ بشكل عام على علوم الدين من حديث وفقه وعلم كلام اقتصر على الجانب العقيدي وتصوف وعبادات وغير ذلك. واعتبر أي خروج فكريّ عن هذه العلوم بدعة وضلالة، إن كان من حيث الاشتغال على الفكر الوضعيّ العقلانيّ، أو الخروج فكريّاً عن رؤية علماء الدين السلفيين في تفسير وتأويل النص الدينيّ المقدس، أو ما أَصَلَ له الشافعي في الفقه وأصوله، أو ما أصل له أبو حسن الأشعري والغزالي في علم الكلام. هذا مع تأكيدنا هنا، بأن هناك اتجاهاتٍ فكرّيةً عقلانيّةً محدودة راحت تتعامل مع النص الدينيّ وفهم الواقع إن كان في المغرب العربيّ، أو في الأندلس كابن حزم وابن رشد وابن خلدون وغيرهم، بالرغم من أن بعض هؤلاء المفكرين الفلاسفة لم يسلموا من الحسبة على ما طرحوه من أفكار عقلانيّة كان للبعد السياسيّ دوراً فيها، كما جرى لابن رشد وابن خلدون على سبيل المثال لا الحصر.
إذن نستطيع القول: منذ تاريخ المتوكل حتى سقوط الدولة العثمانيّة كان هناك حصار قد فرض على التفكير العقلانيّ الحداثي أو التنويريّ بشقيه الدينيّ والوضعيّ. ولا نستغرب أن علماء الأزهر وغيرهم في مصر قد اختلفوا في تاريخنا الحديث على النظر في مسألة السماح باستخدام (حنفيّة الماء) في الحياة العامة، فمنهم من رفضها باسم الدين واعتبارها بدعة، ومنهم من قبلها باسم الدين أيضاً، كدعاة الفقه الحنفيّ، ومن هنا جاء اسم (الحنفيّة) نسبة إلى المذهب الحنفيّ. ولا نستغرب أيضاً أن مشايخ الدين السلفيّ قد أفتوا بعدم صحة التعلم بالمداس الحكوميّة زمن محمد علي باشا عندما أسس الطهطاوي هذه المداس بأمر حكوميّ، الأمر الذي كان يدفع أولياء الطلاب بتوجه من مشايخ السلفيّة المتزمتة والجاهلة إلى ممارسات لا إنسانيّة بحق أعضاء أولادهم الجسديّة حتى لا يلتحقوا بهذه المدارس اللادينية. كقطع اليد أو الرجل أو فقع العين... الخ. (1).
على العموم مع بداية القرن التاسع عشر راحت تظهر توجهات عقلانيّة باتجاه العلم الحديث وخاصة في مصر محمد علىّ باشا، وفي تونس خير الدين التونسيّ، دون أن ننكر تلك الارهاصاتِ الأوليّةَ لهذا التحديث في المشرق العربيّ، كتجربتي فخر الدين المعنيّ في سورية، وطاهر باشا في العراق، إلا أن كلا التجربتين قد أجهضتا، وبقي لتجربتي محمد على باشا وخير الدين التونسي تأثيرها على تاريخنا الحديث والمعاصر. وراحت نتائجهما تظهر بوضوح في مصر مع الطهطاوي وتلامذته من جهة، ثم مع مدرسة جمال الدين الأفغانيّ ومحمد عبده من جهة ثانية. فهذه المدرسة التنويريّة الإسلاميّة راحت تتعامل مع مفردات أفكار الثورة الفرنسيّة، كالديمقراطيّة والحريّة والعلمانيّة وماهية الإنسان، والاجتماع المدنيّ، والمرأة، والقيم الإنسانيّة، والدولة، والتطرف، والتسامح وغير ذلك من مفردات وضعيّة، محاولين أسلمتها من خلال البحث عن نصوص دينيّة أو مواقف ذهنيّة لهذا الخليفة أو ذاك، أو لهذا الفقيه أو ذاك تتوافق مع مضمونها. فالديمقراطيّة وجدوا مرادفة لها وهي الشورى، والعدل والمساوة وجدوا له أحاديث وآيات وموقف ذهنيّة كموقف عمر بن الخطاب من قضية ابن عمر بن العاص والقبطي في قوله (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احراراً).. والعلمانيّة وجدوا لها حديثاً للرسول وهو تأبير النخل.. وللمرأة وحريتها كان موقف عمر ابن الخطاب من المرأة التي حاججته وأخذ برأيها.. وهكذا دارت أمور التحديث. وبالرغم من أن هذا التوجه التنويريّ راح يتسع فيما بعد مع بناء الدولة الحديثة وتوسع التعليم المدنيّ في كل مراحله، ودخول الاختصاص الفلسفيّ في الجامعات. إلا أن شهوة السلطة في الأنظمة العربيّة التي تحولت إلى أنظمة شموليّة حاصرت أصحاب التوجهات الفكريّة التنويريّة وفسحت في المجال واسعاَ للتيار السلفيّ كي يمارس دوره في الوقوف بوجه التيار العلمانيّ التنويريّ، والتصدي لرجالاته ومحاصرتهم وتكفيرهم والتشهير بهم كونهم مارقين عن الدين، ولم يتوانوا أحيانا في التعدي على بعضهم أو تصفيته جسديّا.
أمام كل الذي جئنا عليه هنا، يظل السؤال المشروع يطرح نفسه علينا وهو: كيف الخروج من المأزق السلفيّ في خطابنا الفكريّ العربيّ المعاصر.
لا شك أن الإجابة على مثل هذا السؤال الإشكاليّ ليست وصفة طبية لمعالجة مرض فيزيائيّ يصفها طبيب لمرض شائع، وإنما المرض الذي نعاني منه هو مرض اجتماعيّ واقتصاديّ وسياسيّ وثقافيّ. فإذا كان المرض الاجتماعيّ يتجسد في البنية الاجتماعيّة المفوّتة حضارياً، أي التي لم تزل مسكونة بمرجعيات تقليديّة سيطرت عليها روح وعلاقات القبيلة والعشيرة والطائفة والمذهب، والكثير من القيم الأخلاقيّة التقليديّة المحكومة أيضاً بالعرف والتقليد والعادة، و هي قيم اتخذت الصفة المعياريّة وتعود إلى مئات السنين، أشبعت بقيم الدين التي لا يأتيها الباطل من بين بين يديها أو من خلفها، مع تأكيدنا أيضاً على انتشار الجهل والفقر والتخلف واستبداد الحاكم في الوجود الاجتماعي. فالمرض الاقتصاديّ محكوم بدوره بقوى وعلاقات إنتاجيّة متخلفة وهجينة أو متعددة الأنماط، يسيطر عليها اقتصاد السوق البسيط أو الصغير على مستوى الداخل، والاقتصاد الريعيّ والاستهلاكيّ على مستوى التعامل مع الخارج، وإن وجد هناك أسواق صناعيّة في بعض الدول العربيّة، فهي أسواق صناعيّة تجمعيّة أو ذات اللمسات الأخيرة، ومعظم مكونات هذه الصناعة الأساسيّة مستوردة من الخارج. وهذا الواقع الاقتصاديّ المزري سينتج عنه بالضرورة اقتصاد متخلف غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي ، أو خلق أسواق قادرة على المنافسة مع الخارج ، وأخيراً غير قادر على إنتاج طبقة صناعيّة وطنيّة قادرة على وعي نفسها ودورها التاريخيّ، وبالتالي التخلص من سماتها وخصائها الكومبرادوريّة، وتحقيق إمكانيات قيادتها للدولة والمجتمع. أما على المستوى السياسيّ فغياب المجتمع المدنيّ، سيؤدي بالضرورة إلى غياب البنية السياسيّة العقلانيّة بحواملها الاجتماعيية المؤمنة بتداول السلطة والمشاركة السياسيّة ودولة القانون والمواطنة.. الخ. وبناءً على ذلك ظلت البنية السياسيّة مرتبطة بحوامل اجتماعيّة تقليديّة يسيطر عليها شيخ العشيرة والقبيلة والطائفة في الوجود الاجتماعي، أو يسيطر عليها الأمير والملك والزعيم والقائد الملهم وغير ذلك في الهرم السياسيّ. والملفت للنظر أن عدوى هذا المكونات السياسيّة التقليديّة انتقلت إلى الأحزاب التي تدعي التقدميّة والعلمانيّة حيث راح قادتها يخضعون لشهوة السلطة مما زاد في الطين بلّة بالنسبة لأزمة الخطاب السياسيّ في هذه الدول التي راحت تسير في خطابها السياسيّ كـِسيرِ (بول البعير)، أي الرجوع إلى الوراء. الأمر الذي كان وراء قيام ما سيمّي بثورات الربيع العربيّ التي كشفت عورات هذه الأنظمة وبينت مساوئها ومساوئ القوى المعارضة لها على السواء. أما بالنسبة للمسألة أو البنّية الثقافيّة، فقد أشرنا إلى تخلفها وهجانتها وسكونتيها ووثوقيتها وشفويتها واستسلام حواملها الاجتماعيين لما هي عليه، كما بينا دور القوى السياسيّة المتخلفة التي تدفع باتجاه تكريس هذا الثقافة المفوّتة حضاريّاً خدمة لمصالحها، يساعدها في ذلك مشايخ السلطان ومؤسساته الدينيّة والعديد من المثقفين والاعلاميين من المطلبين والمزمرين الذي يعملون ليل نهار على تكريس التخلف وتغييب الفكر العقلانيّ التنويريّ، ومحاربة حوامله الاجتماعية، إما عن طريق سجنهم كأصحاب رأي أو دفعهم للهجرة خارج الوطن، أو تحريض مشايخ السلطان عليهم للتشهير بهم، تحت ذريعة الكفر والالحاد من جهة، أو الفسح في المجال للقوى الأصوليّة الجهاديّة على قتلهم والتنكيل بهم من جهة ثانية.
****
د. عدنان عويّد
كاتب وباحث من سوريّة
.............................
الهوامش:
1- للاستزادة في هذا التوجه الأصولي ومقاومة الحداثة، راجع كتابنا: إشكالية النهضة في الوطن العربي من التوابل إلى النفط – إصدار داري المدى والتكوين - دمشق .