صحيفة المثقف
استحضار المعنى في: نقوش على جذع نخلة.. مقاربة تأويلية
في النقدية التأويلية ومن خلال استحضار المعنى الشعري يبرز اتجاهان: الإتجاه الأول عندما يتناول نصا شعريا يأتي بأحكام قبلية، محاولا الكشف عن مضامينه وفق تلك الرؤى المسبقة إلى نهاية المشوار النقدي في النص المؤول، ليندرج تحت طائلة الحكم القبلي للنص، غير آخذٍ 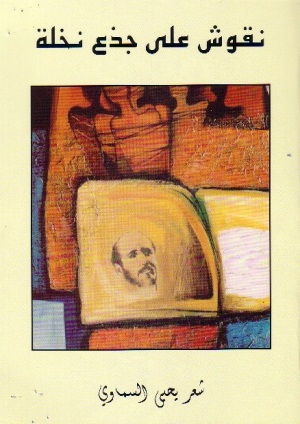 بنظر الإعتبار تأثير الفهم الخاطئ، فهو يأتي بمفاهيم على العكس من رؤى وطروحات الشاعر، مبتعداً عن المعنى الحقيقي للنص ، مغرداً خارج فضاء الشيء نفسه، وهذا بحدِّ ذاته يؤشر إلى كونه لم يفحص النص فحصا شاملا، لذا لم يتم إدراك المعنى، ليغدو النص النقدي في تعمية تامة، والأنكى من ذلك يُسَّوق للمتلقي بحسب هذه الأحكام والتصورات المشوشة عن النص الشعري، وعلى العكس منه نجد الإتجاه الثاني الذي وأن أتى بأحكام قبلية إلا أنه يغير من تصوراته للشيء نفسه، وبحسب الكشف والفهم لمدلولات النص من خلال فك رموزها آخذا بنظر الإعتبار التأثيرات التاريخية والنفسية التي أحاطت بالشاعر لحظة الإبداع الشعري، وهذا لا يعني المحايدة وإنما يبقى القارئ/ الناقد في مغايرة مع النص الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستحضار المعنوي للكمال، من خلال الفهم والمطابقة بين رؤى الشاعر والنص الشعري، أو أنه يغير من تصوراته وفق الكشف الذي توصل إليه من خلال فهمه للنص الشعري، مع الإبقاء على تحيزه لأحكامه المسبقة حتى يتمكن من الكشف الكامل للمعنى، وهذا ما ذهب إليه هيدغر بأنَّ "الفهم يتحدد باستمرار بحركة التصور للفهم المسبق" هذا ما سيتم تناوله من خلال قراءة تأويلية في مجموعة (نقوش على جذع نخلة) للشاعر يحيى السماوي.
بنظر الإعتبار تأثير الفهم الخاطئ، فهو يأتي بمفاهيم على العكس من رؤى وطروحات الشاعر، مبتعداً عن المعنى الحقيقي للنص ، مغرداً خارج فضاء الشيء نفسه، وهذا بحدِّ ذاته يؤشر إلى كونه لم يفحص النص فحصا شاملا، لذا لم يتم إدراك المعنى، ليغدو النص النقدي في تعمية تامة، والأنكى من ذلك يُسَّوق للمتلقي بحسب هذه الأحكام والتصورات المشوشة عن النص الشعري، وعلى العكس منه نجد الإتجاه الثاني الذي وأن أتى بأحكام قبلية إلا أنه يغير من تصوراته للشيء نفسه، وبحسب الكشف والفهم لمدلولات النص من خلال فك رموزها آخذا بنظر الإعتبار التأثيرات التاريخية والنفسية التي أحاطت بالشاعر لحظة الإبداع الشعري، وهذا لا يعني المحايدة وإنما يبقى القارئ/ الناقد في مغايرة مع النص الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستحضار المعنوي للكمال، من خلال الفهم والمطابقة بين رؤى الشاعر والنص الشعري، أو أنه يغير من تصوراته وفق الكشف الذي توصل إليه من خلال فهمه للنص الشعري، مع الإبقاء على تحيزه لأحكامه المسبقة حتى يتمكن من الكشف الكامل للمعنى، وهذا ما ذهب إليه هيدغر بأنَّ "الفهم يتحدد باستمرار بحركة التصور للفهم المسبق" هذا ما سيتم تناوله من خلال قراءة تأويلية في مجموعة (نقوش على جذع نخلة) للشاعر يحيى السماوي.
من حسن حظي أنني هيأتُ
نهري للجفافِ ...وللخراب السنديانة..
والحديقة للخريف...
وللفراق الأصدقاءْ
من خلال قراءتنا الأولى للنص الآنف الذكر نجد الخطاب موجها لنفس الشاعر المنكسرة ، بعد أن أدركت النهاية المحتومة التي ستصل إليها شاءت أم أبت، فرفعت الراية مقدماً معتبرة هذا الإجراء من حسن الحظ، والأكثر غرابة أنها اعتبرت جفاف النهر وخراب السنديانة وخريف الحديقة وفراق الأصدقاء ضمن منظومة حسن الحظ، ولو أمعنا النظر وفككنا رموز المفردات، لأدركنا الاعتراض واضحا فليس من حسن الحظ كل ما سلف ، بل أنه سوء حظ، هذا الذي سيطر على نفس الشاعر وجعلها تعيش الأزمة والخراب الذي مرَّ به وما سيمر به مستقبلا، وهو شاهد حقيقي لمرحلة تاريخية مرت بنا جميعا:
الليلُ نفسُ الليلِ
إلا أنَّ بيتي لا يُضاءْ
بجبين أمي وهي تختتم النوافل بالدعاءْ
على الرغم من كون الرمز حاضرا إلا أنه يمكننا تحديد الأشياء وكذلك تسميتها بأسمائها الفعلية، فالليل هنا لا يشكل الليل المعتاد أي المعنى الحرفي للمفردة/الزمن، إنما الليل ما توالت من فترات ظُلم متعاقبة، بتعاقب السلطات المستبدة (الليلُ نفسُ الليلِ)، فكيف نرجو بعد كلِّ هذا الخلاص ما دام يتوالد ظُلَماً، لتضيق رؤى التفاؤل بامتداد الظلمة للبيت/ الوطن، وما دام مطمح الحرية (أمي/ الحرية)، مُستبعَداً عن دائرة الضوء، فمن يكبح جماح الظلمة ، لنبقى قابعين في سواد لا متناهٍ فلا ثورات ولا حتى حراك من شأنه إيصال صوتنا عبر طقوس تفتق الحُجب، راكنين إلى الدعاء والنوافل، حجج الشبيبة الثائرة آنذاك، فالدعاء دعوة للتغيير معبدة بنافلة العقيدة الصادقة :
والدّربُ مرَّ عليَّ مرتبكاً
ومرَّ النهر محتضناً نخيلهْ
هرباً من الأرض الذليلةْ
وأنا مررت علي...بتُّ أثنين:
صحراء....وسنبلةٌ عليلةْ !
تكشف لنا القراءة الفاحصة كيف بدا الانكسار جليا في النص الشعري لما يفصح عنه السياق من بث ثقافة الهروب التي شكلت منعطفا بارزاً في حقبة التسعينيات من القرن المنصرم، فالدرب مرتبك والنهر محتضن نخيله هاربا من الأرض الذليلة، فعراقة النهر، وشموخ النخيل يقف في حراجة أمام موقف هذي الأرض التي لم تنجب إلا الهروب، في انهزامية منقطعة النظير، وهذا كله متأتٍ من ركام هائل من حروب وجوع، ألقت بظلالها على الموجودات فأحالتها إلى جبن وتراجع، وصولا للتصحر والاعتلال، (وأنا مررت علي...بتُّ أثنين/صحراء....وسنبلةٌ عليلة !)، كيف لا وقد صار أثنين، صحراء وسنبلة عليلة ، الأزمة النفسية التي مرَّ بها واضحة الدلالة والمفهوم، بل انها صارت المعنى المحايث دائم الظهور في جنبات النصوص بالمجمل، وهذا ما يدعونا لاستحضار معنى خراب السنديانة، إشارة حقيقية ترمز للاحتضار الذي لاحَ الموجودات بمختلف تسمياتها.
حاوَلَتِ اجتياز سور الوطن المسبي فجراً
غير أن البشر الذئابْ
كانوا وراء البابْ
أنَّ القراءة المتأنية للنص قد تشي بتصور كامل عن الوضع المجتمعي المأزوم الذي هو نتاج لمرحلة ألقت بظلالها على البنى الجوانية للنص الذي أنتج مسحة من الشعور بالضياع، فالتأثيرات النفسية، وليدة أزمة، فالحروب تنتج أزمة، وسوء استخدام السلطة يخلف أزمة، وتنامي الفقر أزمة قائمة بحد ذاتها، كيف وقد اجتمعن تحت طائلة زمان ومكان واحد؟ لذا نجد الهروب حاضرا هذه المرة (حاولتِ اجتياز سور الوطن ) وللأسباب نفسها، والمفارقة التي حدثت من تصدير معنى جديد لممارسة السلطة (المسبي فجراً) السبي فعل يقوم به محتل غاشم أو أنَّه فعل عفا عليه الدهر، كيف بنا ونحن نجد من يمتلك مؤسسة السلطة، وهو يمارس هذا الفعل، لذا يمكننا عده مغتصبا لها، في معنى مجاور للمحتل الغاشم، وما ذهب إليه بوصفه بشرا ذئابا، وما للذئب من رمزية الغدر، وما وقوفهم وراء الباب وأن جاء كنوبة مراقبة ورصد، إلا أنهم اعتادوا الوقوف خارج أسوار الوطن وهذا يؤكد ما ذهبنا بأنهم مغتصبون/محتلون/أغراب.
كان الماء من حجرٍ
ولا عشب فينبئُ عن طحين في رحى وجعي
حزمت بقيتي.. لكنَّ باب البحرِ موصدةٌ
وأرصفة الموانئ مقفرةْ !
ولو تأملنا النص تأملا فاحصا لما آل إليه الشعور الإنساني من يأس وإحباط، لا نلمح غرابة، وقت يكون الموت حاضرا لمداهمة الأشياء وبما فيه من إعلان عن النهاية التي ساقتها الممارسة الخاطئة للسلطة، في الأمس القريب، فالماء حجر ولا عشب ينبئ عن بشارة لدوار رحى الوجع، في رمزية عالية للجوع الذي قضم أجساد وأعمار من وقع تحت طائلته، كل هذا استدعى محاولة الهرب ثانية بطريقة مختلفة بعض الشيء هذه المرة، (حزمت بقيتي)، لكن النتيجة نفسها، باب البحر موصدة، وأرصفة الموانئ مقفرة، وفي هذا إشارة تدلُّ على أن أبناء البلد قابعون في سجن كبير أسمه الوطن .
مملكتي رصيف يحتفي بأحبتي الفقراء
حاشيتي الزنابق والعصافير الاليفهةْ
والتاج جرح
لا أبيع بجنَّة الدنيا نزيفهْ !
وفي تتابع لما سبق من النصوص يطرأُ تغيّرٌ واضحٌ في النص الحالي لما تمَّ كشفه من معاناة مع الهروب وما تمَّ رصده من عنت السلطة نجد النص ينتج لنا معنى مغايرا لما سبق، فبعد الحزن والقنوط والبحث الدائم عن الخلاص، نجد معنى التأقلم مع الرصيف الذي يحتفي بالفقراء، ليشكل مملكة الرصيف، فالفقراء الذين يرتادون الرصيف لطلب الرزق، راجعين لصغارهم وفي أيديهم دراهم تجعلهم يماحكون السعادة الهاربة من جيوبهم، إلا أنَّ لهم حاشية من زنابق وعصافير أليفة، في رمز للنقاء ومعانقة الحرية الموهومة من جديد، في إشارة لجرحهم النازف الذي عدَّوه تاجاً لا يمكن خلعه.
ما قيمة التحرير
أن كان الذي هبَّ الى نجدتنا
حرَّرنا
وأعتقل الوطنْ؟
من خلال قراءة مؤولة للنص تكرر الهمَّ والجوع والهروب، وستتكرر معه لحظة الانعتاق لكنَّها هذه المرة مكسورة الجناح، بعدما كانت الحلم، أتت مشوهة، فالاحتلال مع كل وعوده لم يسقِ بذرة الحرية، المطلب الذي كان يتقدم على ضرورات كثر، ليأتي الجرح غائرا هذه المرة عميقا، فالاحتلال عمّق جذور التسلط وجاء بثقافة الكراهية والفرقة، ليتذوق الشعب مرارة من نوع آخر، فالوطن تمَّ اعتقاله مجددا، وهذه إشارة واضحة قد تفتح الباب لممارسة فعل الهروب ثانية.
في وطن النخيلْ
يحقُّ للمحتل أن يصادر الإرادةْ
ما دام أن التابع الذليلْ
ينوبُ عن كلّ الملايين التي تبحثُ
عن خلاصها من عَسَفِ الدخيلْ
في النص بات التصريح بممارسة المحتل للقمع ومصادرة الإرادة أمراً واضحاً، ليعيد المحتل إنتاج معنى مرارة ممارسة السلطة التي سبقته وأن بدا تحت عنوان آخر، مرارة مازال طعمها للآن لم يفارق حلق الأمة، فالنخيل ذاته رمز الشموخ والإباء يتعرض للإذلال ثانية بنفس الشخوص (ما دام أن التابع الذليلْ) التابع يتكرر حتى وان تغيرت وجوه القوى المسيطرة على الأرض، ما دمنا متفقين على مَنْ يحكم الوطن متمرس بأسلوب إقصائي قمعي، هو وجه من وجوه الاحتلال في نظر الشعب ، فما بالك لو أنَّه ناب عن الملايين بصوتهم وإرادتهم.
غداً لنا ميعادْ
غداً لنا ميعادْ
مع الصباحات التي تُطرَّزُ البلادْ
بالخير والأمانِ...والرّشادْ
في النص نجد بشارة لموعد مع الغد، فالأمل معقود برجال الوطن الراشدين، أولئك الذين يحملون راية الخير والأمان نصب أعينهم، فالموعد الصبح مازال قائما والمكان الوطن البقاء الحقيقي لمعنى الوجود فلا موعد لمستقبل آت من دون وطن، وبهذا نرجو أننا توصلنا للاستحضار المعنوي للكمال من خلال مطابقة فهم النص بحسب رؤى الشاعر نفسه وما تمَّ إجراؤه من تأويل للنصوص الشعرية آنفة الذكر، بكل ما تحمل من رمزية نفسية وتاريخية، وضعتنا أمام معترك حقيقي خاضته الأمة، قد تبدو بدايته نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثانية، لكننا نبتعد أكثر إلى نهاية الخمسينيات، كتحديد لبداية الخراب، لما أبدته الماكنة العسكرية من دور فاعل في إعلاء كلمة السلطة القمعية وتحجيم دور المؤسسة المدنية.
رحيم زاير الغانم
..............................................
*فلسفة التأويل، هانس غيورغ غادامير، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط2، 2006 ص126
*نقوش على جذع نخلة، يحيى السماوي، دار التكوين، دمشق، ط1، 2006
















