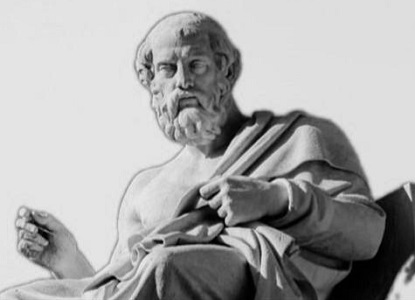صحيفة المثقف
القيم الفنية والجمالية في آراء أدونيس النقدية (1)
 قد يعجب القارئ من الإمكانيات النقدية التي يملكها الشاعر أدونيس؛ من حيث الأفكار، والأسلوب؛ وطريقة التعبير؛ والتقصي في بحث الفكرة؛ وإثباتها؛ أو نفيها؛ أو دحضها؛ فهو يملك الخزينة الثقافية المعرفية في الحكم على الأشياء، وكشفها، وممارسة سلطته التأثيرية في تقصي الفكرة؛ وتبيان الخصوصية في الطرح، والمناقشة، والتأمل؛ يقول الناقد علي جعفر العلاق في إمكانيات أدونيس :" وسط ركام من شعر الأيديولوجيات، والدلالة المباشرة يمثل أدونيس، بالنسبة لي؛ شاعراً شديد الخصوصية؛ فهو لا يضع المعنى أو الدلالة في صدارة اهتماماته، ولا يختفي بأي مرجع خارجي : إنه يهدم الأشياء، والأفكار، والموضوعات، والمشاعر، باستمرار؛ ويعيد بناءها باستمرار؛ بمعنى آخر : إنه يسلط مجمل اندفاعه الشعري؛ في الغالب، للتشويش على ملامح موضوعاته، وخلخلة مكوناتها الدلالية أو اللغوية؛ ليفجر من خلال ذلك كله مناخات، وأجواء تدفع إلى الحيرة اللذيذة، أو اللذة المحيرة ... ولا نبالغ في قولنا :في قصيدة أدونيس لا يندفع الموضوع الشعري إلى الواجهة؛ بل يقبع هناك نائياً، متخفياً، منقوعاً باللغة، وبراعة الاجتهادات . ومن خلال ذلك تواجهنا لغته الشعرية ريانة مستفزة؛ لا تحمل إلينا إلا تشظيات الذات، وفجيعة الكائن البشري، لذلك، فإن ما يشدني إلى شعر أدونيس أنه لا يقدم موضوعاً، أو فكرة تقع خارج القصيدة،أو على مقربة منها؛ بل يقدم جسداً نصياً، نضاحاً بالرفض، والأسئلة المريرة. ومن هنا، فإنه من غير الحكمة أن نأتي إلى قصيدة أدونيس مدفوعين بفكرة مسبقة، أو بانطباع جاهز"(1).
قد يعجب القارئ من الإمكانيات النقدية التي يملكها الشاعر أدونيس؛ من حيث الأفكار، والأسلوب؛ وطريقة التعبير؛ والتقصي في بحث الفكرة؛ وإثباتها؛ أو نفيها؛ أو دحضها؛ فهو يملك الخزينة الثقافية المعرفية في الحكم على الأشياء، وكشفها، وممارسة سلطته التأثيرية في تقصي الفكرة؛ وتبيان الخصوصية في الطرح، والمناقشة، والتأمل؛ يقول الناقد علي جعفر العلاق في إمكانيات أدونيس :" وسط ركام من شعر الأيديولوجيات، والدلالة المباشرة يمثل أدونيس، بالنسبة لي؛ شاعراً شديد الخصوصية؛ فهو لا يضع المعنى أو الدلالة في صدارة اهتماماته، ولا يختفي بأي مرجع خارجي : إنه يهدم الأشياء، والأفكار، والموضوعات، والمشاعر، باستمرار؛ ويعيد بناءها باستمرار؛ بمعنى آخر : إنه يسلط مجمل اندفاعه الشعري؛ في الغالب، للتشويش على ملامح موضوعاته، وخلخلة مكوناتها الدلالية أو اللغوية؛ ليفجر من خلال ذلك كله مناخات، وأجواء تدفع إلى الحيرة اللذيذة، أو اللذة المحيرة ... ولا نبالغ في قولنا :في قصيدة أدونيس لا يندفع الموضوع الشعري إلى الواجهة؛ بل يقبع هناك نائياً، متخفياً، منقوعاً باللغة، وبراعة الاجتهادات . ومن خلال ذلك تواجهنا لغته الشعرية ريانة مستفزة؛ لا تحمل إلينا إلا تشظيات الذات، وفجيعة الكائن البشري، لذلك، فإن ما يشدني إلى شعر أدونيس أنه لا يقدم موضوعاً، أو فكرة تقع خارج القصيدة،أو على مقربة منها؛ بل يقدم جسداً نصياً، نضاحاً بالرفض، والأسئلة المريرة. ومن هنا، فإنه من غير الحكمة أن نأتي إلى قصيدة أدونيس مدفوعين بفكرة مسبقة، أو بانطباع جاهز"(1).
لاشك في أن العلاق قد وقف على نقط مفصلية مهمة في شعرية أدونيس؛ من حيث فرادته،وأسلوبه،وطريقة تعامله مع النص الشعري،وطرحه للموضوعات،وبثه لرؤاه الاغترابية المتشظية؛وقد أشار العلاق –بدقة- إلى خصوصية اللغة الشعرية لدى أدونيس؛ فالقيمة الشعرية الرفيعة التي وصل إليها أدونيس، تخوله النجاح والدقة في إصدار أي حكم نقدي؛ لأنه يشكل موسوعة معرفية في نظم الشعر ونقده؛ إنه قامة شعرية سامقة في عالمنا النقدي والشعري المعاصر؛ لدرجة يمكن القول معها: إن أدونيس "شاعر دائم الحيوية، يسعى دائماً إلى أن يفاجئك بما يقلق، ويثير، ويدفع إلى الاختلاف. وهو قد يسلم نفسه أحياناً إلى كمائن إنجازاته الشعرية، أو إغراءاتها إلا أنه يحاول، دائماً، أن يتجاوز مأزق النجاح الذي يحققه، فالنجاح بالنسبة إليه تحد جيد، وبداية شامة لمشوار شعري أكثر استفزازاً لموهبته، وعقله"(2).
ولم يكن أدونيس على الإطلاق شاعراً، أو ناقداً منهجياً محدداً بإطار أو أسلوب معين؛ بل كان -على الدوام- شاعراً شمولياً، وناقداً مبدعاً، يتقصى الموضوع أو الفكرة بنظرة شمولية؛ بعيدة المدى؛ قوية التأثير؛ شديدة الإحكام؛ والإمتاع، والإقناع؛ إذ يملك أدونيس طاقة حيوية عالية في النشاط والإبداع والخلق الشعري المميز، حتى في دواوينه المتأخرة( تنبأ أيها الأعمى)؛و(وراق يبيع كتب النجوم) لم يكن متراجعاً؛ وإنما بنى لنفسه مملكة شعرية جديدة، حافلة بالتفرد والإبداع؛ولهذا يقول العلاق في مطالعته لشعر أدونيس، ومشروعه الحداثوي النهضوي: " حين أتأمل برنامج أدونيس الشعري والثقافي تتملكني الدهشة حقاً. من أين له كل هذا الوقت؟ كيف تتسع أيامه أو لياليه لاستيعاب هذا الجهد الكتابي الغزير؟ لقد توزع هذا الجهد بين الشعر، والتنظير، والبحث والترجمة، إضافة إلى إسهامه الدائم في الصحافة، والمؤتمرات، والقراءات الشعرية، والتدريس الجامعي... ما كنت أعلم، في البداية أن وراء هذا الغنى إرادة صارمة، وإخلاصاً للحلم الشعري لا حدود له. لقد عرفت من أدونيس، في لقائنا الأول، أن ساعات يومية تتوزع، آنذاك؛ بين التمشي على البحر في ساعات الصباح الأولى، والكتابة الأدبية، وكتابة الشعر، أي بين الماء، والنثر، والقصيدة؛ وإذا شئنا، بين الطبيعة، والعقل، والمخيلة، إنه عالم يبدأ بالشعر، وينتهي إليه... إن الشعر يمثل هنا، جوهر حياته كلها، أما ما عداه فهو امتداد له، أو فائض عنه، وقد اكتشفت في حينه، أن الحياة الخارجية يوماً واحداً ينصرف فيه أدونيس إلى أصدقائه، ومحبيه، وهذه الحياة في واقع الأمر، ليست خارجية بالمعنى الحرفي للعبارة، بل هي، فسحة للتأمل، واستفزازا للعقل والوجدان، إنها حطب إضافي يغذي، في النهاية، موقد الشعر أيضاً لديه"(3).
والجدير بالذكر، أن أدونيس يمتلك إرثاً ثقافياً، وظفه بأسلوب حداثوي بما يتلاءم وطبيعة العصر، والتطورات التي طرأت على شكل القصيدة؛ في الأساليب، والرؤى، والتقنيات؛ فتساؤلات (أدونيس) الوجودية في قصائده أغنت رؤاه، ومنظوراته، وتطبيقاته في الحداثة الشعرية؛ بمعنى أدق: إن الأسئلة الوجودية المحمومة في قصائده كانت محفزاً له للتفكر والخلق،والإبداع والإمتاع الشعري؛:ولاغرابة أن يعرفه القراء بهذا التوجه، " إن أدونيس الذي عرف شاعراً أو إنساناً، بقلقه وتحولاته، لا يمكنه الثبات على منهج صارم كهذا، غير أن المؤكد حقاً أيضاً أن احتفاءه بالجوهري والعميق، في الشعر والفكر والحياة، ظل ثابتاً، و لا بد لي هنا أن أتذكر حالات تشكل النقيض المطلق لهذا المنهج في الإبداع أو السلوك؛ شعراء لا تحتل القصيدة في حياتهم إلا هامشاً ضئيلاً، أو شعراء لا يجدون في الشعر إلا وجاهة اجتماعية، أو تبريراً لانحطاط الذات، أو كميناً لإغواء امرأة"(4).
أما أدونيس فقد اتخذ الشعر جوهراً وحقيقة ومشروعاً نهضويا يسعى من خلال إلى تجذير إبداعه وإثارة رؤاه المواربة النهضوية في الفكر والرؤيا والمخيلة، ولهذا،فإن أدونيس في مختلف آرائه النقدية استطاع أن يقنعنا، ويمتعنا بهذه الدقة في الرؤى، جسارة الطرح، ورصانة الأفكار؛ من خلال بداعة الأحكام، ودقة المنظورات، وإصابتها المعنى المقصود؛ أو المعنى المراد؛ ولهذا؛ يعد أدونيس من أهم النقاد الحداثيين على الساحة الشعرية العربية . نظراً إلى بداعة منظوراته،ودقة أحكامه النقدية، ومناقشته للعديد من القضايا الشعرية المستعصية؛ولهذا سينطلق بحثنا في هذه الرقعة البحثية الضيقة من تحديد أبرز المقومات أو النقط المفصلية التي شكلت نقطة إثارة أحكامه ومنظوراته النقدية، وفقر ما يلي:
بلاغة الجملة ووضوح مقصودها:
ونقصد بـ بلاغة الجملة / ووضوحها المقصدي
قدرة الجملة النقدية على إصابة مغزاها،ومقصودها الفني؛ بأسلوبها التقني؛ ووضوحها المقصدي؛ ومحاكمتها المنطقية الدقيقة للظاهرة المدروسة؛ بإصدار الحكم النقدي الملائم والدفاع عنه بإحكام وفهم ووعي معرفي مؤثر أو مقنع. وقد امتازت آراء أدونيس في بعض القضايا الأدبية بموضوعيتها، ودقتها؛ وبراعتها في استخلاص الحكم النقدي، والدفاع عنه، وإثباته أو دحضه مستقبلاً. ولنأخذ مثالاً على ذلك قوله في مسألة الوضوح والغموض؛ هذه المسألة التي شكلت لديه هاجساً مؤرقاً كلما طرحت هذه المسألة على خارطة التداول النقدي، إذ يقول :" الحداثة انقطاع في سلسلة معطيات يصير وارثوها على أن تتطاول وتستمر،بهيئتها وعناصرها، ومثل هذا الانقطاع يقود إلى ضياع القارئ الذي لا ذخيرة له غير الذاكرة الحافظة، وغير التقليد والعادة. فالقول –بالغموض- إسقاط: إنه وليد هذا الضياع. إنه ناتج عن عدم إدراك الفرق بين طريقة التعبير القديمة، والطريقة الحديثة. وعن عدم إدراك معنى زمنية الشعر، وعن الحكم على اللحظة الحاضرة بلحظة تعود إلى حوالي عشرين قرناً، وهو ناتج كذلك عن تغير النظر، والوعي في حركة التحول"(5).
إن دقة أحكامه؛ ومنطقية رؤيته، من تمهيد للفكرة، ودعمها، وإثباتها، ومن ثم إصدار الحكم النهائي حولها يؤكد نظرته العميقة من جهة؛ وبلاغته في إصابة المغزى أو المقصود من حكمه النقدي، بأقل عدد من اللفظ. وهذه السمة سمة البلاغة والإيجاز؛ والواضح كذلك منطقية الحكم؛ والتقصي الدقيق للظاهرة بجوانبها كافة؛ إذ يقول:
" إنني لا أبشر بالغموض. وهذه مناسبة لأشير إلى أن في حياتنا شعوذة تتخذ من " الغموض " ستاراً لتخفي عجزاً أصابها عن الإبداع.. أكرر، بالمقابل، أنني لا أبشر بالوضوح. وهذه أيضاً مناسبة لأشير إلى أن هناك شعوذة تتخذ من " الوضوح " ستاراً لتخفي، هي الأخرى؛ عجز أصحابها عن الإبداع فعلاً . فلا يعنيني" الغموض" بذاته، أو " الوضوح" بذاته، وإنما الإبداع هو الذي يعنيني... أكرر، في الوقت نفسه، أن ما يسمى بغير مسوغ نقدي، جمالي " غموض الشعر الحديث"؛ إنما هو، تدريجياً، ظاهرة طبيعية . وهذا عائد إلى تفاوت البنى في المجتمع العربي، وإلى استباقية الشعر، مما يولد الانفصال عن الذاكرة والعادة؛ وعن " جمهور" الذاكرة والعادة . ومن هنا أميل إلى القول : إن مسألة الوضوح والغموض ليست متأتية عن القصيدة الصعبة أو الأثر الفني الصعب، بقدر ما هي متأتية عن موقف شعري أيديولوجي" (6).
إن ما يلفت النظر إليه بلاغة الجملة، والتمهيد للفكرة، والتأكيد على مصداقيتها، أو مقاربتها المنطقية؛ بذوق نقدي رفيع، وإدراك معرفي رؤيوي شامل؛ يمتاز به أدونيس على الدوام، من حيث الإدراك، والعمق، والشمولية، والاتزان؛ فالشعرية ليست في الغموض أو الوضوح،وإنما في الإبداع ذاته، هل حقق الشاعر إثارته الشعرية،وارتقى بأسهم قصيدته جمالياً أم لا. هذا السؤال الذي يسأله أدونيس ويجيب عليه قائلاً : " إذا كان الغموض مسألة إيديولوجية لا نصية؛ فإنه مسألة فهم للإبداع من جهته؛ وموقف من الموروث، من جهة ثانية؛ والشاعر العربي الحديث ليس حديثاً إلا بشرط أولي: تجاوز الموقف الإيديولوجي – الفني القديم، ومتضمناته جميعاً : مفهوم الشعر؛ ومفهوم الإبداع، والمعايير النقدية المنبثقة عنها... ثم إن الشاعر ليس شاعراً إلا بشرط أولي: يرى ما لا يراه غيره، أي يكتشف ويستبق. فهناك تفاوت طبيعي، على مستوى الغنى الداخلي؛ وعلى مستوى التعبير، بينه وبين القارئ. لكن هذا التفاوت لا يعني انغلاق كل منهما على الآخر؛ واستحالة التفاهم فيما بينهما؛ وإنما يعني عدم التطابق بينهما : فاختلافهما نوع من الائتلاف، يقتضي من القارئ أن يكون هو الآخر خلاقاً – شاعراً آخر"(7).
إن الوعي الأدونيسي يضعنا على حقيقة الحكم النقدي، فالغموض لايتأتى من الخميرة الإبداعية والحزينة المعرفية العالية التي يمتلكها المبدع، على حساب المتلقي أو القارئ؛ وإنما من ازدياد الهوة بينهما وانقطاع أواصر التلاقي بينهما،وهذا يؤدي إلى تشويش الرسالة الإبداعية، وإخفاق التفاعل بين المبدع والمتلقي؛ وهذا يدلنا أن الغموض -من المنظور الأدونيسي – ليس نتيجة أو إفرازاً لغموض النص ذاته؛ وإنما للقارئ اللامدرب على تلقي مثل هذه النصوص، أي القارئ العادي الذي لا يملك الذخيرة المعرفية لفك مداليل النص؛ وكشف مساربه وأغواره المستعصية؛ فالنص الشعري الحقيقي لا يهب نفسه بيسر للقارئ؛ ولذلك، فالشاعر الحديث ليس حديثاً إلا بتجاوزه للمعايير النقدية القديمة، وللمواقف الإيديولوجية القديمة؛ وهذا الأسلوب المنطقي في محاكمته الأشياء، واعتصارها؛ والتجاوز، والجرأة في طرحها منحته الشهرة النقدية والجسارة الإبداعية؛ وإطلاق الإحكام بوعي وحس معرفي؛ إذ يقول :" ومن هنا، نفهم كيف أن القارئ الذي يصدر عن الذاكرة، والعادة، والموروث، بعيداً عن مناخ الاستباق والكشف؛ لا بد من أن يسلك بفكره، إزاء القصيدة، كما يسلك بجسده إزاء مادة يستهلكها : لا يعد نفسه مالكاً إلا إذا استهلكها . ومثل هذا القارئ قد يكون قارئاً لكل شيء إلا الشعر . ومن هذه الزاوية، فإن من يحارب هذا الشعر باسم " الغموض" يحارب الأعماق من أجل أن يبقى على السطح، ويحارب البحر من أجل أن يبقى في الساقية، ويحارب الغابة والرعد والمطر، من أجل أن يبقى في الصحراء... تصوروا الإنسان أو العالم "واضحاً" . لن يكون –آنذاك- أكثر من تسطح هائل، ولن يكون فيها مكان للشعر"(8).
إن الوعي والفهم النقدي بهذه المسألة يضعنا على محراب الوعي النقدي الدقيق بهذه المسألة؛ فالوضوح ليس مطلبا للشعر، وليس من مؤسسات الشعر؛ بل إن الغموض هو عنصر ضروري من ضرورات الشعرية؛ ومن يحارب الشعر بحجة الغموض والتعقيد فإنه لامحالة لا يفهم الإبداع ولا الحقيقة الإبداعية.
وبتقديرنا :إن ما أشار إليه أدونيس ينم على اهتمامه النقدي؛ وآرائه التنظيرية المحكمة، من حيث بلاغة الجملة، واقتصادها اللغوي، ووضوح مقصديتها؛ ناهيك عن محاكمتها العقلية المنطقية المدعمة بالحجج، والبراهين.
ترابط الأفكار وانسجامها، وتلاحمها:
لاشك في أن الحكم على قيمة الحكم النقدي، أو المسألة النقدية لأمر يتعلق بترابط الأفكار وانسجامها وتلاحمها للوصول إلى منتهى الوعي في الحكم والدلالة على الوعي والفهم بالمسألة المطروحة؛ وبتقديرنا : إن ترابط الأنساق اللغوية، وانسجامها وتوازنها من جهة، واتساق الأفكار وتلاحمها وتضافرها من جهة أخرى ليدل دلالة واضحة على شرعية الحكم النقدي،ودرجة الوعي الجمالي في صوغ الجمل، من حيث الوضوح؛ والعمق، والفاعلية، والتأثير؛ وشعرية اللغة؛ وبهذا التصور يقول أدونيس في مسألة التفريق بين الشعر الجديد والشعر القديم من حيث الأسلوب، والبنية، والاتجاه، واللغة؛ إذ يقول:" تكتفي اللغة، في شعرنا العربي التقليدي؛ من الواقع، ومن العالم بأن تمسها مساً عابراً طفيفاً، فهي لغة وصف وتعبير، ويطمح الشعر الجديد إلى أن يؤسس لغة التساؤل، والتغيير، ذلك أن الشاعر هو من يخلق أشياء العالم، بطريقة جديدة. ثم إن بعضهم لا يزالون ينظرون إلى الكلمة نظرة غائية، فهناك، في زعمهم، كلمات شعرية، وكلمات أخرى غير شعرية . كأن القصيدة- عندهم – نوع من الفسيفساء اللفظية، لكن يصعب أن نجد كلمة شعرية بذاتها أكثر من غيرها . إن للكلمة، عادة، معنىً مباشراً، ولكنها في الشعر تتجاوزه إلى معنى أوسع وأعمق، لا بد للكلمة في الشعر من أن تعلو على ذاتها، أن تزخر أكثر مما تعد به، وأن تشير إلى أكثر مما تقول. فليست الكلمة في الشعر تقديماً دقيقاً، أو عرضاً محكماً لفكرة، أو موضوع ما، ولكنها رحم لخصب جديد. ثم إن اللغة ليست كياناً مطلقاً، بل عليها أن تخضع لحقيقة الإنسان الذي يجهد للتعبير كلياً؛ فهي، إذاً، ليست جاهزة بحد ذاتها، بل تشرق وتصير... علينا في الشعر أن نخرج الكلمات من ليلها العتيق، أن نضيئها، فنغير علائقها، ونعلو بأبعادها "(9).
إن هذا الوعي الدقيق في الحكم على أهمية الكلمة،ومالها من دور مؤثر في سياقها، لدليل على أن الحداثوية الراهنة رفعت من الدور المنوط بالكلمة في سياقها؛ وحداثويتها تظهر في نسقها الشعري المناسب الذي يرتقي بها درجات من التكثيف والفاعلية والإيحاء؛وما نلحظه، هنا، أن أدونيس يربط بين الأفكار، فكرة تلو الأخرى؛ بانسجام وتوافق؛ وإدراك معرفي شمولي؛ إذ يعبر بوضوح عن الفرق اللغوي بين لغة الشعر العربي القديم، ولغة الشعر العربي الحديث؛ من حيث الشكل والنمط والفهم والوعي بالأثر الجمالي. فلغة الشعر العربي الحديث لغة التغيير، والإثارة، والتحفز الجمالي، والانبثاق المدلولي؛ في حين أن لغة الشعر القديم هي لغة وصفية لا تعبر عن العمق، وإنما تبقى على السطح، يقول أدونيس:" إذا كان الشعر الجديد تجاوزاً للظواهر، ومواجهة للحقيقة الباطنة في شيء ما، أو في العالم كله، فإن على اللغة أن تحيد عن معناها العادي؛ ذلك أن المعنى الذي تتخذه لا يقود إلا إلى رؤى أليفة، مشتركة... إن لغة الشعر هي اللغة- الإشارة، في حين أن اللغة العادية هي اللغة – الإيضاح. فالشعر الجديد هو، في هذا المنظور، فن يجعل اللغة تقول ما لم تتعود أن تقوله – فما لا تعرف اللغة العادية أن تنقله، هو ما يطمح الشعر الجديد إلى نقله . يصبح الشعر – في هذه الحالة – ثورة داخل اللغة . وفي هذا، يبدو الشعر الجديد نوعاً من السحر؛ لأنه يجعل ما يفلت من الإدراك المباشر مدركاً . كان الشعر التقليدي شعراً عقلياً، أي شعراً يعبر عن عالم يقوم على الترابط والانسجام، أما عالمنا الحديث فعالم مفكك. والشعر الجديد انبثاق عنه .. إذا ًمهمة اللغة أن تقتنص ما لا يمكن اقتناصه عادة، أو على الأصح ما لم تتعود هذه اللغة اقتناصه. صحيح أنه لا وجود لما لا يمكن التعبير عنه، لكن ذلك ليس بفضل وجود اللغة، كمفردات، بل بفضل وجود الشعر الذي يجعل من اللغة سحراً، ينفذ إلى كل شيء. ليس على الكلمة، إذاً، أن تكون مجرد تعبير بسيط عن فكرة، بل إن عليها أن تخلق الموضوع، وتطلقه خارج نفسه"(10).
هنا، إن درجة الوعي الجمالي في التفريق بين لغة الشعر التقليدي، والشعر العربي الحديث أكدت الوعي والحس الجمالي في إبراز الفرق الشاسع بينهما؛إذ؛ يبدو الانسجام والترابط واضحاً في كل جملة؛ وهذا الاتساق الفني العميق بين الجمل؛ يؤكد على دقة أحكامه؛ وحنكته في طرح الفكرة، ودعمها وتعضيدها بالأدلة، والبراهين من ضمن النسق الشعري من ذاته، وهذا الأسلوب جعله يميز في الفقرة السابقة بين الشعر الجديد، والشعر القديم من حيث طبيعة اللغة، وماهية العالم الموصوف قديماً وحديثاً؛ وما يثير القارئ هذا التقصي الدقيق للفكرة حتى يلم بجوانبها كلها؛ كما في قوله:" لقد انتهى عهد الكلمة- الغاية، وانتهى معه عهد تكون فيه القصيدة كيمياء لفظية. أصبحت القصيدة كيمياء شعورية. وأقصد بالشعور هنا حالة كيانية، يتوحد فيها الانفعال، والفكر. القصيدة الجديدة تركيب جديد ينعرض فيه، من زاوية القصيدة، وبوساطة اللغة وضع الإنسان...... إن الشعر الجديد هو بشكل ما، كشف عن حياتنا المعاصرة، في عبثيتها وخللها، إنه كشف عن التشققات في الكينونة المعاصرة؛ لذلك نحن نذكر هؤلاء الذين يثورون في وجه قصائد غير مفهومة، بأن عقلهم يثور غريزياً ...... نحب أن تكون القصيدة وصفاً وحلية وتأوهات، وقيادة حماسية للجملة الشعرية، واليوم تفاجئنا القصيدة- بعكس ذلك – فتراها اكتشافاً لما لم نره، ولم نشعر به أبداً"(11).
إن درجة الوعي الجمالي بالكلمة وقيمتها قد حقق قفزة في الوعي، والفهم الأدونيسي؛ وهنا بدت الأفكار مترابطة منسجمة، تؤكد حنكة الشاعر في تقصي الرؤية، من خلال تمييزه بين الشعر الجديد، والشعر القديم بأن الأول اكتشاف دائم، وسعي دائم إلى الابتكار. وأما في الشعر القديم فهو نمطي تقليدي يصف الأشياء وصفاً خارجياً؛ لايكاد يكتشف العمق.. وبهذا المقترب يقول :" إذ يتخطى الشعر الجديد العالم المغلق المنظم، يتجاوز الأسس التي يقوم عليها واقعنا، ويتطلع نحو عالم مجهول لم يعرف بعد... استطاع الشاعر في الماضي أن يلعب دوره في مثل ذلك العالم، فانحصر غالباً في مهمة تزيينية أو غنائية، لأنه كان يطمح إلى أن يجمل أو أن يضفي صفات الكمال على الأشياء. لكنه الآن لا يطمح إلى أن يعرض الأشياء في شكل جميل، سار أو مؤلم، مما يستطيع كل ذي بصر أن يحس به، بل إلى أن يكتشف، ويعري ما لا يقدر بصرنا أن ينفذ إليه .. يكاد معظم شعرنا العربي القديم أن يجهل دخيلاء الإنسان؛ وهذه الصميمية التي تقربنا من الأشياء وتتيح لنا أن نتعمقها، وننفذ إليها، غائبة عنه تقريباً . ومن مهمة الشعر الجديد أن يجعلنا في تماس دائم مع هذه الدخيلاء، وهذه الصميمية. ربما ازداد الآن وضوحاً معنى التنافر الذي أشرت إليه وقد يتضح أكثر إذا عددنا بعض مظاهره، فمن مظاهره، الفنية، الجديدة: حذف التسلسل المنطقي، وأدوات التشبيه، وعرض الصور مهما كانت عبثية، كأنها بداهة مضيئة، والانفعال المعقد المرهف، وتداخل الصور، والمشاعر، والرموز، وتجاورها، والمزج فيما بينها، هذا كله يباغت بصيرة القارئ ويبلبله. ومن مظاهر هذا التنافر اضطرار الشاعر أن يحمل الكلمات معاني لا تحملها، أو لم تتعود أن تحملها، أي الانشقاق الكبير بين أدوات التعبير، وما يراد التعبير عنه. ومن مظاهره أيضاً أن الشعر الجديد لا مثال له، لأنه يتجاوز المقولات التقليدية في تحديد الشعر وكتابته. ومن مظاهر هذا التنافر عمق الشعر الجديد، كان معظم الشعر القديم يحيا في سطح المادة والعالم، كان وضوحاً للواقع، ولهذا كان خارج الواقع الحي. والشعر الجديد محاولة للنفاذ إلى أعماق الواقع، وراء المظاهر والسطوح وصوب الخارق والفائق"(12).
لاشك في أن تقسيم الأفكار،والربط فيما بينها من مغريات أرائه النقدية الكاشفة عن حسه الجمالي ورؤيته العميقة،وهذا الوعي في ربط الأفكار،والتوليف فيما بينها من محركات الأحكام النقدية الكاشفة عن حسه الجمالي،ووعيه الشمولي بالقضية النقدية المطروحة.
وبتقديرنا :إن ما أشار إليه أدونيس يؤكد فاعلية رؤيته، وإدراكه للفارق بين لغة الشعر القديم، ولغة الشعر الجديد، إذ يرى أن الشعر القديم يعيش دائماً على السطح، ولا يتغلغل إلى الجوهر، في حين أن الشعر الجديد ينفذ إلى الأعماق؛ إلى مركز الرؤية وجوهرها؛ وبهذا الأسلوب الائتلافي يؤكد الناقد أدونيس فهمه الواعي والدقيق لأهمية الشعر؛ وأساليبه المختلفة، وطرائقه في القديم والحديث؛ وهنا، يصل أدونيس إلى مسألة الخلاف الحادة بين قضية(الغموض/ والوضوح) من منظور تحليلي دقيق، يصل قمة في الوعي والفهم، قائلاً:" والحق -أنه ليس من الضروري لكي نستمتع بالشعر أن ندرك معناه إدراكاً شاملاً، بل لعل مثل هذا الإدراك يفقدنا هذه المتعة. ذلك أن الغموض هو قوام الرغبة بالمعرفة- ولذلك هو قوام الشعر.. إلا أن الغموض يفقد هذه الخاصية حين يتحول إلى أحاجٍ وتعميات. ولهذا؛ فإن شرطه، لكي يظل خاصة شعرية أن يكون إشارة إلى أن القصيدة تعني أكثر مما يقوى الكلام على نقله... إن القصيدة/ الأحجية هي كل قصيدة لا تعكس شيئاً، لا توحي شيئاً، لا تثير انفعالاً .. يمكن أن تحذف هذه القصيدة ليس من الشعر وحسب، بل من حقل الحساسية الفنية أيضاً. ومن جهة أخرى يمكن قصيدة ما، أن تكون واضحة بالمعنى العادي، لا سر فيها ولا سيماء عمق إلا أنها هي أيضاً يجب أن تحذف من الشعر، لأنها لا تقدم خلقاً جديداً لشيء ما، أو لمنظور ما"(13).
إن ما أورده أدونيس لجد دقيق في إصابة الحقيقة الشعرية، أو مكمن الإثارة واللذة في النص الشعري،فالقصيدة الأحجية ليست من الشعرية في شيء، لأنها تصبح معضلة، وهنا تفقد رصيدها من الاستثارة والاستقطاب الجمالي؛ وكذلك الحال في القصيدة الواضحة التي لاتقدم إلا المعنى الأحادي والدلالات السطحية الصريحة؛ وهي كذلك تسقط من حقل الشعر والشعرية.
ولعل ما يميز أدونيس في تنظيراته،ومعالجته للقضايا النقدية الشائكة امتلاكه لذاد معرفي واسع، الأمر الذي يدلل على خبرته المعرفية، وتماسك أفكاره، وانسجامها؛ وترابط الرؤى وتوليفها، ليطرح في النهاية رؤية محددة، وحكماً نقدياً دقيقاً؛ إذ يقول في الحكم النقدي، المكتشف إزاء حركة الشعر الجديد،ومقوماته،ومؤثراته مايلي : " كيف نفهم، والحالة هذه؛ حركة الشعر الجديد؟ نفهمهما أولاً، بالتعاطف معها. فالشعر الجديد تجربة شاملة، معقدة، جديدة. وهو، ككل تجربة، يحتاج في فهمه إلى الإيجابية، وإلى التعاطف. ونفهمهما ثانياً بأن نلخص وعينا وعقليتنا من الأمور التالية:
السلفية، فالعقلية السائدة في المجتمع العربي عقلية سلفية ينبع مثلها الأعلى من الماضي لا من المستقبل.
النموذجية؛ وأعني بها أن الكمال الشعري من جهة نظر العقلية السائدة، كائن سابقاً في التراث العربي. وعلى الشعراء في المستقبل أن ينسجوا على نواله، فليس لمتأخر الشعراء؛ كما يقول ابن قتيبة، أن يخرج على مذهب المتقدمين الشكلية؛ فالتعلق بالنموذج أدى إلى التعلق بالشكل. فليس الشعر، من وجهة نظر العقلية السائدة، رؤيا، بل صناعة ألفاظ . إن الشعر العربي، من هذه الناحية، لا ينبع من كيفية رؤيا العالم وخلقه، بل من كيفية رؤيته وصنعه.
التجزيئية، فلا تنظر العقلية السائدة إلى القصيدة ككل وكوحدة؛ بل تنظر إليها كأجزاء مستقبلية منفصلة.
الغنائية الفردية، فقد درجت العقلية السائدة في المجتمع العربي على فهم، أو تذوق الشعر العربي الذي هو غنائي فردي في مجمله، إذ يعكس انفعال الشاعر كفرد، أو أوضاعه الاجتماعية كفرد.
التكرار، فالثقافة العربية الموروثة السائدة ثقافة إعادة وتكرار. إنها تدور ضمن عالم مغلق، محدد قبلياً، لا حركة فيه. هذه الثقافة، حقائق أبدية، أزلية، لا يجوز تخطيها... وبعد، هل يمكن أن نقوِّم الشعر الجديد ؟ ... إني أرى، شخصياً، أن تقويمه في هذه المرحلة سابق لأوانه إلا أننا، بشكل عام، ودون الدخول في التفاصيل، نستطيع أن نقول: إن الشعر العربي، وبخاصة في الحركة التي تمثلها مجلة شعر، آخذ في تحول، وتطور خلاقين لا مثيل لهما في تاريخه: إنه الآن يتجه – وعلى وجه التحديد- في مجلة شعر، على أن يصبح ذا نبأ تركيبي سمفوني يتيح له أن يحتضن الحياة كلها، والواقع كله. إن هندسة داخلية خفية تسيطر عليه، وتوجهه .مقابل القصيدة الكلمة، والقصيدة الفكرة؛ والقصيدة – الانفعال؛ وهي نماذج أصبحت تاريخية؛ تشرئب القصيدة الجديدة، القصيدة – الرؤيا. والقصيدة هنا ليست بسطاً أو عرضاً لردود فعل من النفس إزاء العالم؛ ليست مرآة للانفعال غصباً كان أو سروراً،فرحاً أو حزناً، وإنما هي حركة ومعنى، تتوحد فيها الأشياء والنفس، الواقع والرؤيا. إنها، بهذا المعنى، القصيدة- الواقع بكل أعماقه وأبعاده، أو القصيدة- الحياة. ومع ذلك فلعل أعظم ما تقوم به الحركة الشعرية الجديدة، بتجسيدها الأعمق والأكمل في مجلة شعر" هو أنها حركة منذورة في هذه الآونة، للبحث، للتقدم. إنها جهد حياتنا المعاصرة، وتوترها، لكي تنمو وتتفتح وتتكامل بلا حد"(14).
لاشك في أن أدونيس في أحكامه النقدية وأطروحاته النظرية حول حركة الشعر القديم وتوجهاته، والشعر الحديث وأساليبه قد وقف على المؤثرات التي تميز كل واحد منهما عن الآخر؛ ومقدار امتلاكه خصائصه المميزة وسماته الخاصة التي يتفرد فيها كل واحد منهما عن الآخر؛وهنا؛ يؤكد أدونيس على دوره المتنامي في إرساء قواعد الاختلاف بين الأسلوب القديم، والأسلوب الحديث المتبع في الشعر القديم والشعر الحديث؛ وبذلك يتبين لدينا فهمه للشعرية ومحفزاتها الجمالية.
د.عصام شرتح