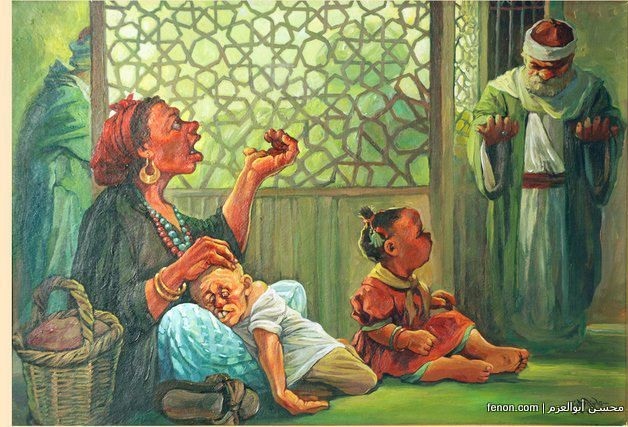صحيفة المثقف
القيم الفنية والجمالية في آراء أدونيس النقدية (2)
 التسلسل المنطقي في تتبع الأفكار، وإبراز توازنها، والبرهنة عليها:
التسلسل المنطقي في تتبع الأفكار، وإبراز توازنها، والبرهنة عليها:
إن ما يميز آراء أدونيس النقدية براعته في تتبع الفكرة، واستقصاء أبعادها، وخلق توازنها وائتلافها مع ما يسبقها من رؤى،وأفكار، وما يتلوها من دلالات ورؤى جديدة مكتشفة؛ فالفكرة-لديه- تجدها مدعمة بالحجج والبراهين التي تؤكد مصداقيتها، وائتلافها وتضافرها مع بعضها بعضاً، للوصول إلى الحكم النقدي الدقيق، مدعماً بالبراهين والأفكار المنطقية المقنعة؛ ومثالنا على ذلك؛ مناقشته لمفهوم الحداثة. إذ يقول: "يمكن اختصار معنى الحداثة؛ بأنه التوكيد المطلق على أولوية التعبير، أعني أن طريقة - أو كيفية القول أكثر أهمية من الشيء المقول، وأن شعرية القصيدة، أو فنيتها هي في بنيتها لا في وظيفتها. وهذا يتضمن نتيجة أساسية : ليست قيمة الشعر في مضمونه بحد ذاته، سواء أكان واقعياً أو مثالياً، تقدمياً أو مرجعياً، وإنما هو في كيفية التعبير عن هذا المضمون. قد يكتب شاعر عن موت شهيد ثوري قصيدة، ويكتب شاعر آخر قصيدة أخرى عن موت عصفور، ومع أن الموضوع الأول أغنى وأجمل. لكن هذا لا يعني أن القصائد تدور حول موضوعات من النوع الأول هي بالضرورة، قصائد رديئة. بل يعني أن المهم هو الشاعر، وكيفية تعبيره، وليس الموضوع بحد ذاته، ومن هذا نخلص إلى ثلاث حقائق:
الأولى، هي أن الإصرار على أولوية الموضوع، أي على وظيفة الشعر، إنما هي نفي للشعر. والثانية، هي أن القارئ الحقيقي كالشاعر الحقيقي لا يعنى بموضوع القصيدة؛ وإنما يعنى بحضورها أمامه كشكل تعبيري، أعني بنيتها الفنية الجمالية.
والثالثة، هي أن على القارئ الجديد أن يتوقف عن طرح السؤال القديم : ما معنى هذه القصيدة؟! وما موضوعها؟ لكي يسأل السؤال الجديد : ماذا تطرح علي هذه القصيدة من الأسئلة، وماذا تفتح أمامي من آفاق؟ . في هذا السؤال ما يشير على أن الشعر، الشعر الحقيقي، لا يستنفد: أي أن فيه كثافة وغموضاً، وإلى أنه يجب تذوقه كما هو، بما هو، لذاته، كما نتذوق الليل، كما نتذوق البحر.
إذاً، كيف نفهم الصلة بين الشعر والثورة؟ يفترض بحسب العادة، أن نحدد الشعر والثورة، قبل أن نحدد الصلة بينهما. لكن السؤال عن ماهية الشعر وماهية الثورة؛ لا يهم الشاعر الثائر، وإنما يهم هواة الثورة والشعر"(15).
إن التدقيق فيما أورده أدونيس من آراء في منظوره النقدي حيال علاقة الشعر باللغة والفرق بين الشعر الحقيقي الذي يبصم،ويؤثر،والشعر الضحضاح السطحي الذي لايتجاوز جسده اللفظي، يقودنا إلى حقيقة آمن بها أدونيس،وهي أن الشعر الحقيقي لا يركز على الموضوع بقدر ما يركز على الطريقة الفنية والجمالية في نقل الموضوع،وتجسيده فنياً، في حين إن المووضوع مهما كان عظيماً لاينتج نصاً إبداعياً عظيماً؛ لأن القيمة ليست بالموضوع وإنما في شكل التعبير ومظاهر إثارته وجذبه للقارئ جمالياً.
ووفق هذا التصور، اعتمد أدونيس في طرحه لهذه المسألة(مسألة التعبير الإبداعي/ والتعبير التقليدي المستهلك) التسلسل المنطقي في تتبع الأفكار؛ والبرهنة عليها؛ معتمداً في البداية تعريف مفهوم الحداثة، ومن ثم اتجه بعد ذلك إلى طرح الأفكار، والتوليف فيما بينها حول قيمة الشعر، وماهية الشعرية والموضوعات التي تطرحها الشعرية؛ ثم استنتاج الحقائق، والبرهنة على صحتها، والوصول إلى النتيجة النهائية، والقيمة المنشودة من هذا الحكم النقدي أو ذاك .
ولو تتبعنا المسألة التي طرحها أدونيس حول مسألة الحداثة والقصيدة الحداثية لخلصنا إلى أحكام جريئة، ومواقف رؤيوية غاية في الوعي والخبرة الجمالية في تتبع الظاهرة والوقوف على حقائقها، إذ يقول " * ليست القصيدة الحديثة مجرد شكل من أشكال التعبير، وإنما هي أيضاً شكل من أشكال الوجود .
* تزداد قيمة القصيدة عند بعضهم بقدر ما تقترب من سيماء شعر عرفوه، أما عندي فإن قيمة القصيدة تزداد بقدر ما تبتعد عن هذه السيمياء، بحثاً عن سيميائها الخاصة .
* هل شعرك حديث؟! إذا هو، قبل كل شيء، ومن حيث التجربة وأشكال التعبير، مختلف عما سبقه، لا مؤتلف معه. علينا، بهذا المعنى، لكي نكون- بالفعل- شهود عصرنا، والمعبرين الحقيقيين عن التجربة العربية الحديثة- علينا أن نفتح الهاوية في كل مكان.
* السائد في الحياة الثقافية الأدبية، هو الحكم للكاتب، أو عليه بمقاييس غير فنية. نرفضه نحاربه، نقلل من شأنه، وأهميته لأنه يخالفنا الرأي، والفكرة، أو العقيدة، أو السياسة . نرى أن أدب الكاتب فاسد لأن آراءه السياسية؛ أو الفكرة بالنسبة إلينا فاسدة. فأهمية الكاتب أو تفاهته تتصلان، عندنا- بآرائه أكثر بكثير مما تتصلان بإبداعه. وهذا مما يفسد الحياة الأدبية، ويشوه قيم الإبداع، ويقضي في النهاية على الإبداع ذاته"(16).
لقد أصاب أدونيس مكمن الحقيقة الشعرية والعقلية العربية في تلقي النص الإبداعي؛ فالقيمة ليست للمبدع أوالمنتج الإبداعي بقدر ماهي للعرف والواقع السائد في الفهم الإبداعي، إن هذا الفهم سرعان ما أضعف العقلية الإبداعية في تلقي المنتج الإبداعي، بل و الحكم عليه سلفاً بالعزلة،والانغلاق،و القيدية (الموت النصي) أو السكتة الإبداعية.وهذا ما كشفه أدونيس في منظوراته النقدية، وأحكامه المختلفة حيال المنتج الإبداعي، وشكل القصيدة،ومضمونها، فالذي يحاربه القارئ يتمثل حقيقة في أفكار المبدع ذاته؛ و ليس شكل الإبداع، وطريقة التعبير؛ وعلى هذا يمكن القول:إن القدرة التي يملكها أدونيس من حيث ربط الأفكار، بتسلسل منطقي، مقنع يهب آراءه النقدية قيمة أدبية عالية من جهة؛ وقيمة فكرية مدعمة بالبراهين والحجج والأدلة الدامغة التي تؤكد مصداقيتها وقربها من ملامسة دواخل المتلقي من جهة ثانية؛ تسعفه في ذلك بساطة في الطرح، وسلاسة في استخلاص النتائج، والبرهنة عليها، ففي قوله: ليست القصيدة الحديثة مجرد شكل من أشكال التعبير، وإنما هي شكل للوجود؛ يبرهن الشاعر على فاعلية القصيدة الحداثية، بوصفها شكلاً من أشكال الوجود، وليست مجرد شكل من أشكال التعبير؛ فهي تتجاوز الشكل إلى نطاق الجوهر، وفي هذا الانتقال تبيان لأهمية الشكل الأسلوبي الجديد للقصيدة الحداثية؛ مقارنة بشكلها القديم؛ فهي ليست مجرد شكل لغوي تتخذه القصيدة كجسد لغوي؛ وإنما هي شكل للوجود؛يظهر أثره من خلال جوهر الرؤيا التي تطرحها القصيدة. وبهذا المعنى؛ تكتسب آراء أدونيس مصداقيتها الفنية، وطاقتها الإبداعية بحسن نسقها، وترابط أفكارها، وتلاحمها، وطرحها النقدي الجديد.
جمالية الانتقال بالأفكار وتعزيزها وتأكيد مصداقيتها:
إن إدراك أدونيس لدور الكلمة، وقيمتها في لغة الشعر؛ دفعه إلى التركيز على كيفية التشكيل وطريقة التعبير؛ لهذا امتازت آراؤه النقدية بجمالية الانتقال الفني المترابط بين الأفكار؛وتعزيزها، وتأكيد مصداقيتها؛ إذ تتضمن أفكاره التسلسل،والتماسك،والإقناع عبر المحاكمات العقلية المقنعة، والإمتاع المعرفي، عبر السلاسة اللغوية، والبساطة في طرح الأفكار وتعزيزها بالبراهين، والأدلة المنطقية الدامغة؛ ومثالنا على ذلك هذه السلاسة في الانتقال بين الأفكار وتعزيزها في قوله :" إذا كان الشعر لا يعمل، وكان تسمية للأشياء، فمن الممكن تحديده بأنه فن لغوي: نوع فريد من اللعب الخاص في حقل الكلمات، أكثرها لصوقاً بالنفس، وكشفاً عن العالم، فإنه أعمقها قدرة على التسمية، وأكثرها نفاذاً وصحة. وهو إذاً، في هذه التسمية، لا " يعبر " عن الأشياء أو الواقع، وإنما يحرك جزءاً غفلاً من الكون، أو يوقظ قوى خفية، ويشير إلى ما ليس معروفا...ً فليس الشعر تعبيراً، إنه تأسيس"(17).
إن هذا الوعي في تتبع الفكرة،والبرهنة عليها، وتعريفها بدقة لهو طريق نجاح أدونبس في إكساب حكمه النقدي قيمته وبلاغته، وإصابته المعنى والهدف المنشود .وهذا يدلنا على أن التمهيد للفكرة، ونسج الجمل والربط بين الأفكار لهو سر إبداع أدونيس في آرائه النقدية؛إذ يعتمد التآلف بين الأفكار من جهة؛ والإمتاع اللغوي عبر الحجج، والبراهين، والرؤى المقترحة من جهة ثانية، مما يكسب أفكاره وأحكامه النقدية خصوصيتها في العمق، والإمتاع، و التأثير،نظراً إلى تقصيه البارع، كما في هذا القول عن وظيفة اللغة الشعرية، ودور اللغة في الإبداع أو الصوغ الشعري البارع؛ودليلنا أيضاً قوله:" باللغة يظهر الإنسان ما هو، وبها يتأسس، ويتحقق ...إنها ممارسة كيانية للوجود، أو هي شكل وجود، قبل أن تكون شكل تواصل، أو بتعبير آخر: لم تكن اللغة للإنسان الشكل الأساس لتواصله، إلا أنها كانت الشكل المبين لوجوده. والشاعر -إذاً- لا يكتب عن الشيء، وإنما يكتب الشيء . إذ اللغة ليست للإنسان لكي يقول ما هو واقع وحسب، وإلا تسامت بغيرها من الأدوات، وإنما هي أيضاً، وقبل ذلك؛ لكي يقول الوجود- كينونة وصيرورة . لذلك حيث لا تكون لشعب ما لغة على هذا المستوى، لا يكون له تاريخ فعال، ولا ثقافة عظيمة.. في هذا المنظور يتضح معنى التجريد، كمفهوم فني. فهو كبحث عن الجوهر، محاولة لرؤية مالا يرى. وهو إذاً، تجاوز للطبيعة، وأشكالها، وخلق عالم من الأشكال المحضة؛ أو هو رد الأشكال كلها إلى جوهرها . إنها تشفيف للمادة. لا يريد منها غير الجوهر. الأشياء المادية فوضى تشوش وزوال .. رماد مبعثر. من هذا الرماد يلتقط التجريد إشارة النار.. فمشروعه تبصيري لا بصري.. إنه مشروع اكتناه"(18) وخلق جديد للوجود.
إن اللغة في الشعر ليست ممارسة لغوية فحسب،وإنماهي طريقة في التفكير والتعبير، وهي بحث عن الكينونة والجوهر،إنها ليست فوضى الإحساس، وهي رؤية ما لايرى، إنها الكون المتنامي الذي مازال يعطي، ويمنح ويخلق وجوده الجديد.
إن ما يميز الجمل السابقة التوليف الدلالي فيما بينها من حيث جمالية الانتقال بالأفكار، وتعزيزها بالأدلة المقنعة، لتأتي الفكرة مبرهنة مقنعة؛ شاعرية، دقيقة في إصابتها المغزى الدلالي.
واللافت أن أدونيس يطرح بعض الآراء القيمة حول الموضوع المدروس اللغة/ الثقافة/ الواقع بإدراك معرفي؛ إذ إنه ينتقل بين الأفكار بسلاسة لغوية، خبرة معرفية؛ تنم على مهارة، وحنكة، ومراوغة في الانتقال من فكرة إلى أخرى؛ ومن دلالة إلى أخرى؛ بحسن تأملي دقيق، وإدراك معرفي شامل؛ إذ يقول:" الاتجاه الثقافي الغالب في المجتمع العربي هو التمسك بثقافة الماضي إلى درجة يعتقد معها أنه بقدر ما يحافظ على هذه الثقافة، يحافظ على وجوده ذاته. ليس هذا التمسك اعتقاداً وحسب، وإنما يتجسد في الحياة ذاتها- في البرامج التربوية، وفي المؤسسات الثقافية، وفي حركة الفكر. وهو يعكس مفهوماً معيناً للثقافة: معرفة الكتب الماضية أو معرفة ما لا يتناقض معها . وهذه معرفة يتحدث عنها الذين يمثلون هذا الاتجاه الغالب، من مربين ومفكرين وكتاب، بنبرة تكاد أن تشارف التقديس .. هكذا؛ يرون أن قوة المجتمع العربي، مرهونة بقوة الثقافة الماضية، ومدى استمرارها، وفعلها... ومن هنا أتى السبب في أن الثقافة العربية لا تزال حفظاً ونقلاً. أي أن العلاقة بينها وبين العربي لا تزال تشبه علاقة مخطئ بمعصوم، وتلميذ بمعلم. التساؤل، الرفض، التجاوز... هكذا كلها ليست خروجاً على الثقافة وحسب، وإنما هي كذلك خروج على المجتمع ذاته، حتى إن الغريب عن المألوف لا يعد إبداعاً، وإنما ينظر إليه من باب الفضول والتعجب، وعلى أساس أنه يصدر عن نوع من الجنون. وليست حياتنا اليومية إلا صورة عن ثقافتنا: عالماً موحشاً من النهي والأمر"(19).
إن نظرة أدونيس الصائبة إلى الثقافة العربية على أنها تقديس الماضي، وتمسك بتعاليم الماضي وبرامجها التربوية ومؤسساتها الثقافية لجد دقيق في إصابة واقع تخلفنا الراهن وثقافتنا القاصرة،ومشكلة النظرة إلى واقعنا وتاريخنا . وهنا،نلحظ أن اعتماد الجمل البسيطة، وتآلفها،وتوازنها يؤكد بداعة منظوره النقدي، وحسه المعرفي؛ من خلال تنظيره وفهمه للقضايا الأدبية ومن ضمنها لغة الشعر؛ إذ يقول: " ليست اللغة وسيلة تعبير وحسب، وإنما هي كذلك طريقة تفكير. لكل وضع اجتماعي إذاً لغته: لغتنا السائدة هي لغة أوضاعنا السائدة . وهذه أوضاع متخلفة على جميع المستويات. لهذا، كانت هذه اللغة متخلفة على جميع المستويات، إنها لغة بيانية، ضعيفة، زخرفية، والمجتمع هنا، يستهلك اللفظة، كمتعة فردية، أي، كما يستهلك السلعة. هكذا فقدت اللغة حيوية الإبداع وحرارة الحياة: تحولت إلى ما يشبه الركام. لهذا، أخذت تناقض العمل . إنها تمجد لحظة الكلام، لا لحظة العمل، لحظة الاستهلاك، لا لحظة الإنتاج"(20).
إن ما اكتشفه أدونيس من أن اللغة طريقة تفكير،وأنها ليست وسيلة تعبير فحسب، جعل حكمه مصيباً وتقصيه مقنعاً، إذ يرى أن الثقافة مظهرها اللغة/ وتطور اللغة؛ لأن اللغة – من منظور أدونيس- ليست وسيلة للإفصاح والتعبير بقدر ما هي طريقة للتفكير... ولما كانت اللغة لغة أوضاعنا المتخلفة فقد أصبحت متخلفة كذلك عن مواكبة العصر والتطور التقني الحالي؛ لذلك، بدت متخلفة هي أيضاً، وبحاجة إلى التطور، لتعبر عن ثقافتنا وأوضاعنا وإبداعنا المستقبلي والراهن .. إن هذا الانتقال بين الفكرة والأخرى يؤكد مصداقية الرؤية النقدية، وعمقها وتآلفها؛ من جهة؛ ويؤكد كذلك بداعة المنظورات النقدية ودقتها عند أدونيس في إصدار الأحكام النقدية، تبعاً لتقصي، وإدراك شامل للرؤية، أو الحدث، أو الفكرة المجسدة.
ويتابع أدونيس هذا التقصي بقوله :" لا يمكن أن يتولد الوعي من قراءة التراث أو تعلمه، فهذه القراءة تنقل ثقافة من فوق، ومن خارج الحياة العلمية : أي أنها تنقل ثقافة تعليمية وتجريدية في آن .. نضيف إلى ذلك " أما الجماهير" العربية فتعيش في دوائر مغلقة، ولا تعيش متفاعلة ذائبة في نسيج اجتماعي متحرك، واحد وفعال. وكما أن ثقافتها جزء من ثقافة السلف، فإن حياتها استمرار لحياة السلف. ليس همها إذاً أن تبتكر، بل أن تتشابه، لكن، لا زمان إلا لمن يبتكر. أما الذي يكتفي بالنقل،والتشبه فكأنه يرفض المستقبل : ويعيش في ماض يتطاول..
إن الجماهير العربية لا تزال تعيش في زمن ثقافي مائت. وهي لذلك، لا تزال تواجه التاريخ بما أصبح خارج التاريخ ... إن دخول الإنسان العربي في حركة الثورة مرهون، إذاً، بحريته الكاملة في الممارسة الثورية، العملية والنظرية، وفي إعادة النظر الجذرية المستمرة في ما يرثه من مفاهيم، وقيم، وفي ما يحققه . وبهذا وحده يتفتت العالم القديم، ويصعد من أنقاضه عالم جديد: عالم زاخر من الأشكال، والأوضاع، والأفكار... من هنا يتغير معنى صلة المثقف الثوري أو المبدع الثوري بالموروث. فهي ليست صلة إحياء أو تمجيد.وإنما هي صلة نقد، وتحليل، وتجاوز. هكذا، ندرك كيف أن دور المبدع لا يكمن في المحافظة على النظام الثقافي الموروث، وإنما يمكن في تفجيره وتطويره"(21).
فأدونيس يرى أن الوعي بالتراث لا ينطلق من ثقافة موروثية، وإنما ينطلق من وعي حداثي بهذه الثقافة، وتمحيصها.. فالثقافة الموروثية هي ثقافة نقد، وتحليل، وتجاوز لا ثقافة إحياء، وتمجيد، وتقديس للتراث؛ والناقد إن لم يملك أدواته المعرفية في نقد التراث لن يحصل شيئاً؛ لأن بذرة المعرفة -عند أدونيس- تكمن في الاكتشاف، والتجاوز، والابتكار لا في التمجيد والتقديس الذي لا ينتج سوى فقاعات لا قيمة لها سرعان ما تذوب، وتضمحل، وتتلاشى. إن هذا الإدراك و الوعي -لدى أدونيس- قد جعل آراءه النقدية من طريقة تفكيره ومظهر حداثته، إذ يقول :" لا يمكن أن تخلق ثقافة عربية ثورية إلا بلغة ثورية. كيف نجعل، إذاً، من اللغة العربية لغة ثورية؟ هذه فيما يخيَّل إليَّ مشكلة من أعقد المشكلات التي تواجهها حركة الثورة العربية. لكن ماذا نعني بثورة اللغة؟ نعني أن تصبح الكلمة، وبالتالي الكتابة قوة إبداع، وتغيير تضع العربي في مناخ البحث، والتساؤل، والتطلع... الكلمة، كما ورثناها، لا تعبر عن كثافة انفعالية أو رؤياوية، بل عن علاقة خارجية، إنها شبه حيادية، لأنها مملوءة بدلالة مسبقة تجيئها من خارج. حين حاول أبو تمام، مثلاً، أن يثور على هذه الكلمة، قيل عنه إنه أفسد الشعر، وهذا يعني إنه غير نظام الكلام الموروث. لذلك لم يفهمه القراء والنقاد الذين يرثون هذا النظام ويحافظون عليه "(22).
ويتابع قائلاً :" الثورة اللغوية هنا تكمن في تهديم وظيفة اللغة القديمة، أي في إفراغها من القصد العام الموروث. هكذا تصبح الكلمة فعلاً لا " ماضي" له، تصبح كتلة تشع بعلاقات غير مألوفة... الثورة التي نتطلع إليها في اللغة العربية ليست، إذاً، شكلية أو جمالية تقصر همها على حروفية الألفاظ؛ على جرسها الخارجي؛ على تآلفات النغم واللفظ. وإنما هي تفجير للغة من الداخل. إن ثورة اللغة حين تقتصر على الشكل، على الجرس وإيقاعاته النغمية، تتحول إلى ترجيع مصطنع(23).
وهو بذلك، يشير إلى أن وظيفة اللغة في ثورتها اللغوية؛ وتجاوزها للمأثور من القول؛ ولذا؛ فالكلمة الشعرية تشع بإيحاءات لا حدود لها؛ تصبح كتلة من المشاعر، والرؤى، والأحاسيس، لا تقتصر فقط على جرسها الصوتي وإيقاعاتها النغمية الخارجية فحسب؛ وإنما هي تفجير للكلمة واللغة من الداخل، لتعبر عن جراح الذات، وتأملاتها، وحيثياتها الوجودية؛ فتبدو لغة الحداثة لغة نابضة من جوهر الذات ومعاناتها، وتطلعاتها؛ وبهذا يؤكد ما يدعم موقفه الحداثوي قائلاً:" ليست هذه الثورة عودة إلى الجذر، أو الأصل. فمثل هذه العودة تجعل من اللغة كياناً مقدساً، لغة فوق اللغة، أي أنها تعزلها عن التاريخ والزمن والإنسان، وتحولها إلى طقس يحرك الإنسان في اتجاه الأبدية . هكذا، تصبح اللغة إقامة مسبقة في الجنة لذلك ترفض التلوث بغبار الأرض؛ أو الاندماج في الواقع اليومي، لأن هذا الواقع تغير مستمر، أي فناء دائم، فيما هو بقاء دائم...، واللغة، بحسب تلك النظرة؛ لا تحب الفاني، بل الباقي.
ومن هنا؛ تهمل الحاضر لأنه ليس إلا عبوراً سريعاً نحو الأبدية. غير أن التعلق بالأبدية يؤدي إلى سلبية كاملة. يصبح اغتراباً كاملاً عن حركة التاريخ؛ وهذا يؤدي باللغة إلى أن تعيش خارج الزمان والمجتمع. ومن الطبيعي، إذاً، أن تهدم الواقع لكي تبني الكلام. لكن زمن مثل هذا الكلام هو نفسه زمن باطل لأنه يتوق إلى الذوبان والانصهار في الأصل والجذر، في الأبدية... والوحدة في لغة كهذه ليست وحدة تأليف بين عناصر مختلفة، وإنما هي كوحدة الخطوط الأرابيسكية؛ وحدة عناصر تتكرر، وحدة مبعثرة.. إنها وحدة الكلمة التي " تصطنع "، ووحدة البيت الشعري المفرد"(24).
إن الثورة اللغوية – التي يقصدها أدونيس – ليست العودة إلى الجذر التاريخي إلى الموروث وتمحيصه؛ وإنما في السعي إلى تجاوز الموروث بما هو جديد ومبتكر؛ بلغة لا تقدس اللغة؛ وإنما تتجاوزها إلى لغة إيحائية، تحطم قيود اللغة السائدة التي تقدس التراث، وتصفه وصفاً دون التغلغل إلى أعماقه، ونقده، والإضافة إليه؛ مما يجعل اللغة تقف على السطح دون التغلغل إلى الباطن، وهذا من ثم يجعلها تعيش خارج الزمان والمجتمع؛ ويجعلها تجريدية بعيدة كل البعد عن الواقع اللغوي الذي نشأت وترعرعت فيه.. وقد جاءت جمالية الأحكام النقدية من خلال الانتقال المتوازن بين الأفكار، وتعزيزها، وتأكيد مصداقيتها؛ عبر سلاسة اللغة، ودقتها، ومحاكمتها العقلية المدعمة، بالحجج والبراهين والأدلة الدامغة؛وهنا يفرق أدونيس بين اللغة القديمة والحديثة قائلاً:" الفرق الأساسي بين اللغتين " القديمة " و" الحديثة" هو أن المعنى في اللغة القديمة موجود مسبقاً، والكاتب يصوغه بشكل جديد .لكن المعنى في اللغة الحديثة ( الثورية ) ينشأ في الكتابة وبعدها.. فالمعنى فيها بعدي لا قبلي .. من هنا تنشأ مشكلة الصلة بين الجمهور والكاتب الثوري. الكاتب الثوري الذي يعيش وسط جمهور كجمهورنا العربي، معزول بحكم إبداعه ( أي ثوريته) من جهة؛ وبحكم التخلف الموروث الذي يخيم على هذا الجمهور، من جهة ثانية. الجمهور يتعلق، بل يتشبث بكل ما يبقيه ضمن العالم الذي ألفه لكن الكاتب ليس ثورياً إلا لأنه يزعزع هذا العالم الأليف؛ الموروث من أجل ابتكار عالم نقي، جديد"(25).
إذاً؛ إن أدونيس يرى أن المعنى في اللغة القديمة معنىً مؤطر بشكل مسبق؛ أي محدد؛ ومقنن؛ في حين أن المعنى في اللغة الحديثة معنىً بعدي، أي تفرضه طبيعة اللغة... فهو الذي يتولد لحظة الصوغ الشعري، في حين أن المعنى في اللغة القديمة معنًى محدد، ومؤط،ر ومقولب بشكل مسبق؛ وهذا ما يجعل اللغة القديمة لغة وصفية محددة من قبل المبدع ومفهومه؛ لا من قبل القارئ ومكتشافاته؛ لأنها تقع ضمن العالم الذي ألفه وعاشه؛ وتعرف عليه؛ لكن اللغة الحداثية لغة ثورية لأنها تزعزع قيم القارئ ومفاهيمه.. نظراً إلى جدة العالم الذي تطرحه، والذي لا يعيه المتلقي؛ وتصدمه بهذا العالم، ليعاود اكتشافه من جديد .. يقول أدونيس:" ليست الكتابة الثورية وقوداً؛ بل هي الضوء الذي يتوهج أبداً؛ بتعبير بسيط: لن تستطيع الكلمة كإبداع أن تربح للثورة شخصاً لا يشكل إبداع الحياة وتغييرها جزءاً جوهرياً من كيانه وفكره. قد تربحه" ككتلة مادية"، كتراكم وراثي"... لكنه في مجمل هذه الحالة لن يكون أكثر من وقود. والأساسي، له، وللثورة، وللمستقبل، أن نجعل له بؤرة من الضوء، لا حطبة يابسة. إن الدور الحقيقي للكاتب الثوري العربي يتمثل -فيما أسميه- تفكيك الزمن الموروث. ووسائل التعبير السائدة، سواء في الشعر أو النثر؛ في الموسيقى أم الرسم، في التمثيل أو الغناء، لا تزال رسوماً تزيينية تلتصق على ساحات هذا الزمن وجدرانه. لقد فقدت، كهذا الزمن، القدرة على الخلق . لذلك لا بد من الشجاعة لرفض هذا الزمن، وهذه الوسائل والهبوط عميقاً، فيما وراءها، إلى التفجيرات القادرة على إعادة خلق الإنسان العربي، وتحريك فكره، وكيانه كله في اتجاه الثورة. لا بد من شجاعة الاعتراف بأن هذا الزمن مات، وبأن وسائله ومضموناته ماتت، وبأنه يستحيل أن نثور به أو بها. دون ذلك سنظل كمن يحارب الطفولة بالهرم، وشمس المستقبل بظلام الماضي"(26).
إذاً؛ إن الدور الحقيقي للكاتب الثوري- من منظور أدونيس- يكمن في تفكيك وسائل التعبير السائدة؛ والثورة عليها بطرائق تشكيل جديدة؛ قادرة على كشف ما مضمر في الداخل؛ أو كشف ما كامن في الجوهر، من خلال القدرة على الخلق الفني، والابتكار. ولولا ذلك لا يمكن أن يطور الشاعر في رؤاه وأفكاره؛ومن هنا فإن الكاتب الثائر هو الذي يغير في أدواته التعبيرية، ليعبر باللغة عن مضمونات جديدة، ورؤاه الثورية التجديدية في الحياة والفكر جميعها.
ويتابع أدونيس قائلاً :" يحدد سارتر الكلمة في دراسة له عن (مالارميه) بأنها طريقة امتلاك الشيء، وهو امتلاك ينقل الشيء إلى الآخر؛ ذلك أن الإنسان يكتب لكي يوصل إلى الآخر ما يكتبه، غير أن (مالارميه) لا يستخدم اللغة لكي يقرب العالم إليه؛ بل لكي يبقيه بعيداً عنه، لكن هل تستطيع اللغة أن تنقل حقيقة العالم؟.. إن كثيراً من الباحثين في علم اللغة يشككون في إمكانية هذا النقل. فاللغة – بالنسبة إليهم- لا تقدر أن تتجاوز سطح التجربة. أما الباقي فيظل خارج اللغة، غائباً، يلفه الصمت. إن الكلمة تعجز أكثر فأكثر عن النفاذ إلى عالم الطاقة الكونية، عالم التواصل الفضائي، والزمن النسبي، والبنية الذرية للكائنات. كأن الحقيقة، إذاً، تبدأ الآن خارج اللغة ..... لكن بعضهم لا يرى أزمة اللغة في اللغة ذاتها، بقدر ما يراها في غياب أو انعدام الأنبياء أو السحرة الجدد الذين يستطيعون أن ينفضوا عنها رمادها، ويبعثوها متوهجة كشمس الصباح"(27).
إن ما يؤكده أدونيس أن اللغة ليست العائق الوحيد في تخلف الفكر العربي؛ وإنما في الفهم الحقيقي لدور اللغة وفاعليتها في التغيير؛ إذ يقول:" إن التطور الحديث بلبل علاقة لغتنا بالعالم، وهو يفصل بينهما شيئاً فشيئاً، مثلاً، الكلمات التي نتداولها ضائعة فهي الماضي الذي تجاوزه تفكيرنا، لكنها- في الوقت نفسه- الماضي الذي لا يزال مستمراً في مؤسساتنا . وهي إذاً، لا تعبر عن واقعنا وحاضرنا، ولا عن مستقبلنا، وإنما تعبر عن وهم استمرارنا في الوجود. وهذا الفرق بين اللغة والواقع آخذ في التزايد يوماً فيوماً . وحين لا يعود للكلمات معنىً تصبح أية كلمة صالحة لأي شيء، أو لأي معنى. هكذا؛ نتكلم لكي نقتل الكلمات، أو لكي لا نقول شيئاً، أو نتكلم لغة لا نقول إلا ما يناقضها؛ الطاغية يتحدث عن الحرية؛ والمنافق عن الصدق، والكاذب عن الحقيقة. في ضوء ذلك، نكتشف أن العجز عن التعبير، عن الإحاطة بالعالم وأسراره، والذي ينسب عادة إلى اللغة، لا يكمن في اللغة بحد ذاتها، وإنما يكمن في غياب الإنسان الذي يعرف أن يفرغ اللغة من ليلها العتيق، ويردها إلى براءتها الأولى. هنا يكمن سر الإبداع الشعري . وفي هذا المستوى وحده يصح القول: إن الشعر هو، أولاً، لغة... لكن إذا أردنا أن ندرس هذه العلاقة بين اللغة والموضوع – على الصعيد الاجتماعي- السياسي في العالم العربي الذي يتحرك في اتجاه الثورة، فماذا نلاحظ؟! نلاحظ أن ثمة انفصالاً بين الثورة، كلغة وفكر، أي كواقع يعبر ويفكر، والثورة كعمل وتغيير، أي كواقع يتبدل في قاعدته وقمته، في بنيته السفلى وبنيته العليا... ويتجلى هذا الانفصال؛ بشكل مباشر وواضح- في كون العربي الثوري لا يزال تجريدياً من ناحية؛ منصهراً في الفكر الثوري العالمي من ناحية ثانية؛ إنه، بتعبير آخر؛ مؤتلف وليس مختلفاً. وهذا الائتلاف يتحول إلى تبعية تقارب الأنساق، لأنه، حتى الآن، لا يتحرك في اتجاه التمايز أو الاختلاف غير أن هذا الاختلاف لا يتم إلا بشرطين: