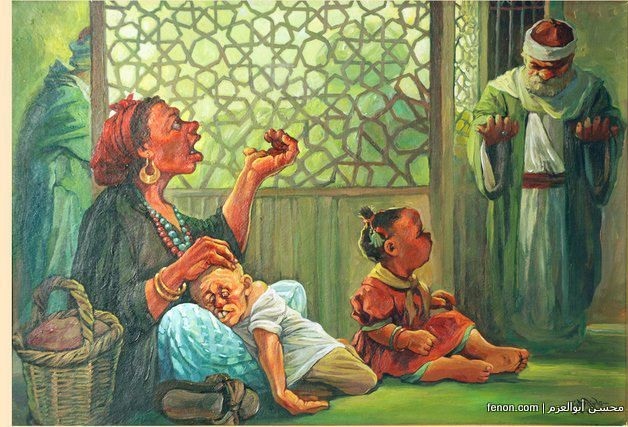صحيفة المثقف
الأغلبية والأقلية أو ثقافة الغالب والمغلوب
 إن المدرسة لا تتوقف عند تعلم القراءة والكتابة فقط، ولا تتوقف الجامعة عند اكتساب شهادة في التخصص، كما لا تتوقف دور الثقافة على تعلم فن الرقص والغناء أو فن المسرح والسينما، بل يتعدى دور هذه المنظومات الثلاث تنمية مشاعر احترام الآخر ومد جسور التواصل والتعايش معه، والإيمان بالتعدديات الفكرية والثقافية والإيديولوجية، والتعدديات العرقية والمذهبية من أجل تحقيق السلام وتعزيز مفهوم الانتماء إلى أمة واحدة لها مكوناتها وتاريخها
إن المدرسة لا تتوقف عند تعلم القراءة والكتابة فقط، ولا تتوقف الجامعة عند اكتساب شهادة في التخصص، كما لا تتوقف دور الثقافة على تعلم فن الرقص والغناء أو فن المسرح والسينما، بل يتعدى دور هذه المنظومات الثلاث تنمية مشاعر احترام الآخر ومد جسور التواصل والتعايش معه، والإيمان بالتعدديات الفكرية والثقافية والإيديولوجية، والتعدديات العرقية والمذهبية من أجل تحقيق السلام وتعزيز مفهوم الانتماء إلى أمة واحدة لها مكوناتها وتاريخها
باعتباره أن الدولة المدنية نموذجا سياسيا، فقد أخذ النقاش حوله اهتمام المفكرين الغربيين وحتى المفكرين المسلمين الذين جعلوه ضمن التراث الإسلامي، بحكم أن الرسول يعتبر المؤسسة الأول للدولة المدنية، فبعد وفاة الرسول طرحت مسألة الحكم ومن له القدرة على القيادة ومن يمسك بزمام الأمور في تدبير شؤون المجتمع البشري، غير أن هذا المفهوم كما يقول أهل الاختصاص طرح إشكالات عديدة في تحديد نظام الدولة، وكيف يتم اختيار الحاكم، وما هي الشروط التي يجب ان تتوفر فيه مثل العلم والعدالة، ويكون على دراية بقواعد القيادة والزعامة، ودون الحديث عما أحدثته واقعة سقيفة بني ساعدة في انقسام الصحابة وتشتتهم حول من يكون خليفة الرسول (ص)، أو كما سميت بـ: "النظرية الشيعية" والتي ما يزال الجدل حولها قائما إلى اليوم، فالمسألة الأكثر تعقيدا والتي خلقت الصراع بين أنظمة الحكم تتمثل في فصل الدين عن السياسة، والغرض منه إبعاد العامل الديني في الحكم، خاصة في دولة تتسم بالتنوع المذهبي والطائفي والعرقي، وتفتقر إلى خطاب إعلامي حر وحيادي، فتجد الأقلية نفسها محاصرة وتمارس ضدها سياط الغبن وحرمانها من كل حقوقها الاقتصادية والثقافية، ونزع عنها صفة الشريك في الوطن، وقد يلصق فيها تهما عديدة منها العمالة، وهو نوع من الإنكار لوجود الآخر، وإضعاف الروابط بين البشر.
فالتفتت والصراعات القبائلية والعشائرية أو المذهبية والطائفية والدينية، والتي أصبحت صراعات دموية، دفعت بالبعض إلى المطالبة بالحكم الذاتي، مثلما نشهده في الكثير من البلدان، السودان، العراق، لبنان، وحتى الجزائر، لم يرتض أبناء البلد الواحد العيش معا في انسجام، رغم أن النظام نظاما جمهوريا ديمقراطيا، بالمقارنة مع دول أخرى كالهند والصين اللتان تعتبران الأكثر عددا من حيث التعداد السكاني، وعملتا على بناء سلام مجتمعي و اقتصادي وكذلك الشأن بالنسبة لماليزيا، التي ضربت المثل في التعايش، بحكم ما تتميز به من تعددية دينية، بحيث حققت المساواة بين المسلمين والبوذيين والصينيين، لأن نظامها ديمقراطي حقيقي ليس شكلي، ولها قضاء عادل، مستقل ونزيه، فالتطرف والتعصب والعنف أمراض ظهرت أعراضها، ولما غاب العلاج انتشرت سمومها وعمّت الجسم كله، كما أن التحديات الاقتصادية التي تفرضها العولمة تدعو العرب والمسلمين إلى إعادة النظر في الكثير من القضايا، وبالأخص نظمها ودساتيرها، بل إعادة قراءة تاريخها واستعادة ثوابتها المفقودة، وهذا لا يتحقق إلى بتصحيح منظومتها التربوية والجامعية والثقافية والاقتصادية، ولعل الفقر والجهل والمرض أولى الأمور التي ينبغي مواجهتها.
إن المدرسة لا تتوقف عند تعلم القراءة والكتابة فقط، ولا تتوقف الجامعة عند اكتساب شهادة في التخصص، كما لا تتوقف دور الثقافة على تعلم فن الرقص والغناء أو فن المسرح والسينما، بل يتعدى دور هذه المنظومات تنمية مشاعر احترام الآخر ومد جسور التواصل والتعايش معه في أمن وسلام، والإيمان بالتعدديات الفكرية والثقافية والإديولوجية، والتعدديات العرقية والمذهبية، والحوار وحده الذي يجمع كل هذه الأطياف، فهو يعدّ أي الحوار قيمة أخلاقية، لا تتحيز لفكر أو مذهب محدد دون الآخر، فالإشتراكي متعصب والليبرالي متعصب، ورجل الدين ورجل السياسة متعصبان، والمتعصبون عادة ما يثبتون على فكرى حتى لو كانت خاطئة، وهنا تتحول المواقف من دفاعية إلى عدائية، تنتهي بحرب أهلية، ولنا تجارب عديدة في الحروب الأهلية التي عاشتها الشعوب في السنوات الأخيرة كما سميت بثورات الربيع العربي، وكانت أولها الجزائر التي عاشت حربا أهلية على مرحليتين، الأولى في منتصف الثمانينيات، ثم مرحلة التسعينيات، ثم ما شهدته تونس، مصر، وليبيا..الخ) أصبحت حدودها مهددة أمنيا، وزاد خطرها مع توسع داعش، لكنها في الوقت نفسه ما تزال تعمل بمقولة: "أنت تخالفني في أمر ما إذن أنت غير موجود"، وهكذا حصل التهميش والإقصاء فتوقف الحراك الفكري للإنسان العربي الذي جعل من نقد الذات خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، بينما نقد الآخر واتهامه ووصفه بالجهل أو الفشل مباح ولا أحد له الحق في محاسبته أو تأنيبه.
علجية عيش