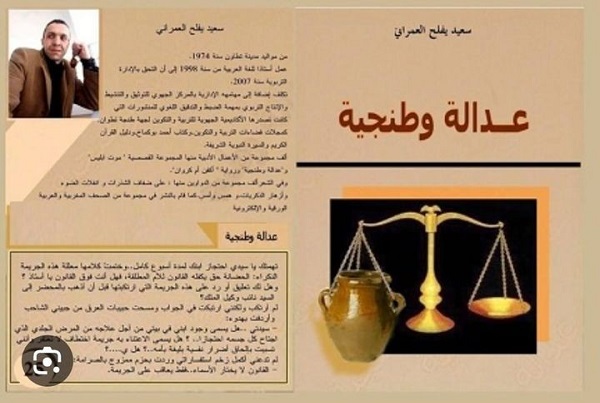صحيفة المثقف
ثناءٌ على الجيلِ الجديدِ (3)
 الذهن كنظام أو "سيستم" يتألف من ثلاثة عناصر: مُدخَلات، ومُخرَجات، ومُعالِج، لأن كلَّ نظام هو مُدخَلات ومُخرَجات ومُعالِج، وبما أن مُدخَلات ذهن الآباء كان أغلبُها محليًا مغلقًا بسيطًا كان يتكيّف عملُ المُعالِج معها فكانت المُخرَجاتُ من جنس المُدخَلات، لكن مُدخَلات ذهن الأبناء تبدلّت فصار أغلبُها كونيًا، مركبًا أكثر ومنفتحًا أكثر ومتعددًا أكثر ومتنوعًا أكثر، فيُفترض أن تصير المُخرَجاتُ اليوم من جنس المُدخَلات، إذ يتكيف عمل المُعالِج على وفق كيفيتها. وحتى لو كان المُعالِج بالأمس هو الذي يتحكم بالدرجة الأساس في تحديد نوع المُخرَجات، رغم تنوع وتعدد المُدخَلاتُ على مدى حياة الانسان، لكن المُعالِجَ بدأ اليوم يتبدل تبعًا للتبدل الهائل في نوع المُدخَلات وكيفيتها، وليس في كميتها فقط.
الذهن كنظام أو "سيستم" يتألف من ثلاثة عناصر: مُدخَلات، ومُخرَجات، ومُعالِج، لأن كلَّ نظام هو مُدخَلات ومُخرَجات ومُعالِج، وبما أن مُدخَلات ذهن الآباء كان أغلبُها محليًا مغلقًا بسيطًا كان يتكيّف عملُ المُعالِج معها فكانت المُخرَجاتُ من جنس المُدخَلات، لكن مُدخَلات ذهن الأبناء تبدلّت فصار أغلبُها كونيًا، مركبًا أكثر ومنفتحًا أكثر ومتعددًا أكثر ومتنوعًا أكثر، فيُفترض أن تصير المُخرَجاتُ اليوم من جنس المُدخَلات، إذ يتكيف عمل المُعالِج على وفق كيفيتها. وحتى لو كان المُعالِج بالأمس هو الذي يتحكم بالدرجة الأساس في تحديد نوع المُخرَجات، رغم تنوع وتعدد المُدخَلاتُ على مدى حياة الانسان، لكن المُعالِجَ بدأ اليوم يتبدل تبعًا للتبدل الهائل في نوع المُدخَلات وكيفيتها، وليس في كميتها فقط.
إن منطقَ الذهن أو كيفيةَ معالجة المُعالِج للمعطيات تحاكي نوعَ المُدخَلات، وتستجيب طريقةُ تمثّلها في الذهن تبعًا لها، أي ان نوعَ المُدخَلات يؤثر في بنيةِ الذهن وطرائقِ مُعالجته وكيفيةِ تمثله لها. ويتحدث علمُ الأعصاب الجديد عن أن العصفَ المتدفّقَ لوسائل التواصل الاجتماعي للدماغ سينتج تبدلاتٍ في تركيبة الدماغ، ومن ثم سيؤثر ذلك على كيفية عمل الذهن وطرائق التعلم.
ويقول الخبراءُ إن إيقاعَ التحولات أسرعُ من استجابة النظام التعليمي لاحتياجات الأبناء، ذلك أن وتيرةَ التبدّل في كيفية عمل الذهن أسرعُ من القدرة على مواكبتِه والانتقالِ بما يستجيب له ويتناغم معه في أنظمة التربية والتعليم، من هنا ستتسع الفجوةُ بالتدريج بين هذه الأنظمة وطبيعةِ احتياجات الجيل الجديد، التي قد يعجز عن تلبيتها حتى النظامُ التعليمي في الغرب.
لكلِّ جيلٍ أمراضُهُ الخاصةُ، استبدّت بالجيلِ الجديدِ أمراضٌ تحكي قوةَ الواقعِ الذي يعيشُهُ، وتعكسُ تعقيداتِه المختلفةِ، والأصداءِ الحادّة لإيقاعِ تحوّلاتِه المفاجِئة. بعضُ هذه الأمراض أشدُّ فتكًا وأعنفُ وأخطرُ من أمراضِ الجيل السابق، كما تُعلن عنها جروحُ الروح، وتوتراتُ المزاج، واضطراباتُ المشاعر، وتقلباتُ التفكير، وتذبذباتُ المواقف.
إن الذهنَ في بلادنا مازال يرتهنه نظامٌ تعليمي قديم، وثقافةٌ تقليدية مهيمِنة، ونمط تدين مغلق، وظروفٌ اقتصادية وسياسية واجتماعية مضطربة يتردد صوتُ العنف فيها، ونتيجة لكل ذلك صار ذهنُ الأبناء مشوشًا. وطبيعي أن يفضي ذلك لأمراض ومشاكل مختلفة معقّدة لم يعرفها من قبل جيلُ الآباء.
نحن بحاجة للكثيرِ من شجاعة التواضع في تخطّي حكاياتِنا المكرّرة وتجاوز مواقفِنا المتصلبة، كي نرى التحولاتِ العميقةَ التي تجتاح العالَم من حولنا، والاعترافِ بتقصيرنا في حقّ الأبناء، وإخفاقِنا في منحهم حقَّ الاختلافِ في التفكير والتعبير، والحرية في التعاطي مع عالمهم، من حيث هم لا من حيث نحن. لنعربَ عن ندمنا ونعلنَ أخطاءنا ونعترفَ بجهلنا في الكثير مما يدور بنا وندور معه رغمًا عنا، في هذا العالم الذي يفرض علينا أقدارَه وأنماطَ العيش فيه.
لقد كانت وما زالت تربيتُنا في البيت والمدرسة والمجتمع والجامع والجماعة لا تربّينا على شجاعةِ الاعترافِ بالخطأ. الاعترافُ بالخطأ ضرورةٌ يفرضها الانتماءُ للعالَم اليوم ودعمُ الابناء في حضورهم الديناميكي الفاعل في عالمهم.
مع ان الآباءَ هم نموذج الأبناء، لكن أنا شخصياً لم أسمع من أبي "رحمه الله" إلى وفاته اعترافاً بخطأ في حياته أو ندماً على ممارسةٍ عنيفة معي أو مع والدتي أو اخوتي، أما أنا فكنتُ أخاف من الاعتذار عن العنف الجسدي والرمزي واللفظي الذي أتورط به مع أبنائي في طفولتهم، وواصلت الهروب من الاعتراف بأخطائي إلى العقد الرابع من حياتي، بل كنت أشعر بحرجٍ وألمٍ شديدين لو لمحتُ أو سمعتُ إشارةً أو عبارةً ترشدني إلى أخطائي، فضلًا عن أني كنتُ عاجزًا وقتئذ عن البوحِ بها، ولم أتعلّم ذلك إلّا بالتدريج وبمشقّة بالغة ومعاناة موجعة، عندما بدأت أتحرر من سجوني قبل ثلاثة عقود.
وهكذا لم أسمع من معلّمي في الابتدائية، الذي كان يعنّف زملائي التلامذةَ بأسلوبٍ مستهجن، اعترافاً بخطأ أو ندمًا على عنفِه الجسدي القاسي المتكرّر بحقّ تلامذته، كما لم أسمع أيَّ شيء من ذلك من أحدٍ من أساتذتي في مراحلِ تعليمي المختلفة، إذ كانوا دائمًا يتكتمون على ما يقترفونه، بل وجدتُ أكثرَ آبائي وأساتذتي يتحدّث أو يوحي بصواب كلِّ فعل أو قول صدر عنه، وهكذا هي مواقفُ حكّام بلدي أو قادةُ جماعتي، وكأن الكلَّ كامل. مازلنا ننظر للخطأ بوصفه عاهةً وعارًا وفضيحة، لأن حقَّ الخطأ، الذي هو ضرورةٌ لكلّ عملية تربوية ناجحة تفرضها طبيعةُ الكائن البشري، ليس مكفولًا لأحد في مجتمعنا.
ومع كلِّ ثنائي على ما يعد به الجيلُ الجديدُ وعصرُه، لكني أودُّ أن أشيرَ إلى أن ظاهرةَ التوثينِ لا تختصُ بجيلِ الآباء، وانما هي ظاهرةٌ بشريةٌ تتلفعُ بأقنعةٍ تختلفُ باختلافِ الأجيال، وكلما تطورَ الوعيُ البشري تُمعن في الاختباءِ خلفَ أقنعةٍ يصعبُ جدًا فضحُها. ولا شك أن التوثينَ بكل أشكاله، سواء كان في عالَم الآباء أو ما يكون في عالَم الأبناء، يعمل على تعطيلِ العقل وشللِ الوعي وتهشيمِ الارادة، حتى يستلبَ التوثينُ كينونةَ الكائنِ البشري.
وعلى الرغمِ من تشديدي على أن للأبناءِ أسئلتَهم، غير اني لست في مقامِ نفي الأسئلةِ البشريةِ الأبدية، المسكونِ بها الإنسانُ بوصفه إنسانًا، مثل الأسئلةِ الميتافيزيقية وغيرِها من الأسئلة الكبرى التي تتوالدُ منها على الدوامِ أسئلةٌ جديدة، أسئلةٌ لا ترتوي من الإجابات أبدًا، ولا تكفُّ عن طلبِ المزيد مع كلِّ منعطف وتحوّل حاسمٍ في حياة الإنسان.
كذلك لا أنشد افتعالَ صراعٍ بين الأجيال، بل أحاول الكشفَ عن نسيجِ تضاريسِ الواقع المتشعّبة والمتضادّة الذي تعيشه مجتمعاتُنا اليوم. إنه دعوةٌ لتفهّمِ الآباءِ لعالَم الأبناء، وتفهّمِ الأبناءِ لعالَم الآباء، ولا يتحقّقُ ذلك إلّا بمواقفَ شجاعةٍ للآباء والأبناء معًا، يبادر فيها الكلُّ للحوارِ والتفاهمِ والتصالحِ، والعملِ الجادّ على خلقِ شراكةٍ واقعية تُستثمر فيها كلُّ الطاقات من أجل بناءِ عالم أجمل، والسعي لخفضِ وتيرةِ عدم الاعتراف والتنابذ والاحتراب والقطيعة بين جيل الآباء والأبناء.
وعلى الرغم من الأفقِ المتفائل الذي أتطلع فيه لمصائر الأبناء، لكن لا يمكن التنبؤ بما يفاجؤنا به الغدُ من خساراتٍ وانتكاساتٍ تحدثها منعطفاتٌ للتاريخ غيرُ محتسبة، لأن التاريخَ البشري لا يسير في خطّ تصاعدي أبدي، ولا يتقدّم إلى الأمام باستمرار، فقد يتوقف لحظةَ تقدّمه، أو قد ينكص فينتكس لحظةَ صعوده، إذ انهارت حضاراتٌ كبيرةٌ ما كان متوقعًا انهيارُها، وغربت شمسُ امبراطوريات ما كان متوقعًا أفولُها، وانهزمت دولٌ بعد أعظم انتصارتها، وتمزّقت أممٌ عاشت قرونًا مسكونةً بتفوقها، ولبثت مدةً طويلة تَعدُ البشريةَ بمهمتها الرسولية الإنقاذية.
وإن كان التاريخُ أكبرَ معلّمٍ للإنسان، إذ لا مُعلّم َكالتاريخ، لكن قلّما يتعلّمُ الانسانُ من التاريخ، مضافاً إلى أن الإنسانَ ليس بوسعه أن يتحكّمَ بمصائره كليًا ليرسم لها خرائطَ الغد، الذي تتغلّبُ فيه المفاجئاتُ المباغتةُ أحيانًا على مسارِ التطور والتقدم في التاريخ.
عبد الجبار الرفاعي