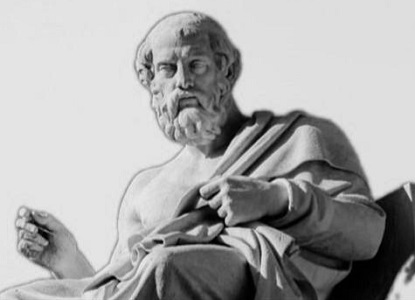صحيفة المثقف
الحاج ابو عباس
 بعد صلاة المغرب، احس الحاج ابو عباس بالتعب والإعياء الشديدين، لذلك لم يتسن له ختمة القران التي ابتدأها مُذ فقدان زوجته، التي وافاها الأجل اثر نوبة قلبية مفاجئة قبل أشهر عدة.
بعد صلاة المغرب، احس الحاج ابو عباس بالتعب والإعياء الشديدين، لذلك لم يتسن له ختمة القران التي ابتدأها مُذ فقدان زوجته، التي وافاها الأجل اثر نوبة قلبية مفاجئة قبل أشهر عدة.
بقيت سجادة الصلاة التي اعتاد ان يطويها ويضعها على الصندوق الخشبي القريب من جهة نافذة الغرفة المطلة على الشارع العام في مكانها على الارض، كأنها تنتظر نافلة اخرى من نوافل الصلاة المستحبة، أو تستنجد حضوره طلبا لإستكمال التسبيحات ربما، أوبعض الادعية والمناجاة.
حينما حاول الانصراف لتحضير طعام العشاء الذي هو عبارة عن قدر صغير من العدس، اضافة الى إبريق الشاي الذي اعتاد ان يكون بجانبه قبل الطعام، مع قطعة رغيف من الخبز الأسمر.
بات الليل بأثقال ألوانه التي اخترق سوادها لون الشمس الغارب، وشيكا يستقبل ساعاته الأولى، كأنه يفتح عباءته الى ذلك الظلام، كان الجو باردا، وكانت السماء ملبدة بقطع من الغيوم في الخارج، بينما ثمة صفير ريح خفيف ابتدأ يداعب أغصان نخلةٍ حطت بسعفها المنهك عند جدار زاوية قريبة الى بيته الصغير.
أما الأصوات الاخرى التي اعتاد على سماعها خارج المنزل كل يوم، فقد كانت هادئة ذلك المساء، لولا أزيز بعض محركات الدراجات النارية التي زعيقها ينتشر بصخب حاد، مضافا اليه نباح كلب الجيران.
الساعة التي أمامه كانت تتحرك عقاربها ببطء، كما نبض أتعبهُ الوجع، ليبحث عن مخبأ يقيه ذلك الوهن الذي المَّ به منذ حين، ليجعله أسيرا لفراشهِ الذي لم تفارقه القشعريرة.
قبل شهر مضى كان بوضع يؤهله لأن يمشي على قدميْه، يذهب الى مقهى زائر صالح، يلتقي ببعض الأصدقاء، يحتسي الشاي معهم، يتحدثون مع بعضهم عن ذكريات الماضي.
الزمن القديم ما فتئ مثل جدارية شاهقة، ترتسم في عمقها تلك المشاهد والاحداث، الكلام فقط ينأى بعيدا، يغيب في مثل هكذا ذكريات، بإعتباره تجتمع فيه تفاصيل يصعب التقاطها في لحظة واحدة، رغم انها تبقى شاخصة بصماتها تلك المواقف.
السيناريوهات، بجميع شخصياتها عبارة عن صور، لمسافات حركيّة يقطعها الزمان؛ الاعمال الطيبة نعم تبقى، هتف مع نفسه، كأنه اكتشف سرا عميقا، ثم راح محاولا ان يستدرج ذاكرته، الكلمات يصعب تداولها، أما البطولات والشعارات الملازمة لها فتبقى عالقة مثل نجوم لم تختف، لذلك الأبطال، أمجادهم خالدة على مر التاريخ، فهم يصنعون الحياة حتى بعد موتهم، شعاراتهم تنبض في الوجدان.
ومثلها تلك القصص التي أحداثها تستقر في المشاعر، تتوالى هكذا مثل بندول الساعة، هذا الذي يتحرك من اليمين الى اليسار.
الثلاثينيات منتصفها، كما الأربعينيات، الحاج سالم، ابنه الذي تم قتله يوم اعترض على ابن السركال الذي كان يتعامل مع الفلاحين بقسوة ويضربهم بالسوط، بنت حجّي ماهود التي قتلت كونها لم ترضخ لنهوة ابن عمها المصاب بهستيريا الغرور حينما اعترض طريق الرجل الذي تقدم للزواج منها، الفلاح الذي أراد ان يسرق بيت الاقطاعي متحديا، الخمسينيات، نهاياتها التي ما زالت في معانيها ترتبط مع ثورة الزعيم، الستينيات، أستاذ وليد الشيوعي الذي دفن حيّا ابان زمن الحرس القومي، السبعينيات نهايتها، التي انتهت بنزيف الدم والسجون، والمعتقلات، الثمانينيّات التي ارتبطت بموضوعة الحرب مع ايران، التسعينيات وزوجته التي ماتت اثر سماعها بنبأ مقتل ولدها الوحيد.
القيود التي بات يشعر انه مكبلا بها، تركض الان به، تجتاح جميع تفاصيل جسده، تصرخ في أقصى أعماقه، لتحلق به بعيدا عن اثقال جسده المتعب، وجد نفسه امام منظومة من الألغاز التي تفرض عليه ان يلملم تلك السجلّات، يطويها بعد ان ايقن ان لا قدرة له لأن يرويها الى الاخرين.
الهاجس هو نفسه، تلك اللقطات والاثار التي تركت بصماتها في مشاعره، بما في ذلك صديقه الذي عرض عليه ان يتبرع بكليته اليمنى لنجدة حياته ابان فترة تقدم الطب السبعيني.
بقي ابو عباس هكذا وحيدا تصطف في بصيرته تلك الموضوعات، يقلبها الواحدة تلو الاخرى، املا ان يغمض عينيه مغادراً هذا العالم الذي ألوانه أضحت يتهاوى بريقها، مثل أقراص شمس، احاط بنهاياتها الغروب، ليرتدي اثواب صمتها.
اما قلبه فقد راح يخفق مع بعض الكلمات التي سمعها ذات يوم من ابنه ابان حرب ايران، حين قال له مودعا لم أُنسك ايها الاب الحنون.
بقي هكذا، تنغرس في قلبه كالسكاكين أنباء من فارقهم، لعله يعيد نموه ذلك البستان الذي شاهده في منامه قبل ايام، على شاكلة شجرة كبيرة تتفرع أغصانها فقط عند المساء، لتدنو نحوها تلك الأسراب من العصافير.
عقيل العبود