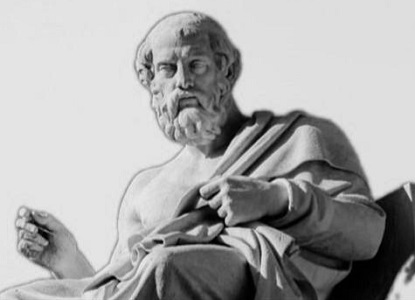صحيفة المثقف
السلمُ وليس الحربُ هو الهدفُ المحوري للقرآن الكريم
 الحربُ تفريغٌ عنيفٌ لغريزة العدوان لدى الإنسان، ومتى ما عجز الإنسانُ عن التفريغ السلمي لغريزة العدوان تفجّرت الحربُ في حياته. ويذهبُ علمُ النفس الحديث إلى أن الإنسانَ تتنازعه غريزتان متضادتان: الأولى هي غريزة البقاء، لذلك نراه يعملُ كلَّ شيء من أجل الاحتفاظ بحياته واستمرار البقاء في هذا العالم. والثانية هي غريزة العدوان، وعنها تتوالد الكراهيةُ والحربُ وما تفضي إليه من موت للإنسان وتدمير وتخريب للعمران. ومالم يتخلص الإنسانُ من الحرب، ويكون قادرًا على التحكّمِ بها لا يمكنه امتلاكُ وسائل العمران، والتحكّمُ بتوظيف طاقاته التي تستنزفها الحربُ في بناء الحضارة.
الحربُ تفريغٌ عنيفٌ لغريزة العدوان لدى الإنسان، ومتى ما عجز الإنسانُ عن التفريغ السلمي لغريزة العدوان تفجّرت الحربُ في حياته. ويذهبُ علمُ النفس الحديث إلى أن الإنسانَ تتنازعه غريزتان متضادتان: الأولى هي غريزة البقاء، لذلك نراه يعملُ كلَّ شيء من أجل الاحتفاظ بحياته واستمرار البقاء في هذا العالم. والثانية هي غريزة العدوان، وعنها تتوالد الكراهيةُ والحربُ وما تفضي إليه من موت للإنسان وتدمير وتخريب للعمران. ومالم يتخلص الإنسانُ من الحرب، ويكون قادرًا على التحكّمِ بها لا يمكنه امتلاكُ وسائل العمران، والتحكّمُ بتوظيف طاقاته التي تستنزفها الحربُ في بناء الحضارة.
ويتطلبُ القضاءُ على الحرب وترسيخُ السلامِ حربًا مضادّة، إن كان معاشُ المجتمع يقومُ على الغزو، وتتحكم الحربُ في رسم علاقاته، وتعمل على تشكيل نمط اقتصاده، كما هو مجتمع الجزيرة العربية في عصر البعثة. وبالرغم من أن السلمَ وليس الحربُ هو الهدفُ المحوري للقرآن، إلّا أن طبيعةَ الحياة في مجتمع البعثة فرضت أن يتحدّث القرآنُ بلغة لا تخلو في بعض المواضع من العنف.
وقد فوجئتُ بفعلٍ غريبٍ قبل سنوات قام به أحدُ الكتّاب، إذ عمل على حذف كلِّ آيةٍ تشي دلالتُها بما يشيرُ للعنفِ في القرآن الكريم، ووزّع نسخًة محدودة التداول على بعض القراء. ورأيتُ جماعةً من الكتّاب والخطباء يلتمسون السبلَ المختلفةَ لنفي العنف في لغة القرآن، والتشديدِ على أن لغتَه لا تتضمن سوى السلام والتراحم، وليس فيها أيُّ حضور للعنف. وقد ألجأهم لذلك الموقف الاعتذاري تفجّرُ العنف الفاشي للجماعات التكفيرية، وتسويغُها جرائمَها بآيات وأحاديث وفتاوى تحيل إلى كتب التفسير والحديث والفقه.
إن كلَّ من يقرأ القرآنَ الكريم يجدُ العنفَ ماثلًا بتعبيراتٍ مختلفة في بعضِ آياته، فمثلًا وردت كلمةُ "قتال" والكلماتُ ذات الصلة بها في القرآن بحدود 170 مرة[1]. ويعود نفيُ وجود أيّ شكل للعنف في لغة القرآن إلى تجاهلِ سياقات النزول في محيط الجزيرة العربية، الذي يتشكّل من عناصرَ دينيةٍ وثقافيةٍ واجتماعيةٍ وجغرافيةٍ تختصّ به. وكلّ من يعرف محيطَ الجزيرة الذي احتضن نزولَ القرآن لا يمكنه إنكارُ بصمة بيئة عصر البعثة فيه. ويمكن القول: إن القرآنَ مرآةٌ تعكس الملامحَ الواضحة للحياة العربية في الجزيرة عصر البعثة. ومن هذه الملامح أنها حياةٌ معروفةٌ بخشونتها القاسية وتعبيراتها العنيفة، وهو ما تجلّى في شيءٍ من أساليب اللغة العربية وانطبع في شيءٍ من ألفاظها. ولا يمكن أن يخاطب القرآنُ أو أيُّ كتاب مقدّس مجتمعًا من دون أن يمتلك لغتَه، أو يتحدّث معه بما هو خارج مقدرة عقله على الإدراك والفهم. روي عن النبي "ص" أنه قال: "أُمرنا معاشر الأنبياء أن نكلّم الناس على قدر عقولهم"[2].
اللغةُ ليست وعاءً أجوف، بل هي مكوّنٌ لهوية الكائن البشري العقلية والروحية والعاطفية، وعندما ينشد صاحبُ رسالة أن يوقظ روحَ مجتمعٍ وعقلَه وضميرَه، فإنه لا يلتقط كلماتٍ محدّدةً من لغته، فيما يستبعد معجمَ اللغة الواسعَ كلَّه، إذ لا يمكن إبلاغُ الرسالة من دون استثمار الرأسمال اللفظي المتداوَل في اللغة.
العنفُ ظاهرةٌ ليست غريبةً على البشر، وقد كان العنفُ في العالم القديم أشدَّ حضورًا، وكلّما تطوّر الوعي تحضّرتْ حياةُ الإنسان واتسعتْ مساهمةُ الوسائل السلمية في حلّ نزاعاته، وإن كان العنفُ يتخذ أشكالًا أشدَّ خفاءً وخبثًا مع تطوّر الوعي البشري. وكان العنفُ أحدَ الأمراض المتوطنة في الجزيرة العربية، فأرسل اللهُ لهم رسولًا معه كتابٌ يداوي أمراضَ الروح والقلب والعقل. وفي كلِّ حالات الإدمان المرضي الخطيرة لا يكون الدواءُ إلّا من جنس الداء، فمدمنو المخدراتِ وغيرِها يبدأ علاجُهم بجرعات مخفّفة منها بالتدريج، وربما تتواصل سنوات حتى يشفى المدمن. ولا يمكن أن يخاطب النبيُّ الكريم "ص" الناسَ بلغة خاصة هو يبتكرها، أو ينتقي كلماتٍ من لغتهم ويترك ما هو متداولٌ من ألفاظها وعباراتها، لأن مثلَ هذه اللغة المُخترَعة أو المنتقاة تعجز عن التواصل معهم، وقد لا يعثر على متلقٍ يصغي له، لذلك فرضَ معجمُ اللغة وسياقاتُ مجتمع الجزيرة في عصر البعثة على النبيّ هذا النمطَ من الخطاب، إذ لا يمكنه أن يتحدّثَ مع القوم خارج وعيهم ولاوعيهم اللغوي. وعلى الرغم من أن لغةَ القرآن اهتمت بكلِّ ما يحطم أغلالَ العقل، ويحيي الروحَ، ويوقظ الضميرَ الأخلاقي، لكن المجالَ التداولي للعربية ونمطَ ثقافة المجتمع فرضا على لغة القرآن ألا تخرج كلّيًا عن أساليب الخطاب المعروفة فيه. والعنفُ الذي ظهر في الغزوات وعصر البعثة ينتمي إلى طبيعةِ المجتمع العربي وقتئذٍ، وعجزِ الوسائل السلمية للدعوة في مثل هذا المجتمع عن إنجاز وعودها، لذلك اضطر النبي محمد "ص" للهجرة وبناء قاعدة الإسلام في المدينة.
مفتاحُ دراسة العنف في لغة القرآن هو معرفةُ نمط حياة الأمة التي نزل فيها، وبنيةُ لغتها، وأساليبُ تعبيرها. إن ألفاظَ اللغة ومصطلحاتِ معجمها وأساليبَ بيانها، والحضورَ المتنوّع للعنف في الحياة العربية، وأثرَه الواضح في رسم أنماط العلاقات المجتمعية في عصر البعثة، كلها كانت قيودًا ضاقتْ بسعة الرحمة الإلهية، وعجزتْ عن أن تستوعب تجلّياتِ غريزة الرحمة في شخصية ودعوة المبعوث رحمةً للعالمين.
النبيُّ محمد "ص" أحدُ أعظم دعاة الحرية ومن أرسَوا أسسَها في التاريخ البشري، عاش في مجتمع يؤسّس العنفُ حياتَه، ويحوك العنفُ نسيجَ علاقاته الاجتماعية، وتنبثق من العنف تقاليدُه وعاداتُه، والعنفُ مادةُ أحكام الجزاءِ والعقوباتِ لجرائمه وجُنَحِه وجناياتِه، ويرفد العنفُ معيشتَه، ويؤثّر في نمط اقتصاده، بل يغذّي العنفُ لغتَه وتتوالد هذه اللغةُ في فضاءاته، إنها لغةٌ ينتجها ويحتضنها ويكرّسها العنف. في مثل هذا المجتمع لا يمكن لثائرٍ على كلِّ أشكالِ الاستعبادِ وهتكِ الكرامة البشرية إلّا أن يستعيرَ شيئًا من عنف لغة المجتمع الذي يخاطبه بدعوته، ويتسلّحَ بمواقف صارمة؛ لا تخور أمام عنف لغتهم، ولا تنهزم أمام عدوانيتهم، ولا تتراجع أمام توحّش بعضهم. لغةُ العنف في آيات القرآن تعكس أنطولوجيا لغويةً عنيفةً كانت ماثلةً في الحياة العربية. وأيّةُ محاولة تُخفي ذلك فإنها تسيء للقرآن عندما تنكر ما هو واضحٌ صريح فيه.
ويظلّ السِّلْمُ وليس الحرب هو الهدفُ المركزي الذي يرمي إليه القرآن. القاعدةُ التي أسّسها القرآنُ هي السِّلْم كما تتحدّث عنه كثيرٌ من الآيات، ومنها هذه الآية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً"[3]. إذ ورد "السِّلْمُ" والكلمات ذات الصلة به في القرآن بحدود 140 مرة[4]. وجاءت كلمةُ الحرب ومشتقاتُها في القرآن 6 مرات. وشرّع القرآنُ الحربَ في ذلك العصر لتثبيتِ أقدامه، ولرفعِ الاضطهاد وردعِ العدوان، ولكي يؤسّس للسِّلْمِ الدائم. وإلّا فكيف بكتابٍ يقوم منطقُه الداخلي على الرحمة ولا ينشد إلّا التراحمَ أن يضادَّ منطقَه وينقضَ رسالتَه؟!
وفي ضوء الفهم الذي قررناه فيما سبق من أن الرحمةَ الإلهية هي مفتاحُ فهمِ المنطق الداخلي للقرآن، تكون الرحمةُ في القرآن أصلًا كليًا يتسعُ لكلِّ الأزمنة ويستوعبُ كلَّ الحالات، ويكونُ كلُّ ما يعارضها مختصًا بزمان وحالة معينة[5].
قراءةُ آيات القرآن بحسٍ تاريخي تقودنا إلى فهمِ العنف في لغته بوصفها ضرورةً ظرفيةً فرضتها طبائعُ المجتمع الذي نزل فيه، والمعجمُ اللغوي الذي كان يتحدّثه ذلك المجتمع. أما ما هو أبدي في القرآن وما تهدف إليه رسالتُه، فهو: بناءُ مرتكزات راسخة للسِّلْمِ العالمي الدائم، وحمايةُ الكرامة البشرية، وإرساءُ أسس إنسانية كونية ترفد كلَّ مشترك قيمي بين البشر، وتنميةُ القيم الروحية والأخلاقية والجمالية، وإثراءُ كلّ ما يلهم المحبةَ والشفقةَ والتراحمَ في حياة الفرد والجماعة.
ويظل الدينُ بمعناه الروحي والأخلاقي والجمالي مشروعًا ينشدُ تكريسَ إنسانية الإنسان، ولا يمكن له تحقيقُ ذلك من دون الإعلاء من الكرامة البشرية وحمايتها من أيّ شكل للانتهاك. الدينُ يرى الكرامةَ بوصفها تمثّل أحدَ مكونات الهوية الوجودية للكائن البشري، أي إن الكرامةَ قيمةٌ أنطولوجية عميقة، لا إنسانيةَ للإنسان من دونها.
وعلى الرغم من حضورِ لغة عصر القرآن والثقافةِ المحلية للمجتمع الذي نزل فيه في بعض آياته، غير أن ذلك لم يحجب رسالةَ القرآن الكلية عن البشرية، ولم يعطّل ما هو أبديّ في هذا الكتاب من المفاهيمِ المحورية العقائدية والروحية والأخلاقية، الناطقةِ باسم الإنسان في كلّ زمان ومكان، فقد كانت هذه المفاهيمُ ومازالت وستبقى ملهمةً لحياة المسلم على الدوام، وإن كان تمثّلُها في حياة الإنسان متنوعًا مختلفًا، على وفق طبيعة المجتمعات وثقافاتها وتمدّنها ودرجة تطورها الحضاري، وكذلك يتنوّع تمثّلُها بتنوّع الأفرادِ وطبيعةِ نشأتهم وتربيتهم وأحوالهم وثقافاتهم.
وكلُّ من يعرف نشأةَ الأديان، سواء كانت وحيانيةً أو غيرها، يعرف الأثرَ السحري الذي تحدثه كتبُها المقدّسة في أرواح وقلوب وعقول المؤمنين بها، لكن ليس كلُّ كتب الأديان تمكّنت من إنتاج حضارات رائدة. الحضورُ الشديد الأثر للقرآن في العالم يكشف عن فرادةِ صوت الله فيه، وقدرتِه الاستثنائية على أسر القلوب والأرواح. لقد كان وسيظل الفعلُ الحضاري للقرآن عظيمًا، وتعكس مكاسبُ الحضارة الإسلامية للبشرية الصورةَ الناطقة للقرآن في التاريخ، فلا نجدُ كتابًا مقدسًا أشدَّ حضورًا وتأثيرًا من هذا الكتاب في الأرض منذ عرفه الإنسان.
د. عبدالجبار الرفاعي
...........................
[1] ورد "القتال والكلمات ذات الصلة به في القرآن بهذه الصيغ: اقْتَتَلَ، اقْتَتَلُوا، اقْتُلُوا، اقْتُلُوهُ، الْقَتْلَى، الْقَتْلُ، الْقِتَالَ، أَتَقْتُلُونَ، أَقَتَلْتَ، أَقْتُلْ، تَقْتُلَنِي، تَقْتُلُوا، تَقْتُلُونَ، تَقْتُلُوهُ، تَقْتُلُوهُمْ، تَقْتِيلًا، تُقَاتِلُ، تُقَاتِلُوا، تُقَاتِلُونَ، تُقَاتِلُونَهُمْ، تُقَاتِلُوهُمْ، سَنُقَتِّلُ، فَاقْتُلُوا، فَاقْتُلُوهُمْ، فَقَاتِلَا، فَقَاتِلُوا، فَقَاتِلْ، فَقَتَلَهُ، فَقُتِلَ، فَلَقَاتَلُوكُمْ، فَلْيُقَاتِلْ، فَيَقْتُلُونَ، فَيُقْتَلْ، قَاتَلَ، قَاتَلَكُمُ، قَاتَلَهُمُ، قَاتَلُوا، قَاتَلُوكُمْ، قَاتِلُوهُمْ، قَتَلَ، قَتَلَهُ، قَتَلَهُمْ، قَتَلُوا، قَتَلُوهُ، قَتَلْتَ، قَتَلْتُمُوهُمْ، قَتَلْتُمْ، قَتَلْنَا، قُوتِلُوا، قُوتِلْتُمْ".
[2] الحديث مرويّ في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرِهما، لكنه ورد بصيغ مختلفة الألفاظ.
[3] البقرة، 208.
[4] ورد "السِّلْمُ" والكلمات ذات الصلة به في القرآن بهذه الصيغ: أَأَسْلَمْتُمْ، الْإِسْلَامَ، الْمُسْلِمُونَ، الْمُسْلِمِينَ، السَّلَامَ، السَّلَمَ، إِسْلَامَكُم، إِسْلَامِهِمْ، أَسْلَمَ، أَسْلَمَا، أَسْلَمُوا، أَسْلَمْتُ، أَسْلَمْنَا، بِسَلَامٍ، تَسْلِيمًا، تُسْلِمُونَ، سَالِمُونَ، سَلَامًا، سَلَامٌ، سَلَمًا، سَلِيمٍ، سَلَّمَ، سَلَّمْتُم، فَسَلَامٌ، فَسَلِّمُوا، لِلْإِسْلَامِ، لِلْمُسْلِمِينَ، لِلسَّلْمِ، لِنُسْلِمَ، مُسَلَّمَةٌ، مُسْتَسْلِمُونَ، مُسْلِمًا، مُسْلِمَاتٍ، مُسْلِمَيْنِ، مُسْلِمُونَ، وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالسَّلَامُ، وَأَسْلَمْتُ، وَأَسْلِمُوا، وَتَسْلِيمًا، وَتُسَلِّمُوا، وَسَلَامًا، وَسَلَامٌ، وَسَلِّمُوا، وَيُسَلِّمُوا، يُسْلِمُونَ، يُسْلِمْ.
من أجل وضع الأفكار الواردة في هذا المقال في السياق الذي تنتظم في اطاره، نحيل إلى مراجعة سلسلة مقالاتنا المنشورة سابقًا، والتي شرحنا فيها ما خلصنا إليه من رؤية تبتني على أن "الرحمةَ مفتاحُ فهمِ المنطق الداخلي للقرآن". وهذه المقالات منتظمة بالتسلسل الآتي: 1. سعة الرحمة الإلهية. 2. الرحمةُ ليست بديلًا عن العدالةِ. 3. الرحمةُ مفتاحُ فهمِ المنطق الداخلي للقرآن. 4. احتكارُ النجاةِ. 5. السلمُ وليس الحربُ هو الهدفُ المحوري للقرآن "هذا المقال". وتأتي هذه الرؤية في ضوء مفهومنا للدين وحدود المجال الذي يتحقق فيه في حياة الإنسان، ومديات كل من الديني والدنيوي، والتي شرحناها بأبعادها المختلفة وتنويعاتها المتعددة في ثلاثية مؤلفاتنا: 1. الدين والنزعة الإنسانية. 2. الدين والظمأ الأنطولوجي. 3. الدين والاغتراب الميتافيزيقي. [5]