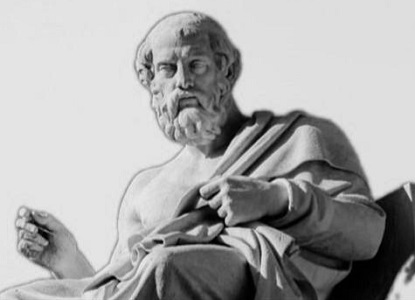صحيفة المثقف
طريق النهر

لم يتحرك في داخلي شيء، أو مشاعر لأي رجل، كنت كما الطفل عندما تحصنه أمه قبل الخروج من البيت بالآيات القرآنية، هكذا غدوت آنذاك. أضع في رأسي الحيطة والحذر والخوف من الانجراف في متاهات، لا استسيغ الوقوع فيها. كانت رفيقة دربي ودراستي ابنة عمتي، السمراء، الشخصية المرحة، المستبشرة، هذا ما ورثته عن أمها، صاحبة نكته، لا أفارقها إلا والابتسامة تلوح على شفتيها وشفتي، عمتي المرأة المسكينة، ماتت منزوية، منكسرة، جردوها من ممتلكاتها، ومنعت حتى من استلام راتبها التقاعدي لسنوات، لولا مساعدات ابنتها، لماتت كمدا وحسرة على سنوات العمر الضائعة في تربية أبناء شقيقتها المتوفاة، تركتهم صغارا، لا يكاد أحدهم يميز بين الصح من الخطأ، تكفلت بتنشئتهم، تبرعت بكل ما تملك لهم، وبعدما أشتد عودهم، جحدوا عمرا أهدرته في خدمتهم، لتكتف بهم عائلة. فمن أين لها أن تدفع إيجار البيت الذي باتت تسكنه، والمعيشة كيف كانت توفرها؟! وهي امرأة لم تعتد على العمل الشاق. ابنتها المرحة، المقبلة على الحياة، لم تفارقني طوال سنوات الدراسة، كانت تصحبني، أتهرب منها، أعود إلى بيت أهلي، تأتي وتدسّ رأسها تحت لحافي، توقظني صارخة بي: "قومي لا أستطيع القراءة بمفردي، لا أفهم شيئا مما أدرس". تسحب ما كنت ألتحف به عن جسدي، أعدو معها حيث بيت العائلة الكبير، نعتزل الجميع، وأقوم بما أُنيط بي كمعلمة صغيرة.
تخامرني الأفكار، تلحّ عليّ الذكريات، أشتاق دائما إلى طريق النهر، كنا أنا ورفيقتي _ابنة عمتي _ نختصر المسافة للوصول إلى البيت. هناك مساران، الطريق الرئيسي كان يكتظ بشباب تتابع عيونهم حركة الفتيات عند خروجهن من المدارس، وطريق النهر الفارغ إلا من الأشجار التي زُرِعت على جانبيه، برائحة المياه العبقة، تلك الزفرة المحببة أيام تكون الرطوبة عالية، ياه، كم أشتاق للعودة بالزمن، أستنشق ذاك العمر الذي تبدد بين يدي دون معرفة، أوقد شموعه، تُضيء عتمة روحي.. كبرنا معا أنا بقامة رشيقة ملفته للأنظار، وهي بسمرة محببة وحب الشباب الذي حفر آثاره على بشرة وجهها وجسدها، لم ننته من الدراسة، إلا وفي رأسي شيء، أتضاحك مع رفيقة دربي، أقول لها " لن أتزوج إلا رجلا يُرى من خلاله" ! ربما كان كلامي ساذجا حينها، وما كنت أنطق به ! تتضاحك معي، ترد علي بسؤال آخر، وبطريقتها التهكمية: ما معنى: رجل يُرى من خلاله؟! أُجيبها: أن يكون شفافا، جميلا، أنيقا، مثقفا، ويعشقني كثيرا.
ولمحته صدفة بطريق النهر، جاء من كان " يُرى من خلاله " أخيرا، وافقت مرة، عِلّ الوّجل يغادرني، وثانية أتوقى اندفاع غيري من الصديقات، وثالثة أطوف بين أصابعه المبدعة، أزداد بإشراقه رغم أني لم أره إلا كطيف عابر، ولم أسمع له صوتا، لكن من هيأه، قدم صفاته، وردد عبارتي دون أن يعلم " أنه رجل يُرى من خلاله ". همستُ بصوت يكاد لا يُسمع: هذا هو ! انتظرت بعدها دؤوبة بدنوَ بزوغ شمسه، تُراقص عيني بالإطلالة البهية. تأخر الوقت، وزادني الانتظار تصدعا، تساءلت: أين من أراه ولا يراني؟! حبستُ انفاسي، ألتقط ما تبدد منه. أُنادم ضجري على قارعة العمر، أخيرا، أُخبرت، تم ابعاده ! " ماذا ..؟!" مبهوتة صرخت. رفضه من هيأه وقدمه ! تبجح بالبيت، الأثاث، و... منذ ذلك اليوم صاحبني طيفه، ولم أضجر من انتظاره، عند طريق النهر!
***
خلود البدري