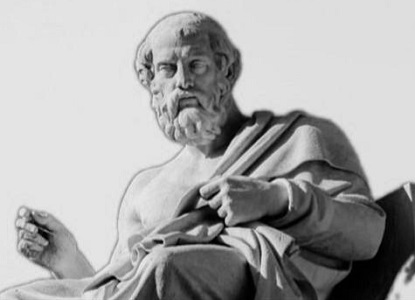صحيفة المثقف
مع التفسير الإشاري
 (9) للتفسير الإشاري، كما تقدّم، طابع خاص وصبغة مميزة، وله مذاقه المشروط في التخريج، وفي الحفاظ على دلالة الآيات القرآنية في ظاهرها اللفظي ثم استنباط الإشارة من الظاهر ممّا تؤول إليه في الباطن.
(9) للتفسير الإشاري، كما تقدّم، طابع خاص وصبغة مميزة، وله مذاقه المشروط في التخريج، وفي الحفاظ على دلالة الآيات القرآنية في ظاهرها اللفظي ثم استنباط الإشارة من الظاهر ممّا تؤول إليه في الباطن.
وليس بالصحيح أن يقال : القرآن "قانون أمة" فالتماس المعاني الباطنة من هذا القانون إنما هو تجاوز يسمح بمسخ هذا القانون، كما فعل "إقبال" حين سُئل عن بعض تفسيرات ابن عربي، فقال :" أنا لا أنكر عظمة الشيخ ابن عربي، ولكن التماسه معان باطنة في "قانون أمة" هو مسخ لهذا القانون".
وعندي أن هذا الوصف كبوةً من إقبال؛ لأن الشريعة نفسها فيها فقه الظاهر، وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال الجوارح. وفيها فقه الباطن، وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال القلوب.
فالتماس المعاني الباطنة من هذا القانون لا يعني مُفارقة حكم الباطن عن حكم الظاهر ولا غياب أحدهما عن الآخر، أو استحالة الجمع بينهما، بل يعني التكامل والاتفاق في وحدة قائمة تجمع بين مسلك التشريع ومسلك التحقيق.
ومن هنا؛ كان للشريعة ظاهرٌ وباطنٌ لا على معنى أن الشارع أظهر حكماً وأبطن حكماً كما يقول "الباطنية"، ولكن بمعنى أن للشريعة حكماً على المُكلَّفين من حيث ظاهر أعمالهم، وحكماً عليهم من حيث باطن أعمالهم؛ وهذا هو معنى قول الصوفية إن للشريعة ظاهراً وباطناً. ولم يكن ابن عربي بمعزل عما ينهجه الصوفية في تناولهم لهذا القانون والتماس المعاني الباطنة منه.
من أمثلة التفسير الإشاري لدى المتصوفة فهمهم من قوله تعالى : (يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)؛ أن القلب السليم هنا هو الذي لا تعلُّق له بشيء دون الله تعالى. ومن قوله سبحانه : (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ)؛ أنه لا يَصحُّ مجيئك إلى الله تعالى بالوصول إليه إلا إذا كنت فرداً ممّا سواه. ومن قوله تعالى : (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى)؛ أنه لا يأويك إليه إلاّ إذا صَحَّ يُتمك ممَّا سواه. وفهموا من قوله عليه السلام :"إن الله وتر يحب الوتر"، أنه تعالى يحب القلب الذي لا يشفع بمشوبات الآثار فكانت هذه القلوب لله، وبالله، وفي الله.
وليس التفسير الإشاري سوى ذلك "الفهم الجديد"، مستنبط بالذوق فهذا الذي ذكرناه عن ابن عطاء إنمّا هو فَهْم أحد العارفين ينقله ابن عطاء الله في "التنوير"، فيذكر أنه قال:" أتظن أنك تدخل إلى الحضرة الإلهية، وشيء من ورائك يجذبك"، ثم تأتي الآيات المذكورة شواهد مستملحة للإشارة. ومن الإشارة حَامُوا حول المعنى الذي قاربوه تلميحاً من طريق الكشف والفتح والشهود، فجعلوها مُلغزة تعزُّ على غير أهلها، مضنوناً بها عَمَّن سواهم ممَّن لا يعرف معرفتهم وليس يذوق قطرة من علومهم، وهم في مثل هذا "المضنون به على غير أهله" حقيقون بالتقدير، وهم أكثر جدارة بالاحترام حقيقة، ولنا من الشواهد المناسبة على ذلك ما يبرر وقفتنا معهم وتأييدنا لموقفهم هذا الذي اتخذوه ضناً بالإشارة على غير أهلها، وتأسيساً لعلم ممتع ومثير هو علم الإشارة الصوفية.
* * *
ونعودُ بعد تلك الوقفة العارضة إلى الآية الكريمة التي ذكرناها فيما تقدّم في المقال السابق (فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْساً وَلَا رَهَقًاً) فنقول : إنّ المستوى الأعلى للإيمان يجعلنا نفتح ألفاظها لِتَسعَه ولا تنقبض عنه عندما نُحمِّل معاني "البخس" و"الرهق" ما يمكن أن تحتمله في تقرير حكم النظر في الماورائيات.
وحكم النظر إلى الماورائيات لا يسلب عن البخس والرهق معناهما الذي تؤديِّه الإشارة الواقعية ولكنه يُضيف وفقاً للمستوى الأعلى للإيمان تلك الدلالات الماورائية، أي يضيف إليها ما بعد إشارة الحسِّ، فيصبح مدلول الآية في معناها المفتوح : أن من يؤمن بالله حق الإيمان لا يخاف بخساً، كائناً ما كان هذا البخس : في الرزق أو في العمل، في المرض أو في الأمل، في الوجود أو في العدم، في الحياة أو في الفناء، أو فيما يُلاقيه من صنوف الأنشطة التي يفرضها على الحياة أو تفرضها الحياة عليه، فلا بخس مطلقاً مع الإحسان.
ولا بخس هنالك مطلقاً إذا آمن الإنسان بالله وجعل الإيمان مُقَدَّماً على أعماله يستفتح به نشاطه وهو على الله معتمد وقويّ الاعتماد.
وما يجري على البخس في معناه المفتوح، يجري كذلك على "الرَّهَق" لو توخَّينا فتح اللفظ على دلالته الماورائية حاملة القوة الخفية بحوافز الباطن، فماذا يكون معنى الرهق إذا فتحناه ولم نقْصر إشارته على ما أشار إليه من معنى ضئيل يقع تحت طائلة الحس؟ لا يكون من معناها هنا سوى ذلك المعنى المفتوح الذي سبق أن جرى على أخيه "البخس"؛ فيصيرُ مدلول الآية في معنى الرهق المفتوح : أنَّ من يؤمن بالله على الحقيقة لا يخشى أن يقع عليه رَهَق أياً كان هذا الرهق، ولا ظلم لا من العباد ولا من ربِّ العباد ولا من نفسه التي بين جنبيه؛ لأن الظلم الذي يلحقه من العباد يشعر به ويحسُّه في حالة نقص الإيمان، والظلم الذي يقع عليه من الله، إنْ جاز أن يقع، يحسَّه ويشعر به حين يغيب عنه قوله تعالى: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ)؛ والظلم الذي يقع عليه من النفس يحسُّه ويستشعره في حالة يكون فيها ليس إلى الإيمان الحق بقريب؛ فمن شأن الإيمان أن ينفي الظلم وينفي الرهق إذا استوى عالياً في قلب المؤمن، وإذا أنطلق منه المؤمن محققاً أشراطه عارفاً بلوازمه ومقرراته، فلا بخس هنالك ولا رَهَق عند تحقق موضوع الإيمان في قلب مَنْ يؤمن، ولا ظلم كذلك في معناه ومرماه، ولكن الناس مع قلة الإيمان لأنفسهم يظلمون.
وبعدٌ؛ أفلا يكفينا هذا الذي تقرّر عندنا أن تجيء لغة الخطاب الصوفي مفتوحة تصيب الرمز والإشارة من وراء العبارة وتعطي من ذاتها ومن تجارب أصحابها : أحوالهم ومنازلاتهم، ما ليست تعطيه أذهان من توافروا على فهم العبارات العادية؟
ثم ألم يكن القشيري يصرح في مطلع رسالته (ولتجدر الإشارة السريعة إلى أن هناك تعليقات على هذا النَّص تحديداً وضعها المحققان، نربأ بقرَّاء الرسالة من أهل الذوق والبصيرة أن يلتفتوا إليها بوجه من الوجوه؛ بسبب أنها لا تقوم في المجمل فضلاً على التفصيل إلا على فراغ محض من الدلالة الذوقية، ولا تكشف قيد أنملة عن علم صريح بالتصوف بل يحركها اتجاه تعتقده وتتبناه لا يستند إلى بصيرة الذوق والعرفان)؛ بأن للقوم ألفاظاً مُسْتَبْهَمَة على الأجانب كانوا قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم، والستر على من باينهم في طريقتهم وخالفهم في منهاجهم، غيرةً منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها؛ وذلك لأن هذه المعاني التي أراد المتصوفة كشفها لأنفسهم إنما هى بنت حقائق ليست مجموعة بنوع من التكلف (اللفظي) أو مجلوبة بضرب من التصرُّف (العقلي)، ولكنها هى معان أودعها الله تعالى في قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم؟
ألا يكفينا ذلك كله للإيمان بأن لغة الخطاب لدى الصوفية ليست تتاح للأجانب ممَّن ليسوا بصوفية، وممَّن غَلقَوا فهم الكلمة والعبارة وقصروها على ظاهرها اللفظي؟ فإذا لم يكن يكفينا هذا كله، ففي المقالات القادمة مزيدٌ من التفاصيل.
(وللحديث بقيّة)
بقلم : د. مجدي إبراهيم