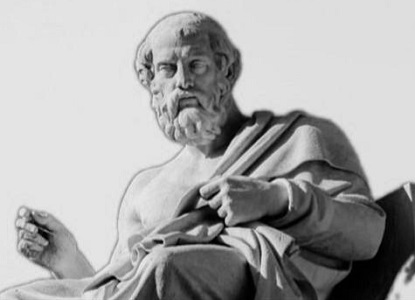صحيفة المثقف
مفهوم المعنى
 (13)
(13)
لم يكن الوعي الصوفي، وهو الوعي العالي ليس بالعادي، والحاصل دوماً في حال الفناء والموحي بلغة الخطاب، بالذي ينقل المُعطى الحسي كما ينقل دلالته المفهومة إلى لغة رمزية وكفى؛ ولكنه أيضاً يحوّله بوصفه مُدْرَكاً روحيّاً وشهودياً قام على خصوبة الخيال؛ إلى إشاراتٍ. وقد تقدّمت الإشارة إلى أن من الألفاظ ما هو مفتوح، تُجيزُه الرمزية في تجربة العارف بمقدار ما تجيزُه رُوح المجاز اللغوي، وتجيزُه بنفس الكيفية لغة الخطاب الصوفي، ويرمي من طريق الرمز إلى "ما وراء" بعد إشارته إلى المحسوس ودلالته المفهومة من أول لقاء.
فإذا نحن لم نُدْرك هذا الأمر، فقد يسهل علينا أن نرمي مَن يدركه ويتمثله بصنوف البهتان وما من عجب:" فمن لم يكن في مرتبتك من العقل، لم يذق مذاقك في الفضل" كما يقول الإمام محمد عبده؛ ظناً مِنَّا أن كل ما لا ندركه بحواسنا الظاهرة يقع في حكم العدم، بل ما لا تدركه أنت قد يدركه غيرك لو كنت مُنْصِفاً حقاً.
ومن ثمَّ، فقد وددت لو تقرَّر عندنا اليقين الدائم في أن اللفظة العربية وراؤُها قوة شاعرة وصلت إليها من ثورة الروح وفورة الشعور والوجدان. وأنه لعَسَفُ في الاتجاه واضح كل الوضوح، ولو فيما نراه نحن، ذلك الذي كان يهدف إليه اتجاه فلاسفة التحليل المعاصرين أمثال "جورج مور" (G.Moore (1873- 1958)؛ وبرتراند رسل (B . Rusell ) (1872- 1970)؛ ولوفيج فتجنشتين (L.Wittgenstein) (1889 - 1951)؛ ومن العرب زكي نجيب محمود وعزمي إسلام، من ضرورة تقييد معنى "اللفظ" بدلالته الواقعية الحسيَّة وكفى؛ لأن المعنى عندنا أرفع وأسمى من أن نقصره على إشارات الواقع فيما يشير إليه اللفظ إلى شيء حسيِّ هو من دنيا الأشياء الواقعة بالفعل ولا يزيد؛ ربما أفادت دراساتهم في مجال العلاقة بين المنطق واللغة فقط، وازدادت على أيدهم الصلة بينهما فلم يَرَوْنَ في الفلسفة كلها إلا هذا الاتجاه: التحليل المنطقي للغة الجارية. ومن يقرأ "المنطق الوضعي" و"موقف من الميتافيزيقا"، للدكتور زكي نجيب محمود، و"مفهوم المعنى" و"اتجاهات في الفلسفة المعاصرة" للدكتور عزمي إسلام؛ يتبيِّن له وقوف الألفاظ وتحديدها، على ما تشير إليه من موضوعات جزئية أو مُفردات، أو حوادث (مثل هذا الكرسي، أو هذا الشيء الأحمر).
فاستخدام الرموز اللغوية لا ينفك بإشارته إلى فئات الموضوعات أو الحوادث (كفئة الكراسي، أو الأشياء الحمراء)، أو الكليات أو الخصائص أو الماهيات كالاحمرار أو الاستدارة.
كما أن هنالك من الألفاظ البنائية الوصفية تجيء الرموز اللغوية فيها مرهونة بتحديد الحواس، كما يقول الدكتور زكي نجيب محمود:" الرمز اللغوي؛ كلمة كان أو عبارة؛ إنْ دل على مجموعة من الصفات، فهو لا يقتضي بالضرورة أن يكون مُسَمَّاه موجوداً وجوداً فعلياً؛ إذْ قد يكون هنالك المسمى الذي تنطبق عليه تلك الصفات وقد لا يكون؛ فقل مثلاً "حصان أبيض ذو ذيل أصفر وغرة صفراء"، يكن لك بذلك بناء وصفي؛ لكن هذا البناء الوصفي لا يقتضي بالضرورة أن يكون الكائن الموصوف موجوداً بالفعل أو غير موجود؛ فالحواس هى التي تدلني إنْ كان لمثل هذه الكائن وجود بين الكائنات أو لم يكن".
ولربَّما مثلت الكلمات معاني هى الحالات العقلية أو الأفكار أو الصور الذهنية، وجميعها يتطلب تحديداً يرتدُ باللفظ إلى المحسوس والواقع، ولا يرتفع فوقهما أو ينفتح فيما وراءهما بحجة أن كثيراً من الكلمات تستخدم بطريقة تدعو للالتباس، والتباسها يعوق عملية الاتصال فضلاً عن كونه ينتهي إلى قبول حجج وبراهين فارغة من المعنى، هى في حقيقتها لا تبرهن على شيء.
ولمَّا كان استخدام اللغة وقواعدها يأتي من طريق الاتفاق العام على المعاني، وكانت المعاني تتمثل في كيفية استخدام الرموز اللغوية المختلفة؛ صارَ من الواجب التخلص من جميع الرموز "مشتركة المعنى" لاستبعاد كل التباس فيه ولتوخِّي الوضوح في الدلالة. ولكن هذا يتعارض مع أصول اللغة العربية وفنون البلاغة بمقدار ما يتعارض مع التخريج الذوقي للّغة بل صار يتعارض مع بلاغة العمل العقلي للغة العربية كونها مجازاً، وهو من بَعْدُ لا يعطينا الحق في تقييد المعنى مثل هذه القيود المُجْحفة، وإلاّ قضينا على الرمز، والإشارة، والمجاز، والتأويل، ثم العبارات الأخلاقية برمتها، واكتفينا بما نلمسه من دلالة اللفظ الظاهرة، وهو ممَّا لا يجوز في لغة العرب؛ إذْ الجائز لزوم الاشتراك لاتساع المعاني وعدم تناهيها. والمتناهي من الألفاظ إذا وُزِّع على غير المتناهي من المعاني، لزَمَ الاشتراك، كما عرفنا فيما تَقَدَّم من كلام الشوكاني.
لقد سقناً في السابق عدة أمثلة لنُدلِّل بها على أن هناك معنى بعيداً غير المعاني القريبة. وهذه المعاني البعيدة لها أهميتها "الفاعلة" على نشاط الألفاظ وروحانيتها من وراء معانيها، ومن ثمَّ لها كذلك أهميتها "الفاعلة" على نشاط الإنسان وتوجُّهاته: يتأثر باللفظ وما ورائه من دلالة روحيَّة تأذن بتوجيه الإنسان في أنشطته الحياتية الفاعلة، وتحوِّلُه "الكلمة"، باطنياً، يسمعها على الحضور، من حال في الحياة إلى حال، ومن طريق إلى طريق، ومن اتجاه إلى اتجاه.
وفيما العجب؛ فإنّ اللفظة التي تخرج من فيك رامية إلى معنى بعيد لهى أحرى بالعناية من لفظة تنقلها عن لافظ، كان قد نقلها بدوره عن لافظ آخر، وهى بالطبع لا تحمل غير تكرار غريب من معاني قريبة، ومبتورة، وَرَثَّة، وبالية:" فقد اعتادت الألسنة والأقلام؛ هكذا يقول الدكتور زكي نجيب محمود، أن ترسل القول إرسالاً غير مسئول؛ دون أن يطوف ببال المتكلم أو الكاتب أدنى شعور بأنه مطالب أمام نفسه وأمام الناس؛ بأن يجعل لقوله سنداً من الواقع الذي تراه الأبصار وتمَسَّه الأيدي". نعم .. (ليس الحسُّ هو المعنى).
نقول: نعم ! غير أن ضلالة هذا القول غير المسئول يرتدُّ فيما نرى إلى الحس والواقع، وهما مصدر تلك الضلالة ومبعثها بكل تأكيد، وماذا عَسَاهُ يكون الشأن في قول يُقال لا عمَّا تراه الأبصار ولا عَمَّا تمسه الأيدي؟ ضلال ! أليس كذلك؟ بالطبع لا؛ بل هو اليقين الذي لا شك فيه إذا اختلفت المنطلقات والتوجهات.
لمّا أن قرأ "العقاد" المنطق الوضعي لزكي نجيب محمود، أستوقف نظره هذه النقطة بالتحديد، إذْ "الفرق كبير جداً بين صعوبة تعريف المعنى وبين انعدام المعنى على الإطلاق، ليس الحسّ هو المعنى. فقد يكون المعنى شيئاً مستمداً من الحس أو مُفَسِّراً لعوارضه وأجزائه، وأمّا أن يُقال الحسّ والمعنى شيء واحد، فالواقع لا يثبته إنْ لم نقل بالقطع إنه ينفيه".
هناك معاني قريبة في متناول النظر التقليدي المحدود أو إن شئت قلت المحسوس، وهنالك معاني بعيدة خفية عن الظاهر الملموس، لكن مُجْمَل هذه المعاني البعيدة لا يمكن لنا تحصيلها ونحن نعترك الواقع ونغوصُ غَرقى في نكبات الحياة المتوالية دون أن نتجرَّد لحظة واحدة لما هو أسمى وأصفى؛ فالنظافة الجُوَّانيَّة لها في إثراء الباطن ووعي الدخائل تحقيقٌ مشروط للكلمة القويمة واللفظة الرامية إلى معنى بعيد.
وعن هذا الاختلاف في تصور المعنى الواحد يرى "زكي مبارك" إنك مثلاً لو قلت إنك تترجم القرآن ترجمة صحيحة فأنت صادق، ولو قلت إنك لا تترجم إلاّ ما فهمت فأنت صادق: أنت صادق في الأولى؛ لأن القرآن في الأصل جاء لهدايتك، فلم يكن له أن يحتجب وينتقب. وأنت صادق في الثانية؛ لأنه رمز لمعان يختلف في فهمها الناس بفضل ما يختلفون في دقة الفهم وقوة الإدراك (التصوف في الأدب والأخلاق: 104)؛ وليس من خطأ الرأي عندنا أن يُقال: إنّ الاختلاف في تصور المعنى الواحد لا يرتد إلى صحة الجسم وعافية الروح، كما زعم المرحوم زكي مبارك، بمقدار ما يرتد إلى اختلاف في التوجه الفكري والاحتكام إلى التكوين الثقافي والخلفية التاريخية والأيديولوجية.
(وللحديث بقيّة)
بقلم: د. مجدي إبراهيم