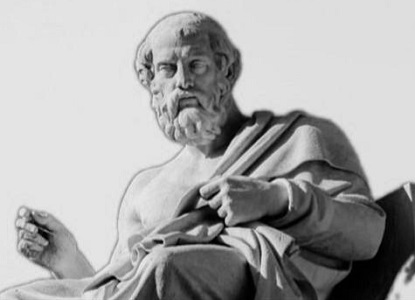صحيفة المثقف
العقلُ في القارورةِ

وبعد، سأتطرق إلى الدافع وراء كتابة الأسطرِ أعلاه؛ وهو أني، وإلى جانب تساؤلي المعلل عن هموم المثقفين التي يمكن لك أن تعود لكتاب قيِّم بهذا العنوان للدكتور المصري زكي نجيب محمود، أتساءل عن الوسائل والآلياتِ المعتمدتين من قبلِ الدولِ للدفع بالشعوب المضطهدَةِ إلى العزوف، والزهدِ الكليِّ عن مشاكلها الحقيقية؟
للإجابة عن هذا السؤال القديم/الجديد، والذي قدْ سبق لباحثين ومثقفين كُثُرٍ طرحُهُ، ومحاولةُ الإجابةِ عنه، كان لزاما علي محاولةُ قراءةِ المعطياتِ والمؤشراتِ المتعلقةِ بالحياةِ اليوميةِ للمجتمعِ الذي أعيشُ فيه عامةً، وللأشخاصِ القريبين مني على وجه الخصوص.
أعتقدُ أن ثمةَ وسائلَ كثيرةً اُعتُمدتْ كسلاحٍ بغيةَ تدجينِ وترويض الشعوب حتى تغدو كالخاتم في إصبعِ مضطهدِيها. وهذه الوسائل متنوعة ومختلفة بناء على الفترة التاريخية المستعملة فيها، كما أن لها مفعولا مختلفا أيضا.
يعد التطهيرُ الفكريُّ، والذي لا ينفصل عن التصفية الجسدية في فترات تاريخية ماضية، وفي التاريخ المعاصر، سلاحا فعالا في يد الدول الحاكمة، حيث إنه ينصبُّ على الفئة المثقفة التي تحاول التفكير من خارج الأدلوجةِ الرسميةِ المعتمدةِ من قبل الدولة؛ بمعنى أن الفئة التي تخرج عن الأدلوجة تحليلا ونقدا، وتعديلا وتحويرا، تشكلُ خطرا كبيرا، وعوض تصفيتها جسديا، فإنها ستمارسُ عليها، أي على الفئة المنشقة، تطهيرا فكريا حتى تغدو خاضعة لرقابة جماعية- ذاتية في كل وقت وحين. وأقترح عليك أيها القارئُ اللبيبُ أن تعود إلى رواية 1984، للكاتب الإنجليزي جورج أورويل (واسمه الحقيقي هو إريك آرثر بلير: 1903-1950) طبعا إن كنت لم تقرأْها بعدُ، لتعرف نوعَ الإنسانِ الذي استشرف أورويل أن المجتمع الرأسمالي الغربي، في القرن العشرين، يريد إنتاجه وإعادةَ إنتاجه. وهذا طبعا بعيدا عن الرؤية الديستوبية؛ لأن نبوءته قد تحققت فعلا وإن عبر مراحلَ متباينةٍ. كما أني أدعوك إلى العودة إلى روايته، التي نراها واقعية، المعنونة ب" الطريق إلى رصيف ويغان"، في سياق نقده للرأسمالية والآلة، حتى تعرفَ ما قصده ب"العقل في القارورة" الذي اخترته عنوانا لهذا المقال؛ أي أن المثقف مطلوب منه أن يأخذ إجازة عن التفكير إلى الأبد في ما يعيشه داخل الحياة الاجتماعية وما يرتبط بها من سياسة واقتصاد.
ومن بين الوسائل المعتمدة، إلى جانب تجريد المثقف من سلاحه، أي من استخدام عقله، ودوره في توعية وتثقيف الشعب أو العقل الجمعي، أو الرأي العام، لترويض الشعوب نجد وسائلَ الإعلامِ سواء أكان إعلاما مكتوبا مقروءا أم مسموعا مرئيا. وفي هذا السياق، سأعود مرة أخرى إلى استحضار جورج أورويل من خلال كتابه "لماذا أكتبُ (وهو مجموعة من المقالات التي كتبها أورويل بين الثلاثينيات والأربعينيات من القرن المنصرم) لأقفَ عند مقالٍ لهُ بعنوان "الشعر والميكروفون" حيثُ انتقد بعضَ وسائلِ الإعلام التي باتت رسميةً ومسيرة من قبل البيروقراطية، وبالتالي، فإن ما تنشره وتبثه، وأورويل كان يتحدث عن المذياع آنذاك، له القدرةُ الفعالةُ على بلورةِ وتشكيلِ الوعي المنمط للرأي العام. كان أورويل قد تساءل عن السبب الذي جعلَ الرأيَ العامَّ الإنجليزيَّ ينفر من الشعر (بدعوى غموضه، وريائه الفكري...إلخ)، فتوصل إلى أن الجهاتِ المسؤولةَ ليست لها الرغبةُ في توجيه الرأي العام إلى فنِّ الشعر، ولأسباب أخرى عرضها بتفصيل لا يتسع المقامُ لذكرها.
وهكذا، نجد في المجتمعات العربية، أن وسائل الإعلام قدْ وَأَدَتْ كلَّ قريحةٍ فكريةٍ، أو رغبة في النقد والتساؤل، وإنما دأبت لسنوات طويلة على تقديم الوجبات السامة للعقل الجمعي (والذي من خصائص حامليه أن السواد الأعظمَ منهم لا يتوفر على مناعة واعية وعقلانية وعلمية) الذي يتجرعها دون أن يتساءل عن مصدرها، والغاية من ورائها. فلما كانت سياسةُ وسائلِ الإعلام والتواصل هشةً وتافهةً، كان من الطبيعي أن تبلورَ وعيا تافها خرافيا، وعقلا جمعيا ميالا إلى الضربِ صفحا عن همومه ومشاكله. لقد كنت، في أحيان كثيرة، أتساءل دوما: لمَ لا تحركُ الشعوبُ المضطهدَةُ ساكنا أمام المخططات والسياسات التدميرية التخريبية والسامة التي تُمارَسُ عليها؟ فكنت أجد عزاءً لنفسي في قولي "إن رغبةَ الشعوبِ فاترةٌ الآن، ولكنْ ستثورُ يوما" أو "إنه الصمتُ الذي يسبق العاصفة". بيد أني غدوت أكثر تطرفا لما ذهبت إلى أن السبب هو مسكناتٌ ومهدئاتٌ يتجرعها الطفلُ في الحليبِ المصنَّعِ، والمواد المعلبة منذ أنْ فتحَ عينيه.
إضافة إلى ما سبق، يمكن القولُ إن للمدرسة دورا كبيرا في ترويض الأجيال الناشئة (طبعا لا ننس جهودَ عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو في هذا الصدد) من خلال المراقبة والمعاقبة (وهذا عنوان لكتاب ميشيل فوكو) التي تُمارَسُ على المتعلم في المدرسة، والسجين في السجن، والمجنون في المارستانات؛ إنها كلَّها تمثل نوعا من الرقابة الخارجية التي تغدو مع العادة والتكرار رقابةً ذاتيةً، ترافقُ المرءَ طوال مراحل نشأته وحياته. ومرة أخرى، وتأكيدا للرقابة والمراقبة، أستحضر عبارة "إن الأخ الأكبرَ يراقبك" من رواية 1984.
وفي الختام، أود القولَ إن للمثقفين قسطا مهما من تزييف وعي الشعوب المضطهدَة؛ لأنهم باتوا يمارسون نوعا من اللامبالاة واللامسؤولية في ظل هذه الفترات التاريخية الأخيرة المزرية؛ إنهم يمارسون ضربا خبيثا من التقية، أو ما أسماه أورويل، في سياق نقده ل ميللر، ب "يونس في بطن الحوت"، أي الفرار من هموم ومشاكل المجتمع، وعدم المشاركة والخوض في معاركه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية الثقافية. كما أن القسط الأعظم يقع على كاهل المدرسين والمعلمين؛ لأنهم مسؤولون عن المنتوجِ الذي يخرجونه للمجتمع. أما العبءُ الأكبرُ، فإنه كان وما يزال وصمةً في تاريخِ الحكام المضطهدِين، والمستبدين الذين يجهدون أنفسَهم للحفاظ على الدول الشمولية الاستبدادية، من خلال تقديمها في ثوب الدولة الديموقراطية. وربما ما تزال الدول تسعى إلى استعباد شعوبها من خلال التجهيل والتفقيرِ، والتشديد على الرقابةِ الفكرية، أو ما سماهُ أورويل بجريمة الفكر.
محمد الورداشي