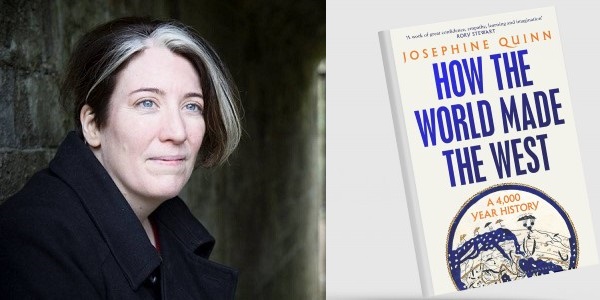صحيفة المثقف
تفكيرٌ في الدِّين (4)
 لم نكن لنتجاوز الصواب إلى ما ينقضه حين نقول إنه ما من مفكر ظهر في الإسلام إلا ومردود تفكيره يرجع إلى ضرورة اجتماعية أو سياسية، ربَّما لأن الشَّرع هنا يحثُّ على "المصلحة"؛ وأن هذه الضرورة الاجتماعية أو تلك الحاجة السياسية مصلحة عامة ينتفع بها المسلمون. ومن مأثورات الإمام محمد عبده:"حيثما كانت المصلحة فثمَّ شرع الله". والمصلحة سياسة، ولكن أيضاً من جهة أخرى هو القائل:" ما دخلت السياسة في شيء إلا أفسدته".
لم نكن لنتجاوز الصواب إلى ما ينقضه حين نقول إنه ما من مفكر ظهر في الإسلام إلا ومردود تفكيره يرجع إلى ضرورة اجتماعية أو سياسية، ربَّما لأن الشَّرع هنا يحثُّ على "المصلحة"؛ وأن هذه الضرورة الاجتماعية أو تلك الحاجة السياسية مصلحة عامة ينتفع بها المسلمون. ومن مأثورات الإمام محمد عبده:"حيثما كانت المصلحة فثمَّ شرع الله". والمصلحة سياسة، ولكن أيضاً من جهة أخرى هو القائل:" ما دخلت السياسة في شيء إلا أفسدته".
أمّا الضرورة العقلية البحتة فلم تكن لتظهر فى الإسلام إلا لأنها تهدف إلى إثراء المطالب العملية والمقاصد الواقعية، ولم تكن لتتشكل في الواقع الإسلامي لولا وجود تلك المقاصد، عملية كانت أو واقعية، ولم نعدم من الإسلاميين؛ مَنْ شطب بجرة قلم على ما يُسَمَى فلسفة إسلامية أو فكراً فلسفياً في الإسلام، واعتبار ذلك كله في المجمل ترفاً فكرياً، ولا زيادة عليه لمستزيد. مثلما فعل سيد قطب حيث قال:" لسنا حريصين على أن تكون هناك "فلسفة إسلامية"! لسنا حريصين على أن يوجد بيننا هذا الفصل في الفكر الإسلامي، ولا أن يوجد هذا القالب في قوالب الأداء الإسلامية! فهذا لا ينقص الإسلام شيئاً في نظرنا، ولا ينقص "الفكر الإسلامي"، بل يدل دلالة قويّة على أصالته ونقائه وتميزه"(!!).
وفي الحق أن هذا الرأي، وإنْ يكن يعبر من الوهلة الأولى عن رجعية وتخلف ورفض للمقبول من التوجهات الفلسفية، لم يقم عند صاحبه من لا شيء، مجرد رأي كيفما أتفق والسلام! ولكنه كان صادراً عن وعي الرجل بفكرته، حتى ولو جاءت هذه الفكرة تهدف إلى غاية شديدة التقليد للنزعات المتطرفة الرافضة للفلسفة والتفلسف، تدعو إلى الانغلاق ولا تدعو إلى الانفتاح، وتؤسس للعنف الديني ولا تؤسس للتسامح بين الأديان وتخشى على العقائد الإسلامية من أن يشوبها التحريف من جَرَّاء أعمال النظر الفلسفي.
هذه الفكرة ممّا تحمل الرأي ولا شك بدائيةٌ متخلفةٌ، غارقةٌ في التقليد والتخلف والجمود، ولكنها مع ذلك تعبّر عن اتجاه، وعن موقف إزاء الدّرس الفلسفي، مجرد تفكير في الدين، ليس ملزماً لأحد، ولن يكون من حق أحد قبوله، ولا رفضه في حالة تسويغه لدى من يراه صحيحاً. وبما أن لكل أحدٍ أن يكون حُرَّاً في اختيار فكرته، فلا مصادرة على الأفكار لدينا بل دراستها وفحصها تحت مشارط النقد والتحليل؛ ففكرته هى: أن يرفض استعارة "القالب الفلسفي" في عرض حقائق التَّصُّور الإسلامي، وهو على قناعة بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين طبيعة "الموضوع" وطبيعة "القالب"؛ وأن الموضوع يتأثر بالقالب. وقد تتغير طبيعة الموضوع ويلحقها التشويه، إذا عرض في قالب، في طبيعته وفي تاريخه عداء وجفوة وغربة عن طبيعته ! الأمر المتحقق في موضوع التصور الإسلامي والقالب الفلسفي.
والذي يدركه من يتذوق حقيقة هذا التصور كما هى معروضة في النّص القرآني. وإنه ليخالف "إقبال" في محاولته صياغة التصور الإسلامي في قالب فلسفي مستعارُ من القوالب المعروفة عند هيجل من "العقليين المثاليين"، وعند أوجست كونت من "الوضعيين الحسيين".
أحيانا قد تجد الذهب في المزابل، والتبر المسبوك بين أكوام الواغش المهجور. لم يكن الرجل يدعي مجرد ادعاء لا يثبت أمام المنطق المقبول، بل كانت فكرته الأساسية وإنْ أخذناها على أنها فكرة متطرفة جرجرت صاحبها فأدت به إلى أن يرفض ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، إلا أنها في هذا المستوى الذي يتحدث فيه مقبولة في العقل بحكم التعامل مع المجالين، مجال العقيدة ومجال الفلسفة، وبحكم انعكاس هذا المجال الأخير صراحة أو ضمناً على ما شأنه أن يكون سبباً مباشراً في غيبة قراءة الإيمان على وجهه الصحيح.
تقوم هذه الفكرة فيما يصرح:" على أن العقيدة إطلاقاً والعقيدة الإسلامية بوجه خاص تخاطب الكينونة الإنسانية بأسلوبها الخَاص، وهو أسلوب يمتاز بالحيوية والإيقاع واللمسة المباشرة والإيحاء: الإيحاء بالحقائق الكبيرة التي لا تتمثل كلها في العبارة ولكن توحي بها العبارة، كما يمتاز بمخاطبة الكينونة الإنسانية بكل جوانبها وطاقتها ومنافذ المعرفة فيها ولا يخاطب "الفكر" وحده في الكائن البشرى، أمّا الفلسفة في نظره فلها أسلوب آخر؛ إذْ هى تحاول أن تحصر الحقيقة في العبارة، ولما كان نوع الحقائق التي تتصدى لها يستحيل أن ينحصر في منطوق العبارة فضلاً عن أن جوانب أساسية من هذه الحقائق هى بطبيعتها أكبر من المجال الذي يعمل فيه الفكر البشري، فإن الفلسفة تنتهي حتماً إلى التعقيد والتخليط والجفاف؛ كلما حاولت أن تتناول مسائل العقيدة !".
يكشف هذا الرأي حقيقةً، ولو فيما نراه نحن، عن تلك المحاولات العابثة التي اتخذتها الفرق الكلامية حين جعلت من العقائد موضوعاً لتوجهات سياسية أو لمجرَّد رؤى عقلية جافة لا تجعل من الإيمان روحاً يدرك ولا شعوراً يُحَس، جعلت العقل بمعزل عن الشعور والوجدان، ومضت به تواقة إلى المزيد من الخطابات الجدلية الغريبة العازلة له عن نبض القلوب وإيحاء الشعور ومعايشة العقيدة والإحساس بالقرآن. الأمر الذي أسفر في النهاية عن كوارث وأزمات فكرية كانت في الماضي كما لا زالت باقية إلى يوم الناس هذا!
وعليه؛ فالطابع النظري الصرف مُغْلق في الثقافة الإسلامية؛ لأنه طابع لا يُشكل روحها ولا عقيدتها ولا مطالبها الاجتماعية ولا حاجاتها السياسية؛ بعكس روح الثقافة اليونانية مثلاً، فلقد كانت في أكثر جوانبها نظريّة بحتة، مصروفة إلى إحياء هذا الطابع فيها دوماً وبغير انقطاع.
القرآن نقطة التشكل الأولى:
يَهمُّني في هذا السياق أن أمسك بنقطة انطلاق الباحثين في التراث الفكري والفلسفي الإسلامي قديماً، من فلاسفة ومتكلمين ونظَّار ومفكرين، حيث يبدو النظر البحت مرفوضاً أو شبه مرفوض من الوجهة الإسلامية؛ تلك التى اعتمدت على النظر العقلي والدلالة العملية معاً، فلا يأتي النظر مقطوع الصلة بالجوانب العملية ولا هو بمفصول عن الأبعاد الاجتماعية والسياسية تلبية للحاجات الجماعية، ومن ثم يجيء البحث الفكري الفلسفي كله في الغالب ليتخذ لنفسه نقطة انطلاق ذات مصدر داخلي، (بالإضافة طبعاً إلى تعدد المصادر الخارجية وبخاصة اليونانية). أقول؛ يتخذ نقطة انطلاقه من" مضمون" متمِّيز، يميِّزه فيتميز به عن غيره؛ ليُشَكِّل طريقته في النظر والمعرفة والإدراك، بمقدار ما يرى في الدلالة النظرية مدلولاً واقعياً وتطبيقاً عملياً. هنالك تجد مضموناً إسلامياً يتخذ من القرآن الكريم قاعدته الأساسية ومنطلقاته النظرية والعملية.
وليس يشك باحث منصف في الفكر الفلسفي الإسلامي وفي الحياة الإسلامية في أن القرآن كان "نقطة انطلاق" المسلمين؛ إذْ اتجهوا إليه بالمباشرة يقرأونه ويتدبّرونه. والقرآن "حَمَّال أوجه"، يعطي لكل" الوجه الذي يريد".
ومن هذا التدبُّر وهذا التفكر في أعماق النّص الإلهي، فيما كان يرى الدكتور على سامي النشار، في المقدمات التمهيدية لنشأة الفكر الفلسفي في الإسلام - بدأ الفكر الإسلامي: اختلفت الطرق بالناس ولكن الأصل واحد: هو القرآن. والحياة الإسلامية ليست سوى التفسير القرآني؛ فمن النظر في قوانين القرآن العملية نشأ الفقه.
ومن النظر فيه ككتاب يضع "الميتافيزيقا" نشأ علم الكلام. ومن النظر فيه ككتاب أخروي نشأ الزهد والتصوف والأخلاق. ومن النظر فيه ككتاب للحكم نشأ علم السياسة. ومن النظر فيه كلغة إلهية نشأت علوم اللغة .. الخ. وتطور العلوم الإسلامية جميعها إنما ينبغي أن يبحث في هذا النطاق: في النطاق القرآني نشأت، وفيه نضجت وترعرعت، وفيه تطورت، وواجهت علوم الأمم تؤيدها أو تنكرها في ضوؤه".
وهذه وجهة نظر صائبة تماماً بل وتستحق الاحترام، من باحث ممتاز له قدْره، وله أثره على الفكر الفلسفي الإسلامي ولكن هذا لا يمنعنا من ملاحظة بعض المآخد التي نصيغها في مثل هذه الأسئلة: هل كانت النشأة كالتطور؟ وهل كان القرآن بالفعل في مراحل التطور هو المقصد الأوحد الأسمى للفكر الديني والحياة الإسلامية؟ هل كان هو المُقَدَّم دائماً على أية أغراض سياسية أم لعب به السياسيون كما أغلقه الفقهاء على ما يفهمون منه، وحجَّر المتكلمون معاني آياته بجفاف أنظارهم العقلية، فدخلت فيها الأهواء البشرية التى ليست مُلزمة لأحد لا في عقيدة ولا في دين؟! صحيح أن نقطة التّشكل الأولى لنشأة العلوم الإسلامية كانت من القرآن الكريم، لا شك في هذا، إذْ كان المصدر الداخلي الذي اعتمد عليه المسلمون وتوجهوا منه إلى إقامة حضارتهم وحرصوا على تطبيق مبادئه في العلم والحياة، ولكن النشأة لم تكن كالتطور، ولم تكن حركة التطور في واقع المسلمين تحفظ قوة المنشأ وتَقْتدرُ عليه مع حلول الخلاف، وبخاصةٍ الخلاف السياسي.
فالعقليون والحدسيون والذوقيون والجدليون والخطابيون والظاهريون والفقهاء والمفسّرون، وشتى المناهج لشتى الفِرَق، وكل من كانت له إسهامات في التراث الفكري الفلسفي والديني، كانوا جميعاً يستندون إلى "القرآن"؛ ليرون فيه وجهتهم ومبتغاهم، حتى أولئك الخارجون عليه، كانوا ينطلقون منه وإنْ لم يعودوا إليه؛ لأنهم إذْ ذَاَكَ كانوا يوظفونه توظيفاً يخدم مآربهم السياسية والطائفية.
لم يكن غرضهم وافياً بمقصود القرآن ولكنه كان وافياً بمقصودهم هم من وراء القرآن. فهو (أي القرآن) بغير مراء نقطة التشكُّل الأولى في الإسلام، أعنى نقطة التشكل التوجيهي معرفياً وفكرياً؛ ومن أغرب الغرائب أنها هى هى نفسها النقطة التي اتخذها السياسيون ومَنْ دانوا لهم من فِرَق ومذاهب وطوائف، ذريعة لاحتكار السّلطة وتعصُّباً للمذهب والطائفة والفِرْقة.
ثم هى عينها "النقطة" التي سَمَحَتْ باختلاف وجهات النظر واختلاف الرؤى واختلاف درجات التخريج وحالاته من منهج لمنهج ومن رؤية لرؤية.
فإذا أردنا لأنفسنا توحيداً للمواقف المتفرقة التي زعمت الهداية والإرشاد إلى الحقيقة الدينية، وأردنا أن نجمِّع بين متفرقاتها، وأردنا أن نلمَّ شعث التَّمزُّق الفكري الذي سبَّبته تلك المذاهب والاتجاهات والفِرق المتصارعة على امتداد التاريخ، ثم أورثت الأجيال بعد الأجيال تمزُّقها المذهبي وتشتتها الطائفي وتفرُّقها إلى شراذم ضعيفة لا تملك سوى المزيد من الفُرْقَة والخلاف.
أقول؛ إذا نحن أردنا ذلك صادقين؛ كانت وجهتنا الأولى التماس "الوحدة" فيها من تلك "النقطة"، نقطة التشكل الأولى: أعني نقطة الانطلاق من القرآن الكريم، حتى إذا ما كانت البداية من القرآن الكريم، باعتباره النَّصّ التأسيسي المقدَّس، إذْ كان المصدر لنشوء الثقافة الإسلامية وحركاتها الفكرية ومذاهبها الفلسفية برمتها، مع وجود مصادر خارجية بالطبع شكَّلت تلك الثقافات، فلقد كان أولى بنا أن نلتمس "الوحدة" في هذا المصدر ونتساءل: أهو الأقوى والأغلب على تلك الحركات الفكرية التي كانت تتنازع فى الماضي وتتطاحن فيما بينها، فينعكس ذلك بالسلب على اعتقادات المسلمين، وما ينشأ عنها من تمزُّق وتشتت، أم هو الأدنى بعد غلبة المصادر الخارجية: يونانية كانت أم فارسية أم هندية أم يهودية أو مسيحية؟
وفي الغالب - بعد الرجوع إلى تلك الحركات - لن تجد القرآن مع الأسف في مُقدِّمة اهتماماتها، ولن تجده هو الأغلب دائماً، بل هو الأقل في الغلبة؛ إذْ كان بمثابة "التوظيف" السياسي للتوجُّهَات الفكرية لهذه الحركات: ثقافاتُها، ومبادؤها، وأصول مذاهبها، وشرعيتها السياسية، ونفوذها المستمد من ذلك التدعيم السياسي؛ فكانت السياسة لا القرآن هى الغالبة.
لو كان القرآنُ هو هو الأغلب دائماً، لما نشأت أزمات فكرية دينية في القديم ولا في الحديث، ولا كانت هنالك مواقف مرشدة للعقل إلى الحقيقة الدينية في غير إرشاد صادق ولا بيِّنة روحية مستمدة من حضور الوعي بهذا الكتاب، اللّهم إلا إذا استثنينا حالة واحدة، حالة الذين تبتَّلوا في خدمة القرآن وانقطعوا له على الدوام ورأوا فيه كتاب عقيدة خالصة لا كتاب سياسة معوجَّة وسلطة غاصبة.
(وللحديث بقيّة)
بقلم: د. مجدي إبراهيم