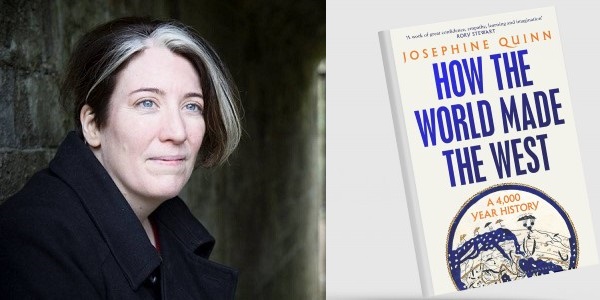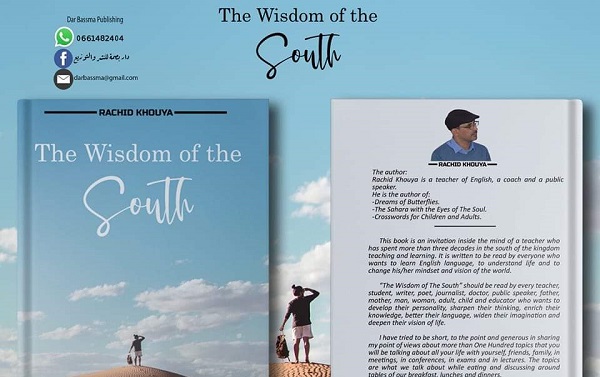صحيفة المثقف
تفكيرٌ في الدّين (9)
 كما يكون الحضور في القرآن مطلبَ علم نظري وعقل مجرّد، يكون كذلك مطلب وجدان صوفي صادر عن القلب، وشعور فياض بالمعاني الباطنة، وبالقيم السامية وبالمبادئ الروحية النبيلة. وعلى هذه الفكرة، وفي إطارها، يُجمل بنا في هذا الصدد مناقشة تلك الوجهة من النظر، وهى التي حمّلها "عابد الجابري" كتاباته في مُدْخَله إلى القرآن؛ مناقشة قد تطول معنا - ولابد منها - ليطول من أجلها هذا المقال فيما لم يكن من المعتاد الذي أردناه أو خططنا له.
كما يكون الحضور في القرآن مطلبَ علم نظري وعقل مجرّد، يكون كذلك مطلب وجدان صوفي صادر عن القلب، وشعور فياض بالمعاني الباطنة، وبالقيم السامية وبالمبادئ الروحية النبيلة. وعلى هذه الفكرة، وفي إطارها، يُجمل بنا في هذا الصدد مناقشة تلك الوجهة من النظر، وهى التي حمّلها "عابد الجابري" كتاباته في مُدْخَله إلى القرآن؛ مناقشة قد تطول معنا - ولابد منها - ليطول من أجلها هذا المقال فيما لم يكن من المعتاد الذي أردناه أو خططنا له.
مناقشة لا بد منها:
وربما تفْرِض علينا هذه المناقشة أن يطول معنا هذا المقال على غير المتوقع، وكان لا بد منها، وبخاصة أنها تتصل بالقرآن كونه معجزة روحية عقلية معاً؛ إذْ كان النظام الروحي هو بمثابة أساس التهذيب وأساس قواعد الخُلق. ولا ريب جاء حضور القيم في القرآن العزيز، مطلق القيم ومطلق الخُلق الكريم؛ ليشكل معجزة روحية تضاف إلى المعجزة العقلية بما من شأنه أن يكشف عن الذاتية الخاصّة للقرآن.
فإذا كان هناك وجهتين للنظر: الأولى تعتبر القرآن علاقة حميمية مع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه: علاقة يومية بل لحظية، وهذا صحيح، ولكنها بقيت تتحرك دوماً في حدود المعقول. وأنه ليس في الإسلام ما من شأنه أن يجعل المعرفة بالدين تقع خارج تناول العقل. وإنه؛ إذا وجد هذا الإيمان "بالأسرار" (Mysteres) في كل دين، فكان من ضمن خصوصياته في كل الثقافات، فلن يكون موجوداً في الإسلام؛ إذْ كانت حياة الرسول وتعاليم الكتاب موضوعاً مفتوحاً لإعمال العقل. فهذه التقريرات فيها الخطأ وفيها الصواب، والصواب محمولٌ فيها على توجُّه بعينه يأتي من جنس الحق الذي يُراد به باطل، والاجتهاد الذي يعوزه الإنصاف. ومن أجل ذلك، فرضنا في هذا المقال تلك المناقشة الطويلة.
أقول؛ إذا نحن أردنا مناقشة هذه الوجهة من النظر فأول ما يتبادر إلى الأذهان منها أنها وجهة ليس من حقها أن تلغي تماماً - كما أراد لها الجابري - وجهة النظر الأخرى التي تكملها ولا تناقضها.
بادي الرأي عندي: تأخذ بالأساس الروحي الذي تقوم عليه الحضارة الإسلامية برمتها كما صَوّرها القرآن الكريم. وجهة النظر الأولى تقوم على العقل، لكن "العقل" مع ذلك محدود، والمعارف العقلية ليست كل شيء في القرآن.
ولم يكن العقل المنطقي الاستدلالي الذي يريد الجابري أن يُعْمِلَه في القرآن كافياً بغير معالجة العقل البصيري المتمم له، والمكمّل لنقصانه، والمُسدّد لقصوره عن الإحاطة بملكات الإنسان المعرفية تتوزّع فيها الطاقات الباطنة، مُفرزةً القيم التي تغذي الإنسان بالمُضيّ قدماً نحو ربط الدنيا بالدين، والمسير بالمصير.
ولم يكن العقل في الإسلام بالمعزول عن القيم الحضارية كما صَوّرها القرآن لأنه لم يكن عقلاً منطقياً محدوداً بحدود ما يُفكّر فيه، ولم يكن عقلاً حداثياً يعالج حقبة زمنية أو فترة من فترات التاريخ المحدود بحدود ما فيه من ظواهر فكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية وعلمية أو ما شئت أن تضيف...، ولكنه كان عقلاً مفتوحاً، يعطي المبدأ المُطلق للإنسان بالأخذ به في كل مناشط الحياة، ولا يقيّده عن النظر والبحث، ولا يغلُّه عن الحركة، وإنْ كانت الحركة في إطاره محدودة بحدود المساحة المعرفية التي يتحرك فيها. فالعقل في القرآن ليس هو العقل الذي أراده "الجابري"؛ ليكون موظفاً يخدم اتجاه كان تبناه؛ ليلغي سائر الاتجاهات الأخرى التي تكمله ولا تنفيه.
كتب المرحوم الدكتور هيكل - طيّبَ الله ثراه - في خاتمة كتابه "حياة محمد" بحثاً ممتازاً مطولاً بعنوان "الحضارة الإسلامية كما صوّرها القرآن"، هو من أروع وأمتع ما قرأت من بحوث، لست أجدُ بدّاً من الاستدلال به؛ كقيمة معرفية كبرى، تجيء في إطار هذه المناقشة؛ لتكون وثيقة بالغة الأهمية، شاهدة - بعد فيضٍ لا يُجَارَىَ من الوثائق التاريخية والعلمية المُمَحَّصَة التي اعتمد عليها في هذا الكتاب - على أصالته العلمية، وأصالة الرأي الذي انتهي إليه. ففي الصفحات الأولى منه مقارنة بين الأساس المادي للحضارة الغربيّة التي عزلت منطق العقل عن منطق الشعور والوجدان، واكتفت بالعقل المنطقي الاستدلالي أو منطق العقل المُجرَّد ومقررات الواقع كيما تعتمد فقط على الملاحظة المادية أو ما يُسمى لاحقاً بالتجريبية العلمية، وبين الأساس الروحي للحضارة الإسلامية. فالأساس الذي قامت عليه هذه الحضارة غير الأساس الذي قامت عليه تلك الحضارة؛ ولسوف نعتمد على هذا العنصر في مناقشتنا لمحمد عابد الجابري؛ لأنه بتلك العبارات السابقة طمَسَ المعجزة الروحيّة للقرآن أو خُيِّل إليه أنه يطمسها، وَعَدَّها عقلية فقط تجعل المعرفة بالدين لا تقع خارج حدود العقل.
خَلّف مُحَمدٌ - هكذا يقول الدكتور هيكل - هذا الميراث الروحي العظيم الذي أظلَّ العالم ووجَّه حضارته عدّة قرون مضت، والذي سيُظلُّه من بعدُ ويوجّه حضارته حتى يتمُّ الله في العالم نوره. وإنما كان لهذا الميراث كل هذا الأثر فيما مضى، وسيكون له مثله وأكثر منه من بعدُ؛ لأنه أقَامَ دين الحق ووضع أساس حضارة هى وحدها كفيلة بسعادة العالم. والدين والحضارة اللذان بلّغْمُهَا محمد للناس بوحي من ربه (القرآن) يتزاوجان حتى لا انفصال بينهما؛ ولئن قامت هذه الحضارة الإسلامية على أساس من قواعد العلم وهدى العقل، واستندت في ذلك إلى ما تستند إليه الحضارة الغربية في عصرنا الحاضر؛ ولئن استند الإسلام من حيث هو دين إلى التفكير الذاتي، وإلى المنطق التجريدي (الميتافيزيقي)؛ فلا تزال الصّلة في الإسلام مع ذلك وثيقة بين الدين ومقرراته والحضارة وأساسها (ص: 516).
إنّ حضور القرآن لإبراز تلك الصّلة؛ لهو الذي شَكَّل خصائصها وميزها عن الحضارة الغربية بخصائصها وسماتها التي ترتكز عليها، ولا ترتكز عليها حضارة الإسلام تقوم على حضور القرآن فيها. واختلاف الأساس الذي تقوم عليه كل حضارة ينقض فيهما المطالب والغايات. إنّ الإسلام ليربط بين التفكير المنطقي والشعور الذاتي، وبين قواعد العقل وهدى العلم، برابطة لا مفرّ لأهله من البحث عنها والاهتداء إليها؛ ليظلوا مسلمين وطيداً إيمانهم. وحضارة الإسلام تختلف من هذه الناحية عن الحضارة الغربية المتحكمة في العالم إلي اليوم، كما تختلف عنها في تصوّر الحياة وفي "الأساس" الذي يقوم هذا التصور عليه. وهذا الاختلاف بين الواحدة والأخرى من هاتين الحضارتين جوهرىُّ إلى الحدِّ الذى يجعل أساس كل واحدة منهما نقيض الأساس الذي تقوم عليه الأخرى.
فقد أدّى النزاع في الغرب المسيحي بين السلطتين الدينية والزمنية أو بين الكنسية والدولة إلى الفصل بينهما، وإلى إقامة سلطان الدولة على إنكار سلطة الكنيسة. وكان لهذا النزاع على السلطان أثره في التفكير الغربي كله. وفي مقدمة النتائج التي ترتبت على هذا الأثر ما كان من تفريق بين الشعور الإنساني (منطق الوجدان) والعقل الإنساني من جهة، وبين منطق العقل المجرَّد ومقررات العلم الواقعي المستندة إلى الملاحظة المادية. وكان لانتصار التفكير المادي أثره البالغ في قيام النظام الاقتصادي أساساً رئيسياً للحضارة الغربية.
هذا هو أهم مَعْلَم حَدَثَ في الغرب، لكنه لم يحدث على الإطلاق في الإسلام؛ إذْ ليس في الإسلام فصلٌ بين الشعور الإنساني والعقل الإنساني العام، وبين منطق العقل المُجَرَّد ومقررات العلم الواقعي، يستند على الملاحظة المادية.
والقرآن نفسه لا يسمح بهذا الفصل التعسفي ولا يحيل العقل الإنساني إلى مجرد آلة مادية تعبد كأنه وثن كما يحدث في التفكير الغربي. ولم يقم فيه كما قامت في الغرب المذاهب المادية تريد أن تجعل كل ما في عالمنا خاضعاً لحياة هذا العالم الاقتصادية. لم يكن في الإسلام، ولا في القرآن، ولا في الحضارة الإسلامية المؤسسة على حضور القرآن فيها ما كان في الغرب حين أراد غير واحد أن يضع تاريخ الإنسانية كلها في أديانها وفنونها وفلسفاتها وتفكير رجالها وعلومها، بوحي ما كان من مدّ وجزر اقتصادي في أممها المختلفة.
ولم يقف أمر هذا التفكير عند التاريخ وكتابته، بل أقامت بعض مذاهب الفلسفة الغربيّة قواعد الخُلق على أسس نفعية مادية بحتة. ومع ما بلغته هذه المذاهب من براعة في التفكير وقوة في الابتكار، لقد أمسكها التطوُّر الفكري في الغرب في حدود المنفعة المادية المشتركة، تُقيم عليها قواعد الخُلق جميعاً، وترى ذلك من المقتضيات المحتومة في البحث العلمي.
فأمّا المسائل الرُوحيّة فهى في نظر الحضارة الغربية مسألة فردية صِرفة، فلا محلَّ لأن يُعنى الناس أنفسهم جماعة بها. ومن ثمّ كانت الإباحة في العقيدة بعض ما قدّسه أهل الغرب، وكانوا أشدّ تقديساً لها من تقديسهم الإباحة في الخُلق، وهم أشدُّ تقديساً للإباحة في الخلق منهم لحرية الحياة الاقتصادية المقيدة بالقانون تقييداً ينفذه الجندي وتنفذه الدولة بكل ما أوتيت من قوة (ص: 517). ومن الصحيح أن نعتقد، وأن يكون هذا الاعتقاد متجذّراً سارياً في ضمائرنا: أن حضارة تجعل الحياة الاقتصادية أساساً، وتقيم قواعد الخُلق على أساس هذه الحياة الاقتصادية، ولا تقيم للعقيدة وزناً في الحياة العامة، تقصُر عن أن تمهد للإنسانية سبيل سعادتها المنشودة. بل إنّ هذا التصوير للحياة لجدير أن يجرّ على الإنسانية ما تعانيه من محن في هذه العصور الأخيرة. جدير أن يجعل كل تفكير في منع الحروب وفي توطيد أركان السلام في العالم قليل الجدوى غير مرجو الفائدة. (وللقارئ أن يلاحظ هذه النظرة الاستشرافية فيما بين سطور الكاتب ويقارن بموضوعية بينها وبين ما نحن عليه الآن، والقارئ مرجوُّ أن يأخذ هذا بعين الاعتبار).
فما دامت صلتي بك أساسها الرغيف - لا القيم العلوية - الذي آكل أنا أو تأكل أنت وتَنَازُعُنَا عليه ونضالُنا في سبيله، قائمة بذلك على أساس القوة الحيوانية في كلِّ منَّا، فسيَظلُّ كل منَّا يرقب الفرصة التي يُحسن فيها الاحتيال للحصول على رغيف صاحبه، وسيَظلُّ كل منَّا ينظر للآخر على أنه خصمه لا على أنه أخوه، وسيَظلُّ الأساس الخُلقي الكمين في النفس أساساً حيوانياً بحتاً، وإنْ بقى كميناً حتى تندفع الحاجة إلى ظهوره. وستظلُّ المنفعة وحدها قِوام هذا الأساس الخلقي، على حين تنزلق عليه المعاني الإنسانية السامية والمبادئ الخُلقية الكريمة: مبادئ الإيثار والمحبة والأخوَّة، فلا يكاد يمسكها ولا تكاد تعلَق به (ص: 518). وما هو واقع اليوم خيرُ مصداق عملي على تلك السيطرة المادية؛ فالتنافس والنضال هما المظهر الأول للنظام الاقتصادي، وهو بدوره أول مظهر لحضارة الغرب. وما دام التنافس والنضال على المال هما جوهر الحياة، ومادام النضال بين الطوائف طبيعياً، فالنضال بين الأمم طبيعيُّ كذلك، وللغاية التي يقع من أجلها نضال الطوائف. ومن ثمّ كانت فكرة القوميات أثراً محتوماً بحكم الطبيعة لهذا النظام الاقتصادي. أمَا ونضال الأمم في سبيل المال طبيعيُّ، أمَا والاستعمار لذلك طبيعيُّ أيضاً (بشتى ألوان الاستعمار وبكل أشكاله الجديدة) فكيف يمكن أن تمتنع الحرب ويستقر السلام في العالم؟!
إنمّا السلام في عالم هذا أساس حضارته حُلم لا سبيل إلى تحقيقه، وأمنية معسولة، ولكنها سرابٌ كذوب.
تلك هى - كما ترى - ثمار الحضارة الغربية على طول تاريخها. وتلك هى ثمار غرسها وسيطرتها على أرجاء هذا العالم الحيران، تقوم على الأساس المادي، وتجعل النظام الاقتصادي أول المظاهر الذي يُحقق للإنسانية الخير والتقدُّم (لاحظ العلاقة اليوم بين أمريكا والصين وقارن).
ولم تكن حضارة الإسلام تتأسس على هذا الأساس، ولم يكن تصوّرها يخرج عن حضور القرآن الفاعل فيها، أو يخرج عن حضور تعاليمه الخلقية والروحيُّة المقرّرة لربط الدين بالحضارة لا باتجاه النظر إليه معزولاً عن الفعل والعمل والتأثير، ولا عن المبدأ العقدي الموصول دوماً بتغذية قيم "الوجود الروحي" في الإنسان على التعميم.
القرآن معجزة عقلية روحية معاً:
لم يكن "الجابري" الذي وضع القرآن تحت سيطرة العقل المنطقي الاستدلالي أو التجريبي الواقعي وجَرّدَه بالمطلق عن قيمه الروحيّة، وجعل الأول يدور في فلك الثاني، ففصل الشعور عن منطق العقل بهذا المفهوم؛ بالذي يعي خطورة هذا كله، أو هو قد وعاه ولكن تجاهل خطورته، ولا كان بالذي يدرك الأساس الروحي والخلقي للحضارة الإسلامية تقوم عليه. ولم يكن القرآن - بادي الرأي عندي - معجزة عقلية وكفى، ولكنه معجزة عقلية روحيّة معاً:
تقوم الحضارة الإسلامية على أساس هو النقيض من أساس الحضارة الغربية، فإذا كان أساس الحضارة الغربية يتقرَّر فلسفياً وفق قواعد الخُلق على أسس نفعية مادية بحتة، فأساس الحضارة الإسلامية يقوم على ذلك الأساس الروحي، يدعو الإنسان إلى حُسن إدراك صلته بالوجود، ومكانه منه قبل كل شئ. فإذا بلغ من هذا الإدراك حدِّ الإيمان، دعاه إيمانه إلى إدامة تهذيب نفسه وتطهير فؤاده، وإلى تغذية قلبه وعقله بالمبادئ السامية: مبادئ الإباء والأنفة والأخوّة والمحبة والبر والتقوى.
وعلى أساس هذه المبادئ ينظّم الإنسان حياته الاقتصادية. هنا يكون "القرآن" هو الفاعل المؤسس لهذا الأساس الروحي للحضارة الإسلامية؛ فإنّ هذا التدُّرج هو أساس الحضارة الإسلامية، وأساس القيم العلوية فيها كما نزل الوحي بها على محمد، وكما تقرّر في القرآن الكريم. فهى، من أجل ذلك، حضارة رُوحيّة أولاً. والنظام الروحي فيها - لا النظام الاقتصادي - هو أساس التهذيب وأساس قواعد الخُلق. والمبادئ الخُلقية هى أساس النظام الاقتصادي، فلا يجوز أن يُضحىَّ بشيء من مبادئ الخلق في سبيل التنظيم الاقتصادي.
هذا التصوير الإسلامي للحضارة هو باليقين التصوير الجدير بالإنسانية، الكفيل بسعاتها بلا شك. ولو أنه استقر في النفوس، وانتظم الحياة انتظام الحضارة الغربية اليوم إيَّاها، لتبدّلت الإنسانية غير الإنسانية، ولانهارت مبادئ ساقطة يؤمن الناس اليوم بها، ولقامت فيهم مبادئ سامية تكُفل معالجة أزمات العالم الحاضر على هدى من نورها.
والناس اليوم، بل وفي كل يوم في كل زمن، في الغرب والشرق، يحاولون حَلّ هذه الأزمات دون أن يتنبَّه أحدُ منهم، ودون أن يتنبَّه المسلمون إلى أن الإسلام كفيلُ بحلّها، فأهل الغرب يتلمسون اليوم، وكل يوم، جدّة روحيّة تنقذهم من وثنية تورطوا فيها، وكانت سبب شقائهم، وعِلّة ما ينشب من الحروب بينهم، تلك عبادة المال. وأهل الغرب اليوم يتلمّسون هذه الجدّة في مذاهب الهند والشرق الأقصى على حين هى قريبة منهم، يجدونها مقرّرة في القرآن، مصوّرة خير تصوير فيما ضربه النبي العربي للناس من مثل أثناء حياته (ص: 519).
وعلى كل هذا الذي تقدَّم، وأبعد من هذا الذي تقدَّم، فكما يكون القرآن معجزة عقلية، يكون كذلك لا أقل من ذلك بل أبعد منه، معجزة روحيّة فيها الشفاء من الشقاء:" ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى". وفيها الإخلاص والنقاء والتسليم لله الواحد الأحد إنْ في الفكر وإنْ في العمل. وهذا التسليم نفسه هو المنقذ من ضلال الوثنية. هذا التسليم هو عينه الطمأنينة القلبيّة، تنتج عن المعجزة الروحيّة للقرآن، حين يتذوقها قلب المؤمن بالله كما أنزلها الله. فقد ضمن الله، وفي ضمان الله منجاة، للذي يجاهد في سبيله أن يساعده بالهدى إلى سبيله:"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبُلنا". وإنه ليغير حال الناس حين يغيروا ما بأنفسهم، وأنه لا يغير ما بهم حتى يغيروا ما بأنفسهم:" إنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".
هذان النَّصّان يوضحان لنا العلاقة بين الجهد البشري يبذله الناس، وعون الله ومدده الذي يسعفهم به، فيبلغون به ما يجاهدون فيه من الخير والهدى والصلاح والفلاح.
وعلى أساس هذه القيم الروحيّة قامت الحضارة الإسلامية: على الدين كما يصوّره القرآن لا كما يُستقى الدين من مصادر خارجة عنه ليست داخلة فيه. فإرادة الله: مصدر الطمأنينة القلبية، ومصدر التسليم بقضائه وقدر، هى الفاعلة في النهاية. وحضورها في قلب الفاعل المؤمن بالله هو الذي يجعل القرآن الكريم معجزةً روحيةً تضافُ إلى المعجزة العقلية أيضاً بما يشكل الذاتية الخاصّة للقرآن.
وبدون إرادة الله لا يبلغ الإنسان بذاته ولا بطاقته العاملة وحدها، ينفقها في العمل المتواصل شيئاً، ولكن هذه الإرادة تعين من يعرف طريقها، ويستمد منها العون، ويجاهد في الله ليبلغ رضاه. وقدر الله مع ذلك كله هو الذي يحيط بالناس وبالأحداث، وهو الذي يتم وفقه ما يتم من ابتلاء ومن خير يصيبه الناجحون في هذا الابتلاء.
هناك المجاهدة مقرَّرة سلفاً لا مناص منها، وموزّعة على جميع المستويات التي تحملها الطاقة البشرية، سواء جهاد النفس أو جهاد الأعداء، الجهاد الداخلي (الأكبر) أو الجهاد الخارجي (الأصغر). هذه بديهة أولى ثم يتلوها الإيمان بالفعل الإلهي وبالقضاء الإلهي وبقدر الله من خلف حجاب السّبب.
في إطار هذا التصوّر يتحرَّك الفعل الإنساني ويتصل العمل بروابطه المصيرية وبأصالته الشعورية إنْ في النفس وإنْ في الضمير. ولم يكن التعقيب الذي جاء على غزوة أحد حين أرادت حكمة الله أن تكشف عن نفسها من وراء الابتلاء كله، فتبيّن أسباب النصر وأسباب الهزيمة؛ ليسطع فيها تدبير الله كذلك من وراء النصر والهزيمة:"ولقد صدقكم الله وعده إذْ تحسُّونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبُّون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثمَّ صَرفَكم عنهم ليبتليَكم".
أقول؛ لم يكن هذا التعقيب الذي يُقرر حكمة الله في هذا الموطن إلا للتعريف بسُّنةٍ الله الشاملة، ومردّها في النهاية إلى مشيئته الطليقة وقدره النافذ في الأشياء والأحداث، ومن وراء الأسباب والوقائع.
ليس يمكن للجهد البشري، ولا للطاقة الإنسانية أن تريد ما لا يريد:" إنْ يمسسكم قرحُ فقد مَسَّ القوم قرحُ مثله، وتلك الأيام نداولُها بين الناس، وليعلم الذين آمنوا، ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وليمحِّصَ الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين". لم يكن سوى تدبير الله ومشيئته وقدره؛ ليتمّ ما يريده من وراء الأسباب والأحداث، ومن خلف حجاب السبب، وهو الأمر الذي لا يسأل عنه سبحانه؛ لأنه شأنه الإلهي الذي لا يُسأل عنه. وتلك هى حقيقة الإيمان الكبرى التي لا يتم في النفس إلا باستقراره فيها، واطمئنانها إليه من طريق حضور القيم القرآنية، وتفعيل النفس لها، وتوليها بالرعاية والعناية لحقيقة الفعل الإنساني يتحرك في إطارها حتى إذا ما لزمت المجاهدة المقرِّرة للنشاط الإنساني، وتأكد العمل بمقتضاها، فقد يلزم عنها بالضرورة التوجُّه بالمباشرة إلى وحدة القصد على الإيمان بالمبدأ العقدي، وعلى التسليم بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو عز وجلَّ "الفاعل" على الحقيقة من وراء الأحداث والوقائع: من خلف حجاب الأسباب.
فكما يكون العمل العقلي مقرّراً في القرآن الكريم، وكما يكون أمراً من أوامره، يكون التعلق بالبصيرة النورانية الكاشفة أساس الإيمان بالله، ويصبح قلب المؤمن على أساس هذا الإيمان مُلآناً بالمعرفة المستنيرة بنور الله قصداً؛ فلم يكن "العقل" على هذا الأساس بمعزل عن نور القلب، ولم يكن نور القلب بالذي يدفع حركة العمل العقلي أو يخاصمها؛ ليفصل الإنسان فصلاً تعسفياً أو ليشطره شطراً مبالغاً فيه بين الشعور والوجدان وبين "العقل" بمفهومه المقرّر الثابت في القرآن.
إنّ عزلاً كهذا العزل لا يقيم بناء الإنسان الروحي، ولا يرقى من قيمه الباقية النافعة، فضلاً عن أنه لا ينهض دليلاً شاهداً على قيام الحضارة الإسلامية على هذا الأساس الروحي الذي لا تقوم في القرآن إلا عليه. إنما القيم الدينية العلوية؛ كالتوكل، واليقين، والتقوى، والصبر، والعزيمة، والصدق، تخرج عن مشكاة النور القلبي كما هى ظاهرة الوجود في القرآن؛ لأنها تمثل كونه بالإضافة إلى المعجزة العقلية معجزة روحيّة تشكّل للقرآن ذاتيته الخاصّة، وتبني في الإنسان قيمه الأصيلة؛ لتهيئه لاكتشاف باصرته التي هى فوق طور العقل المحدود وفوق طور المعقول.
وإذا كان "الجابري" قد تعامي عما في القرآن من معجزة روحيّة كانت هذه بعض سماتها وخصائصها، فقد عاد فقال في خاتمة المدخل: التعريف بالقرآن ما نصّه:
"قلتُ في مستهل هذه الفقرة إنّ ما يميز الإسلام، رسولاً وكتاباً، هو خلّوه من ثقل "الأسرار" (Mysteres) التي تجعل المعرفة بالدين تقع خارج تناول العقل، وعليّ أن أعترف الآن أن هناك سراً لم يستطع عقلي اكتناه حقيقته: إنه هذا الذي عبرنا عنه "بالعلاقة الحميمية" بين الرسول محمد عبد الله وبين القرآن الحكيم" (ص: 433). وفي تقديري أنا، أن هذا الذي لم يستطع عقل "الجابري" اكتناه حقيقته هو بلا شك حدّ التصوف: المعجزة الروحيّة التي تجاهل وجودها في القرآن، وتغافل عامداً عنها.
لم ينظر "الجابري" إلى القرآن نظرة مجملة، محيطة شاملة، ولكنه نظر إليه نظرة قاصرة متجزئة بقصور ما في العقل المحدود وتجزؤ ما فيه من مدراك محدودة ووقف عند هذا الحد لا يتعداه، ولا يريد أن يتعداه، وهجم على من يدرك فوق إدراكه، هجوم التجهيل والسخرية ثم الاستخفاف بالقيم الروحية وإنكارها في مواضع عدة من كتاباته كما فعل في "العقل الأخلاقي" أو في "بينة العقل العربي"، خدمة لاتجاه محدود بحدود ما ينظر فيه. والأدهى من ذلك كله أنه يحملها على القرآن فلا تفترق النظرة الضيقة المتحجرة عن محمولها، ولا تقتصر على الفهم الذي فهمه هو من القرآن وكفى.
وبديهيٌ أن تكون نظرة الجابري ضيقة متحجرة كذلك إزاء التصوف في الإسلام. ومعلومٌ أن كتاباته ترفض "العرفان" رفضاً قاطعاً، وتتخذ لنفسها مسحة نقدية ظاهرة موصولة النسب بالاتجاهات السلفية بمقدار ما تتخذ من النقد الهدّام بصدد التصوف قيمها ومنطلقاتها.
التشدد العقلي كالتشدد السّلفي سواء!
لا فرق فيما بينهما من تحجير الرأي والرؤية، نظرة قاصرة لا تعوّل كثيراً ولا قليلاً على محاولة الفهم لتلك النوازع الوجدانية الخاصّة بتوجهات الصوفية. وبما أن التصوف اتجاه مضاد بطبيعته لاتجاه الجابري العقلاني، فقد صارت النزعة العقلية المفترض فيها أن تكون عميقة وشاملة ومحيطة تنقلب من فورها تحت عشوائية النقض الرافض الهدام إلى سذاجة خالصة في اللامدرك من مفاهيم وتوجهات الحياة الروحية في الإسلام.
لقد لاحظنا فيما تقدّم أنه يقول إنّ العلاقة بين النبي والقرآن علاقة حميمية، وصفها بأنها "علاقة يومية بل لحظية". وهو عندي وصف صحيح لا يمكن إنكاره؛ لأنها بالفعل علاقة لحظية بل هى علاقة "رُوحيّة" لا وصف لها ولا حدِّ تنتهي عنده. ولكن ليس من المقبول أن يقول في سياق العبارة نفسها عن تلك العلاقة:"ولكنها بقيت تتحرّك دوماً في حدود المعقول، بل كان ذلك في إطار الطبيعة البشرية للرسول".
كيف هذا؟ ماذا تقول يا رجل؟ هذا التصوّر ضد العقل نفسه، وضد محدوديته، وهل يمكن في طاقة العقل أن يستوعب عمل الوحي؟ وهل كان العقل أساساً هو الوحي؟ وهل الوعي العقلي هو نفسه الوعي النبوي الصادر عن مشكاة الوحي؟ ما هذا التخليط والتخبيط؟
لكأنه يعزُّ عليه أن يصفها (العلاقة) وصفاً روحياً يخالف اتجاهه العقلي مع أنه يراه واضحاً أمامه بما لا مزيد عليه. ثم يقول الجابري متابعاً:" لم يحدث قط أن تحدّث القرآن عن محمد بن عبد الله بما يُشعر أنه من طبيعة غير بشرية: لقد امتدح خُلقه وقيادته، وفي نفس الوقت سجل عليه ملاحظات ومؤاخذات وواجهه بأسئلة فيها لوم وعتاب، ولم يتردد في استعمال عبارات من قبيل "عفا الله عنك لمَ أذنت لهم حتى يتبيّن الذين صدقوا وتعلم الكاذبين" ممّا جاء في سورة التوبة (آية: 43). (مدخل إلى القرآن: ص 430).
وواضح جداً مقدار الكزازة المعرفية والعطب الروحي في التعامل مع القرآن، يقرأه كما يقرأه المستشرقون قراءة مفقودة الذوق خالية منه، مُجرَّد نصّ يخضعه للنظر العقلي المباشر، ويعزله عن مقتضيات الشعور الديني؛ لتكون الآيات في إطاره مجرد عبارات مستعملة من قبيل الملاحظات والمآخذ، كأنه ينظر في نص بشري يجري عليه العمليات النقدية. أفئن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على فقدان الذوق والحماسة الروحيّة والكمون في دائرة محدودة، دائرة المنطق العقلي الاستدلالي يرجع إليها ولا يرتفع فوقها ويظل يلف ويدور في محيطها.
لقد صَرّح "الجابري" أن القرآن لم يكن يُفْرط في مدح الرسول وامتداح مواقفه، بل كان ذلك يتم في إطار الطبيعة البشرية للرسول، وهل قال أحدٌ أن محمداً إله؟ لكن هذا في المجمل صواب جداً فيما لو فهمت العبارات في حدودها وفي مستواها اللفظي الدال على معناها لا فيما تحتها ممّا يريد الجابري أن يحملها ما لم تحتمل. ربما يريد - وهذا واضح - أن ينكر ما جاء في مذاهب الفكر الإسلامي ممّا هو الحال عند الشيعة أو عند الصوفية القول: بقدم النور المحمدي، ولا يعتد أبداً بالأحاديث الواردة في هذا الشأن مثلما كان الحنبلي المتشدّد ابن تيمية (ت 728هـ) وأضرابه ينكرونها؛ فحديث جابر بن عبد الله الأنصاري حين سأل النبي عن أول ما خَلق الله، فقال صلوات الله وسلامه عليه في حديث طويل:"نورُ نبيك يا جابر". وحديث:"كنتُ نبياً وآدم بين الماء والطين"، قال فيه ابن تيمية لا أعرف له أصلاً والصحيح:"كنتُ نبياً وآدم بين الماء والجسد". وجاء في طبقات ابن سعد قوله صلوات الله عليه:"كنتُ أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث". وعن أبي هريرة مرفوعاً: "كنتُ أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث". وصَحَّ عن ابن عباس - ممّا جاء من كتاب ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري في شرح حديث البخاري - أنه قال:" أوحى الله تعالى إلى عيسى، عليه السلام، يا عيسى: آمن بمحمد ومُر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولا آدم، ما خلقت الجنة والنار، ولولا محمد ما خلقتُ العرش. ولقد خلقتُ العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله, فسكن". وقال السّبكي بعد ذكر حديث آدم الذي جاء فيه:" أسألك بحق محمد أن تغفر لي، وقوله تعالى، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك". هذا حديث صحيح الإسناد، رواه الحاكم.
وعليه؛ فجميع هذه الأحاديث وغيرها الكثير تثبت قدم النور المحمدي وتثبت الحقيقة المحمدية وأوليّة النور المحمدي ولا تقدح في بطلان القول بها. ولكن مقدار التشدد السّلفي هو نفسه مقدار التشدد العقلي بالنظر إلى تلك الجهة: التقوقع والانغلاق والتحجير وعدم السماح للأفاق العقلية أن تستوعب ما سواها، مع القطع عندي بالفروق الجوهرية الفارقة بين مذاهب الشيعة وتوجهات الصوفية الروحيّة. أنا شخصياً لستُ منكراً وجود توجهات روحية في الإسلام تدور في هذا الإطار، ولست منكراً كذلك خروجها أحياناً بالمغالاة عن حدود النظر العقلي، لكن وجودها لا يستند على ترهات أو خرافات بمقدار ما يستند على قناعات عقلية وتوجهات ذوقية لا يمكن تجاوزها في سياق النظر إلى الآيات القرآنية، وفي إطار كون القرآن الكريم معجزة روحيّة.
بالطبع؛ أنا لا أناقش هنا مسألة قدم النور المحمدي ولا الحقيقة المحمدية، وليس هذا المقام موضع مناقشة هذه المسائل، ولكني أنوّه فقط إلى خصوصياته عليه السلام، تلك التي لا يقاربها غيره من البشر ممّا أنكره الجابري ودعا الناس إلى إنكاره.
فمن غير المقبول أن يقال: إنّ القرآن لم يحدث قط أن تحدّث عن محمد بن عبد الله بما يشعر أنه من طبيعة غير بشرية، ثم يُراد لنا أن نفهم من وراء هذا القول قصور الرؤية كما قصرها الجابري على الناحية العقلية حتى ولو كان في ذهنه أن محمداً عليه السلام لم يكن كالسيد المسيح، منكراً كل التوجهات الروحية في الإسلام. ليس هذا بالقطع هو المبرر لإنكار الجانب الروحي في التفكير الإسلامي والأخذ منه بالعقلاني الذي تتحرك العلاقة الحميمية فيه بين محمد والقرآن في حدود المعقول. مع أن هذا المعقول نفسه يفرض التخريج الذوقي كما يقتضي التأمل وفق مقتضيات الشعور الديني باتجاه النظر إلى الآيات القرآنية.
القرآن يقول: " قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين ". فإذا كان القرآن هو الكتاب المبين فالنور هو سيدنا محمد رسول الله. سماه النور، وسماه السّراج المنير، "وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً". وسمّاه القرآن الإمام المبين:"وكل شئ أحصيناه في إمام مبين". فالحقيقة المحمدية في بعدها الروحي لا بعدها الزمني فقط مُقرَّرة في القرآن بنص القرآن، فلا يكفي أن يقال إنه لم يحدث قط أن تحدَّث القرآن عن محمد صلوات الله وسلامه عليه بما يشعر أنه من طبيعة غير بشرية؛ وهل كان النور والإمام المبين والسراج المنير فضلاً عن الخلق العظيم طبيعة يتصف بها كل البشر أم الصحيح أن يقال أن هنالك خصوصية له صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيه البشر فيها هى لب لباب العلاقة الحميمية بينه وبين القرآن، وهى التي لم يستطع عقل الجابري أن يكتَنِه أسرارها؟!
إذا شئت فانظر في الحديث الشريف من أنه كان صلوات الله عليه يواصل الصوم؛ فأراد أصحابه عليهم السلام أن يواصلوا مثلما كان يواصل؛ فشق عليهم مواصلة الصوم، فنهاهم عليه السلام أن يواصلوا وقال قولته الشريفة: "إنِّي أبيتُ عند رَبِّي يطعمني ويسقيني". وفي معناه أيضاً: "إنَّ لي هيئةُ ليْسَتْ كهيئتكم". فمن المؤكد أن هذه الهيئة النبوية المباركة لها استعداداتها التي لا تتساوي معها استعدادات أحد غيره ممّن تحتملها الطبائع البشرية، ولو كان هذا الغير من صحابته عليهم كرائم الرضوان. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يقول:" إِنَّهُ ليُغَانُ عَلَى قَلْبِي فَاسْتَغفر الله فِي اليَوم سَبْعِيَن مَرَّة"؛ أتراه يستغفره من "غين الأغيار"؟ لا والله بل من "غين الأنوار" يستغفر:
غين الأغيار علائق مادية وكزازات نفسانية تستشعرها الروح الدنيا السفلية على الدوام، يستشعرها البشر كل البشر، ولكن لا تستشعرها الخصوصية النبوية ولا تقارب الوعي النبوي، وغين الأنوار علويٌ هو، فيه تتوتَّر الروح لأنها في حالة عروج دائم، في حاله اتصال مع الله هى نفسها العلاقة الحميمية بين محمد والقرآن، تلك التي لم يستطع عقل الجابري أن يغذوها. وبفراق الجسد للروح تتحرّر من حَبْسها فيه؛ فإنّ الشعور هنا بالفناء يعطي الروح نوراً لترى ما لم تكن تراه وهى حبيسة في أخلاط الكثافة الظلمانية (= غين الأغيار بالتعبير النبوي): كثافة الأجساد التي كانت تعيق رؤيتها وتحيطها بالغشاوة والحجاب.
هذا "الغين" الذي أوجب رسول الله صلوات الله عليه منه الاستغفار لأمته. أمّا استغفاره هو؛ فمن "غين الأنوار" لا من "غين الأغيار"؛ لأن هيئته ليست كهيئة أحد غيره. ولا خصوصيته مع ربه كسائر البشر، فهو يستغفر من غين الأنوار، وهو يواصل الصوم لأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، وليس من حق أحد في خصوصياته مع ربه صلوات الله عليه أن يستوي معه أو يدعي مجرد ادّعاء لا يقوم عليه دليل أن القرآن لم يحدث قط أنه تحدث عن محمد بما يشعر أنه من طبيعة غير بشرية. نعم! هو بشر لكنه ليس ككل البشر، بل كالياقوتة بين الحجر، له خصوصياته مع ربّه، له التعزير والتجليل والتكريم والتوقير بما ليس للبشر أن يكونوا مثله.
د. مجدي إبراهيم