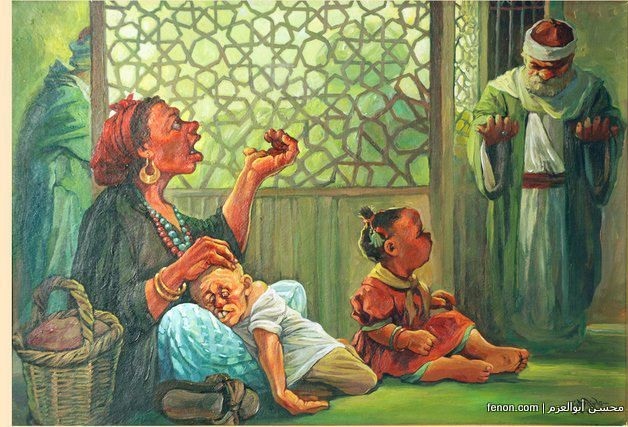صحيفة المثقف
تفكيرُّ في الدِّين (12)
 لم تخل النفس الإنسانية في حظها الوفير من اهتمام القرآن؛ فمباحثها فيه أوسع من أن تحيطها مقالة أو إشارة عارضة أو لفتة عابرة؛ فإنَّ النفس التي سواها الحق، فألهمها فجورها وتقواها، لهى هى التي حظيت بمباحث لا نستوفيها في عبارات عارضة أو إشارات مقتضبة.
لم تخل النفس الإنسانية في حظها الوفير من اهتمام القرآن؛ فمباحثها فيه أوسع من أن تحيطها مقالة أو إشارة عارضة أو لفتة عابرة؛ فإنَّ النفس التي سواها الحق، فألهمها فجورها وتقواها، لهى هى التي حظيت بمباحث لا نستوفيها في عبارات عارضة أو إشارات مقتضبة.
يعطي القرآن ومضات لامعة لجوانب من توجُّهات النفوس، وفي كل ومضة بارقة تستطيع أن ترشدك إلى خصائص تلك النفوس على اختلاف أقدراها؛ فالضالون لهم صفات وسمات، والمؤمنون لهم صفات وسمات، والعالمون لهم صفات وخصائص وسمات، والعاقلون والمتفكرون والسامعون والموقنون وأولو النهي وأولو الألباب وأولو الأبصار، كل أولئك وما دونهم، لهم في القرآن أقدراهم وتوجهاتهم وخصائصهم وسمات نفوسهم في صورة مشخَّصة مرسومة بدقة وكمال.
وأدنى إطلاع على الآيات القرآنيّة يُوحي بالحظ الوفير الذي والاه القرآن اهتماماً بالنفس الإنسانية، وارتقاءً بها إلى حيث معرفة الخالق ومحبته وموالاته. ناهيك عن ضروب التقسيم الذي حَفيّ به القرآن بين نفس أمارة ولوامة ومطمئنة وراضية ومرضية ممّا هو معروف متاح لقارئ الكتاب الكريم؛ فلا يعوّل معوّل على الإهمال وهو معدّ العدة للبحث في جوانب هذا الموضوع.
غير أننا نركز هنا على الخاصّة الذاتية للقرآن، كونها تجعل من تحويل النفس من حال في الحياة إلى حال آخر، خصوصية فريدة؛ لتمضي بها إلى سواء: استقامة عادلة لا تنازع فيها ولا خطوب ولا مصارع تواتيها أو تقف دون موالاتها للحق على التحقيق.
تحويل النفس:
ولم تكن النفس الإنسانية في ملكوت القرآن بالأمر المهمل الذي يسقط معه الإنسان في مستنقع الغفلات؛ فبالقدرة والإرادة يمكنه أن يغلبها فتعليه، وبالخمول والتكاسل والسلبية يسقطها ويدنيها فترديه: هو مالك لنفسه إذا شاء، وتملكه إذا لم تكن لديه مشيئة. ولا ريب في أن غلبة النفس عسيرة، ولكنها إذا جُوهدت وتيسّرت، فكل شيء أمامها مغلوب.
ولمَّا كانت نفوسنا الضعيفة نفوساً خربة تشاء الكسل وتأنف من بذل المجهود، تشاء المتعة وتمتنع عن الإقلاع، تشاء الرذيلة وتمتنع عن الفضيلة، تشاء الرغبة وتمتنع عن الإحجام، تشاء الأكل الكثير والراحة الدائمة والنوم العميق وتمتنع عن مشقة الجوع وألم المشقة وعناء السَّهر، تشاء إتباع الهوى والشهوة والشيطان وتمتنع عن حظيرة الله والاستقامة والإيمان.
لمّا كانت نفوساً هذه أحوالها في الغالب، وكانت تلك أوصافها، فلن يكون خير لها ولن يتم، ما لم يَردُّها صاحبها بعزم الأمور عن بعض ما تشاء. والأصلُ في ذلك كله هو الصبر جهاداً والتحلي تَصَبُّراً بأطيب الفضائل وأكرم الأخلاق.
وتأتي رسالة القرآن لتقول:
ما لم تتحوّل النفس عن ركامها المتراكم الدفين، إلى حياة تتلقَّاها من أعلى، ما لم ترتحل من جسد يطويها وكثافة تشملها، فإنها لن نتحقق أملها المنشود في الخُلاص. فالتغيير الذي يتمُ في الواقع لابد أن يكون قد سبقه تغيير قد تمَّ فعلاً في النفس؛ لأن الواقع لن يغير نفسه بنفسه، فلا مناص من وجود أشخاص غيروا من أنفسهم أولاً، وارتحلوا عن طباعهم ثانياً، فاستجاب لهم الواقع ثالثاً، فحققوا ما كانوا يؤملونه من نشدان الخلاص رابعاً. وتلك هى إحْدى ركائز الذاتية الخاصَّة للقرآن: قدرة التغيير في الواقع بعد التحويل في النفس.
والتعلُّم والاكتساب في البداية هما بالطبع من أهم الصفات المؤهلة لطالب القرآن. التعلم بداية معرفة بأولوَّيات تلك الخاصة الذاتية كما قلنا؛ لأنه اجتهاد وممارسة وسلوك في إطارها يلزم عنها بالضرورة، ويجيء الاكتساب شروعاً في التطبيق لذاته لا لغيره، أي شروعاً في تحويل النفس من مكانها الذي اعتادت أن تقف عنده ولا تتجاوزه؛ ليجيء "التحويل" دليلاً على وضوح السبيل من طريق فهم القرآن:
ولا يتمُّ رَدُّ النفس وتحويلها من حال في الحياة إلى حال إلا بعزم الأمور؛ أي بالصبر الموصوف من قبل طاووس العلماء كأبي القاسم الجنيد: بتجرّع المرارة من غير تعبيس. والصبر كله فضيلة كبيرة هو على الحقيقة "عزم الأمور". لم ترد "عزم الأمور" في القرآن الكريم إلا في ثلاث مرات فقط، ولعَلَّ الدلالة فيها أنها عزيزة لنُدرتها وندرة من يأيتها، هى "الصبر": نصف الدين حقيقة لا مجازاً.
الأولى: في آل عمران:"لتُبلَون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً، وإنْ تصبروا وتتقوا، فإنّ ذلك من عزم الأمور".
والثانية: في لقمان:" يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنْه عن المنكر واصبر على ما أصَابَك, إنَّ ذلك من عزم الأمور". والثالثة: في الشورى:" ولمن صَبَرَ وَغَفَرَ؛ إنَّ ذَلَكَ لمَن عَزَمِ الأمُوُرِ ".
انظر إلى هذه الآيات الكريمة وتدَبَّرها جيداً تجد الصبر في الآية الأولى، صبراً على البلاء في النفس والمال وسماع الأذى ممَّن لا يعرف رقابة الله عليه، فاحتساب ذلك كله من شئون الصبر وأمور التقوى، وتسليم الأمر كله ظاهره وخافيه لله، كل أولئك من العزائم التي لا يأتيها إلا أصحَّاء الضمائر وأصحَّاء القلوب. وفي الآية الثانية؛ ترى الصبر مقترناً بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على المصائب ظاهرها وباطنها، إنمّا هو جهاد ذوي العزم ممّن تخلق بالأخلاق النبويّة، فإنّ من يأتيها يأتي في الوقت نفسه عزم الأمور.
وفي الآية الثالثة؛ ترى الصبر مُفْرَدَاً باعتباره نصف الدين حقيقة كفيلاً وحده لمن تحقق به أن يكون ممَّن عَزَمُوا الأمور، حتى إذا أضيف إليه الغفران من أجل الله وكفى، دَلَّ ذلك من أول وهلة على أن الصبر والغفران وقلة الجزع أو عدمه من خُلق الأنبياء الذين يعرفون أن الأمور كلها بيد الله فيوكلون إليه حالهم ومآلهم ثم يَسَلِّمُون ويحتسبون.
"مصدر الأخلاق الجميلة؛ كما قال الأستاذ "العقاد" في كتابه (الفلسفة القرآنية): هو "عزم الأمور" كما سَمَّاه القرآن وهو مصدر كل خُلق جميل حَثَّتْ عليه شريعة القرآن".
عزم الأمور نيةٌ في القلب خفيّة، وقدرةٌ في المنع قوية، وردٌّ للنفس عن بعض ما تشاء. وليس من شك أن مجاهدة الصابرين تورث غماً، ولكن مَا من غَمّ إلا وفي أطرافه بلاء، والبلاء ضربٌ من الحب إذْ كان الحب ضرباً من تجلى المحبوب.
ولك أن تقرأ قوله تعالى: " لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور". وقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أصبروا وَصَابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون"؛ لتجد في الصبر والمصابرة وفي الرباط والتقوى أمراً يتواصى بتطبيقه المؤمنون؛ لأنه فوق كونه علامة على الهمّة القوية العالية وثبات العزم من جهة، تأكيدٌ على الإيمان من جهة ثانية، ففي الصبر حبس النفس على المكاره، وجهاد الهوى من أجل العبادة. وفي المصابرة قوة تزيد الصبر حتى ليغلب بها الصابرون أعداؤهم. وفي الرباط قيام على الحدود وتأهب للجهاد. والتقوى إيمانٌ بكل هذا؛ وأصلٌ لكل هذا.
والإيمان الحق عزم لا يعرف طريقه إلى خذلان صاحبه إذا كان صاحبه على فضائل الصبر والمصابرة وعلى عزائم الرباط والتقوى، فمتى اقترن الإيمان بثبات العزيمة مقدار اقترانه بتلك الفضائل فهو الفلاح بعينه. وإنك لتجد في قوله تعالى:" وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها"؛ توكيد الأمر بالصلاة وتوكيد الاصطبار عليها طاعة للأمر. والأمر بالصلاة والاصطبار عليها هما معدن الإيمان يتأصل في الوجدان الديني بالكيفية التي يتأصل فيها الشعور بالتبعة.
ولا بقاء عندنا للوجدان الديني ولا قيمة لشعور الشاعر بضخامة التبعات ما لم يكن الأصل في هذا وذاك هو يقين الإيمان بل هو حق اليقين في الإيمان.
الدلالة الجوانية الباطنة:
الدلالة الجُوَّانِيَّة صارمة في فهم القرآن، وهى دلالة تتأتى مؤكداتها في ملكة الوعي: الوعي بالإقبال على الله بصدق، ثم ارتقاء الوعي في الرغبة لفهم كتابه باجتماع هَمِّ هو بالضبط ضد غفلات التعطيل؛ لأن التعطيل في أول مقام ضد الحضور، والحضور كذلك في أول مقام معناه إزاحة القلب عن التعطيل من طريق فعل الهِمَّة، وبقاءَه دوماً في حيوية روحية وحركة فاعلة.
وحضور القلب يأتي ليكون معناه إزاحة التعطيل عن الفهم، حتى إذا ما ثُقِلَ فهم القرآن أو صعب؛ فإنّ مرَدَّ ذلك إلى الوهم الذي يربض غائراً في جوف الوعي تحت ظلمات التعطيل.
هنا أشير إلى شذرة لافتة للانتباه جديرة بكل آيات التأمل؛ هى من شذرات الأستاذ الإمام "محمد عبده"، المجموعة عنه من قِبَل تلميذه رشيد رضا؛ تقول الشذرة المُلفتة للنظر:
"إنَّمَا يُصِّعب القرآن تَوَهُّم أنه صَعْبُ، وكلما أدخل الإنسان على نفسه الصعوبة صعُب عليه، وكلما مَكَّن نفسه من الفهم مكَّنَه اللهُ منه".
ولتلحظ التعطيل هنا كامن في الإنسان نفسه؛ في التَّوهُّم الذي يُحيط به من جميع أقطاره من جهة، ومن جهة ثانية في دخوله الصعوبة على نفسه من أجل تراكم ما استقرَّ في أعماقها من آفاتٍ وأباطيل هى الموانع الصارفة عن الفهم، والداخلة بالإنسان في مزالق التعطيل.
مرة أخرى؛ فإذا ثقل فهم القرآن أو صَعُبَ، لأسباب يستشعرها ذلك الذي يجد في نفسه ثقلاً أو صعوبة؛ فالتعطيل في طليعة هذه الأسباب: تعطيل القلب عن الحضور وعن الفهم:"ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم؛ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون". على أنَّ السماع هاهنا، يترادف مع الفهم، وعدمه أيضاً مرادفُ لعدم الفهم؛ فلو علم الله فيهم خيراَ لأفهمهم؛ ولكنهم لمَّا ضيَّعوا الفهم واستبدلوا به التعطيل؛ ليجيء صارفاً من صوارف الغفلة على عادة التوهم المرذول، كانوا عن الفهم بالقطع الذي لا مرية فيه عاطلين؛ وكانت:"لهم قلوبٌ لا يفقهون بها، ولهم أعينٌ لا يبصرون بها، ولهم آذانٌ لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل؛ أولئك هم الغافلون". فمن تمام الغفلة فيهم أن قلوبهم مقفلة، وعيونهم غير مُبْصِرة، وآذانهم صَمَّة لا يسمعون بها، لأنهم كانوا أغلقوا منافذ السّماع بمقدار ما انطمست لديهم الرؤية وأظلمت على الحقيقة أنوار القلوب.
لقد أُثُر عن "الوليد بن المغيرة" أنه قال حين سمع شيئاً من القرآن: "والله .. إنّ له لحلاوة، وإنّ عليه لطلاوة ...". ونحن نسأل: من أين؟ من أين لك - يا وليد - بهذه الحلاوة وبتلك الطلاوة، وأنت - من بعدُ - لم تسلم، ولم تعتقد عقيدة الرجل الذي نزل عليه هذا القول حين وصفته بالحلاوة وبالطلاوة؟
إنّ الوليد حينما عبَّر عن حلاوة القرآن بهذه الكلمات اللطيفة النافذة؛ كان يتَّجه مباشرة إلى "وحدة القصد" لما في القرآن من تأثير على الشعور والوجدان. وأن سليقته الجُوَّانيَّة الباطنة التي يتغلّب فيها حكم الطبع لم تستطع أن تقاوم "وحدة القصد" الغلابة لوقع القرآن: وقعه على بؤرة الضمير وعلى شغاف القلب، ووقعه على الشعور الدفين وعلى الإحساس بالغيب؛ كلام لا ككل كلام ولا كأي كلام؛ كلام ألفاظه من لغة العرب بيد أن معانيه العجيبة تُميِّزه عن أجناس الكلام البليغ.
هذا الوَقْع ليس شيئاً، لا.. بل هو كل شيء فيه: خاصَّة ذاتية تتجه إلى وحدة القصد بالمباشرة. ولك أن تنظر في قوله تعالى:"والله غالب عَلى أمْرِهِ"؛ لترى وحدة القصد تتحقق بهذه "الغلبة": نفوذ القرآن في الضمائر والقلوب، وفناء ما دونها من مظاهر الغلبة الظاهرة، تلك التي تبدو (أي الغلبة الظاهرة) وكأنها من جنس الغلبة وهى في الحقيقة لا غلبة لها ولا سلطان.
إنمّا الغلبة لله في قوله وفي فعله، وفي كل صفة يتجَلىَ بها على عباده بنسب ومراتب لا يعلمها إلا هو، لكنها على الجملة في حكم الغلبة على وجه التحقيق.
الله غالبٌ على أمره بشرف التجليات الإلهية في حضراته الخمس: حضرة الذات وحضرة الأسماء وحضرة الصفات وحضرة الأفعال وحضرة الأحكام. وكلها حضرات مباركة تعطي قوة الغلبة الظاهرة والباطنة في قوله تعالى:"والله غالبٌ على أمره"؛ فإذا شاء الحق تبارك اسمه أن يعطي مثل هذه الغلبة لكلمته العليا، ويمنع ما سواها أن تكون له على الحقيقة غلبة أو سلطان قال: "ما فَرَّطنا في الكتاب من شيء".
والدلالةٌ فيه صارمةٌ بحكم الغلبة على احتواء القرآن على أصول العلوم والمعارف في كلمته المقدسة:"وَنَزَّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء"؛ ما استثنى شيئاً ولا فاته شيئاً، ولكنه بيَّن كل شيء في كل شيء، وأحصى كل شيء في كل شيء، ثم إنه لهدى، ورحمة، وبشرى للمسلمين.
فإذا وُجدت وحدة القصد في شعور أحد يريد أن يعرف من تجليات المراتب والحضرات الإلهية شيئاً، كان كل ما يريد أن يعرفه من علوم ومعارف مجلى من هذه المجالي الإلهية، وكان كل ما يطلبه من هذه المعارف والعلوم موجوداً في الكتاب:"مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيءٍ".
ذلك هو حكم الغلبة.. وذلك هو هو حكم الإعجاز الباهر الوضَّاء؛ خاصَّة ذاتية لا نَمَلُ من تكرارها أبداً تتجه إلى وحدة القصد بالمباشرة.
أين موطن "الحلاوة" فيما سمع الوليد، وأين موطن "الطلاوة" فيما شَعَر به من قوة هذه الوحدة القصْديَّة في ذلك القول الغَلاَّب؟ ذلك ما لم يقدر الوليد على الإجابة عنه سوى أنه قال: ليس بقول بشر ! (والله .. إنّ له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإن أسفله لمثمر، وما يقولُ هذا بشر..!!).
كل ما هنالك أنه استسلم لحكم السليقة فيما تصيبه السليقة من وقع على الشعور والوجدان، وأن تذوّقه الرفيع مجرد التذوق لمعاني هذا القول الغَلاَّب قد أصاب منه كوامن النفس الصَّفِيَّة وبواطن البؤرة الدفينة في منْبَت الشعور.
لقد اتجه الوليد بالسليقة الذوَّاقة والشعور الوجداني اتجاهاً مباشراً إلى وحدة القصد في القرآن. هذه الوحدة التي تشمل روح القرآن كله، وهى روح عليا، ذاتية خاصَّة له؛ لا توجد في سواه، روح عليا لا وصف لها عندنا ولا حدَّ سوى سِرَّ قوله تعالى:"واللهُ غَاَلِبٌ عَلى أمْره ". لقد قدرَّ وحكم أزلاً أن تكون كلمته تعالى هى العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، وبهذا التقدير الإلهي وبتلك القدرة النافذة، تَسْري حضرات التجليات الإلهية في الكون كله على ما يشاء، وفيما يشاء الله أن يُسْريها: " قُل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي، لنَفدَ البحر قبل أن تنفد كلماتُ ربي ولو جئنا بمثله مدداً ".
إنّ الاتجاه إلى وحدة القصد بالمباشرة لهو الذي يجعل من القرآن طراوة في النفوس بفضل تأثير أسلوبه على القلوب مهما تطاول عليه الزمن وتداولت على عباراته وكلماته الأيام. ولقد لاحظ المستشرق الفرنسي "ليبون" مثل هذه "الخاصَّة الذاتية" حين قال عن القرآن الكريم:"حسبُ هذا الكتاب جلالاً ومجداً أن الأربعة عشر قرناً التي مَرَّت عليه لم تستطع أن تجفِّف ولو بعض الشيء من أسلوبه الذي لا يزال غضاً كأن عهده بالوجود أمس". كان هذا ذوق باحث أوروبي له صِلة غير مباشرة بالقرآن، وهو مع ذلك يكتشف ما فيه من طراوة الكلمة وحلاوة الأسلوب، على ما مَرَّت عليه من أزمنة ودهور لم تستطع أن تغير في جماله شيئاً. وهنالك آراء توصّل إليها كبار الباحثين الأوربيين حول القرآن؛ لا يكاد المرء لقوتها وعمقها أن يظفر بها في بحوث الباحثين العرب.
(وللحديث بقيّة)
بقلم: د. مجدي إبراهيم