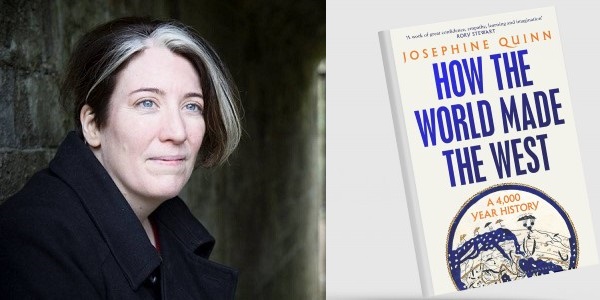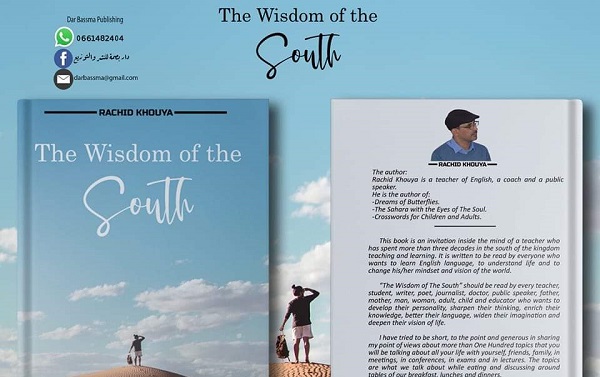صحيفة المثقف
المحبةُ معينٌ متدفقٌ أبدي
"توضأ بالمحبة قبل الماء، فإن الصلاة بقلب حاقد لا تجوز" - جلال الدين الرومي
هذه حكمة يتجلى فيها معنيان متباينان متضادان؛ الأول المعنى المطهّر للقلب المتجسد بالمحبة عند العرفاء والمتصوفة؛ جاء في المقطع الأول منها، والثاني المعنى المدنس أو الملوّث للقلب المتجسد بالكراهية، التي تفضي الى الحقد عند بعض العامة من الناس، ورد في المقطع الثاني منها.
قادني الفضول المعرفي للبحث المتواضع في معنى هذه الحكمة عند المتصوفة والعرفاء، وإن كنت لستُ على اطلاع واسع على تراثهم. وليس المغزى من البحث تبني مقولة الرومي هذه بقدر ما أجد فيها معنىً جديدا للمحبة أود الخوض فيه، وقد فتح لي نافذة أطل من خلالها على باحة البحث عن معنى المحبة عند العامة سيما نحن في موسم المحبة... شهر رمضان الكريم.
المحبة مصطلح يختلف اللغويون في تفسيره، فبعض عبّر عنه بأنه أحد أسماء الحب، "المحبة أيضا أسما للحب"[1]، وبعض عبّر عنه بأنه أعم وأشمل من الحب، وبعض قال إنه أخص من الحب الذي هو معنى شامل.
و"المحبة لغويا تعني الثبات واللزوم في الحب، أما معناها اصطلاحا فتعني الحب الطاهر، وهو ميل النفس الى ما تراه ساريا ووصولها في بعض الأحيان الى التعلق"[2].
المحبة في القرآن الكريم جاءت بثلاثة مسميات وهي المحبة والحب والمودة؛ فالمحبة وردت في الآية الكريمة (وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني)[3] والله جل وعلا هنا يخاطب فيها النبي موسى(ع)، وهي محبة من عامة الناس للنبي موسى. ووردت بعنوان الحب، كالحب المتبادل بين الله وعباده (يحبهم ويحبونه)[4]. ووردت بعنوان المودة؛ وهي خاصة بالجنسين الذي تتدخل فيه مصالح بيولوجية، وهي الحب الخاص بين الزوجين الذي يسكن صميم القلب كما ورد في القرآن الكريم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة)[5]؛ وهو ليس محل بحثنا.
أما في السنة النبوية فقد احتلت المحبة حيّزا كبيرا وجاء على لسان الرسول(ص) الحديث القدسي" المتحابون في جلالي، لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء"، وفي موضع آخر،"والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أَوَلا أدلّكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم".
ويعّرفها ابن القيم بقوله: "معاني الحب لا تعلم حقيقتها الاّ بذوقها ووجودها، وفرق بين الذوق والوجود، وبين التصور والعلم، والحدود والرسوم التي قيلت في المحبة صحيحة غير وافية بحقيقتها؛ بل هي إشارات وعلامات وتنبيهات"[6].
المحبة عند المتصوفة تعني" ميل القلوب" أو"الإيثار للمحبوب" أو"المحبة لذة في المخلوق واستهلاك في الخالق". [7]
وعرّفها ابن عربي بقوله "الحب صفة الوجود الموجود دوما في الوجود الاّ الله، فلا محب ولا محبوب الاّ الله عزوجل؛ فما في الوجود الاّ الحضرة الإلهية وهي ذاته وصفاته وأفعاله". وسئل الجنيد عن المحبة قال"كأسٌ لها وهجٌ اذا استقر في الحواس وسكن النفوس تلاشت"[8].
وفي الديانة المسيحية احتلت المحبة مركز الصدارة واعتبرت محورا لها وجاء في إنجيل يوحنا بأن "الله محبة"[9] ودعا المسيح (ع) الناس الى ممارسة المحبة حتى مع الأعداء.
المحبة أشمل من الحب، وهنا لا نعني بها الحب البيولوجي بين شخصين، بل هي أشمل وأطهر وأزكى وأسمى، وهي التي أطلق عليها ب"الحب الافلاطوني" المجرد من المصالح المادية، و "المحبة تعبر عن علاقة خالصة بين المحب والمحبوب لا يشوبها أي رغبات أو حاجات مادية بالمقابل"[10].
وهي على أنواع؛ منها محبة الله، والرسل والأنبياء، والصالحين، والأهل، والأصدقاء، و ما يكتنز به الكون من مظاهر مادية ومعنوية؛ لكن ما يهمنا هنا هي المحبة للآخر سواء المقدس أم غيرالمقدس عند المتصوفة والعوام.
النفس مركز المحبة
والنفس عند الفلاسفة لها تعريفات كثيرة نتعرّض لها باختصار؛ لأنها ليست هنا محل البحث؛ وأحد تعريفاتها أنها جوهر غير جرمي أي "ليست جسما ولا جزءا من جسم ولا عَرَضا"[11]، وهي قابلة لإدراك الأمور العقلية والحسية بالقوة معا ثم بالفعل أخيرا على التمام و الكمال[12]، ولها مراتب هي العقل الهيولاني[13]، والعقل بالملكة[14]، والعقل بالفعل[15]، والعقل المستفاد[16] .
ويقسّم عالم النفس "سيجموند فرويد" النفس الى ثلاث بُنى؛ هي: الهو، والأنا، والأنا العليا. فا "الهو" الجزء الأساسي الذي ينشأ عنه فيما بعد الأنا والأنا العليا، ويتضمن جزئين هما: جزء فطري؛ وهو الغرائز الموروثة التي تمد الشخصية بالطاقة بما فيها "الأنا" و"الأنا العليا"، وجزء مكتسب؛ وهي العمليات العقلية المكبوتة التي منعها الأنا (الشعور) من الظهور. و"الهو" لا يراعي المنطق والأخلاق والواقع ويعمل بمبدأ اللذة وهو لا شعوري كلية. و"الأنا" هي شخصية المرء اعتدالا بين الهو والأنا العليا، فتقبل بعض التصرفات وتمارس الرغبات وفق قيم المجتمع والأخلاق، بينما "الأنا العليا" هي شخصية المرء في صورتها المتحفظة العقلانية، حيث أن أفعال المرء تتحكم فيها القيم الأخلاقية والمجتمعية والمبادئ مع البعد الكامل عن جميع الأفعال الغرائزية[17].
والنفس في القرآن الكريم وردت بعدة معانٍ، الأول بمعنى ذات الشيء وحقيقته ونفس الإنسان هي جملته من الجسم والروح، والثاني بمعنى الروح التي بها الحياة، والثالث بمعنى الضمير، والرابع صفة توجه الإنسان نحو الخير والشر، والخامس صفة في الإنسان ترافقه في حالة الإحساس وتفارقه في حالة النوم، والسادس بمعنى جنس الإنسان وفصيله[18]، وهي على أنواع "النفس الأمارة"، وهي الأمارة بالسوء، وظيفتها التحريض على عمل المنكر وسيئات الأعمال(إن النفس لأمارة بالسوء)[19]؛ و"النفس اللوامة" وظيفتها اللوم وتأنيب ضمير صاحبها اذا أقدم على فعل سيء (ولا أقسم بالنفس اللوامة)[20]؛ و"النفس المطمئنة"، وهي التي هجرت المعاصي، فبلغت مرحلة الاطمئنان والراحة والطاعة التامة لله؛ و"النفس الراضية"، وهي القانعة بما قدمت؛ و"النفس المرضية" التي أرضاها الله بما قدمت من عمل الخير(يا أيها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية)[21]؛ و"النفس الملهمة" وهي التي ألهمها الله فعل الصالح والطالح؛ و"النفس الكاملة"، وهي التي سلكت سبيل الصلاح؛ فاستقرت وسكنت واستقامت.
لكن مسميات النفس عند المتصوفة هي خمسة: "الحيوانية" وهي نفس الطفل، و"الأمارة"، وهي التي تميل بالطبيعة البشرية فتأمرها بالتدني والتسافل، و"اللوامة"، وهي المتيقظة، التي كلما أساءت استدركت وتداركت نور التنبيه الإلهي فتلوم نفسها وتؤوب الى ربها؛ و"المطمئنة"، وهي التي تنورت بنور القلب، وانخلعت عنها الصفات الذميمة، وتوجهت بالقلب نحو الترقي الى جانب عالم القدس متنزهة عن الرجس؛ و"الملهمة"، وهي التي تفعل الخير بإلهام إلهي أو تفعل الشر بالإقضاء الطبيعي [22]؛ وأضيف اليها مسمى سادسا هو"النفس الكاملة"، وهي التي بلغت الكمال.
- حسب ظني - وأستند فيه الى الحديث القدسي الذي يخاطب فيه الله العقل(لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبلَ، ثم قال له أدبر فأدبرَ، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب الي منك، ولا أكملتك الاّ فيمن أحب، أما إني إياك آمر، وإياك أنهي، وإياك أُعاقب، وإياك أُثيب)، فإن العقل أول مخلوقات الله، فهو المسؤول عن تبني موقف ما سواء سلبي أم إيجابي بعد تلقيه إيعازا من النفس. والنفس هي ميدان الصراع بين المعاني المتضادة... بين الخير والشر، الحق والباطل، الصالح والطالح، الحسن والقبح، المحبة والكراهية...وغيرها الكثير، فهناك صراع الإرادات والرغبات والنزعات في داخل النفس. مثل النفس مثل المقود للسيارة، فهي القائد المتحكم والمتبصر وهي تختار الصح أو الخطأ، وظيفتها النظر والإحساس المعنوي بالشيء ايجابا أو سلبا؛ فهي تتحكم بالعقل وليس العكس؛ فتقوده نحو فعل الخير أو الشر. الصراع في داخل النفس محتدم بين المعاني المتناقضة، فإن استطاعت النفس الانتصار لصالح المعنى الإيجابي كالمحبة مثلا؛ فقد كسبت المعركة وأعطت إيعازا للعقل نحو تبنّيها، وإن انتهى الصراع لصالح المعنى السلبي كالكراهية مثلا؛ فقد قادت العقل نحو تبنّيها(ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)[23] . فالنتيجة تنتهي بالعقل الذي به يعاقب الله وبه يثيب، وقد يكون معناه في الآية هو النفس (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها)[24].
يظهر هذه الحقيقة أبو حامد الغزالي بقوله "كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك الاّ على وفقها لا محالة. وكل فعل يجري على الجوارح فإنه يرتفع منه أثر على القلب"[25].
المحبة عند الأنبياء
المحبة عند الأنبياء مفروغ منها، وتنتجها النفس الكاملة التي وصلت الى درجة الكمال والاتزان التام. تتجلى المحبة في نفوس الأنبياء بأفعالهم المتجلية بالطاعة المطلقة للمحبوب الذي هو الله، والتفاني من أجله؛ فالله جل وعلا اختار الأنبياء لمهمة النبوة؛ لأنه وجد في قلوبهم حبا له وتفانيا لأجله ومحبتهم مباشرة مكشوفة يحبهم ويحبونه، فالمحبة متبادلة بينه وبينهم. إذا تتبعنا سيرة بعض من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم لألفينا محبة الله حاضرة في قلوبهم وطاعته مطلقة، فمحبة النبي ابراهيم(ع) لله وتقديم ابنه قربانا له، هي أبرز تجلٍ لمحبة الله في نفوس الأنبياء. ومعاناة الأنبياء، وهم كثر في سبيل قيادة البشرية نحو الخير والكمال ومحبة الله، فالنبي موسى(ع)، مذ كان في المهد صبيا امتحنه الله فأوحى لأمه أن تلقيه في صندوق في النهر، وخاطبه الله بالآية الكريمة(وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني)، والمحبة التي وردت في القرآن الكريم مع النبي موسى هي محبة ملهَمة وملقاة على خَلْقه لنبيه لضرورة إلهية؛ ليكون نبيا للأمة، ومن بعدها تعرّض لأنواع من الابتلاءات، وصَبَر وهو أكثر أنبيائه ذكرا في القرآن الكريم، وغيره من الرسل والأنبياء الذين عانوا الكثير في مسيرة محبة الله، وكانوا كلهم محبين ومطيعين له كل بحسب ظرفه وزمانه.
هنا يُثار سؤال هو: إذا كان الأنبياء محبين ومطيعين لله فلماذا عصى النبي آدم ربه وهو أول أنبياء الله وأول خلقه؟، هل كان في معصيته صالح للبشرية أم طالح؟ وهل كان ينطوي على النفس الكاملة التي انطوى عليها بقية الرسل والأنبياء؟، وهل كان يفقه المعصية التي ارتكبها، وانتهت به الى الهبوط من الجنة على الأرض؟ وهل إن أنبياء الله كانوا على نفس الدرجة من الخَلْق والخُلُق أم مختلفين حسب الزمان، وطبيعة الحياة، وتدرج وعي العقل عند المجتمعات؟
الإجابة عن التساؤلات يتطلب بحثا مطولا لكن يمكن القول إننا لا توجد لدينا معلومات مفصلة عن أول الأنبياء(آدم) وشخصه وطبيعته، والآية الكريمة أفصحت عن وضع المجتمع البشري في بدايات تكوينه (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين)[26]- حسب فهمنا – للآية إن العقل البشري سابقا كان بسيطا غير معقد، والمجتمع صغير وبدائي لا يحتاج الى تعدد النبوات والرسالات، ثم بعث الله رسله تترى كلا حسب ظروف وطبيعة مجتمعه، وزمانه، وجغرافية المكان. والتعدد ينتهي الى تدرّج في وعي وفهم ونضج عقول الناس، ومدى تقبّلهم للرسالات السماوية والمرسلين، والموضوع ليس محل بحثنا هنا.
المحبة عند العرفاء والمتصوفة
طبيعة النفس عند المتصوفة مختلفة عن نظيرتها عند عامة الناس؛ فالنفس عند المتصوفة هي ميدان جهاد، همهم إعدادها إعدادا معنويا، وهم مشغولون بها، وعن كل ما يمت بصلة للعالم الخارجي المادي. و-بحسب رأيي طبعا- فإن منطق العقل عند المتصوفة أقوى من منطق النفس؛ فالعقل يتمعن بعمق ووعي في الصراع الحاصل داخل النفس ثم اعطائها ايعازا باتخاذ موقف تجاه تبني المعنى الايجابي ونبذ المعنى السلبي، والعقل هو المسؤول عن حسم الصراع بين القوى المتضادة والمتناشزة في داخلها، لذلك ينتصر الصوفي على نفسه؛ فالعبودية عند الصوفي هي لله، وهي الأساس الذي ينفي الأنا(الأمارة بالسوء)، وحين تنفيها تبدأ النفس بالتدرج على السلم المعنوي. النفس عند المتصوفة في سيرورة تصاعدية متدرجة، تخضع فيها لرياضات روحية، ووفقا لمحبة الله تسير النفس في مسالك الكمال حتى تبلغ مرحلة النفس الكاملة التي تؤدي بالسائر الى الطاعة المطلقة للحق تعالى، وتزيح الموانع بينها وبين نور ذاته المقدسة، فتنفصل ذات العابد وتذوب في ذات المعبود حتى تصل الى الفناء التام فيه، وتشتعل فيها جذوة محبة الله فيصبح القلب محلا لتجلي أوصاف الربوبية. و"تتلاشى الأبعاد غير الحسية التي يعبر عنها بالحجب بين الرب والمعبود، هي الطريقة التي تجعل العابد ينتقل من الحضور مع العبادة الى الحضور مع المعبود فيعبد الله كأنه يراه، ثم توصله الى مرتبة فناء العابد في المعبود، حيث يذوب بنور المحبة، فلا يبقى لنفسه شيء فيذهب المحب الفاني وتتجلى فيه أنوار المحبوب الباقي، أي يفنى عن نفسه ويبقى بربه"[27].
المتصوف أو العارف حينما يخوض تجربة السفر نحو الحق يُسمى (سالك)؛ لأنه يسلك أربعة أسفار معنوية متدرجة "يرحل السالك فيها من العالم السفلي الى العالم العلوي؛ فيسافر في قوس الصعود من عالم المادة لتنتهي رحلته الى الحق تعالى، وهي رحلة روحية ارتقائية تكاملية، يطوي فيها السالك الى الحق أربعة أسفار في مدارج تكامله المعنوي يمر عبرها بعدة منازل، ويرتقي من مرحلة الى أخرى يتصاعد من الدنيا الى ما هو أسمى وأكمل من السابقة، وهكذا حتى يصل الى غايته التي هي منتهى كل غاية وهو الحق سبحانه"[28]. فتنتهي رحلته بالفوز بساحة المحبوب؛ فينفصل السالك عن أناته وذاته ليتحد ويذوب في محبة الحق فينشغل به عما سواه. وبالطبع فإن إرادة الله تتدخل حسب طبيعة النفس، حين ترى من الصوفي رغبة جامحة في بلوغ الوصال والاتحاد بالمحبوب، فيّلبس الله قلبه بجلباب الربوبية، فيخلع عليه الصفات الجمالية استحقاقا ذاتيا له، فتسري فيه الأنوار الإلهية" النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس، فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار، وقطع عنه مدد الظلم والأغيار"، "الأنوار مطايا القلوب والأسرار"، "ما يزال عبدي يتقرب اليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن أستعاذني لأعيذنه". وقال جل وعلا(عبدي أطعني تكن مَثَلي تقل للشيء كن فيكون). "حتى أقاموا عند باب حجرة القلب، وأخرجوا من قلوبهم كل ما سوى الله من جنة ونار، وأرواح وأجسام وغير ذلك، ليس لهم شأن سوى طلب الحق"[29].
والمحبة عند المتصوفة مكتفية بذاتها لا تأخذ ولا تعطي حسب تعبيرهم، ومفروغ منها. والمحبة لديهم هي الانقطاع التام والذوبان في حب الله والعروج في مسالك العشق والوجد الإلهي، وهو قد اختصر كل ألوان الحب والمحبة وهم أساسا مستغنون عن حب البشر أو محبتهم، فحينما "يجتمع نور العقل ونور القلب فهما مجتمعان بكلمة الله التي هي المحبة" "الحق تعالى عندما يجعل عبدا لائقا بمقام القرب ويذيقه شراب لطف الأبد، يصفي ظاهره وباطنه من الرياء والنفاق، فلا يبقى لمحبة الأغيار في باطنه متسع، ويغدو مشاهدا للطف الخفي وينظر بعين الاعتبار في حقيقة الكون، وينظر للمصنوع الى الصانع، ويصل من المقدور الى القادر. واذ ذاك يمل المصنوعات وينشغل بمحبة الصانع. لا يبقى للدنيا خطر لديه ولا يبقى للعقبى مرور بخاطره. يغدو غذاؤه ذكر المحبوب، ويتباهى جسده بهيجان الشوق الى المعبود، ويذوب روحه في محبة المحبوب، لا وجه لديه للإعراض ولا عدة للإعتراض. وعندما يموت وتخرج حواسه الظاهرة عن دوران الفلك، تمتنع كل أعضائه عن حركة طبيعته، وهذا كله تغير للظاهر، لكن الباطن مملوء بالشوق والمحبة(أموات عند الخلق أحياء عند الرب) لدى الناس أموات ولدى الحق أحياء"[30].
يعبّر المتصوفة عن محبتهم للحق تعالى على لسان الحلاج المتصوف البغدادي:
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتني أبصرتَه وإذا أبصرتَه كان أنا
روحه روحي وروحي روحه من رأى روحين حلاّ بدنا
والمعاني عند المتصوفة مُؤَوّلة لا تشبه المعاني التي نعني بها نحن العوام؛ فالصوم عندهم لا يعني الإمساك عن المفطرات، بل له رمزية تتمثل في الإمساك عن سائر الخلق، والانقطاع للمعشوق، ولها مفاهيم متعددة معبرة عن مسلكهم الروحي. والصوم هو معراج الى الحضرة الإلهية والانفصال عن كل ما سواها، الذي يضفي على قلوبهم نورانيته. "الصوم هو إشارة الى الامتناع عن استعمال المقتضيات البشرية ليتصف بصفات صمدية"[31]. و"كل ليلة للعارف بمنزلة ليلة القدر" لأن كل أيامه ولياليه وساعاته تدور حول محور محبة الحق تعالى.
المحبة عند العوام
النفس الأمارة، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة هذه الثلاث تتبادل الأدوار عند أغلب العامة من الناس. والمحبة عند عامة الناس مختلفة عن مثيلتها عند الأنبياء والمتصوفة. والمحبة كما عبرنا منجمها النفس، وهي شعور له درجات في النفس الإنسانية فبعض يبالغ بها، وبعض آخر يعتدل بها، وبعض آخر ليس بالضرورة أن يوجد حيزا لها في نفسه. والمحبة محورالصراع داخل النفس؛ فإن استطاعت أن تكسبها وتتجلبب بها فقد حسمت الصراع وتحققت سكينتها، وإن لم تحسم الصراع فقد تغلبت الكراهية على المحبة، والنفس هي في صورة النفس الأمارة " ان الخلق ليس فعل الجميل أو القبيح ولا القدرة على الجميل أو القبيح، والتمييز بين الجميل والقبيح، وانما هو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر عنها الإمساك والبذل. فالخلق اذن هو عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة"[32].
مقولة جلال الدين الرومي "توضأ بالمحبة قبل الماء" فيها أمر بالتحلي بالمحبة، والأمر يتعلق هنا بالإرادة المتحكمة بالنفس البشرية، وهو أمر موجه بشكل مباشر الى تلامذته ومريديه. تعني المحبة التي لدى عامة الناس كأن تكون محبة لله أم لأي من خلقه، وتأخذ صورا وأشكالا مختلفة. محبة الله عند العوام يشوبها القلق والاضطراب، فهي مترددة قلقة غير ثابتة؛ تارة تكون مشوبة بالخوف والرهبة، وأخرى بالرغبة وجزيل الجزاء الأخروي على معنى محدد، يتجلى معناها في قول المتصوفة التالي: "مؤمن مضطرب! إذا صام المرء شهر رمضان كلّه باسم الله، وقدم خروفا أو عنزة كل عيد ليغفر الله له ذنوبه، واذا جاهد المرء طوال حياته ليحج الى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، واذا سجد خمس مرات كل يوم على سجادة صلاة، وليس في قلبه مكان للمحبة، فما الفائدة من كل هذا العناء؟ فالايمان مجرد كلمة، إن لم تكن المحبة في جوهرها، فإنه يصبح رخوا، مترهلا، يخلو من أي حياة، غامضا وأجوف، ولا يمكنك أن تحس به حقا"[33].
بعضٌ من العامة تتجلى في نفوسهم محبة الله الحرة الخالصة التي لا يشوبها شيء سوى توحيد الله وتمجيده وشكره جل وعلا، ومحبة خلقه كذلك؛ وهم ممن يحملون النفس المطمئنة القارة الساكنة المستقرة. وهؤلاء محبون لله ومحبون للناس، ومحبة الله لديهم هي الشغل الشاغل. والمعاني عندهم فيها تأمل عميق. للإمام جعفر الصادق (ع) حديث عن معنى الصوم عند هذه الفئة من الناس؛ وهو"الصوم يميت مراد النفس وشهوة الطبع، وفيه صفاء القلب وطهارة الجوارح وعمارة الظاهر والباطن والشكر على النعم و الإحسان الى الفقراء وزيادة التضرع والخشوع والبكاء وجل الالتجاء الى الله وسبب انكسار الهمة وتخفيف السيئات وتضعيف الحسنات"[34].
في بعض الأحيان تكون المحبة عند بعض الناس طبعا ذاتيا للنفس وليس مكتسبا، فهي مبنية على كمال داخلي فطري، ونعني أن بعض الناس خُلقوا بالفطرة مجبولين على المحبة لمن حولهم، لكن قد تتدخل عوامل لها دور مؤثر في المحبة عند العوام؛ وهي:
البيئة الأولى: ونعني بها المنزل، فالمنزل له دور وأثر كبيران في النقش على صفحة حياة ساكنيه، خصوصا حينما يفيض عليهم معاني المحبة، والدفء، والاحتضان، والاهتمام، فيحملون أنفسا تتحلى بالشجاعة، والثقة العالية، والاتزان في شخصياتهم، وبالنتيجة ينفتح في نفوسهم حيز كبير لمحبة الآخرين.
قلب الطفل صفحة بيضاء، يستقبل العادات والأخلاق الحسنة والسيئة، ويستبطنها في وعيه وفي لا وعيه. وأهم عامل في البيئة الأولى الذي يؤسس للمحبة الكبرى هما الأبوان، فوجود أبوين محبين رحيمين يمنحان الإبن محبة كبيرة تحقق له سعادة على امتداد الحياة وتُشبع ذاته منها؛ وتمنحه قوة وشجاعة في تحقيق طموحاته ومآربه التي يريدها، ومواجهة المحيط الخارجي، وما فيه من تحديات ومخاطر ومخاوف. ويتحقق الأمان لديه نتيجة تلقيه حبا عظيما من المنزل وينشأ عليه آمنا مستقرا غير خائف ومتوجس.
وقد أكد بعض من متخصصي علم النفس أن الإحتضان والقبلة في المنزل الأول منذ الصغر لهما دور كبير في التنشئة السليمة للفرد، والقُبلة وفق تحليلهم هي أهم عوامل الإستقرار النفسي للفرد، وعلى المدى البعيد "كثير من الدراسات التي عملت بخصوص القبلة والاحتضان تؤكد أن الإنسان الذي ينشأ في بيت فيه تقبيل واحتضان يكون أصح نفسيا من الإنسان الذي ينشأ في بيت لا قبلة فيه ولا احتضان"[35].
إذا كبر الطفل وشبّ على المحبة التي تلقاها من حضنه الأول، واختزنها عقله الباطن؛ فإنها ستكبر معه، وستؤول به لتأسيس حياة آمنة قارة في المستقبل؛ فيما إذا اقترن بشريك حياة يحمل نفسا مشبعة بالمحبة، التي بدورها ستكون عامل خصب ونماء في العلاقة الاجتماعية مع باقي الأسر التي تربطهم معا جغرافية المكان. لكن كثيرا ما يقترن أحد الأبوين بشريك غير مشبع عاطفيا في طفولته، وهذا الاقتران يحدث خللا في منح المحبة بينهما، فضلا عن الطفل الذي ينشأ عليها، وستصل اليه مشوّهة وناقصة وتحدث خللا، وفراغا عاطفيا يفضي بدوره الى مشاكل على صعيد النفس أولا، والمجتمع ثانيا.
الشخص المشبع ذاتيا من حضنه الأول يستبطن المحبة في نفسه، وينفقها بسخاء على من حوله، والمجتمع كذلك؛ وإن منحها للمجتمع والحياة فإنها ضمن منظومة قيم اجتماعية ضرورية كان قد تلقّاها على بيئته الأولى؛ لتؤسس لحياة آمنة، مستقرة، متزنة. الشخص المشبع عاطفة ومحبة منذ الصغر يكون آمنا ومطمئن النفس، وسعيدا في نفس الوقت، لا يتمحور حول ذاته؛ فحبه ممنوح للناس وللمحيط، وحينما يمنح المحبة تُعَد له مكسبا مبهجا لنفسه، وليس همّا يقصد منه الأمان على ذاته أو اتقاء خطر محدق، فهو آمن ومطمئن.
إن الشخص المحروم من المحبة نتيجة خلل في السلوك الذي منشؤه إعاقة في التربية والتنشئة الأولى ينشأ ضعيف الشخصية، مهزوزا، وليس ذا ثقة عالية بالنفس، وغير شجاع، وغير مغامر، وانطوائيا يخاف الحياة. وحين يفقد المحبة في الصغر يستجديها من المحيط والناس عند الكبر بأي صورة؛ ليكون معترفا به؛ ليعوض ما فقد من محبة وأمان واحتضان في الصغر؛ فيعوضه من المحيط والمجتمع. وإذا لم يتلقَّ الشخص المحبة من حضنه الأول بشكل صحيح ويشبع ذاتيا منها، فهو لا يمكنه منحها لأحد؛ ف(فاقد الشيء لا يعطيه)، وإذا استطاع منح المحبة لمجتمع، أو لشخص بعينه فسوف تكون مشوهة، فضلا عن كونها صمامَ أمانٍ وحماية له من الأخطار الاجتماعية المحدقة؛ لأن محوره هو ذاته المنكمشة والانطواء عليها، وهو بالأحرى يعيش في سجن ذاته الذي لا يمهله فرصة عيش سعيدة تتحقق فيها الراحة والسكينة النفسية، وما زال في سجن الذات لا يستقبل المحبة الحقيقية من المحيط، ولا يمنحها ما لم يتحرر من ذاته، ويطلق سراحها، وإن تحرر فهو يحرر المحبة، والمحبة لا تقبل السجن وهي حيوية فعّالة؛ لأن المحبة من المفترض أن تكون ذات معيار واحد ومتكافئ من الطرفين. الخوف من منح المحبة من شخص محروم منها لشخص ما أو للمجتمع هو في حقيقته خوف من الفشل والضعف، أو الاستغلال من قبل بعض أفراده، وكل ذلك – حسب رأيي – هو ضعف في ذات الشخص وجبن؛ فالشجاع يعطي المحبة، والمحبة بنفسها قوة عظيمة، من الشخص ومن المجتمع على حد سواء، ويحاول ما بوسعه أن يداري شعور المحبة، ويمنحها المزيد من الجهود النفسية المضنية حتى يصل الى بر الأمان الذي هو هاجسه الدائمي مازال على قيد الحياة. توليد المحبة في القلوب الضعيفة صعب كونها تعاني نقصا منها منذ الصغر، ويكون إنفاقها للآخر صعبا، وشاقا، ومخيفا في نفس الوقت، ويعبر القرآن عن هذا الصنف من الناس بقوله (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم)[36]. والألفة في الآية الكريمة تعني التأليف بين القلوب وجمعها على المحبة.
المحيط الخارجي
ونعني به الفضاء العام خارج المنزل، والمتضمن الناس والحياة وما يتعلق بهما.
في السابق كان المحيط الخارجي رحيما، وكانت الحياة تشوبها المعاني المضيئة؛ فالمحبة، والألفة، والتواد، والتضامن، وكلها تمنح الإنسان محبة لسواه وللمحيط؛ لأن إيقاع الحياة آنذاك كان مختلفا عن الزمن الحاضر؛ فالمادة ومظاهرها محدودة؛ وهو ما جعل المعاني تشرق في النفوس، وتتجلى مصاديقها العملية في حياة الناس. وبالطبع فإن المحيط إذا كان مشبعا محبة وتآلفا فإن الأفراد المتساكنين سيسود حياتهم الهدوء والسكينة والراحة؛ فإن في المحبة راحة النفوس وطمأنينتها. والناس آنذاك كانوا على قدر كبير من الشعور بالمسؤولية إزاء بيئتهم، فالمحبة هي من أولويات التساكن أولا، وهي تؤسس لحياة اجتماعية آمنة مطمئنة فهي مشتركة، ولابد أن تسودها المحبة والاحترام بعيدة عن المصالح المادية الصرفة. ومن المحبة يستمد أفراد المجتمع المتعايش القوة، وهي تكون منبع العطاء لحياة اجتماعية سعيدة، فالمحبة الحقيقية هي شجاعة، وأصالة، وحرية برغم كون المحبة تعني الألفة والوحدة التي تربطنا بالآخرين لكنها تطلق سراح الذات.
الشعارات التي يطلقها منظرو علم النفس والاجتماع، وأهل التصوف والعرفان هي موضع تأمل وتحليل، فالمعاني لا تلقّن - بنظري- في الكبر، والناس يتلقوْنها في مقتبل حياتهم وفي سنيّهم الأولى. التنظير لم يجدِ نفعا مع الكثيرين، أغلبنا يمر مرور العابرين حين نقرأ نظريات ومقولات لمشاهير في علوم الاجتماع والنفس والتصوف، وهي تلقينية مفروضة؛ لأن – حسب رأيي - النظريات في الأخلاق والقيم ما لم يعمل بها لا طائل من ورائها. بعض من متخصصي علم النفس يفعّلون مقولاتهم بالعمل، فيوجهون المرضى نحو الاندماج في المجتمع، والانخراط في العلاقات الإنسانية، لأن لها مردودا ايجابيا على الصحة النفسية للفرد؛ وقد حثّ الدكتور ألفرد أدلر "بتوجيه مرضاه النفسانيين الى الاهتمام بالناس الآخرين واندماجهم معهم ومساعدتهم، ويقول: متى فعل المريض ذلك فإنه يكون قد برئ من مرضه"[37].
ولا نخفي ما تحفل به الحياة الحاضرة من قيم مشوهة ممسوخة؛ فالمادة موجوة بإسراف، وهي حجبت عنا لذة الاستمتاع بنقاء المعاني وصفائها ونورانيتها، فضلا عن أن الاختلاف السائد بين البشر على أساس الأديان، والمعتقدات، والأفكار؛ أنتج القسوة، والحقد، والكراهية، والخداع، والمكر، والكذب، والكيد، والظلم. والإنسان اليوم حذر حينما يمنح المحبة للآخر، ومنبع الحذر والخوف هو تبدل الحياة وانقلاب موازين القيم والأخلاق، فلم تعد مقولة(أشعر بوعي كل شخص وكأنه وعيك أنت) أو(أحبب جارك كما تحب نفسك)؛ نعم كانت هذا المقولة وأمثالها سارية المفعول في الماضي، وهي اليوم صعبة عند الكثيرين، وعالمنا قائم على الحروب والشرور التي مصدرها القلوب غير المحبة، والكراهية تأتي من النفوس التي تألف الظلم، والظلم يأتي من الظلام أي السواد؛ وإذا منحت محبة لأحد فقد ارتدت قناعا كاذبا، وفيها تصنّع ونفاق يحمل بين طياته شرور الحياة الحاضرة.
وفي رأي الكثيرين أن منح المحبة بإسراف في حياتنا الحاضرة نابع من نفسٍ محبة للعبودية، فالمحب يكون فيها عبدا لشخص أو جماعة، و- نقول- لنسجن الذات في المحبة بدلا من سجنها بالكراهية، لأن المحبة تفيض على حاملها الراحة والسكينة والطمأنينة، والكراهية تجعل الذات مكبّلة بالشر، فضلا عن أن شعور الكراهية مؤلم للنفس وذو مردود سلبي عليها. والمحبة العامة للناس أيضا تنتج بدورها محبات للمحيط والطبيعة وبدورها تفرز حرصا وحفاظا عليهما. مع زيف الحياة وخدعها وحيلها فإن القلوب المحبة مضيئة، مبتهجة، ساكنة؛ بيضاء؛ والقلوب المبغضة مظلمة، متجهمة، مضطربة، سوداء.
نحو منحى جديد للمحبة
المحبة الأولى تنطلق من الله؛ فالله هو "المحبة" كما وصف نفسه، وهو نفخ المحبة في نفوس خلقه(ونفخنا فيه من روحنا)[38]؛ فهو منجم المحبة العظيمة والحرة غير المقيدة، المحبة عند الله واسعة وذات فضاء رحب وحر، لا يحدها دين، أو مسجد، أو كنيسة، أو دير، والله القائل في حديث قدسي(ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن). وهي المحبة التي ينطلق منها حب خَلق الله كيفما كانوا. والمحبة الأصلية التي تحملها القلوب المحبة لله هي المحبة العظيمة التي لا تحتمل القوالب الضيقة ولا التشييء، إذا شُيئت المحبة استحالت الى مادة للمقايضة، وخرجت من كونها معنى. هذه المحبة تجلت في إحدى جلاليات الرومي وهي"ذلك المسجد الذي انطوت عليه قلوب الأولياء هو مسجد للخلق كافة فهناك الله".
المحبة دينامية، حيوية، تتدفق من الذات الإنسانية لكل ما يحيطها من أفراد، ومجتمع، وطبيعة، وحياة، لأن منبعها الروح الأصيلة.
نحن اليوم أمام محنة حقيقية اجتاحت سكان الأرض، بعد جائحة"كورونا" التي هزّت الكرة الأرضية برمتها، ووحّدت العالم بأسره، ووضعته في حلبة صراع ومواجهة مع شيء هو ليس كائنا حيا، بعد أن نسى العالم حروبه، واختلافاته، وأعراقه، وأديانه، وانشغل في كيفية مواجهة خصمه على الأرض، فهل سيحتفل العالم بالانتصار عليه، ويكسب المعركة، وتلتئم جراحاته التي خلّفتها الصراعات، ويلمّ شمله المشتت، كما احتفل ثقب "الأوزون" بالتئامه فوق قطب الأرض الشمالي، والتم شمله؟
وهل يا ترى سوف تجتمع قلوب البشرية وتعيد تشييد بنى العلاقات الاجتماعية على أسس المحبة القوية التي تشدّها للأرض وللإنسانية جمعاء بعيدا عن التشرذم والاختلاف والتقاتل؟؛ وهي بارقة أمل في أن تنسى حروبها وعداواتها و(رب ضارة نافعة).
ومن هذا الذي ينطوي على نفس قوية هي منجم محبة خام نقية لها القدرة الخارقة على تكسير تكلّس النفوس واختزال كل اختلافات البشرالمتراكم عبر الأزمان نتيجة ظروف الحياة المتلونة التي اكتنفتها الانتصارات والانكسارات؟ وإذا تحلى بهذه النفس فهو الانسان ذو الروح البكْر القادر جدا على قيادة البشرية نحو شاطئ المحبة النقية والسلام والأمان ففيه الإنسانية الأصيلة.
أروع تجلٍ للمحبة الأصيلة ما ورد عن خطبة لجبران خليل جبران بلغة صوفية في كتابه "النبي" اقتطع نصا منها:
المحبة لا تعطي الاّ نفسها، ولا تأخذ الاّ من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد لأن المحبة مكتفية بالمحبة. أما أنت إذا أحببت فلا تقل: إن الله في قلبي، بل قل: أنا في قلب الله.
بقلم: إنتزال الجبوري
...................................
[1] ابن منظور. لسان العرب.
[2] امام، محمد علي محمد. المحبة.
[3] طه – 39.
[4] المائدة – 54.
[5] الروم- 21.
[6] بندق، د. صهباء محمد. الحب كيف نفهمه وكيف نمارسه. القاهرة: دار السلام، الطبعة الأولى، 2006، ص25.
[7] أبي خزام، د. أنور فؤاد. معجم المصطلحات الصوفية. بيروت: مكتبة ناشرون، ط1، 1993، ص157.
[8] نفس المصدر والصفحة.
[9] انجيل يوحنا4:8.
[10] معجم المصطلحات الصوفية، ص157..
[11] مسكويه، أحمد بن محمد بن يعقوب. تهذيب الأخلاق. دراسة وتحقيق: عماد الهلالي. بغداد- بيروت: منشورات دار الجمل، ط1، 2011، ص238.
[12]نفس المصدر، ص239.
[13] أي الاستعداد المحض لإدراك المعقولات بالقوة وخالية من الفعل. نفس المصدر والصفحة.
[14] أي الاستعداد لإدراك المعقولات أما بالفكر أو الحدس. نفس المصدر والصفحة.
[15] أي حضور المعقولات متى شاءت من غير طلب لحالة تكرار المشاهدات. نفس المصدر والصفحة.
[16] أي كمال النفس فالمعقولات حاصلة بالفعل مشاهدة، وشبهت بالمبادئ العالية، صائرة عالما عقليا يضاهي العالم العيني في الصورة لا في المواد. نفس المصدر والصفحة( نقلا عن دغيم، سميح. موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي. بيروت: مكتبة ناشرون، 2004، ص934).
[17] موقع المعرفة الألكتروني.
[18] توفيق، محمد عز الدين. التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية. القاهرة: دار السلام، ط2، 2002، ص64-65.
[19] يوسف – آية 53.
[20] القيامة – آية 2.
[21] الفجر- الآيات 27-30.
[22] أبي خزام، د. أنور فؤاد. مصدر متقدم، ص174.
[23] الشمس – الآيات 7-10.
[24] الحج- 46.
[25]مبارك، زكي. الأخلاق عند الغزالي، ص133.
[26] البقرة- 213.
[27] بن أحمد، حسن. الحب ومحبة الله عند الصوفية. موقع نفحات.
[28] الرفاعي، د. عبد الجبار. إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين. بيروت: دار التنوير، ط2، 2013، ص35.
[29] الرومي، جلال الدين. المجالس السبعة. ترجمة وتقديم: د. عيسى علي العاكوب، دمشق: دار الفكر، 2004،ص113.
[30] نفس المصدر، ص110-111.
[31] الجيلي، عبد الكريم. الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، ج2، ص88.
[32] الغزالي، أبو حامد. احياء علوم الدين. ج3، ص56.
[33] شمس الدين التبريزي. قواعد العشق الأربعين.
[34] خير الدين، عادل. العالم الفكري للإمام جعفرالصادق، ص169.
[35] الدريع، د . فوزية. القُبلة. منشورات الجمل، ط1، 2006، ص47.
[36] الأنفال- 63.
[37] نجاتي، د. محمد عثمان. الحديث النبوي وعلم النفس. القاهرة: دار الشروق، ط2، 1993، ص85.
[38] الأنبياء- 91.