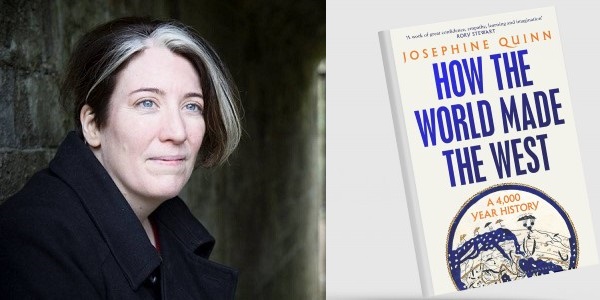صحيفة المثقف
الأصولية والتجديد عند الصعيدي
 أمّا عن مدراس التجديد المنشودة، فيحدثنا عبد المتعال الصعيدي أنه ينبغي ألا يقتصر جهدها على التغني بفضائل الإسلام وعظمة حضارته وورع رجاله وعدلهم، بل يجب تخطى ذلك كله إلى دراسة متأنية لواقع المسلمين للكشف عن علة جمودهم ومعوقات نهوضهم، ووضع برنامج إصلاحي للتغلب على هذه المعوقات متخذًا من الأصول الشرعية سبيلًا للتغلب عليها، موضحًا أن الثورة والقوة التي يجب أن تتحلي بها مدرسة الإصلاح لا تعني التغيير المفاجئ أو الوثوب على السلطة لفرض الرأي، بل هي روح النضال التي لا تهادن الرجعية ولا تمالئ أصحاب السلطة، الأمر الذي يشير إلى نقضه لمشروع الإخوان المسلمين.
أمّا عن مدراس التجديد المنشودة، فيحدثنا عبد المتعال الصعيدي أنه ينبغي ألا يقتصر جهدها على التغني بفضائل الإسلام وعظمة حضارته وورع رجاله وعدلهم، بل يجب تخطى ذلك كله إلى دراسة متأنية لواقع المسلمين للكشف عن علة جمودهم ومعوقات نهوضهم، ووضع برنامج إصلاحي للتغلب على هذه المعوقات متخذًا من الأصول الشرعية سبيلًا للتغلب عليها، موضحًا أن الثورة والقوة التي يجب أن تتحلي بها مدرسة الإصلاح لا تعني التغيير المفاجئ أو الوثوب على السلطة لفرض الرأي، بل هي روح النضال التي لا تهادن الرجعية ولا تمالئ أصحاب السلطة، الأمر الذي يشير إلى نقضه لمشروع الإخوان المسلمين.
أما القوة المرجوة، فتتمثل في كثرة الأنصار الذين يعملون على تطبيق خطة الإصلاح، وذلك لن يتحقق إلا بالخطاب المستنير الذي يرشد الجماهير ويوعيهم ويجيّشهم لخدمة غاياته، ويعمل على إقناع الرأي العام القائد بحسن نواياه والمنفعة العامة التي سوف تعود على المجتمع باسره من تطبيق مساعيه.
ونجده على الرغم من تسليمه بأنه لا كهانة ولا عرافة في الإسلام، إلا أنه يؤكد على ضرورة وجود صفوة من علماء المسلمين يقومون على عقائده وشريعته ليجددوها ويبصروا بها الناس، مستشهدًا بقوله تعالى "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون" (التوبة :122)، وقد كان الصعيدي من أوائل دعاة إنشاء مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى لحكماء الإسلام واتحاد علماء المسلمين أيضًا. ويشترط الصعيدي ألا تنحصر هذه السلطة في طائفة أو جماعة بعينها، وألا يكون لهم سلطان أو سطوة إلا النصيحة والإرشاد.
وهو يعيب في ذلك على "خالد محمد خالد" ( 1920م - 1996 ) تلميحاته التي وصف بها بعض الجامدين والمتعصبين في الإسلام بأنهم كالكهنة.
ويكره في الوقت نفسه من الشيخ "محمد الغزالي (1917م-1996م)" إدانته "لخالد محمد خالد" والتشكيك في نواياه تجاه الإسلام، مؤكدًا على ضرورة تحلي المجددين بالاعتدال في نقداتهم ومساجلاتهم والعزوف عن آفة التعصب في التصريح بآرائهم وذلك لإتاحة الفرصة للحوار بينهم وبين خصومهم، وهو يتفق في ذلك تمام الاتفاق مع محمد فريد وجدي (1878م – 1954م) الذي سوف نتناول مشروعه لاحقًا باعتباره أحد المجددين في معيّة المحافظين - مبينًا أن التجديد مثل قارب النجاة، دفته الإصلاح ومجدافيه التسامح والتعقل، ويقول "إن للإسلام رجال دين علماء لا كهنوت، وأنه يجب أن يكون لهم حق إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالدين، وأن الذي يجب أن يُصلح ويُقَوم فيهم هو جمودهم لأنه هو الموجود الآن فيهم لا الكهانة" .
ويمكننا أن نلاحظ من العرض السابق لحديث "الشيخ الصعيدي" عن معنى التجديد وسمات المجدد، وحكمه على المجددين العديد من الأمور منها، ما هو خاص بمنهجيته في معالجة هذه القضية وبعضها يعكس تأثره ببعض معاصريه، والبعض الأخر يكشف لنا عن علة موقفه من بعض قضايا التجديد الأخرى. فأولها : يبيّن أن "الصعيدي" كان أقرب إلى الاتجاه العقلي الانتقائي أو إن شئت قل (الاتجاه المحافظ المستنير) منه إلى الاتجاه السلفي المعاصر، وذلك في تحديده معنى التجديد، وصفات المجدد، وتجويزه ظهور المجددين في أمة الدعوة شأن أمة الاستجابة، ذلك فضلًا عن حرصه على مقارنة حال المسلمين ومجدديهم وحال غيرهم من الأمم المعاصرة لهم وذلك خلال تقييّمه لأعمال المجددين في كل جيل.
فذهب إلى أن حال المسلمين في القرن الثاني عشر الهجري كان يسير من السيئ إلى الأسوأ، وذلك على أثر استدانة "آل عثمان"، وإهمالهم شئون الخلافة، وانحطاط نظم التعليم في الولايات، وترّدي القيّم والمبادئ الأخلاقية والروحية، وتفكك الروابط الاجتماعية وظهور الحركات الانفصالية والمليّة، التي ضاقت بعنصرية الاتراك واعياها تعصبهم واستبداد حكامها الأمر الذي انعكس على طبيعة التجديد والإصلاح في هذا القرن، فلم يظهر سوى دعاة إصلاح ديني أقرب إلى السلفية منهم إلى التحديث.
في حين كان المجتمع الغربي على النقيض من ذلك الجمود والتشرذم تمامًا، حيث التقدم على الصعيدين العلمي والفلسفي والثراء الاقتصادي والثقافي، وظهور النهضوّيين والتنويرييّن الذين أعادوا صياغة العقلية الأوروبية، أضف إلى ذلك دعوة فلاسفة هذه الحقبة إلى الثورة على الاستبداد وتحقيق العدالة والمساواة والسلام بين الشعوب، وحرية الفكر والاعتقاد.
وخلص من هذه المقابلة إلى أن أمة الإسلام كانت أحوج إلى تجديد "إسحاق نيوتن 1643-1727م"، و"مونتسكيو 1689-1755م"، و"فولتير 1694-1778م"، و"روسو 1712-1778م"، و"ديدرو 1713-1784م" بعد تهذيب آرائهم ونقدها وغربلتها وتطهيرها ممّا يتعارض مع الثوابت الشرعية. وبيّن أن ذلك أفضل من مسايرة جمود الفقهاء السلفيين الذين مكنوا الأوروبيين - بجمودهم وجهلهم بأصول الحضارة الحديثة - من الانقضاض على البلاد الإسلامية والاستيلاء على ثرواتها، وظهور في الوقت نفسه الجماعات الجامحة والفرق الجانحة والفلول الماجنة، ذلك فضلاً عن تساؤل جمهور المثقفين عن علة تأخر المسلمين وتقدم غيرهم وكيفية اللحاق بالأمم الراقية وإحياء مجد الحضارة الإسلامية التليد. ويقول: " كان المسلمون في هذا القرن أيضًا ينتظرون مجدده من بين الفقهاء الذين لا يعرفون شيئاَ سوى الفقه وما إليه من العلوم، فعاشوا بين تقليب أوراقه، يجهلون دنياهم الجديدة، وما فيها وتجهلهم هذه الدنيا، لأنهم يعيشون في دنيا قبلها مع إنهم كانوا يحتاجون في هذا القرن إلى مجدد يعرف دنياه الجديدة، ويعرف ما جد في العصر الحديث من علوم ومعارف لينفع المسلمين بها، وينهض بهم كما نهض غيرهم في هذا القرن" .
ويضيف "الصعيدي" أن أوروبا كانت تدعو إلى الحكومات الدستورية منذ أخريات القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادييّن، وشاغلة بالمخترعات الحديثة والأسلحة الفتاكة، وعلى النقيض من ذلك كان الخلفاء مشغولين بتثبيت عروشهم وقمع الحركات الانفصالية، وصدّ الهجمات الأوروبية وإحاكة المؤامرات ضد أحرار الفكر، وصياغة الفتاوي التي تحرّم العلوم والفلسفات الغربية، وتبرر في الوقت نفسه انتحال بعض النظم العسكرية والقضائية الأوروبية الحديثة. كما بيّن الصعيدي أن المجددين في القرن الثالث عشر الهجري لم ينجحوا أيضًا في النهوض بالأمة الإسلامية، وذلك لأن بعضهم عُنيّ بالتجديد في الأمور المدنية وأهمل الشئون الدينية، (ويقصد هنا مشروع رفاعة (1801-1873م) وعلي مبارك (1823-1893م) في مصر وجماعة الاتحاد والترقي في تركيا)، والبعض الأخر جنح عن الأصول الشرعية والمبادئ العقلية وأضحى عاملًا من عوامل التبديد وليس التجديد (ويقصد هنا الفرقة البابية والفرقة البهائية وعبدة الشيطان وجل التيارات العلمانية المتأثرة بالفلسفات المادية والأيدولوجيات الإلحادية)، والقليل منهم هو الذي عرف الطريق الصحيح وراح يدعو العامة والخاصة للموازنة بين القديم والجديد والموائمة بين الدين والعلم (ويقصد هنا مدرسة الشيخ حسن العطار (1766-1835م) ثم مدرستي الأفغاني ومحمد عبده)، غير أن الرجعييّن ورعونة الحكام وجهل الجمهور حال بين أولئك المجددين وبين تحقيق رسالتهم.
وظل هذا الضعف سائدًا في القرن الرابع عشر الهجري، وزاد عليه خضوع معظم الولايات الإسلامية إلى الهيمنة والسيطرة الأوروبية، واستجاب المسلمون للنعرات القومية التي روّج لها المستعمر، ذلك فضلًا عن تفشي الطائفية والحزبية المليّة في الرأي العام، وانشغل قادة الفكر بألاعيب الساسة وانصرفوا عن رسالتهم الإصلاحية، وراحت الطرق الصوفية ترتع وسط عالم الكسالى والمتنطعين والجامدين، فزيّفت وعي الجمهور وصرفتهم عن البحث في أمور دينهم ودنياهم.
مؤاخذات الصعيدي ونقداته لمخالفيه في التجديد:
انتهى عبد المتعال الصعيدي إلى أن تمزق الأمة الإسلامية، وأفول نجم حضارتها كان أمراَ محتومًا، إذ بلغ الغرب في مطلع القرن العشرين الميلادي ذروة قوته العسكرية واستقرت فيه ثقافة الروح العلمية والفلسفية، التي تدفع المجتمع إلى النهوض والرقي، فقضت سنة الحضارات بخضوع المسلمين إلى الاستعمار الروسي في أسيا وبعض بلدان أوروبا، والاستعمار الإنجليزي والفرنسي والإيطالي في أفريقيا وشبه القارة الهندية .
كما ذهب إلى أن مجددي ذلك القرن قد انقسموا إلى أحزاب واتجاهات عجزت جميعها عن إعادة البناء وإصلاح ما أفسده الجهل والجمود والتخلف، "فمصطفى كامل 1874-1908م"، و"قاسم أمين 1863-1908م"، و"محمد فريد وجدي 1878-1954م" قد حاولوا الإصلاح في جانب وأهملوا الجوانب الأخرى، بينما غلب على كتابات "طه حسين 1889 - 1973م " النكوص والتردد وعدم القدرة على التأليف بين الأصيل من الثوابت والحديث من المتغيرات.
الأمر الذي جعل الكثيرين من المحافظين وضعه في قفص الاتهام ونعته بالجنوح والتجديف والشطط أحيانًا. ويضيف أن معظم كتاب القرن العشرين قد أهملوا توعية الأجيال الشابة من خطر الغزو الفكري وأكاذيب المستغربين والمتشيعين للفلسفات المادية الالحادية. ويقول "ويمكننا بعد هذا أن نحكم بأن الأقرب إلى التجديد الإسلامي في هذا القرن هو من كان يجمع بين الثقافة القديمة والحديثة، وينادي بالإصلاح الشامل لأمور الدين والدنيا، وهذا لم يتوفر في واحد من هذا القرن من أوله إلى يومنا هذا كما توفر في الشيخ محمد عبده" وكبار تلاميذه.
أما المتفرنجون؛ فلم يكن شرهم أقل من الجامدين، فقد دعوا إلى تقليد الغرب دون تمحيص أو الإبقاء على الشخصية الإسلامية.
ولا غرو في أن هذه المقابلات والتحليلات التي قام بها "الصعيدي" للواقع الحضاري للمسلمين في العصر الحديث تكشف عن منهج عقلي في النقد، وثقافة موسوعية ودراية بفلسفة الحضارة، رشحته لاعتلاء منبر المستنيرين في النصف الثاني من القرن العشرين، وأفصحت عن انتمائه لمدرسة الإمام "محمد عبده" ذلك الذي وصفه بالإمام والمعلم ورائد الإصلاح والتجديد الذي يجب السيّر على سنته في إصلاح الدين والدنيا، وإنهاض المسلمين.
ولا يؤخذ على "الصعيدي" إلا عدم درجه "رفاعة الطهطاوي" ضمن المجددين وذكر إياه عرضًا، رغم مناقشة "رفاعة الطهطاوي" لقضية التجديد والمجددين من جل نواحيها - التي أشرنا إليها سلفًا - إذ تحدث باستفاضة عن "كتاب السيوطي" وحديث المائة الذي استشهد به وصفات المجدد وعدد المجددين في القرن الواحد، ذلك فضلًا على اشتراطه الاجتهاد في المجدد - وكذا تجاهله لجهود "محمد إقبال (1877-1938م)" رغم اتفاقهما في العديد من القضايا، وتوسعه في عرض فكر "الباب ميرزا على محمد (1819-1950م)"، و"البهاء ميرزا حسين على (1817-1892م)"، و"ميرزا غلام أحمد القدياني (1835-1908م)" دون تبرير إلا رغبته في فضح حقيقة هذه الاتجاهات الهدامة التي افتتن بها بعض المسلمين، ولاقت قبولًاً لدى الأمريكيين والأوروبيين، وكذا نقض الصعيدي فكرة المهدي المنتظر التي تبناها المتواكلون، ووقفوا عليها بعث مجد المسلمين ونهضتهم بعد كبوة لا يعلم مداها إلا الله.
أمّا المأخذ الثاني فيبدو في تأثره بالسابقين عليه وموافقته لبعض معاصريه، التي لم تكن على سبيل المسايرة والتقليد بل كانت وليدة نظرة تحليلية نقدية تعبر عن رؤية صاحبها الخاصة.
فلعل نقداته لبعضهم كانت وراء غضبة الأزهريين عليه والمفكرين الحداثيين أيضًا، فعلى الرغم من تصريحه بإعجابه "بجمال الدين الأفغاني" نجده يعيب عليه بعض النواحي في نهجه الثوري في الإصلاح ويخالفه في حكمه على "السيد أحمد خان (1817-1898م)"، إذ حسبه "الأفغاني" من أذيال الإنجليز وواحدًا من الذين ارتدوا عن دينهم وخلطوا بين الأديان بغية توحيدها شأن الماسونيين وحرفوا الكلم في تأويله للقرآن، ودعوا إلى مسايرة أوروبا وتبني فلسفتها المادية، في حين جعله "الصعيدي" من المجددين الذين يُؤخَذ منهم ويُرَد عليهم.
وقد خالف "الصعيدي" الإمام "محمد عبده" - الذي أكد بانضوائه تحت رايته وانتهاج ضربه - وذلك في موقفه الناقض من "محمد على باشا (1767-1849م)"، اذ كان يرى فيه - الأستاذ الامام محمد عبده - القائد التاجر والزارع والجندي الباسل والمستبد الماهر والحاكم الظالم، الذي قهر المصريين وانتهك كرامتهم، وذهب إلى أن نجاحه في العمران لم يكن سوى نجاح المستعمر الذي يعمل من أجل مصلحته، وتوطيد أركان ملكه وليس من أجل المصريين. كما أن خلفائه من بنيه لم يحسنوه معاملة المصريين، بل كانوا مثل الاتراك في جحودهم وتعاليهم.
ورغم ذلك كان "الصعيدي" يرى أن موقف "محمد على" الداعم لخطاب النهضة ومشروع التحديث قد دفع الرأي العام القائد وشجع الرأي العام التابع لنجاح حركة التجديد التي اضطلع بها "حسن العطار"، و"إبراهيم باشا" وغيرهما من المصلحين في شتى الميادين. وبرر عزوف محمد على عن إصلاح الأزهر يرجع إلى عنت شيوخه ورفضهم لمشروع حسن العطار وخوفهم من غضبتهم وتهييجهم للرأي العام. كما نجد الصعيدي يتفق مع "محمد إقبال"، و"عباس محمود العقاد" (1889-1964م) في مؤاخذاتهما على "محمد بن عبد الوهاب (1703-1792م)" ودعوته، ذلك لأن ما جاء به لم ينهض بالبلاد ولم يُحَدِث المجتمع، ولم يُخَلِص الفكر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الجزيرة العربية من جموده.
كما يأخذ محمد إقبال والعقاد على محمد بن عبدالوهاب عزوفه عن العلوم الغربية الحديثة، وتعويله على الميراث الفقهي في التأويل وحده، وقصره باب الاجتهاد على شرح الأحكام الشرعية، واستناده على الأحاديث في الفتوى دون تمحيص لها وإهماله متطلبات الحياة العصرية. ويوافقهما في تقييمهما لحركة "السيد أحمد خان" وثورة "كمال أتاتورك". ويخالف في الوقت نفسه أحمد أمين (1886-1954م) في إدراجه الحركة الوهابية ضمن الحركات النهضوية الإسلامية.
(وللحديث بقية)
بقلم : د. عصمت نصار