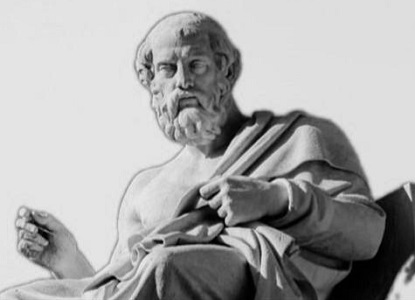صحيفة المثقف
معالم الثورة في الإنذار الهودي
 أصولُ الثقافة الثوريّة في القرآن (4)
أصولُ الثقافة الثوريّة في القرآن (4)
يتضمَّن "الإنذار" الهودي ثورة عظمى كأقوى ما تكون الثورة، إذ يفتح المسافة سانحة لحرية الاعتقاد من جهة، ويقيمها متصلة بآفاق الاستقامة من جهة أخرى، فالحرية على وجه العموم مؤسسة في الإنذار الهودي على الاستقامة، وهذا هو وجه الأهمية كما أنه وجه الخصوصية في ثورة هذا الانذار، فعندما قال هود عليه السلام لقومه: "أعبدوا الله ما لكم من إله غيره"، لم يتوقف "الإنذار" في ثورته هذه عند ذلك الحد، ولكنه أعقبَه بإنذار يؤكده من جنس تلك الثورة المنذرة، غير أنه في مستوى آخر وبمعْلَم آخر يضم البشارة ويضع أمام الأنظار حسن العاقبة.
يا قوم لا أسألكم، فيما أنذر به لكم، لا أسالكم على نعمة الإنذار أجراً؛ لأن أجري لا هو عليكم، بل على الذي فطرني؛ على الله الذي تولاني في أنْ أقدَّم لكم إنذاري هذا، أفلا تعقلون؟! أفلا تكونوا - فضلاً عن كونكم مُفترين - قربين من العقل، فتعتقدون أني أسألكم - حال كوني مُنذراً لكم - أجراً على هذا الإنذار أو على النعمة التي تصادفكم لو أمتثلتم طاعةً لفكرته العقائدية الكبرى؟
يا قوم! إنْ أردتم أن يُرسل الله السماء عليكم مدراراً، ويزدكم قوة إلى قوتكم؛ فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فلئن كانت لكم قوة غشومة هى مدعاة الافتراء لديكم؛ فإنّ القوة التي تضاف إلى قوتكم بعد التوبة والاستغفار إنما هى قوة تتحوّل بها طاقتكم الغشومة إلى قوة أخرى إلهية هي لا تكونن من جنس القوة التي أدت بكم إلى منازل الافتراء، بل ستصير قوة عليا من رافد إلهي عظيم.
وهذا هو موطن الزيادة من القوة المُضافة إلى قوتكم بعد اعتقاد الإيمان، وبعد انشغال الظاهر والباطن بعظمة الاستغفار ثم التوبة الخالصة إلى الله تعالى. وهذا هو موطن الثورة في ذلك الإنذار: أن تتحوّل القوة من جانب سلبي إلى جانب إيجابي يضاده، وأن تتبدل الوجهات والاعتقادات، وأن يصير الكفر إيماناً، والخبيث طيباً، والشر خيراً، وأن يتغير جو الحياة الباطنة تغيراً تاماً كاملاً ليس يدع للنقيضين اجتماعاً .. إمّا حق وإمّا باطل، وإمّا كفر وإمّا إيمان، إمّا شر وإمّا خير، وإمّا صلاح وإمّا ضلال.
هنالك تتنزل الرحمات؛ لترسل السماء مدرارها، وتزيد القوة زيادة مشروطة بالإنابة والرجوع وتحويل القصد والغاية إلى متجه آخر؛ فإرسال السماء مدراراً، وزيادة القوة المضافة أمور مشروطة بالثورة الباطنة وقلب أنماط الحياة وتحقيق التحول اللازم من حال في الحياة إلى حال آخر؛ فالاستغفار في ذاته حركة ثورية لإزالة الواغش الدفين في أعماق الذات، وهو سبب السعادة والمتاع الحسن في هذه الدنيا؛ لأنه سبب مباشر لتحقيق التوازن والانسجام والطمأنينة القلبية، وما من فضل يؤتيه الله لكل ذي فضل إلا والاستغفار شرطه الأول، والاعتذار عن سابق الغفلة دعامته الكبرى. وهذه هى البشارة التي اشتمل علها الإنذار الهودي من حيث كونه نذيراً من الله، وبشيراً. ومن غلبته نفسه - كما في إشارات العارفين - وقع في المعصية التي تغضب الله. وأن الأصل في كل معصية وغفلة وشهوة هو الرضا عن النفس. وأصل كل طاعة ويقظة وعفة؛ عدم الرضا منك عنها، ولأنْ تَصْحَبْ جاهلاً لا يرضى عن نفسه، خيرٌ لك من أن تَصْحَبْ عالماً يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؛ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟!
ولعلك تلاحظ تكرار قوله: " يا قوم، ويا قوم، يا قوم " ثلاث مرات، وفي كل مرة تنتهي الآية بتعقيب على الحكم بما عساه يدل على الثورة دلالة ظاهرة، مباشرة، ففي المرة الأولى تنتهي الآية بثورة الكلمة بما فيها من وقع قاسي في قوله: "إنْ أنتم إلا مفترون"؛ لأن وجود الافتراء لديهم شائعاً قد صرفهم عن عبادة الله الذي ما لهم من إله غيره؛ ففي هذه الحالة يكون الخطاب، فيما لو أردنا كشف الثورة الداخلية فيه، مُوجّهاً إليهم في لفظة "يا قوم" هذه، تنبيهاً يدل على قوة الإنذار وشدّة تبليغه، ليشمل كل الأبعاد التي جاء ليحققها، ثم تكرار هذه اللفظة مع القوة المنذرة لتوكيد مضمونه، واختلاف صفة الحالة التي عليها القوم في جزء جزء من أجزاء معالم الإنذار الثائر.
في الحالة الأولى؛ يا قوم أنتم مُفترون؛ لأنكم لا تعبدون الله - وما عبدتم الله - الذي ما لكم من إله غيره. وفي الحالة الثانية؛ يا قوم أنت لا تعقلون؛ لأنكم تعتقدون أني أسألكم أجراً عمّا مكنني الله فيه من إنذار إليكم، ولا تعرفون إن أجري إلا على الله الذي فطرني، وهو الذي بعثني إليكم فأمدني بعين الاعتقاد الذي أنذركم؛ إذ أنهاكم عما تفترون به على الله كذباً، فتشركون في دعواكم أن لله شريكاً؛ وهذا هو عين الافتراء كما أنه عين الجهل والغباء، وهو كذلك كل السَّفه الذي يوجبه البعد عن العلم والعقل والقرب من الجهل والعناد. ولتلحظ الثورة في تكرار اللفظة "يا قوم" مع اختلاف الصفة "اللاعقل" في هذه الحالة؛ لتجيء مع الملاحظة تأكيداً على تحول "الإنذار" وتنوّع أهدافه ومراميه؛ ليتخذ وجهاً آخر من معالم التثوير.
ثم تأتي الحالة الثالثة؛ فترى الإنذار يتشكل في مستوى مغاير، بتشكل مراده الثائر في صفة ثالثة مختلفة عن الصفتين السابقتين؛ وهى صفة "التولي المُجرم"؛ في قوله "ولا تتولوا مٌجرمين"، فإنِّ الحرص على الاعراض عن الحق هو إجرام بكل تحقيق. والمُراد من تكييف الثورة هنا تكييفاً يجمع خيوطها المتفرقة الأجزاء في كلية من التصور العقدي عامة، هو مراد التمكين من العبادة المثلى على تحقق معنى العبادة في أسمى مراحلها وأخلص أسرارها : التوبة والاستغفار. هذا تراتب حركي فاعل لم يكن مجرد تكرار وكفى، بل لغرض أسمى وأنبل : حظ المنطقية والقبول فيه أعلى من أية حظوظ متوهمة تؤدي للتناقض والارتباك.
قسط النبوة هنا تبليغ، ولكن صفة النبيّ أقدر بعون الله على البلاغ وأصدق تصديّاً لكل ما ينقضه أو يحاول طمس معالم ثورته وهو مدود العون بمدد السماء؛ فاليقين النبوي أدعى إلى إزالة العقبات، وأوفر ثقة وطمأنينة وأرفع مقصداً من أن يتولاه اليأس من التبليغ حتى ولو كان التولي أو كان الإجرام هماً السد المانع من حركة الثورة في إنذار لم يشأ له أن يتكمل ويؤدي الغرض منه. ولا أقلَّ ميراثاً لهذا اليقين النبوي من قدرة الاستبصار وحدة الإدراك، فلو لم يكن يقيناً لما اتخذ من الصمود عوناً وعصمة، ولما صاحبه الاستبصار الكاشف عن شتى المألات.
والتولي والإجرام هما صفة الذين لا يستقبلون الثورة إلا وهم معرضون؛ ففي تلك الحالة الأخيرة من ثورة الإنذار الهودي، ترى تشكل الخطاب بنبوءة العاقبة الحميدة في حالة الثورة بتكرار اللفظ "يا قوم"، وفي حالة اختلاف الصفة عن بقيّة الصفات السابقة في قوله "لا تتولوا مجرمين"، فكأن الإشارة تعطي دلالتها : يا قوم لا تتولوا مجرمين عن استغفار ربكم وعن التوبة إليه، فلئن كان الحرص على الإعراض عن الحق هو تولى وإجرام بكل تأكيد، فإنّ الاستغفار إزالة لكل إجرام، والتوبة الدائمة عقبة أمام التولي وأمام الإعراض.
ويجرى السياق مجراه الثائر المنبّه إلى أن في مثل هذا التولي إجرام غير محمود العواقب، ولا هو ممّا يُرجىَ لقوم أرسل الله لهم نذيراً من عنده، ولكنكم - هكذا يمضي السياق - إنْ استغفرتم ربكم وعاهدتموه على التوبة إليه، وهو شرط النبوءة بمحمدة العاقبة، كانت النتيجة من وراء ذلك أنه سبحانه يرسل السماء عليكم مدراراً غزيراً متتابعاً بلا انقطاع فيه إضرار، وبلا تتابع فيه مضرَّة. ثم إنه لا يكتفي بإرسال السماء عليكم مدراراً بالعناية والحفظ، ولكنه يزدكم قوة من عنده إلى قوتكم إن كنتم تحسبون أنكم أقوياء على الحقيقة، ولو كنتم أقوياء أولي قوة ذاتية، فإن هذه الزيادة المدودة من القوة الإلهية لهي بمثابة الرعاية الحافظة لقوتكم .. أفبعد هذا يمكنكم أن تتولوا مجرمين!
هذا شئ ممّا يتضمنه الإنذار الهودي، فكيف كان استقباله من قومه، رغم ما به من ثورة مشروطة بصلاح العاقبة، كيف كان استقبالهم لهذا الإنذار الثائر؟
بعض الناس فينا، وبخاصّةِ من ذوى النفوذ، إذا أنت ذكّرته بقوة رب العالمين، قابله باستخفاف شديد، ولم يكتف بذلك بل يدمن السخرية من المقولات الدينية ويأبى منك أن تذكره مجرد تذكرة، هو إعراض وتولي وكفى. حقيقة أنه لأمر شاق على القلوب، عسير على النفوس، وبخاصّة نفوس وجهاء القوم وساداتهم، وقلوب هؤلاء الذين ينظر إليهم الناظر لأجل مكانتهم الاجتماعية بين الناس.
يشق على قلوب هؤلاء المترفين ونفوسهم أن يستقبلوا الثورة التي من شأنها أن تكتسح مكانتهم التي اعتادوا أن يظهروا بها بين عشيرتهم :"وما أرسلنا في قرية من نذيرٍ إلا قال مُتْرَفُوها إنّا بما أرُسلتم به كافرون"(سبأ: 34).
ولماذا المترفون؟ لأنهم الوجهاء والسادة أصحاب السلطان والنفوذ، أصحاب الأمر والنهي، أصحاب الكرامة الصوريّة والسفالة الخلقية، هم القراصنة والأباطرة والطواغيت، هم الآلهة في الأرض، وهم الكبراء الذين لا يطيلهم سهم ولا ينالهم أذى، هم الذين يجرمون ويتولون ولا يريدون أن يُنزَع عنهم السلطان ولا الجاه ولا النفوذ ولا الصولجان، هم الذين يتعرضون لتكذيب الإنذار، ويعرضون عنه، فالثورة عليهم وضدهم أولى وأجدر وأقمن أن تسير سيرها تجاههم متحدية منذرة.
وإنه لشيء طبيعي أن يرفضوا الإنذار الثائر ولا يتمثلون أو يمتثلون منه إلا الصدود والعزوف يجيء منهم تأكيداً للجاجة والرفض ومقاومة الاستسلام بدواعي وأسباب ومبررات تبدو منهم أقوى من قوة الإنذار الثائر نفسه، وأحكم في المناهضة من مجرى التصديق، ولو كان في المناهضة تلف أرواحهم، وطبيعيٌ يتَحَدُّوا ثورته فلا يستجيبوا لها، ولم لم تكن منهم هذه القوة الرافضة مدعاة للتولي المُجرم، ما كان يمكننا أن نطلق عليها صفة "الثورة" من حيث كونها نذيراً أميناً، وما كان يمكننا كذلك وصف القائمين عليها من حيث إنهم يتجسد فيهم، روّادها وقادتها، وحملة مشاعلها، ذلك النور الروحاني الخالد الباقي، بمثل هذا الخلق الذي يندرج في الأصل تحت "أخلاق الثائرين".
"قالوا يا هود : ما جئتنا ببيِّنةٍ، وما نحن بتاركي ألهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. إنْ نَقولُ إلا أعتراكَ بعض ألهتنا بسوء".
لاحظ قوة رد الفعل وهى ولا شك من نفس القوة التي جاءت بها قوة الإنذار الثائر، حتى إذا ما كانت الثورة فيه فياضة بالقوة جاء رد الفعل يتناسب مع قوتها تناسباً عكسياً، لكن الفرق كبير جداً بين قوة الحق إذ كانت ثورة، وقوة الباطل إذ كانت رفضاً ومكابرة، تظهر في رد الفعل وهو مغلف بالسخرية.
فلم يكن هنالك تمهل منهم ولم يكن هناك انتظار، بل كانت المكيدة وكان التبريء ممّا يشركون تبرءً توكل فيه منذرهم على الله ربّه وربهم الذي كانوا به يشركون. وها هم قد اتّصفوا بالجحود، جحود آيات الله، واتصفوا كذلك بعصيان الرسل واتباع أمر كل جبار عنيد، ولكنهم لم يتركوا، بل كان الإمهال من الحق تعالى إبعاداً فيه لعنة، حين أُتبعوا في هذه الحياة الدنيا لعنة، وفي يوم القيامة ألا بعداً لعادٍ قوم هود.
إنَّ الصورة التي يرسمها القرآن لثورة الإنذار الهودي لهي من أجل وأعظم الصور الباقية التي تحققها ثورات العارفين، والجهاد فيها من أشرف مراقي الجهاد بالنفس الأبية والقدرة الزكية والعون المدود وهو لا شك جهاد الأنبياء، وجهاد مَنْ والاهم واستن بسننهم إلى يوم الدين، فالصورة الثورية باقية في الأنفس وفي الآفاق لم تزل محفوظة لا في ذاكرة الوعي بمفردات القول الإلهي فحسب، ولكن بالإضافة إلى ذلك تضيء جوانب الطريق، وتظل محفوظة على وجه الزمان الذي تقام عليه ثورات الفاعلين، ومن ورائها ثورة القرآن في التغيير والإصلاح.
فالإنذار الهودي يؤكد قوته الثورية في ذاته أولاً، ثم تجيء الصورة المرسومة له بهذا النموذج الفعال في عالم الواقع حافلة بالأسس التي تخرق حجب الزمان والمكان : قوم آمنوا به، فكان أن نجّاهم الله معه بإيمانهم، وقوم نكروه وطلبوا الإعجاز فما تركوا آلهتهم وما آمنوا به وقالوا : لا نقول إلا أن أصابك الخبل والجنون! فلا تنطفئ شعلة الإنذار بهذه الواقعة أو فيما بعدها، بل تستمر وتوقد وتستنير، فنَفَسُ الباطل إزاء الحق قصير.
غير أن هذه الشعلة المتوقدة المستنيرة تمضي معنا؛ لتعبِّر عن ثورة البلاغ القرآني كله ممثلاً في هذا الإنذار الثائر وفي غيره من إنذارات الرسل الأكرمين.
هنالك قوم سبق لهم أن توجهت إليهم إنذارات كثيرة من رسل كثيرين؛ فإن لم تكن لكم عبرة التفهم لهذه الثورة : شأنها الحاكم وأفقها الواسع، من نفوسكم وضمائركم .. ما مفادها وما دلالتها؟ وكيف يترائى لكم واقعها فيكم؟ وماذا عساه يكون استخدامكم لها في واقع حاله أشبه بمثل هذا الواقع المتردي وهو واقع ستعيشونه في مستقبل الأيام وسيحتاج بالفعل إلى روح الثورة لتطهيره وتنقيته من عوامل الجمود والكنود والفساد؟! وهل اعتبرتموها أم لم يكن لديكم اعتبار فيما يتصل بها من معادن الفهم والاستيحاء .. فما يصح اللوم من بعدُ إلا على العقول التي لا تدرك، وإلا على القلوب التي لا تعقل، وإلا على الآذان التي لا تسمع كلمات الحق ولا تعي ذاكرة القرآن وهى مفعمة بثورات التغيير :"أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؛ إن في ذلك لآيات لأولي النهى" (طه : 128) :" أوَ لمْ يهدى لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؛ إن في ذلك لآيات؛ أفلا يسمعون؟!" (السجدة: 26).
الثورة الروحيّة .. ذاتيّة في القرآن وخاصّة :
يلخص القرآن، بقص القصص الوارد بين صفحاته المباركة، جهود البشرية في كفاحها المتصل وفي سيرها الحثيث المتوازن من أجل تحرير الروح الإنساني وخلاصه من التعلق الواصب بالطينة الأرضية. ولم يكن ميراث النبوة في أصل عنصره الرفيع سوى هذا الجهاد الدائم المتصل في الحق، ومن أجل التماس ذلك النور الروحاني من مظانه الرئيسية وأشعته الباقية، واستمداد أسبابه ووسائله. ولم يكن خلوص العبرة إلا علامات يدركها أولو النهى، غير أنها تتفوّت على أصحاب الشواغل الدونيّة، الأرضيّة، في حين يدرك حكمتها وحكمها أصحاب العقول والأرواح، ويخفق في إدراكها لا محالة من شغلته الأوهام والأشباح.
على أن ثورة الروح بكل تأكيد علامة ارتقاء العقل وارتقاء الفكر وارتقاء القلب والضمير، ودلالة التمسك الواصب بقوانين الملأ الأعلى، لأنها ثورة من عند الحق بإزاء الباطل، مقصودة. والجهاد في سبيلها هداية إلى الحق من أقرب طريق:" والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبُلُنَا". لكن ثورة الباطل في المقابل مهما طالت واستطالت فهى في نهاية المطاف تنعكس بالسلب على أصحابها، ولم تكن مسائل المصير الإنساني برمتها إلا الصدى المباشر لذلك الانعكاس.
الثورة بهذه المعالم في أجلى مظاهرها خاصَّة قرآنية، ذاتية هى، ولا جرم في وجودها ضمن الخواص الذاتية للقرآن، ومن أهم معالمها الاستقامة المقرونة بالتحدي: تحدي الباطل، وتحدي الشر، وتحدي الآفات والرذائل، وتحدي الضعف والخنوع والتكاسل والتقليد. وما أكرم الصلة الوثقى بين الاستقامة على الأمر الإلهي والحرية الحقيقية .. ما أكرمها!
فالاستقامة تعتمد على مضمون ديني، تستند إليه وتأخذ منه وتعطي صاحبها على أساسه، أي تعتمد على الكتاب الكريم وسنة رسول الله، صلوات الله عليه، فيما خاطبه الحق تعالى واسْتقم كما أُمِرْتَ؛ وهذا عندي هو ما يميّز الثورة في القرآن كونها خاصة ذاتية دالة عليه. ويتأسس مبدأ الحرية على تحرير الإنسان عن كل نوازع الشر والحيوانيّة واتصاله بمصادر الإلهيّة فيه، فلن يكون إنساناً، وهو يُعطي الفرصة سانحة للأغيار أن يدفنوه حيّاً بين صراعاتهم ومكاسبهم ودحرهم للقيم الإنسانية العاملة، أو لنزوع حيواني يفعل فيه هو نفسه الأفاعيل، ويُرْديه صريعاً مع الأهواء القاتلة تغالبه ويغالبها؛ فلا ينتصر عليها إلا بمقدار ما لديه في الغالب من حكمة : إخلاص المرء لعقله، وبذله الجهد للتفكير بنفسه، هنالك تتجلى قيم الحرية في أعلى مستوياتها، إنها (أي الحريّة) ازدهار العقل في أنفسنا، وهى أيضاً تربية وإصلاح لغيرنا؛ لأن الحريّة الشخصية لا تنفصل عن حرية الغير؛ فكما تطالب بالحرية لنفسك، فليس من حقك أن تجور على حرية الآخرين، أو تقلل من شأن هذه الحريّة لهم، وبما أن للحرية متنفّساً عاماً وإنسانيّاً، فالعبيد وحدهم هم من يضيّقونها ويذلّون الإنسان بحرمانه منها.
في سبيل الحرية إذن؛ ذلك اللحن الشّجي النّدي؛ بذل الباذلون وسعهم وأكثر؛ لمعرفة سرّ الإنسان، ولا يزال أمام الإنسان شوط واسع المدى كيما يتحرّر ويقف بالمجهود أمام نفسه أولاً ليعيش الفكرة في بعدها العملي التطبيقي واقعاً محققاً بالفعل. وفي طريق الحرية الإنسانية كان الإيمان بالروح هو أول خطوة صحيحة؛ لأنه هو أول من عَلّم الإنسان التبعة "وإنّ كل نفس بما كسبت رهينة". وهذا هو أساس التكليف وأساس الحقوق إذا حَسُن استخدام التكليف مع الإيمان بالروح.
ليس هذا فقط، ولكن الإيمان بالروح يوحي إلى العقل عقيدة المساواة بين جميع الناس أمام الله وأمام شريعة الله. وبفقدان هذا الإيمان الروحي تفقد المجتمعات الإنسانية شريعتين مهمتين أولهما : شريعة التكليف الذي يأتي من طريق التبعة. وثانيتهما : شريعة الحقوق التي تقوم عليها الديمقراطيات الحديثة اليوم. ومع فقدان الإيمان بهاتين الشريعتين يفقَد الروح الإنساني حريته على الإطلاق؛ ويفقَد معه الدلالة على وجوده، فيكون عرضة لسفه الأخلاق ونذالة السلوك وانبات الشرور وضلالة المعتقدات ونزع الإنسانية من المجتمعات.
والأصلُ في هذا هو غياب الاستقامة على الأمر : أصل الإيمان الروحي وأصل الجهاد في سبيله مشروط بشرطه لا يتعداه إلى سواه. وبفقدان أصل الاستقامة يفقَد الخُلق الإنساني وجوبه في الحياة كونه واقعاً فيها مُحَقِقاً لوجودها.
لم تشيّب هود، سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، من فراغ، ولكن لتعذر الاستقامة على الأمر؛ ولصعوبة تحققها؛ ولكشفه، صلى الله عليه وسلم، حقيقة الأمر على ما هو عليه.
وقد تظل العلاقة بين الحرية والاستقامة أظهر العلاقات ذات الروابط المشتركة، تعطي الأولى مساحة لتحديد الفعل الإنساني على شرط الاستقامة، وتأخذ الثانية نشاطها في ظل الحرية، فليست الحرية فوضى قادحة في الفعل الإنساني ناكبة الطريق إليه، ولكنها ملكة عقلية تنتظم السلوك المقرر وفق الاستقامة.
وإذا انفصلت الاستقامة عن الحرية وعملت هذه الأخيرة عملها بغير حدود ولا شروط، وبغير قواعد يتأسس الفعل عليها في العقل الإنساني، أصبحت فوضى ولها بالفوضى نسب عريق، وصارت بعينها هى القيد الذي يحد من عمل الإنسان ويعوق حريته إلى منتهاه؛ إذْ يصبح من الواجب عليه كسره وتجاوزه إلى حيث الاستقامة. فالفارق كبير جداً في مجال القيم بين القيود الحاجزة عن العمل، الحاجبة للحرية، وبين القواعد التي تتأسس على فعل الاستقامة كونها التزماً يُقَرَّر في جوف الضمير. الأولى كسرها والارتفاع عليها واجب. والثانية؛ لأنها بنت الاستقامة؛ فالالتزام بها شرط العمل النافع والإرادة الفاعلة في كل حال.
الحرية ليست فوضى ولا هى بالقيد، ولكنها تصبح فوضى في إطار العمل الفاسد مع غياب الاستقامة؛ تصبح عبودية لأنها تحوّل الفعل الإنساني من القاعدة إلى القيد : من حالة الالتزام الذي يصدر عن الاستقامة، وهو هنا القاعدة، إلى حالة القيد الذي يفرضه التحجير كما تفرضه العبودية بكل أطيافها وألوانها، وهو هنا دعوى الحرية بغير قواعد من شروط الاستقامة على الأمر.
في الحالة الأولى : يكون النشاط الإنساني مدعاة للفوضى والتخريب؛ لأنه عبودية لا يصدر عن قاعدة ولا عن استقامة.
وفي الحالة الثانية : تتصدَّر الاستقامة حرية الالتزام وفق مقرراته؛ فيجيء الفعل الإنساني نشاطاً مثمراً نافعاً بكل تأكيد. وقس على هذا المقياس كل صنوف النشاط الإنساني في مجال القيم، وفي مجال الحياة على كافة أنشطتها الفعالة.
(وللحديث بقيّة)
بقلم : د. مجدي إبراهيم