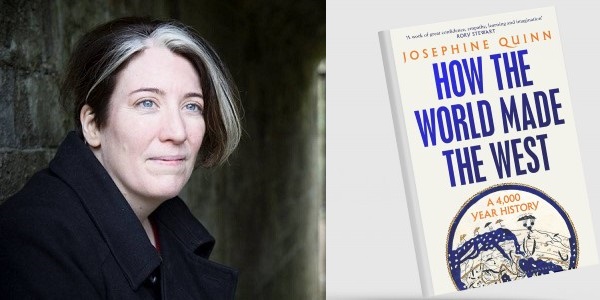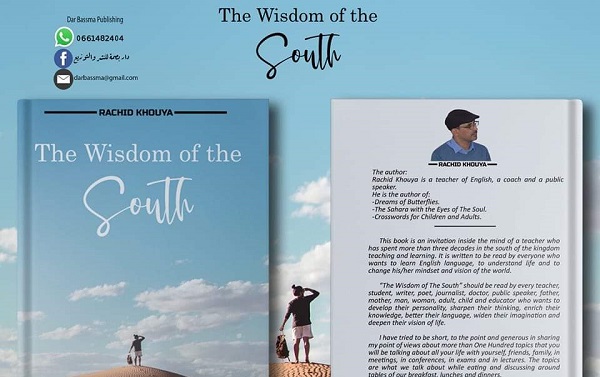صحيفة المثقف
صوتُ أبي
 في صباي حين كنتُ أعيش مع أهلي في منزلنا القديم. كانت لدينا في الطابق العلوي نافذة تطل على الشارع من غرفة والديّ. يجلس خلفها أبي ويراقبني إذا نزلت للعب مع أبناء الجيران. ولم أكن أر منه شيئاً فالنافذة ذات ستارة مشبكة. لكنني أسمع ويسمع الأخرون من صوته الجهوري المخيف. حين أنسى نفسي وأنا أهرول وراء الكرة مثلاً يأتيني صوته العالي محذراً: انتبه.. سيارة آتية. وإذا حدث شجار بيني وبين أصدقائي، يتدخل مُرسلاً صوته القوي سنداً لي، فيرتعد الصبية حين يسمعون دويّه، ويتركونني وشأني خوفاً من صاحب الصوت. في الحقيقة لم أكن أجلس كثيراً عنده داخل الغرفة، بل أفتح الباب على مهل وأسرق نظرات حين أطالعه وهو يدّخن عند النافذة. جالساً على كرسيه وواضعاً الشرشف على فخذيه. ولم أر ساقيه إلا في المرات التي تغير أمي فيها الشراشف بين مدة وأخرى. وكنتُ أسأل أمي عن سبب بقاء أبي الطويل في الغرفة، على ذلك الكرسي ذي العجلات. ولماذا لا يخرج إلى الشارع، الحي، السوق؟. لماذا لم أر صديقاً يزوره أو يزور هو أحداً من أقاربنا أو من أصدقائه؟!، فتجيب أمي: لا تشغل بالك بهذا.. هناك ما يستحق أن يشغل بالك كدراستك وواجباتك.. سيفرح أبوك بهذا. ثم تغيّر الموضوع ولا أجني منها إجابة واضحة تشفي غليلي. كنتُ أثق بصوته أكثر من ثقتي بحضوره. ففي أوقات المدرسة كان يتصل هاتفياً بالإدارة. والعجيب أن مدير المدرسة الذي كان يتزمّت في رأيه معي، يلين ويتواضع حين يتصل به أبي ويكلمه عن شأني. فيغض النظر عني إذا كنت قد أسأت في موقف ما، ويساندني إذا احتجتُ أية مساعدة في أوقات الدوام.. جابي الكهرباء المنهك حين يدخل لباحة المنزل، أكون واقفاً قربه أطالع وجهه العابس في ضجر، وما إن يسمع صوت أبي فيتبدل وجهه إلى ارتخاء وطريقة كلامه إلى لين، ثم يستعجل في قطع ورقة الكهرباء ويرميها في يدي ويخرج بخطى سريعة.. البستاني الذي يأتي كل مدة لتشذيب الحديقة، أبي كان يوجهه إلى كل خطوة يجب القيام بها في عمله، بائع الخضروات المتجول حين يخاطبه، يتسمر عند العربة ناظراً للنافذة التي خرج منها الصوت، ثم يضع لي في الكيس أجود الخضروات وأينعها. وبالنسبة لي لم يكن دوري سوى الوقوف قرب هؤلاء وغيرهم، ولكم يفرحني انصياعهم واحترامهم الواضح له. كنت سعيداً لأنني أشعر أن الصوت خارج من حنجرتي أنا. أتخيل أنني من اتحدث معهم وأهيمن عليهم واحركهم كما يحرك صانع الدمى ألعابه. حتى أنني كنتُ مرتاحاً لأنه لا يقوى على مغادرة كرسيه المتحرك. لقد منحني الصوت هيبة في قلوب من يعرفونني، لولا الخفة التي كانت عندي بعض الشيء، لكنت قد أتقنت الدور بشكل كبير. فأنا لم أكن عنيداً كأبي. عناده وأنفته إلى أبعد حد يتخيله الإنسان. لم يكن يرضى بمساعدة أحد سوى أمي، وحتى أمي رسم لها والدي حدوداً للمساعدة لا تتخطاها. ففي بعض الأحيان ينْترُ ذراعه بعنف إذا أمسكت بها أمي، ويحدجها بنظرة حادة لتذكيرها فتنتبه وتواصل عملها بهدوء. لم يكن القرب من أبي مثيراً للطمأنينة كما هو البعد عنه. حين أكون قريباً منه لا أسمع صوته كثيراً. قربنا منه يجعله صامتاً طوال الوقت. ربما لأن قربي منه يمنحه الراحة والطمأنينة على حالي. ولكن حين أدنو من الشارع ينبري عبر نافذته لمراقبتي. فلم يكن يسمح لي بالابتعاد كثيراً. باعثاً صوته المهيب لمساندتي تارة، أو لتوجيهي في قضاء شيء قبل خروجي من المنزل. كانت نظرات الخشية الدائمة في عيون أبناء الشارع من ذلك الصوت، تثير في نفسي الغبطة والتفاخر عليهم. ولم أكن أحزن إلا في الأوقات التي يذكرني فيها بضعفي. حين يصارحني منبهاً:
في صباي حين كنتُ أعيش مع أهلي في منزلنا القديم. كانت لدينا في الطابق العلوي نافذة تطل على الشارع من غرفة والديّ. يجلس خلفها أبي ويراقبني إذا نزلت للعب مع أبناء الجيران. ولم أكن أر منه شيئاً فالنافذة ذات ستارة مشبكة. لكنني أسمع ويسمع الأخرون من صوته الجهوري المخيف. حين أنسى نفسي وأنا أهرول وراء الكرة مثلاً يأتيني صوته العالي محذراً: انتبه.. سيارة آتية. وإذا حدث شجار بيني وبين أصدقائي، يتدخل مُرسلاً صوته القوي سنداً لي، فيرتعد الصبية حين يسمعون دويّه، ويتركونني وشأني خوفاً من صاحب الصوت. في الحقيقة لم أكن أجلس كثيراً عنده داخل الغرفة، بل أفتح الباب على مهل وأسرق نظرات حين أطالعه وهو يدّخن عند النافذة. جالساً على كرسيه وواضعاً الشرشف على فخذيه. ولم أر ساقيه إلا في المرات التي تغير أمي فيها الشراشف بين مدة وأخرى. وكنتُ أسأل أمي عن سبب بقاء أبي الطويل في الغرفة، على ذلك الكرسي ذي العجلات. ولماذا لا يخرج إلى الشارع، الحي، السوق؟. لماذا لم أر صديقاً يزوره أو يزور هو أحداً من أقاربنا أو من أصدقائه؟!، فتجيب أمي: لا تشغل بالك بهذا.. هناك ما يستحق أن يشغل بالك كدراستك وواجباتك.. سيفرح أبوك بهذا. ثم تغيّر الموضوع ولا أجني منها إجابة واضحة تشفي غليلي. كنتُ أثق بصوته أكثر من ثقتي بحضوره. ففي أوقات المدرسة كان يتصل هاتفياً بالإدارة. والعجيب أن مدير المدرسة الذي كان يتزمّت في رأيه معي، يلين ويتواضع حين يتصل به أبي ويكلمه عن شأني. فيغض النظر عني إذا كنت قد أسأت في موقف ما، ويساندني إذا احتجتُ أية مساعدة في أوقات الدوام.. جابي الكهرباء المنهك حين يدخل لباحة المنزل، أكون واقفاً قربه أطالع وجهه العابس في ضجر، وما إن يسمع صوت أبي فيتبدل وجهه إلى ارتخاء وطريقة كلامه إلى لين، ثم يستعجل في قطع ورقة الكهرباء ويرميها في يدي ويخرج بخطى سريعة.. البستاني الذي يأتي كل مدة لتشذيب الحديقة، أبي كان يوجهه إلى كل خطوة يجب القيام بها في عمله، بائع الخضروات المتجول حين يخاطبه، يتسمر عند العربة ناظراً للنافذة التي خرج منها الصوت، ثم يضع لي في الكيس أجود الخضروات وأينعها. وبالنسبة لي لم يكن دوري سوى الوقوف قرب هؤلاء وغيرهم، ولكم يفرحني انصياعهم واحترامهم الواضح له. كنت سعيداً لأنني أشعر أن الصوت خارج من حنجرتي أنا. أتخيل أنني من اتحدث معهم وأهيمن عليهم واحركهم كما يحرك صانع الدمى ألعابه. حتى أنني كنتُ مرتاحاً لأنه لا يقوى على مغادرة كرسيه المتحرك. لقد منحني الصوت هيبة في قلوب من يعرفونني، لولا الخفة التي كانت عندي بعض الشيء، لكنت قد أتقنت الدور بشكل كبير. فأنا لم أكن عنيداً كأبي. عناده وأنفته إلى أبعد حد يتخيله الإنسان. لم يكن يرضى بمساعدة أحد سوى أمي، وحتى أمي رسم لها والدي حدوداً للمساعدة لا تتخطاها. ففي بعض الأحيان ينْترُ ذراعه بعنف إذا أمسكت بها أمي، ويحدجها بنظرة حادة لتذكيرها فتنتبه وتواصل عملها بهدوء. لم يكن القرب من أبي مثيراً للطمأنينة كما هو البعد عنه. حين أكون قريباً منه لا أسمع صوته كثيراً. قربنا منه يجعله صامتاً طوال الوقت. ربما لأن قربي منه يمنحه الراحة والطمأنينة على حالي. ولكن حين أدنو من الشارع ينبري عبر نافذته لمراقبتي. فلم يكن يسمح لي بالابتعاد كثيراً. باعثاً صوته المهيب لمساندتي تارة، أو لتوجيهي في قضاء شيء قبل خروجي من المنزل. كانت نظرات الخشية الدائمة في عيون أبناء الشارع من ذلك الصوت، تثير في نفسي الغبطة والتفاخر عليهم. ولم أكن أحزن إلا في الأوقات التي يذكرني فيها بضعفي. حين يصارحني منبهاً:
- لن أكون سنداً لكَ إلى الأبد.. عليك تحمل المسؤولية.. دافعْ عن نفسك وأمك إذا حدث قدرٌ لي.
هذه العبارات التي تشي بخوفه، تثير في قلبي هزة وارتباك لا أنساهما بسهولة. القلق من غياب نبرته المؤثرة، كان يسيل في روحي فتنمو أشواك الظنون والأحزان.. هل كان أبي صوتاً وحسب؟!. لقد أختصر الأبوة كلها في صوته الرهيب. لم يرافقني إلى مكان ما. لم نسافر، لم نذهب إلى الطبيب أو يشتري لي ملابس العيد والمدرسة. لم يفعل الكثير الذي يفعله آباء الأولاد الآخرون. ولكن مع هذا شعرتُ أنه قد منحني الأمان كله عبر نبرته المشحونة بالثقة. حتى أنني لم أفكر في موت بدنه بل بموت صوته!. لم يعد يربطني بأبي سوى حنجرة قوية ذات نبرة لا يصمد أمامها أحد. والحزن كلُّ الحزن كان يستوطن في بقاع نفسي حين أفكر في رحيله ذات يوم. الضيق والألم الذي يتركه الصمت والسكون بعد غيابه!. وهذا ماحدث يوم حملوه من كرسيه ذات ليلة لا أنساها. كانت أمي تسير ببطء وراء الرجال الذين حملوا جثمانه. اخرجوه من الغرفة وتركوني وحيداً أمام كرسيه والشرشف الذي كان يضعه على فخذيه. لم أهتم ساعتها إلى أين سيأخذونه وماذا سيجري بعدها، لأنني كنت أجثو كعصفور جريح في ظلام وصمت الغرفة. مددت رأسي من النافذة العالية التي كان أبي يناديني ويحذرني ويساندني من خلالها. لم أر غير المنازل وأضواءها اللامعة التي تهتز بسبب دموعي المنهمرة. مازلت أذكر ليلتها حين نمت على كرسيه حتى مجيء الصباح. الحزن يورث في البدن تعباً لا يوصف. لهذا التحفت بالشرشف المركون على الكرسي المتحرك وغفوت.. كان حلماً غريباً.. حلمت بصوت يسير معي ويطير فوقي ويحط كالنسر على ذراعي. لا أعرف كيف تجسد تارة على شكل طائر، وتارة على شكل إنسان ضوئي، كلما أردت مسكه تلاشى من أمامي!. في صباح اليوم التالي حين صحوتُ من نومي، كانت عظامي كلها تؤلمني وكأن عجلات سيارة سحقت بدني. نهضت على مهل وانا أطالع ضوء الشمس المتسلل بدفء عبر النافذة. لقد كانت عيناي متعبتين جداً وذابلتين حين طالعتهما في المرآة. بدأت أجسّ الغرفة التي كان يسكن فيها أبي بنظراتي. الآن وبالتحديد صرت أميز بعض أثاثها وزواياها، لأنني لم أكن أطالع حين أجلس قربه سوى صوته. كنت أراه قبل أن أسمعه وهذا ما أعاد لي الحزن الشديد لحظتها. لم يثر انتباهي سوى بعض الأقراص الليزرية وجهازها. كانت مركونة بشكل مرتب على طاولة إلى جانب النافذة. أذكر أن هذا الجهاز الصوتي كان أبي يستعين به على سماع أدعية في الصباح، وبعض الاغاني حين ينتصف النهار والموسيقى ليلاً. اقتربت من الطاولة ونظرت للأقراص والجهاز الذي كان حريصاً على نظافته. وتحت ضغط فضول وشوق شديدين إلى سماع شيء كان يسمعه هو من قبل، ألقمت الجهاز قرصاً من ضمن الأقراص المرصوفة.. إنه صوت أبي..!!. نعم.. صوته مُسَجَّلٌ في تلك الأقراص!!. أحاديث ووصايا وتنبيهات وذكريات لم يحكها لي من قبل. بل حتى صراخ منه وعبارات جاهزة كتلك التي كان يطلقها من النافذة.!. في تلك اللحظة شعرت أنه عاد إلى الحياة. كان مثل ما خُيل لي عبارة عن صوت هائل راكد في جوف ذاكرتي. في الأيام التي تلت وفاته كنتُ فرحاً وسعيداً، على الرغم من مجلس العزاء الذي كانت النساء يتوافدن إليه لتعزية أمي. على الرغم من توبيخها هي ونظرات النسوة المليئة بالعتب والتقريع. لكنني لم أهتم بشكل كبير. لقد عاد إلى الحياة كمن سافر ورجع.. أسمعه عبر السماعة الكبيرة في الغرفة وأنا ألعب مبتهجاً في الشارع، مع استغراب ودهشة الصبية من صدور الصوت بعد رحيل صاحبه.. صوته هو الإرث العظيم الذي تركه لي، أنا وأمي التي وهن صوتها من شدة البكاء ثم الشيخوخة. لكنها حين كبرتُ صارت تبتهجُ، وتغمضُ عينيها بسلام كلما تكلمتُ معها وسمعت نبرتي.
***
إنمار رحمة الله