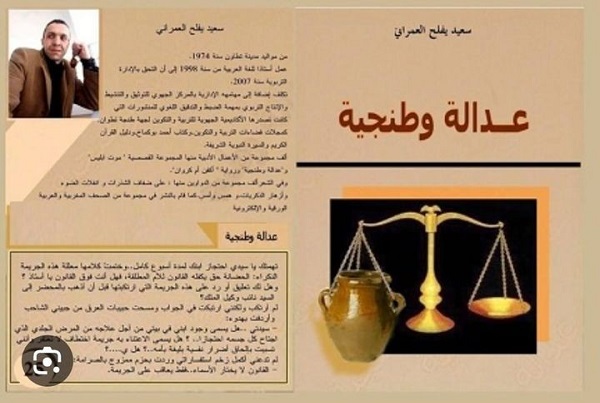صحيفة المثقف
الغاية المعرفية وخصوصيتها المتسامية عند الصوفية
 أولا: تحديد الغاية الصوفية أساس تقييم المنهجية
أولا: تحديد الغاية الصوفية أساس تقييم المنهجية
قد يرى بعض الباحثين المحدثين أن الغاية من التصوف ليست محددة وموحدة الهدف، وأن النظرة إليها تختلف من صوفي لآخر[1]، فيدعي البعض أن من الصوفية من تكون غايته منه هي التحلي بالأخلاق الحسنة والتحلل من الصفات الرديئة، كما هناك من يهدف في تصوفه إلى تفسير موقفه من الكون وتحديد صلة الإنسان بالخالق، سيرا وتمشيا مع تصورات الفلاسفة العقلانيين، مما قد يجعل تصوفهم غايته فلسفية محضة، وهنا أيضا من تكون غايته أبعد من هذا وذاك ألا وهي: معرفة الله سبحانه وتعالى[2]، وهذه هي أعلى المطالب وأسماها:"وأن إلى ربك المنتهى".
إن نسبة تعدد الغايات واختلافها عند من يتسمى بالصوفي أو يدعي نسبته إلى التصوف ليست ناتجة إلا من الجهل بحقيقة التصوف والتعريفات التي حيكت وصيغت حوله وعرفه بها الأقطاب الصوفية السالفين الذكر .
فالغاية الأخلاقية عند الصوفية الحقيقيين ليست إلا وسيلة والغاية الفلسفية ما هي إلا دخيلة، لكنهم على التحقيق نراهم قد يهدفون من البداية الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتوحيده بالعقد والقول والحال، والانتقال بالفناء، كما يصطلحون عليه، عبر المراتب الرئيسية ألا وهي:توحيد الذات والصفات والأفعال.
هذا، مع العلم بأنه لن تتيسر لهم هذه المعرفة إلا بعد الأخذ بالعلم الأولي الضروري الذي تقتنع بع العقول والتحلي بالأخلاق التي تهذب الطباع وتكسبها القبول، فهناك حينئذ سيتبين للمريد الصوفي كيفية السلوك ثم كيفية الوصول إلى الله تعالى وصول عرفان ومعنى وقرب، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا حيز ولا مكان ولا زمان، والوقوف [3]بين يديه تعالى يعبده كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتلك هي درجة الإحسان التي جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها في الصلاة.
إذن فإن غاية الصوفي الحقيقي هي الوصول إلى الله تعالى وصولا يجعل الإنسان يرى الله بقلبه، بعد أن يرى آثاره وشواهده وآياته بعينه وفكره في كل ما خلق[4].
يقول ابن عطاء الله السكندري في الحث على طلب الغاية الحقيقية من التصوف:"ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا ونادتك حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر".
والمعني المستخلص من هذا النص هو أن السالك طريق الله تعالى قد تتجلى له فضائل وأسرار وكرامات ونعم، ويشعر بمقامات وأحوال، فإذا أراد أن يقف عندها تناديه الحقيقة التي شرع طريقه من أجل الوصول إليها ألا وهي معرفة الله سبحانه وتعالى .
ولا تلتفت في السير غيرا فكل ما سوى الله غير فاتخذ ذكره حصنا
وكل مقام لا تقم فيه إنه حجاب فجد السير واستنجد العونا
ومهما ترى كل المراتب تجتلي عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنى[5].
إن مصطلح المعرفة قد يوجد فيه اختلاف بسيط ودقيق بين العلماء عموما وبين رجال التصوف، فالمعرفة على لسان العلماء معناها و مرادفها العلم، فكل علم معرفة وكل معرفة علم، وكل عالم بالله تعالى يسمى عارفا، كما أن كل عارف يسمى ويكنى عالما.
لكنها عند الصوفية قد تطلق على من عرف الله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه، وقام بالأعمال على وجهها الأكمل، وسعى إلى الإخلاص والتحلي بالأخلاق الحسنة وأصر على الدعاء والتضرع والتهجد حتى صار لا يرقب إلا الله تعالى ولا يرجو إلا إياه ولا يخشى إلا هو، و أصبح حينئذ محلا للإلهام و الهداية وكان من بين المحدَّثين[6]، أي الملهمين كما ورد به الحديث النبوي.
فالمعرفة عند الصوفية عملية باطنية ومدد روحي يرد من الله تعالى على قلب العبد الصالح وليست من كسبه أو ثمرة جهده الذي قام به أثناء سلوكه وتخطيه للعقبات[7] وقطعه المراحل والترقي في المقامات.
يقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه:"إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك!ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأين ما تهديه إليه مما هو مورده عليك؟!"[8].
وقد يعبر عن المعرفة بالله عند الصوفية بالوصول إلى الله تعالى، والمقصود بهذه الكلمة عندهم هو الوصول إلى العلم التحقيقي بالله تعالى، سبق وقد قسمنا إليه مستويات الإيمان وخصوصيته في هذا الباب، وهذا هو غاية ما يطلبه الصوفية السالكون ومنتهى سيرهم، وليس يقصد به الوصول المعروف بين الذوات مما يوهم بالحيز والمكان. فالله سبحانه وتعالى يتنزه عن كل هذا وذاك، ويؤكد هذا المعنى أبو القاسم الجنيد رحمه الله فيقول:"متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير هيهات! هذا ظن عجيب إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان"[9].
ثانيا: المكتسبات المعرفية وخصوصية الأداة عند الصوفية
كما أن معرفة الصوفي قد تكون عن طريق القلب لا عن طريق الفكر والحواس، ولقد شبه الغزالي المعرفة عن طريق الحواس بماء متسرب إلى حوض وهو الإنسان، وهذا الماء يحمل في جوانبه ومن خلاله جريانه رواسب وسموما ومنافع في نفس الوقت.
أما المعرفة عن طريق القلب فهي كالنبع من قعر ذلك الحوض، يبقى ماؤه صافيا ثجاجا[10]، فقوى الحواس وقوى الفكر غير كافية للمعرفة الكاملة والثابتة، لهذا يلزم السلوك من أجل المعرفة باتباع ما هو محل لوجوده بالقلب وهو الاعتقاد، وبذلك الاعتقاد مع العمل بما يأمر به هذا المعتقد فقد تتسنى المعرفة لطالبها بفضل الله ومنته على عباده.
كما سيعطي لنا مثالا جميلا وملموسا وفيزيائيا حول خصوصية المعرفة الصوفية التي تنبعث من القلب وإليه كنتيجة للمنهج المعتمد لديهم وأصوله التي ذكرنا.
يقول في هذا المعنى:"إن العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب، وأولياء الصوفية يعملون في جلاء القلوب وتطهيرها وتصفيتها وصقلها فقط، فقد حكي أن أهل الصين وأهل الروم تباهوا بين يدي بعض الملوك بحسن صناعة النقش والصور فاستقر رأي الملك على أن يسلم إليهم صفة لينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جانبا ويرخى بينهما حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ففعل ذلك، فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصر ودخل أهل الصين من غير صبغ وأقبلوا يجلون جانبهم ويصقلونه، فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضا!فعجب الملك من قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ!فقيل:وكيف فرغتم من غير صبغ؟ فقالوا: ما عليكم ارفعوا الحجاب !فرفعوا وإذا بجانبهم يتلألأ منه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق، إذ كان قد صار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل".
ثم يعلق قياسا على هذا:" فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه حتى يتلألأ فيه جلية الحق بنهاية الإشراق كفعل أهل الصين، وعناية الحكماء والعلماء الاكتساب ونقش العلوم وتحصيل نقشها في القلب كفعل أهل الروم، فكيفما كان الأمر فقلب المؤمن لا يموت وعلمه عند الموت لا يمحى وصفاؤه لا يتكدر، وإليه أشار الحسن رحمة الله عليه بقوله:التراب لا يأكل محل الإيمان بل يكون وسيلة وقربة إلى الله تعالى"[11].
ويقول الشيخ محيي الدين بن عربي أيضا في مجال خصوصية المعرفة والعارف الصوفي :"أعلم أنه لا يصح وصف أحد بالعلم والمعرفة إلا إن كان يعرف الأشياء بذاته من غير أمر آخر زائد على ذاته، وليس ذلك إلا الله وحده، وكل ما سواه فعلمه بالأشياء إنما هو تقليد لأمر زائد على ذاته.
وإذا ثبت ذلك فليقلد العبد ربه سبحانه وتعالى في العلم به، وإيضاح ما قلناه من أن العبد لا يعلم شيئا إلا بأمر زائد على ذاته: أن الإنسان لا يعلم شيئا إلا بقوة من قواه التي أعطاها الله تعالى له وهي الحواس والعقل. فالإنسان لابد أن يقلد حسه فيما يعطيه، وقد يغلط وقد يوافق الأمر على ما هو عليه في نفسه أو يقلد عقله فيما يعطيه من ضرورة أو نظر، والعقل يقلد الفكر ومنه صحيح وفاسد، فيكون علمه بالأمور بالاتفاق؛فما ثم إلا تقليد!.وإذا كان الأمر على ما قلناه فيجب على العاقل إذا طلب معرفة الله تعالى أن يقلده فيما أخبر به من نفسه على ألسنة رسله ولا يقلد ما تعطيه قواه، وليسع بكثرة الطاعات حتى يكون الحق تعالى سمعه وبصره وجميع قواه كما ورد(كإشارة إلى حديث الولي كما سنرى).وهناك يعرف الأمور كلها بالله، ويعرف الله بالله، فلا يدخل عليه بعد ذلك جهل ولا شبهة ولاشك ولا ريب"[12].
فالملاحظ على هذا النص هو التقارب التام بينه وبين التعريفات السابقة ووحدة الاتجاه والأداة، مع تحديد نفس المنهاج للوصول إلى الغاية القصوى ألا وهي معرفة الله.
ومما يثير الانتباه أيضا هو وحدة آلة المعرفة التي يشير إليها ابن عربي والتي قد تكلم عنها الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، حيث كان قد سحب ثقته بالمحسوسات والمعقولات وجعل فوقها شيئا ووسيلة أسمى ألا وهي: القلب الذي يعتبر كنز المعارف وخزانتها وعن طريقه عادت الثقة لديه بأحكام العقل والحواس[13].
بقي لي بعد الإشارة إلى اتحاد قول الصوفية حول المعرفة والعارف، أن أستشهد بقول عالم مشهور من علماء الشريعة ويعد من أهم الفقهاء في العالم الإسلامي وسلفييهم على الخصوص وهو تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى واصفا لنا حالة العارف بقوله:"العبد العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله، بحيث لا يريد إلا ما يريده الله أمرا به ورضا، ولا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله، ولا يلتفت إلى عذل العاذلين ولوم اللائمين[14]، كما قال سبحانه:"يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم من دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم "[15].
فتعريف ابن تيمية هنا هو عين تعريف الصوفية السالفين الذكر، بحيث لو لم نكن قد علمنا مصدر النص ولم نعرف اسم صاحبه لقلنا أنه قد كتبه شيخ من شيوخ الصوفية العارفين وأصحاب الأذواق.وهذا مما يبين لنا تطابق وجهة النظر بين كثير من الفقهاء العاملين الأتقياء والموضوعيين مع الصوفية العارفين الأصفياء.
فلقد كانت ميزة الفقهاء، حينما كان الفقه يحمله الأتقياء أنهم يسلمون لأهل التصوف السنيين والمعتدلين أمرهم، بحيث قد يحكى أن أحدهم واسمه أبي سعيد بن أبي سريج كان متبحرا في العلم والفهم وقد تنكر مرة لما يصدر عن الصوفية من أقوال وأحوال، ثم حضر مجلس أبي القاسم الجنيد ليسمع منه شيئا مما يشاع عن الصوفية، فلما انصرف قالوا له: ما وجدت؟قال: لم أفهم من كلامهم شيئا إلا أن صولة الكلام ليست بصولة مبطل "[16].
الدكتور محمد بنيعيش
كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة
.............................
[1] محمد جواد مغنية:معالم الفلسفة الإسلامية ط2ص183
[2] أبو الوفا الغنيمي التفتازاني:مدخل إلى التصوف الإسلامي ط2ص10
[3] محمد حقي النازلي:خزينة الأسرار الكبرى ص223
[4] عبد الرزاق نوفل:التصوف والطريق إليه ص27
[5] ابن عباد النفزي:شرح الحكم ج1ص22
[6] القشيري :الرسالة ص141
[7] الغزالي:منهاج العابدين...ص20
[8] ابن عباد النفزي:شرح الحكم ج1ص9
[9] نفس ج2ص39
[10] عمر فروخ :تاريخ الفكر العربي ط1ص382
[11] الغزالي:إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية ج3ص21
[12] عبدد الوهاب الشعراني:اليواقيت والجواهر ج1ص39
[13] الغزالي:المنقذ من الضلال ص11
[14] ابن تيمية:مجموع فتاوى، كتاب التصوف ص77
[15] سورة المائدة آية 54
[16] الشعراني:اليواقيت والجواهر ج1ص11