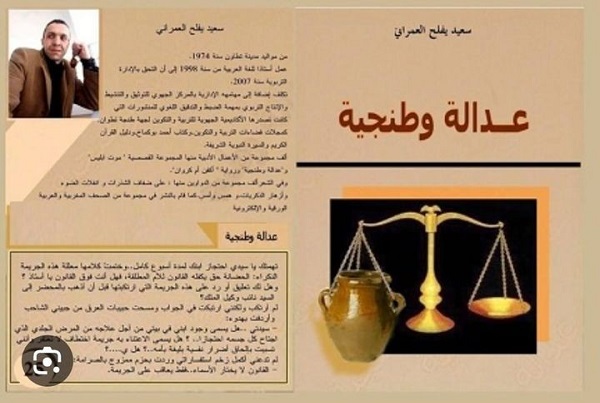صحيفة المثقف
اللقاء على بساط الموت
 وفي المخطوطة أيضا تفاصيل عن شخص آخر يبحث عن أبي يزيد. وهو أتابك، أحد أغنياء المدينة، وله بيت يبدو كأنه مشروع لقصر منيف أو قلعة حصينة. ووراءه حديقة تنمو فيها نباتات الشيطان، نوع من الأشجار القصيرة السود. أما التربة فهي بيضاء كامدة بلون الملح، ولعلها جير من غبار الفردوس التي أغلقت أبوابها.
وفي المخطوطة أيضا تفاصيل عن شخص آخر يبحث عن أبي يزيد. وهو أتابك، أحد أغنياء المدينة، وله بيت يبدو كأنه مشروع لقصر منيف أو قلعة حصينة. ووراءه حديقة تنمو فيها نباتات الشيطان، نوع من الأشجار القصيرة السود. أما التربة فهي بيضاء كامدة بلون الملح، ولعلها جير من غبار الفردوس التي أغلقت أبوابها.
أول الأمر لم يذهب أتابك خلف أبي يزيد شخصيا، ولكنه أوفد حاجبه أو من يدعى الشماس لأنه يسير وراءه في الأيام المشمسة وبيده سيف بتار ليحميه به من كيد أهل النور. كان أتابك من أتباع الأوقات الحالكة. مجرد كائن ليلي يحترم الديجور فقط.
لا يعلم أحد لماذا اهتم أتابك بذلك الشيخ الجليل. ولكن ربما لهذا علاقة بظروف زوجته التي شد وثاقها فوق سرير في مخدعها. أو بسبب هذه الأوضاع الغامضة التي نشبت بعد قيام ابن أبيه (يسميه الخاصة المعتمد) بالتمرد على المنصور. في تلك الفترة كان أتابك وأهل بيته موطنا للأسرار، صندوقا محكم الإغلاق، لن تخمن بسهولة ماذا يجري في دهاليز بيته أو ماذا يتحرك في ذهنه من أفكار، خبيثة أم طيبة..
ثم اتضحت الصورة حينما استدعى أتابك الوصيفة (طويلة) إلى غرفة زوجته. كان لديه صف من الوصيفات إحداهن شمس، وهي مخصصة لأعمال السخرة لأنه يمقت اسمها. وأخرى تدعى قمر، وهي من تخدمه مع زواره في الليوان (قاعة مضلعة مشيدة بشكل مستطيل من أحجار بيض وأخرى سود بالتناوب، وفي وسطها فسقية تترقرق فيها المياه العذبة). وقد وضع فيها قفصا من المرجان وبداخله جوقة من حساسين جهنم. هل سمعتم بها. الحساسين ؟.. إنها طيور صغيرة بأجنحة تبرق في الليل مثل السعير. هذا غير (طويلة) التي ورد ذكرها، وتؤدي المهام الشاقة مثل حمل رسالة لمسافات أو كتابة التعاويذ أو الإشراف على عبيد المثرود. كان لدى أتابك عبيد مهمتهم تهيئة المثرود المسائي، وهي وجبته الأخيرة قبل أن يأوي إلى الفراش.
شاهدت الوصيفة سيدتها تحتضر، وهي في صحوة الموت، بدليل أن أتابك وضع المرآة الفضية أمام صفحة وجهها، فقط لتتأمل انعكاس أنفاسها حين ترحل ببطء، وتنسحب من معترك الحياة بتؤدة لا تحسد عليها. الموت المفاجئ أقل إيلاما، ويحصل فجأة دون الدخول في معترك من الاحتضار كأنك على الصليب..
طلب أتابك من طويلة أن تأتي بماء الزهر ليساعد الراحلة على الانتعاش والسكينة قليلا، ولكن آنذاك، في تللك اللحظات، ألقى عليها سيدنا عزرائيل منديله المعطر بالمسك والزعفران. فأدرك الحاضرون جميعا أن الوقت أزف. ولا سبيل لتأخير هذه الرقدة الأبدية. وكانت بيد سيدنا عزرائيل ورقة من شجرة السدر التي تخيم على العرش. وسمعوا كلهم أصوات أوراق القرآن وهي تنقلب بين أيدي الملائكة. وهنا اضطر أتابك للانسحاب.
وفي رواق المغادرين سأل: هل عاد رسوله إلى أبي يزيد..
وتطوع صبي خادم برأس حليق، وكان يجمع بعض آخر خيوط النور التي تركها الحاجب النهاري وراءه قبل رحيله، للإجابة: فقال كلا يا سيدي.
وحمل جعبته على ظهره ومضى. فحمله خفيف على ما يبدو. لقد حزم خيوط النور القليلة كي لا تفسد مزاج سيده.
وهكذا عزم أتابك أن يخرج بنفسه ليأتي بالبسطامي. أبي يزيد. فقد سمع أنه يتعبد الله في أحد المزارات المباركة. وكان يحدوه الأمل بالعثور عليه قبل انبلاج الفجر، وبهذه الطريقة قد يشتري الغفران لزوجته. وكانت هذه الطريقة مجربة، وقد باع مولانا الجنيد (كما قال له صديقه قائد الجند في معسكر المعتمد) المغفرة مع قدر من السلوان لشقيق المعتمد نفسه.
ومع أن الخروج إلى الطرقات، بعد أن يغلق النهار أبوابه، مخاطرة، فإن هذا لا يثني القانتين أمثال أتابك. أسرع إلى بيت الخيول. ووجد حصانا مسنا طمر رأسه في القش وأغلق عينيه، وفرسا محمومة لها مقلتان حمراوان بأثر الوباء الأخير الذي أصاب السحت، وبعيرا من نوع النوق العصافير. فأسرجه بهودج غير ملون ليعلم من يراه أن فارسه مذكر، وهو يستعد لقضاء حاجة. ثم حمل سيفه وعدة حربه، وأمر بفتح البوابة. وكم أحزنه أن يلاحظ كيف تصبح الأشجار في أول الطريق إلى الليل كالحة، عزلاء تماما من خضرتها ومن زهورها. إن لها هيئة أرامل، وفي أحسن الأحوال سيدات بانتظار أوبة أزواجهن من رحلة المخاطر.
وتوقع أتابك أن يواجه في سبيله مركز تفتيش يعود لأحد الطرفين المتنازعين. لذلك ضرب على وجهه اللثام، فهو لا يأمن رجال المنصور. كان أتابك منحازا في هذه الفتنة للمعتمد. وينتظر لو انتصر أن يوكل إليه أمر الجباية أو وزارة الحمائم وديوان التراسل. كانت علاقته مع المعتمد مباشرة، وتقف وراءها علاقات نسائية، فزوجته " هدى الإسلام " و" خاتون" زوجة مستشار المعتمد، شقيقتان. ولعله لهذا السبب أحاط احتضار زوجته بكل تلك الأهمية. وفي أية حال كان رجال المعتمد الآن يضربون الحصار على قصر وبساتين المنصور. ويتشاحنون بالكعاب والسيوف القصيرة مع قوة من العسكر لم تحزم أمورها بعد، وتنصب مخيماتها في شعاب وراء القصر. كانت الأوضاع الآن بعيدة تماما عن الحسم أو الاستقرار.
وبالفعل قرب ميدان "عطايا مولانا"، الذي يقود لبيت المال، اعترض طريقه عسكري علم من أول نظرة أنه في صف الأعداء. فقد رفع على خوذته ريشة نسر أبيض. وكانت وراءه حلقة أخرى من المقاتلين. وقال له العسكري: إلى أين؟..
فأشار بإيماءة من رأسه إلى نهاية الطريق. فقال له وهو يقبض على لجام فرسه: ارجع. المنطقة قيد الترميم والإصلاح.
تراجع أتابك بالناقة. وتعمد أن يدخل في متاهة من الدروب الخلفية حيث توجد بيوت الفقراء. إنها دور كئيبة ولا يتطاير منها دخان الطعام. وبينها في الفراغات أشجار نخيل لا تثمر لأنها مذكرة. واستطاع أن يلاحظ أن إبليس مر من هنا قبله. وتذكر فورا حديثا مشهورا للبسطامي يقول فيه: إن الله خلق إبليس كلبا من كلابه، وخلق الدنيا جيفة. ثم أقعد إبليس على آخر طريق الدنيا وأول طريق الآخرة. وتبادر لذهنه أن هذا ينطبق على حالته تماما. أليس إنه يبحث عن أول الخيط لآخرة مغسولة من الذنوب. ثم لاحظ وجود زمرة من المخلوقات الغريبة التي تعرف باسم (البدون) لأنهم صعاليك متشردون ليس لهم أرض ولا هوية. وكانت شعورهم منثورة مع النسمات الخفيفة. وتوقع أنهم مثله يبحثون عن المزار ليستريحوا فيه قليلا. ورأى أنه من غير اللائق أن يلقي عليهم السلام كما يقتضي الواجب.
وتابع حتى استطاعت عيناه أن تشاهدا الدرج المحفور في سفح الجبل أو ما تبقى منه. فعلم أنه وصل الى أرض (وادي الطاعة). كان هذا الجبل في سابق عهده مرتفعات شماء، والآن هو أقرب لكومة من الحجارة. فقد اعتدى عليه السلطان وأخذ منه الصخور اللازمة لبناء برج حراسة في قصره.
مهما كان الأمر هنا سيجد من يدله على البسطامي أو غيره ممن يتداولون صكوك الرحمة ويبيعون دقائق تساعد الروح على السكينة.
أناخ الجمل عند أسفل الدرج وابتعد عنه. كان هناك رهط كبير، وعدد من الحمير والجياد الأصيلة وكثير من طيور الأضاحي.. فالقرابين التي تطير تصل بركتها للسماء بلمح البرق، ليس مثل ذوات الحوافر، فهي بحاجة لمهلة إضافية قبل المثول بين أيدي الخالق عز وجل. واضطر أن يقفز من فوق بعض الأشخاص الراقدين على الأرض ممن يبحث عن الاستشفاء من العلل.
وكانت حرارته ترتفع حينما بدأ بالصعود على الدرج. وإحساسه بالألم وصعوبة الفراق الوشيك تتفتح في ذهنه مثل براعم ورود المقابر أو زهر الرمان. وفي مرحلة ما سمع ابتهالات غير بشرية، ربما تصدر من جوقة ملائكة أو جماعة من الأبالسة التائبين. واستطاع أن يميز في هذه الكتلة من الأصوات نبرة ساجدة، هدى الإسلام. كانت ولا شك تغذ خطواتها نحو الضفة الأخرى من نهر الحياة. وواصل الصعود حتى أشرق عليه فيض من النور الذي يعمي البصر، فأسدل جفنيه. وعندما أصبحت قدماه على العتبة الأخيرة، تمكن من رؤية البوابة. فمر منها. ثم دخل إلى قاعة واسعة فصلى فيها وترا. ثم جلس وأطرق للدعاء زهاء فترة هي عند أهل العلم تساوي دورة الشمس من مشرقها لمغربها. بعدئذ غادر من باب جانبي نحو الخلاء. وفيه لم يكن قادرا على رؤية شيء سوى فضاء من زجاج تنعكس عليه ظلال خضر داكنة. ثم انتقل إلى قاعة صغيرة لا تزيد على عرض كتفيه. لكنها مزدحمة بمئات الآلاف من الأناس الذين يرتدون الثياب الفضفاضة ويحملون على أكفهم أرواحهم أو شموعا مصنوعة من شحوم غزلان إفريقية وغيلان دمشقية. ثم سار إلى الضريح الرئيسي. وأدى تحية الإسلام. كان من المفروض أن يلتقي هنا بمن يبحث عنه. ولكن لم يجد أحدا. فتجاوزه إلى قبر أصغر تغطيه المنسوجات الخضر وكأنها بساط من العشب. فركع على ركبتيه، وطفق يبكي لأن الدموع غلبته. لقد كان للفراق معنى. كان للرحيل هيبته بشكل عام وليس بالتخصيص حزنا على زوجته. وفي تلك الأثناء أحس بلمسة على أحد كتفيه. التفت للخلف قليلا. ورأى شابا في منتصف العقد الثاني من العمر. وقد سأله: ما بك يا أخي؟..
لم يرد. فأضاف الشاب: من جهتي أنا أحاول أن أصل للشيخ أبي يزيد البسطامي. هل تعرف أين أجده؟..
وفاجأ ذلك أتابك وقال بملء صوته: هل قلت أبا يزيد؟..
وهنا سأله الشاب: هل رأيته؟ سمعت إنه يلوذ بالضريح ولا يبتعد عنه..
وانتبه أتابك أن صوته مرتفع، ويؤذي أسماع الأرواح التي تعتني بالأماكن العجيبة المقدسة، فهز رأسه بالنفي، ثم قال بصوت وقور: كنت أبحث عنه مثلك. من تكون؟.
فأجاب بصوت مثقل بالهم: ابن أخته. أبحث عنه منذ يوم و ليلة..
وفكر قليلا كأنه يريد أن يضيف شيئا، ولكنه قرر فجأة أن ينسحب. وارتسمت علامات الدهشة على وجه أتابك. لقد انتبه أن البسطامي مثل سائر الناس. إنه غصن من شجرة الحياة التي ينتمي إليها، ولديه أصول وفروع، ويعاني من هموم الماضي وغموض المستقبل مثل العوام. وليصرف عن نفسه هذه الأفكار أخرج من تحت عباءته مصحفا صغيرا. وضعه تحت غطاء القبر وتلا الفاتحة. ثم عاد من حيث أتى، ولم يقابل أحدا في هبوطه الدرجات ولا حتى الشاب المجهول (ابن يعيش كما نفهم من السياق).
وفي درب العودة ألقى التحية على الجماعة المسلحة ذاتها التي منعته من العبور بطريق مختصر. وسمع ردودا لا تليق به. لقد جرح المسلحون كبرياءه حتى قبل أن يعرفوا من هو، فما بالك لو علموا بشخصيته..
وبالقرب من بوابة داره، وهو مغلوب بمشاعر العودة بخفي حنين، من غير صكوك الغفران المنشودة، ولا الوثائق التي يوزعها نائب عن ملائكة الحساب في القبر، فهو الآخر لسوء حظه كان غائبا، لم يشاهد الحرس ولا الحاجب. وانتبه أن الإضاءة تأتي من البرج الذي أودع فيه زوجته. ربما لتهدي روحها الضالة إلى أفضل الطرق. فهدى الإسلام مغمورة بالنقائص.. النميمة، الكذب، انتهاز الفرص، حدث عن ذلك ولا حرج.
أناخ الجمل وهبط ليفتح البوابة بنفسه. وفي هذه اللحظة سمع صوتا ينادي باسمه. صوتا جهوريا. التفت حوله ولم يبصر بين طيات الظلام أحدا، فقال وهو يغالب أحزانه: من المنادي. عرّف بنفسك من فضلك...
ولكن لم يمهله الصوت. فقد شق شبح طويل ستار الليل، وانقض عليه. وفي التو واللحظة ارتفعت حرارته مجددا. ثم شعر بألم فظيع. وأعقبه البرد القارس. ولم يخامره الشك أنه كان هدفا سهلا ولقمة سائغة.. لقد استفاد اعداؤه من ظروفه، وأعدوا له هذا الكمين البسيط. أغلق عينيه. وهو يقول لنفسه: هل بهذه السخافة تكون النهاية؟. ثم استند على البوابة وحاول أن يفتحها. وكانت ثقيلة.. أثقل من ذنوبه المتراكمة. وأثقل من أطماعه التي نضجت ثمارها على الأغصان وحان وقت القطاف. وهكذا تهاوى بالقرب من السور. وانكفأ على وجهه، حتى أنه شعر بطعم التراب في فمه.
ولم يكن يخطر في بال أتابك أنه سيغادر الحياة في نفس اللحظة التي تفارق فيها روح هدى الإسلام جسدها.
كم في الحياة الفانية من غرائب ومصادفات.....
***
صالح الرزوق
.......................
(الفصل الثاني من القصة الطويلة: على خط النهاية)