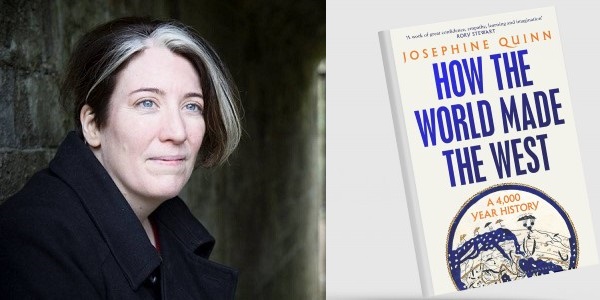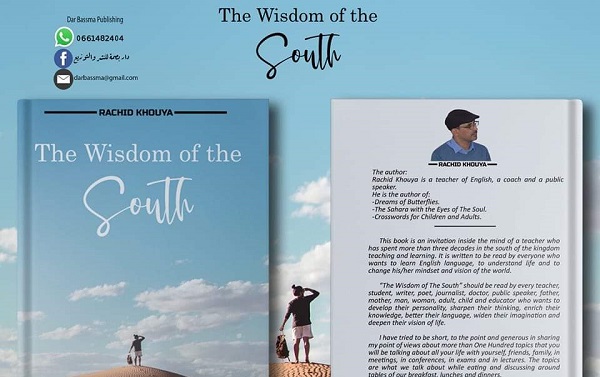صحيفة المثقف
طلاقة اللسان.. الإفشاء الأخرس للعقل الناطق (1)
 العقلانية واللاعقلانية في الفكر العربي الحديث (3)
العقلانية واللاعقلانية في الفكر العربي الحديث (3)
عندما يبلغ الانحطاط مداه الأقصى تصبح العاهات امتيازا. وليس مصادفة أن يفضّل الاستبداد العثماني الحريم على الحرام، والمخصيين على المتحصنين في قصوره وسجونه. وان يبتدع أيضا تفضيل الأخرس على الناطق كأسلوب للحفاظ على الأسرار. وهو "إبداع" يعكس في رمزيته الانهيار التام للروح الأدبي. من هنا القيمة التاريخية العظمى لجهود أدباء عصر النهضة العربية في استنهاض الضمير الغائب.
فقد كان هذا الاستنهاض الأدبي (اللغوي) الرد الشامل على شمولية الانهيار الأدبي (الروحي) للعثمانية. ومن ثم فان تنامي قيمة الكلمة كان مرتبطا بتنامي إدراك الانفصام الحتمي للوشائج الدينية والدنيوية بالعثمانية. مما حدد بدوره فاعلية الوجدان وسيادته في الكلمة. وتحول الكلمة إلى قوة شاملة في الرد والتحدي، ومعوّض في نفس الوقت عن كل ما لا يمكن بلوغه بالقوة المباشرة. فالدعوات الكبرى عادة ما تدرك بدايتها ونهايتها بالكلمة، بعد أن تكون قد لفت الدورة الكاملة لتحول الوجدان إلى منطق. وليس مصادفة أن تصبح عبارة "في البدء كانت الكلمة" دليل الإنجيل، و"اقرأ باسم ربك" بداية الدعوة القرآنية. فالكلمة والقراءة هما توأم الصراخ الملازم لبدايات الظهور كالصراخ بالنسبة للولادة.
فولادة الأمم تفترض أيضا إمكانية تحول صراخها الأول إلى كلمات مفردة. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار كون الثقافة العربية هي ثقافة الكلمة المسموعة والمكتوبة، فإن إعادة قراءتها في أدب النهضة يعني أيضا تضخيم حجمها الأدبي والمعنوي. إذ لم تكن الكلمة عندهم ما كانت عليه عند عرب الجاهلية في مديحها هجائها، ولا في ترغيبها وتهديدها الديني والدنيوي في إسلام الدعوة والرسالة، ولا في إعجازها البياني والعقائدي في مراحل الصعود الثقافي الأول للخلافة، ولا في كلام المتكلمين باعتبارها منطقا ولا في غيبيتها المتسامية باعتبارها حروفا روحية لسرّ الباطن. لقد احتوت الكلمة في هواجس أدب النهضة على الكلّ الكلامي للعروبة والإسلام. إذ أثقل كاهل الأدباء حينذاك المدح والهجاء، والوعد والوعيد، والبيان والإعجاز، والمنطق والأسرار، لأنهم وجدوا أنفسهم أمام نصوص عظيمة وواقع منحط، وتحسسوا مفارقة وجود ارث عظيم وواقع لئيم. وقد أجبرت هذه المفارقة العقل العربي الناطق على أن يتحسس في الكلمة اثر الانفصال التاريخي الثقافي بإرثهم الخاص.
ولم تعد الكلمة المعاصرة كلمة العلوم العربية الأولى ولا كلام المتكلمين. فقد كانت كلمة العلوم العربية وكلام المتكلمين جزءا من جدل الصيرورة التاريخية للدولة والثقافة. لهذا لم يعان أي منهما من إشكالية الانفصام والانفصال والانتماء ما شابه ذلك. إذ توافق مسارهما في العبارة والمعنى مع منطق الثقافة الإسلامية في بناء هرمها المادي والمعنوي. من هنا تراكم عقلانية الرؤية وروح الإبداع، لان الكلمة والكلام كانا يتحركان في نسق الوحدة الروحية والاجتماعية للأمة والدولة، أي أنهما كانا يتكاملان في وعي الذات الثقافي بفعل الهموم المشتركة في الصراعات الفكرية والسياسية. أما بالنسبة لأدباء النهضة فقد كانت معاناتهم الأساسية تقوم لا في إبداع الكلمة وبنائها في العبارة ورصفها في منطق الرؤية الثقافية، بل في استعادتها كما هي واستنطاق ما فيها من معنى معقول بمعايير الرؤية المعاصرة. مما أعطى للكلمة في أحاسيسهم وأرواحهم وعقولهم قوة الحروف السرية لما ينبغي قوله. من هنا اهتمامهم المفرط بها، كما لو أنها المادة الوحيدة لإبداع معنى الوعد بالنعيم والوعيد بالجحيم. فقد كانت همومهم المشتركة نابعة من تحسس الانفصال بالإرث التاريخي، ومن ثقل الانحطاط المادي والمعنوي للعرب. وقد بعث ذلك في نفوسهم سحر الكلمة الفصيحة وبيانها الخلاب، لأنهم وجدوا فيها أسلوب استعادة اللحمة الوجدانية بالتاريخ العربي.
واستثار هذا التحسس الأولى شرارة اللوعة والتفاؤل. ومن خلالهما بدأت تتزاحم الحماسة والاعتزاز الفرديين في إفشاء الأسرار. بينما لا أسرار آنذاك سوى ما له صلة بالإرث المغمور في زوايا البيوت العتيقة والمكتبات الخربة وذكريات الأجيال الخاملة. لهذا أصبح إفشاء سرّ الكلمة يعادل في مضمونه التاريخي إفشاء سرّ الواقع المباشر.
لقد تعامل أدباء النهضة مع الكلمة تعاملهم مع خزين التاريخ والمعاناة. فالشدياق، على سبيل المثال، استفرغ في كتاباته كلمات (مفردات) القواميس العربية، وأورد أعداد هائلة منها في عباراته يصاب لها رأس المرء المعاصر بالدوار. ووجد هذا الموقف تعبيره عند أديب اسحق (1856 – 1885) في الفكرة التي سبقه إليها الشدياق، من أن العبارة هي حركات الإنسان وأفعاله وأفكاره.
كان استفراغ الكلمات في الأسطر مثار الاعتزاز ومفخرة العقل والوجدان. فقد كان هذا الاستفراغ مجرد إقرار بالملكية العامة للغة وحق الاستفادة منها دون ضوابط، والجود بها كما يحلو للنفس الكريمة أن تفعل، باعتبارها الثروة المتحررة من سلطة الباشوات والأغوات، بل ولان قيمتها تعوّض النقص الهائل في حركات وأفعال وأفكار الكيان العربي. فقد كشفت هذه الظاهرة عن الهوة المثيرة لهموم المفكر المبدع في رؤيته لخمول الجسد الثقافي تجاه تحسس تاريخه في الكلمة. فالكلمة (أو اللغة) هي تاريخ الأمة. وتعكس في مستوياتها وميادينها مستوى وتنوع عوالمها المادية والروحية. ومن ثم فأن استفراغ القواميس العربية على أوراق التأييد والاحتجاج والمديح والذم والمناجاة والشتيمة والتأسي والحب والكراهية والتبجيل والتشفي، تعبيرا عن مساعي أدباء النهضة العربية لاستنهاض الجسد الخامل للعروبة. لقد أرادوا القول بوجود روح عربية هائلة في الكلمة هو مصدر التاريخ العربي. لذا فهي بحاجة إلى جسد ضخم للتدرع بها. لهذا لم يشبه بحثهم في أسرار اللغة بحوث الجرجاني وأمثاله، ولا وجدانهم إياها وجود الصوفية في مكابداتهم ومكاشفاتهم.
فقد كانت أسرار (اللغة) العربية بالنسبة لهم هي أسرار العروبة الدفينة. وليس مصادفة أن يسهب الشدياق ببيان ما اسماه بأسرار الحروف في اللغة العربية، وكشف عما فيها من معان دفينة للعروبة الثقافية، مثل عثوره في حرف الحاء على معنى السعة والانبساط كما في كلمات السماحة والانسياح والساحة والراحة؛ وفي حرف الدال على اللين والنعومة كما في كلمات المرد والرغدة؛ أو على معنى الصلابة والقوة كما في كلمات التأكيد والتأييد والحدّة والشدة؛ وفي حرف الميم على معنى القطع والاستئصال كما في كلمات حطم وثرم وحرم وحتم؛ وفي حرف الهاء على الحمق والغفلة كما في كلمات الأبله والتائه والمعتوه. بينما لا نعثر في كتاب (مشهد الأحوال) لفرنسيس مراش على أحوال الصوفية، بل على أحوال العالم العربي من خلال تأمل مختلف تجلياته. إذ نراه يكتب عن أحواله في الشعر والكون والبلد والغربة والحب والكراهية والصحبة والعداوة والعمل والراحة. وتصبح الحياة مادة وقضية للبلاغة في الإطراء والتغزل والتأسف والإعجاب. ويصبح الإنسان العربي موضوعا للبحث يرتقي إلى مصاف التأمل الفلسفي. ونقف أمام نفس ظاهرة تعمق وتجذر الصيغة الأدبية لتأمل الوجود. ومن ثم تعمق مسار الروح العربي نفسه أو إعرابه بمعايير الموقف المتسامي. فمن جهة نرى جزالة اللغة في ترتيب خلجات النفس والضمير، ومن جهة أخرى نرى صريف الأقلام المتناثر في رسم العبارة التي ينبغي أن تتطابق مع محتويات العاطفة والوجدان. وليس أمام الفكر سوى مهمة الاختباء وراء العبارة. ففي موقفه من حال الحياة يكتب "ولا يزال الإنسان سائر في طريق عمره سير المسافر في القفار إلى أن يبلغ رابع الأدوار، وهو دور الاندثار. وفي مقاربة الشيخوخة تصمت ضوضاء حواسه وهواجسه ويخرس أنين أنفاسه ووساوسه، فيكف بصره ويجف فكره وضيق ذوقه ويكثر شوقه ويبخل حتى بالفلس ويزيد حرصه على النفس. فإذا التفت إلى ورائه ورأى الدنيا التي قطعها والطريق التي تتبعها ظهرت له الأشياء أشباح أحلام وأوهام، كلها تجري نظيره إلى الزوال كالطيف والخيال. فيضحك على الجميع ضحك الطفل الرضيع. وإذا ما التفت إلى الأمام وطمع في بضعة أيام جنّ إلى الوجود وهام بحب الخلود. ولا يزال الماضي يدفعه والحاضر يردعه والمستقبل يطمعه، حتى تختطف نفسه المنية وتسلبه كل بغية وأمنية، فيهبط هبوط البنيان أو يغور في قبر النسيان"، حينذاك "تسترجع الكليات جزئياتها وتسترد المجموعات مفرداتها". وطبق نفس أسلوبه هذا على الأحوال الأخرى. ففي موقفه من الموت يتوصل إلى "أن الجماد يسترجع إلى حوزته ما استعاره الحيوان في عوزته".
من كل ذلك يبدو واضحا، بان البحث في أسرار اللغة والتلذذ بتعبيراتها عن حالات النفس وتأملات الفكر هو بحث عن خبايا الأنا الثقافية وتاريخها المنصرم لأجل اكتشاف ما يساعدنا منه في دعم وترصين الأفكار الرامية إلى تغيير الحالة الاجتماعية والقومية.
فعندما يتناول الشدياق، على سبيل المثال، كلمة الهوى فإنه يتوصل إلى أن البحث فيها فقط يجبر المرء على الاعتراف، بأن "اللغة العربية شرك للهوى". وعندما يتكلم عن مراتب العشق الثمان وهي الاستحسان (عند النظر والسماع) والمودة (الميل للمحبوب) والمحبة (ائتلاف الأرواح) والخلة (تمكن المحبة في القلب حتى تسقط بينهما السرائر) والهوى (لا يخالطه تلون ولا يداخله تغير) والعشق (الإفراط في المحبة حتى لا يخلو فكر العاشق من المعشوق) والتتيم (لا يرضى نفسه سوى صورة معشوقه) والوله (الخروج عن الحد إلى الجنون)، ثم يضيف لها كل من الغرام (الحب المستأسر) والشوق (نزاع النفس) والتوقان والوجد والتكلف والشغف. لقد حاول أن يكشف عبر هذا المثال عن الأبعاد السحيقة للروح العربية. فاللغة هي عبارة عن حركات الإنسان وأفعاله وأفكاره، وان تعدد الكلمات تعكس عمق حركاته وأفعاله وأفكاره. واللغة القادرة على عكس خلجات النفس والروح وحركات الجد بتنوع هائل لدليل على عمق أفعالها وحركاتها وأفكارها. ومن ثم فان استنهاض ذخيرة "لغتنا الشريفة" هو إنهاض قواعد نطقها ودقة معانيها من اجل إنهاض العقل العربي ووجدانهم كما قول الشدياق. فحال اللغة هو حال الأمة، كما يقول أديب اسحق.
وليس مصادفة أن يصبح الاهتمام بجمال اللغة وأحوالها أحد الهواجس الكبرى لأدباء النهضة لأنهم وجدوا فيه أسلوب تجميل الواقع القبيح. من هنا لغتهم الجميلة، التي حاولوا من خلالها جعل الواقع القبيح جميلا في اللغة. بحيث جعلوا منه أسلوبا لتغيير الواقع نفسه عبر إثارة محبة الجميل في اللغة بوصفها خزين التراث العربي في أفعاله الماضية وحركته المعاصرة وتأملاته المستقبلية.
إن تنشيط هذا المخزون يؤدي بالضرورة إلى استرجاع التاريخ الأدبي ومن خلاله رؤية النفس بضوء أفعال الماضي وحركات الحاضر وتأملات المستقبل. مما يجبر الأفعال والحركات والتأملات المعاصرة على أن تلبس أحيانا لباس الماضي والتحرك والفعل فيه. وهو لباس يضّيق على الفكر أحيانا إمكانية الحركة الحرة ويهوّرها أحيانا، كما يبكيها ويضحكها في نفس الوقت. انه يساهم في إنهاض الحركة والفعل والتأمل على التفكير بما يجري، ويوقظ في الوعي الاجتماعي قيمة الحكم على ما هو موجود بمعايير وأذواق تجارب الأسلاف. وفي هذه العملية يبدأ تحسس وإدراك الفجوة الهائلة بين الماضي التليد والحاضر الزهيد. آنذاك تصبح طلاقة اللسان إفشاء اخرسا عما في خلد الفعل الناطق من قيم ومفاهيم وأحكام وتصورات. وليس تحرك العقل الناطق من خلال اللغة والتباهي بمفرداتها سوى أسلوب نقد الفجوة الهائلة بين الحاضر والماضي. وهو أسلوب ساهم في تعميق عناصر النظرة النقدية ولضمها مع مرور الزمن في نظام للرؤية الأدبية والاجتماعية والسياسية والقومية.(يتبع....).
ا. د. ميثم الجنابي