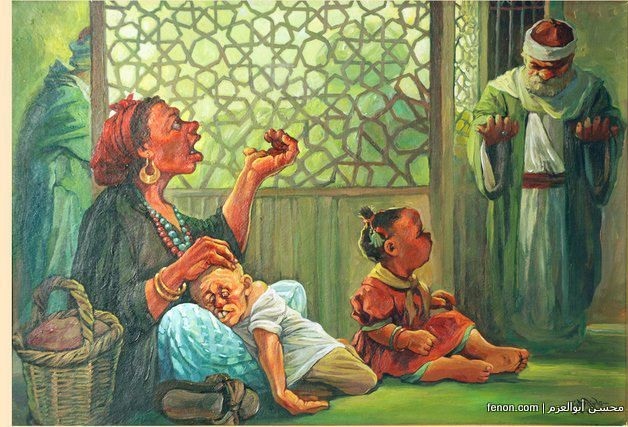صحيفة المثقف
طلاقة اللسان وحكمة البيان القومي لعصر النهضة (4)
 العقلانية واللاعقلانية في الفكر العربي الحديث (6)
العقلانية واللاعقلانية في الفكر العربي الحديث (6)
لقد تعمقت الأبعاد السياسية في الرؤية الإصلاحية لأصحاب النهضة وكذلك حالة الإجماع على أن أسباب الخلل ترتبط بالنظام السياسي والحالة الاجتماعية والروحية (الدينية والأخلاقية). ونظروا إلى هذا الخلل بمنظار النقد الأدبي. بمعنى غلبة الرؤية الأخلاقية والوجدانية في تعاملهم مع حالة الدولة والمجتمع. وهي رؤية عمّقت في نفس الوقت المحتوى السياسي للفكرة الإصلاحية، كما هو جلي في أحد نماذجها الرفيعة والمغمورة في نفس الوقت عند أديب اسحق، التي وضعها في إحدى مقالاته عن ضرورة الإصلاح بشكل عام وأسلوب تنفيذه في العالم العربي بشكل خاص. فهو ينطلق من المقدمة التي بلورها الفكر الإسلامي عن انه "لا عتب على الزمان فانه لا يهلك البلاد وأهلها مصلحون"، ومن ثم فان الإصلاح وقاية للوجود الداخلي للدولة والمجتمع. وبما انه لا يمكن صدور الفعل عن فاعل إلا بوجود الفاعل، لهذا لا يمكن توقع نجاح الإصلاح إلا بمؤازرة الأمة وتضافرهما على إزالة الفاسد وصيانة الصالح. فالإصلاح، حسب نظر أديب اسحق، هو ليس من اختصاص العلية، بل المجتمع ككل. وأن معيار حياة المجتمع يقوم في قدرته على الإصلاح الدائم. واعتبر لهذا السبب انه لا ينبغي للأمة أن تكل أمورها إلى افرد أو فئة لحالها، لان مصير هذا التوكيل والاتكال يؤدي إلى العبودية والاستبداد. وعندما طبق موقفه هذا على السلطنة العثمانية، فانه وجد فيها "منتهى دركات السقوط" وكيانا منغمسا في ترف النعيم الجسماني بلا روح ولا أخلاق ولا قدرة على مجاراة التقدم وصدّ من كان دونها في القوة. وعلى الرغم من تحسسها لهذه المخاطر إلا أنها عاجزة عن القيام بفعل جدي لأنها متذبذبة في المواقف كثيرة الوعود قليلة الأعمال. من هنا ضرورة إصلاحها الشامل من اجل بعث الحركة والحيوية في الهيئات المدنية والسياسية للدولة والمجتمع، وكلية الإصلاح وعموميته على قدر كلية الخلل وعموم الحاجة. بحيث جعله يتكلم عما اسماه بالإصلاح المطلق الذي "لا يكاد يقف عند حد ولا ينتهي إلى تعريف". إذ الإصلاح بالنسبة له بمنزلة "القوة المبقية للموجودات". ولا يعني ذلك سوى إقراره بضرورة الإصلاح الدائم. لان في ديمومته "مصدر الحياة اليانعة". وما عدا ذلك فان للإصلاح الحقيقي شأن كل حقيقة حدودها الملموسة، التي حصرها أديب اسحق بثلاثة شروط هي "الأخذ من الأصل" و"التمكين" و"التدرج". واعتبر أن لكل شرط آفته الخاصة به. فآفة شرط "الأخذ من الأصل" الرضا بالظاهر، وآفة "التمكين" أنصاف الوسائل، وآفة "التدرج" التهور. بهذا يكون أديب اسحق قد وضع شروطا مترابطة في آلية فعلها مبنية على أسس التأصيل الثقافي والاستمرار العملي والعقلانية السياسية. إذ لا يعني الأخذ من الأصل سوى بناء الفكرة الإصلاحية على أساس إدراك ضرورة حاجته استنادا إلى التجربة التاريخية الخاصة وتراثها الثقافي. وبدون ذلك فان التغييرات هي مجرد قشور ظاهرية وتخريب لحقيقة الإصلاح. وبما أن تنفيذ الإصلاح يستلزم وجود الوسائل وتمامها من هنا رفضه لأنصاف الحلول، وذلك لخطورتها بالنسبة لسلسة الإصلاح. أما التدرج فانه أسلوب تذليل الراديكالية (أو التهور حسب عبارة أديب اسحق). حيث ارجع مضمون التهور إلى الأفعال التي لا تلائم أصول المكان ولا تتناسب مع استعداد السكان. وجعل من توفر هذه الشروط جميعا ضمانة نجاح الإصلاح، وبدونها فان "الإصلاح مجلبة للبلاء ومدعاة للشقاء". إذ للإصلاح الحقيقي حسب خطة أديب اسحق، أوجه سياسية (وفيها تدخل المالية والإدارة والقضاء) ومدنية (وفيها تدخل المعارف والمساواة والحرية) واقتصادية اجتماعية (وفيها يدخل الأمن ووقاية العدل وتوزيع الأشغال). وهي أوجه مترابطة لا يتم الإصلاح بدون ترابطها السليم. فالإصلاحات السياسية تستلزم إصلاحا ماليا، لان المال هو أساس الدولة وبدون الأموال لا يمكن إجراء الإصلاحات. ولا تتسع الموارد المالية إلا بتحسن الإدارة واستقامة القضاء. ولا تتم الإصلاحات السياسية إلا بالإصلاحات المدنية عبر تعميم المعارف وحلول المساواة وظهور الحرية. وعليها يتوقف ثبات الأمن واستقرار الأعمال واشتغال الجميع بالقضاء على البطالة. وبمجموعها تؤدي إلى العدل. ولم يجعل أديب اسحق من هذه الحلقات كيانات مستقلة، بل منظومة مترابطة جعل من حلقاتها مبادئ وليس مجرد وسائل. فعندما يتكلم عن القضاء باعتباره أساسا للإصلاح، فانه جعل من ترتيبه وتنقيح أحكامه والاعتناء بمن يعمل به شرطا ضروريا لفعاليته. وربطه في نفس الوقت بالحرية، وربط الحرية بالمعرفة انطلاقا من انه لا حرية بدون علم ومعرفة، ولا قضاء حر ومستقل دون العلم والمعرفة. وينطبق هذا على الإدارة. بمعنى أن إصلاحها وعملها الفعال يفترض ضرورة تغير وتبدل المؤسسة الإدارية نفسها وجعل عملها مرتبطا بمبادئ واضحة تتعلق بتجديد المسؤوليات والواجبات في الفروع والأصول والأطراف والمركز، وليس بإقالة الأشخاص واستبدالهم الدائم بما في ذلك من هو جيد ومناسب. وطبق نفس المبدأ على مختلف جوانب الإصلاح. انه حاول التأسيس العقلاني لمنظومة الرؤية الإصلاحية من خلال بناء مبادئها العامة ووحدتها الداخلية الهادفة إلى تحقيق المساواة والحرية. ولم يقصد بالمساواة هنا سوى سيادة القانون. أما الحرية فإنها ضرورة لأنها الإنسان نفسه، كما قول أديب اسحق.
إن بلوغ اللسان طلاقته التامة كان يعني من الناحية التاريخية تحرره من أسر العبارة نفسها وتقاليدها اللغوية، والانهماك في غمار الحياة وإشكالاتها السياسية الكبرى. وعندما أصبحت قضايا الإصلاح بأبعاده السياسية، والحرية بأبعادها المادية والمعنوية موضوع تأملهم الدائم، آنذاك يكون الوعي الأدبي قد بلغ الحد الضروري الأولى في إدراك جوهرية الهوية القومية بمختلف أبعادها الدولتية والسياسية والثقافية. لأنه كان ينبغي قطع الأشواط الضرورية ابتداء من العثور على الضمير الغائب في اللغة العربية وانتهاء بإعراب الضمير الحاضر. فعندما يتناول الشدياق على سبيل المثال، حالة مصر بعد زيارته للإسكندرية فإنه يشير إلى ما للأتراك من سطوة وتجبر على العرب بحيث كان لا يحل لعربي النظر إلى وجه التركي ولا المشي إلى جانبه. وجعله ذلك يسخر من "مجلس الشورى" التركي الذي استقر رأيه بعد مناقشات حادة على أن يتخذوا مركبا من ظهور العرب! وكيف انه شاهد مرة تركيا يقود جوقة من العرب بخيط كاغد. وينقل لنا صور كثيرة عن عجرفة الأتراك من الرجال والنساء وسرقاتهم واحتيالهم في الحياة والتجارة وما شابه ذلك. ويستغرب في نهاية المطاف من هذه العجرفة، متسائلا مع نفسه عن "سبب تكبر هؤلاء الترك هنا على العرب، مع أن النبي كان عربيا والقرآن انزل باللسان العربي والأئمة والخلفاء الراشدين والعلماء كلهم كانوا عربا". وأجاب على ذلك قائلا "أظن أن أكثر الترك يجهلون ذلك ويحسبون أن النبي كان يقول شويله بويله أن بقالم قبالهم، أو غطالق قاب خلي دلها، طفالق باق يخم بلها، اشكارهم كبي والله، قلاقلها بلابلها".
وعلق على ذلك قائلا " لا والله ما هذا كان لسان النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة إلى يوم الدين"! في حين اعتبر سليم البستاني أن "لغة العرب هي أفصح اللغات وأوسعها". وعندما كتب أديب اسحق إحدى مقالاته المعنونة "بدولة العرب"، فانه طالب "زعماء الأمة العربية" بالتقارب وحشد إمكانياتهم من اجل "النداء بصوت واحد من فم واحد" قائل:"قد جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، هبّت الحاصبة تليها العاصفة. فذرت حقوقنا صارت هباء منثورا، وألمّت بنا القارعة ووقعت الواقعة فصرنا كأن لن نفن بالأمس ولم نكن شيئا ذكورا. فهلّم ننشد الضالة ونطلب المنهوب. لا تقوم بأمر ذلك فئة دون فئة ونتعصب لمذهب من مذهب. فحن في الوطن أخوان تجمعنا جامعة اللسان. فكلنا وأن تعدد أفراده إنسان".
إننا نعثر في لغة الأدباء على معاناة الوجدان في بحثها عن الهوية العربية والارتقاء بها إلى مستوى التأسيس النظري عن ضرورة الانبعاث الجديد للأمة التي سادت قديما على العالم بفضائلها وعلمها وآدابها. فالشدياق يستغرب جلافة وصلف وتجبر الأتراك وهم لا شيء في العلم والأدب والفضيلة. في حين أن فضائل العرب متميزة فريدة وكان يكفيه مجرد إكرام الباي التونسي ليجد في ذلك دليلا على خصوصية العرب في الكرم وتميزهم عن سائر الأمم. بحيث جعله ذلك يستنتج قائلا "الكرم ميزة خاصة بالعرب، وهو سبب كثرة الشعراء فيهم". واعتبر سليم البستاني العرب المعاصرون هم أخلاف العرب الذين سادوا العالم ونشروا العلم والعدل والأخلاق كما كان السريان والكلدان أصحاب المعارف والعلوم، واليونان أصحاب الفلسفة والحكمة. وبني على ذلك استنتاجه القائل، بأننا أمة ذوي تاريخ عريق في كل ما له صلة بالتمدن من أخلاق رفيعة وأرض جيدة ومياه عذبة وهواء نقي.
وشكلت هذه الانطباعات والتصورات والأحكام الصيغة الأدبية السائدة في عقول أدباء النهضة ووجدانهم. وأخذت تشق لنفسها الطريق إلى العبارة السياسية بأبعادها القومية التحررية. فقد توصل بطرس البستاني في تأملاته إلى أن تاريخ العرب هو تاريخ الإبداعات الكبرى. وأن النهوض المعاصر ضرورة لنفض غبار الماضي وكسر قيود التخلف. ووضع ذلك في شعاره "هبّوا! استيقظوا! انتبهوا! شمّروا عن سواعد العزم!" وجعله ذلك يتكلم عن ضرورة تصعيد الغيرة من اجل إنهاض الجنس العربي من حالته الساقطة. وبنفس المنحى كان سليم البستاني يخاطب العرب بعبارات "أيها العرب! انتبهوا! استيقظوا! انهضوا! هبّوا! وانبذوا عنكم كل ما لا يأتيكم بمنفعة!". ووضع ذلك في دعوته عن ضرورة سعي العرب لترتيب حياتهم بالبحث عن نظام شامل عادل فعال. وحصلت هذه الوجدانية الصادقة على تعبيرها الشعري في مطلع القصيدة البائية لليازجي "انتبهوا واستفيقوا أيها العرب…"، والتي يدعوهم فيها أيضا بعبارة "فشمروا وانهضوا للأمر وابتدروا…". ويخاطبهم أيضا "فيا لقومي، وما قومي سوى عرب…". ويستثيرهم بكلمات:
بالله يا قومنا هبوا لشأنكم
فكم تناديكم الأسفار والخطب
ويعنّفهم قائلا، بأنه إذا لم يكن فيكم أهل منزلة ولا أهل علم ولا غيرها من "الأهالي"
أليس فيكم دم يهتاجه أنف
يوما فيدفع هذا العار إذ يثب
ووضع هذا المزاج الحار العاصف والمشبوب بألم المعاناة الصادقة عن حالة العرب في انتقاده الحاد للعجرفة التركية ورذائلها العديدة، معتبرا الترك علوجا وأوغادا سلاحهم في وجوه الخصم مكرهم وخير جندهم التدليس والكذب. من هنا توعده الترك:
صبرا هيا أمة الترك التي ظلمت
دهرا، فعما قليل ترفع الحجب
لنطلبن بحد السيف مآربنا
فليس تجيب لنا في جنبه أرب
وليس أمام العرب في هذه الحالة سوى النضال من اجل التحرر الكامل واستعادة الهوية القومية والثقافية. إذ لا شيء يخسره العرب سوى الذل والمهانة.ووضع هذه الرؤية في نبوءة مفارقة تقول:
ومن يعش ير، والأيام مقبلة
يلوح للمرء في أحداثها العجب!
لقد أبقت هذه الرؤية الشعرية على تركة القرون الخمسة المظلمة للسيطرة العثمانية (التركية) في طي "الأيام المقبلة"، بما فيها من عجائب مقبلة للمرء (العربي)، باعتبارها إشكالاته الخاصة. وسوف تكشف الأحداث اللاحقة للعالم العربي عما في هذه الرؤية من حدس عميق للخلل البنيوي الشامل الذي تركته السيطرة التركية في المنطقة. فقد تضمنت هذه الرؤية في شاعريتها حوافز التحدي العربي وقدرته على تجاوز حالة الانهيار المادي والمعنوي لكيانه الثقافي والسياسي، وفي واقعيتها كانت تحمل أثقال الوجدان المعّذب من تركة القرون الخمسة. وفي ازدواجيتها هذه عكست حالة العالم العربي ومسار وعيه العقلي والوجداني، أي أنها مهّدت مع ما أبدعه رجال النهضة الفكرية في تحصينهم للرؤية الثقافية العربية مقدمات انعتاق الوجدان القومي والاجتماعي للعرب وانبعاثه الجديد.
***
ا. د. ميثم الجنابي