صحيفة المثقف
الذكورة والأنوثة في نظام التخلف
 تعزو رجاء بن سلامة في كتابها (بنيان الفحولة: أبحاث في المذكر والمؤنث)* الفضل في ريادة وتأسيس مفهوم الجندر (ص11) أو ما تسميه النوع الاجتماعي (ص13) لفرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي. ومع ذلك كان منهجها أقرب لحفريات فوكو. فقد تابعت ولادة معنى الجنس الثالث (المخنث) واللاجنسي (الخصيان) في المدونات ابتداء من القرآن وحتى الأغاني لأبي فرج مرورا بكتابات الجاحظ، ولم ترفد قراءتها بأي دليل مادي. بمعنى أنها اكتفت بتذييل نص على نص مثلما فعل ابن رشد بأرسطو على سبيل المثال. وهذا يترك كل شيء على ذمة الراوي. كما أنها خلال تشريح المدونة اكتفت بجانب واحد من الحقيقة اللغوية. فقد اعتبرت أن القرآن حرّم بشدة المثلية الذكورية ولكنه وعد الصالحين بولدان مخلدين. ورأت أن هذه الإشارة تدعم موضوع متعة الرجال بغلمان من الجنة (ص15). ولم تكلف نفسها عناء قراءة العبارة بسياقها اللاهوتي، على الأقل، والذي يشير بكل وضوح لدور خدماتي لا يشمل البهجة الجنسية أو اللذة. ناهيك أن كلمة ولدان تدل على يافعين وغير بالغين وكلمة مخلدين تدل على أهل الجنة (من نشأ فيها بعيدا عن كل قيود وأعصبة الواقع الدنيوي). ثم إن العبارة غير نوعية ولا مخصصة، وتطلق على المذكر والمؤنث. ولا أعلم لماذا ترى ابن سلامة في هذا المشهد شيئا يتجاوز حدود الخيال الإسلامي لليوتوبيا. فهو مجرد وعد من الذات الإلهية بتوفير أساليب ووسائل الراحة للكبار الذين اتبعوا توصيات الخالق وطبقوا كل تعليماته. وربما لا يوجد في كل القرآن آية نظيفة ومتعالية على الشهوات مثل هذه الآية. ولدينا كم هائل من المشاهد فوق الطبيعية سواء في القرآن أو الحديث، وفيها تتعايش كافة الأجيال والأجناس في جو مسحور، وفي إطار رموزي يتعمد المبالغة.
تعزو رجاء بن سلامة في كتابها (بنيان الفحولة: أبحاث في المذكر والمؤنث)* الفضل في ريادة وتأسيس مفهوم الجندر (ص11) أو ما تسميه النوع الاجتماعي (ص13) لفرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي. ومع ذلك كان منهجها أقرب لحفريات فوكو. فقد تابعت ولادة معنى الجنس الثالث (المخنث) واللاجنسي (الخصيان) في المدونات ابتداء من القرآن وحتى الأغاني لأبي فرج مرورا بكتابات الجاحظ، ولم ترفد قراءتها بأي دليل مادي. بمعنى أنها اكتفت بتذييل نص على نص مثلما فعل ابن رشد بأرسطو على سبيل المثال. وهذا يترك كل شيء على ذمة الراوي. كما أنها خلال تشريح المدونة اكتفت بجانب واحد من الحقيقة اللغوية. فقد اعتبرت أن القرآن حرّم بشدة المثلية الذكورية ولكنه وعد الصالحين بولدان مخلدين. ورأت أن هذه الإشارة تدعم موضوع متعة الرجال بغلمان من الجنة (ص15). ولم تكلف نفسها عناء قراءة العبارة بسياقها اللاهوتي، على الأقل، والذي يشير بكل وضوح لدور خدماتي لا يشمل البهجة الجنسية أو اللذة. ناهيك أن كلمة ولدان تدل على يافعين وغير بالغين وكلمة مخلدين تدل على أهل الجنة (من نشأ فيها بعيدا عن كل قيود وأعصبة الواقع الدنيوي). ثم إن العبارة غير نوعية ولا مخصصة، وتطلق على المذكر والمؤنث. ولا أعلم لماذا ترى ابن سلامة في هذا المشهد شيئا يتجاوز حدود الخيال الإسلامي لليوتوبيا. فهو مجرد وعد من الذات الإلهية بتوفير أساليب ووسائل الراحة للكبار الذين اتبعوا توصيات الخالق وطبقوا كل تعليماته. وربما لا يوجد في كل القرآن آية نظيفة ومتعالية على الشهوات مثل هذه الآية. ولدينا كم هائل من المشاهد فوق الطبيعية سواء في القرآن أو الحديث، وفيها تتعايش كافة الأجيال والأجناس في جو مسحور، وفي إطار رموزي يتعمد المبالغة.
ولكن هذا لم يمنعها من استنتاج ملاحظات هامة عن الفجوة المعرفية التي تفصل الواقع عن النص. فقد كان المجتمع العربي منذ بداياته يعاني من ازدواجية في المعايير، ويتعايش مع واقع شيزوفراني تسوده مقاييس غامضة. وهو ما رأت فيه ريبكا غولد، ضمن دراساتها عن إسلام العصور الوسطى، اضطرابا بالتعبير المجازي. فالعرب كانوا يميلون للاستعارة والفرس للتشبيه. وأعتقد أن هذه النتيجة هي تحصيل حاصل لدراما الصراعات البينية. وإذا كان الصراع على الموارد قد تحول إلى صراع على السلطة، وإذا كانت تلعب به أيدي الدول العظمى (الفرس والبيزنطيين) فقد انتقل لصراع بين بين لوبي حضارات، أو ثقافة شمسية مقابل ثقافة قمرية. وهو ما تطور في العصر الحالي لنوع من المواجهة بين الولاءات. وبلغة رجاء ابن سلامة بين عرب محدثين وموجات تدخل في عداد ما يسمى الصحوة الإسلامية (ص20). ولا تنسى بهذا السياق أن تشير لعقدة مستعصية في تفكيرنا السياسي المعاصر وهي تهمة التآمر والتجسس. حتى أن محمد حسنين هيكل ذكر في كتابه “كلام في السياسة” أن ملك الأردن السابق كان يتقاضى راتبا شهريا من المخابرات الأمريكية. ويحالف ابن سلامة الصواب حينما تعزو هذه المشكلة لسقوط وتصدع النظام الأخلاقي (وضمنه الجنسي والسياسي) عند العرب. فالسياسة مثل الجنس مجال خصب للأوهام وإضفاء هالات تقديس مزيفة وبلا طائل، وهي جزء من الأساطير التي اختلقها النظام المثنوي في عملية الخلق الإلهي. وقادها ذلك إلى قراءة سريعة في بعض المفاهيم ومنها مبدأ القوامة في الإسلام (ص30)، فهو مبدأ اجتماعي وله أسباب اقتصادية فرضها النظام الاقتصادي المتبع في القرن السادس بعد الميلاد والذي يتصف بأنه اقتصاد جائر وغير متوازن ويعبر عن اختلافات عميقة بين بقايا مجتمع البادية ورواسب الحياة الحضرية. فقد كانت حياة القبائل تعتمد على الصدفة والمغالبة، بينما استقر في المدن نظام عمالة هرمي وطبقي، وبقليل من المرونة يمكن أن تفهم أن الحياة في المضارب تحتاج لذراع لحمل السيف، إن لم يكن بهدف الحرابة فعلي الأقل لمواجهة مخاطر وغدر الطبيعة، مقابل الإيمان بالقيمة التبادلية للسلع والحرف في المدن. حتى أن الأمر الإلهي كان مشروطا. فقد ربط القوامة بالتفضيل والإنفاق (ص 30). وكما لاحظت ابن سلامة إن انتهاء الظرف يفرض إنهاء المفعول. وتعتقد أنه ضرورة واقعية ولا مندوحة عنها، ولذلك تدعو دون مواربة في خطوة أولى لإنهاء وصاية التراث وفرض الحداثة باعتبار أنها مكسب مدني ومعرفي تنظر للإنسان على أنه قيمة بحد ذاته وليس مصدرا للقيمة فقط. وفي خطوة ثانية لافتراض حداد على الماضي وأمواته، أو بالأحرى لتبني “عمل حداد” بلغة فرويد. وتضيف لاحقا: إن الحداد لا يسيء لأحد ولكن يضفي جوا من الاحترام والتقدير دون أن يسمح للموضوع المنعدم بالتحكم بحياتنا ومصيرنا (ص146).
لم يكن الإسلام دينا جاهزا ومفصلا بشكل مسبق مثل الأحزاب السياسية الحديثة، ولكنه جاء ليعيد ترتيب العلاقة بين الوعي والطبيعة أو بين نظام المعرفة ونظام العمل. ولم تبدأ المشكلة إلا حينما تحول لدين دولة. وهذه نقطة مفصلية. وسرعان ما فقدت المرأة بعد ذلك الحقوق التي كفلها لها الشرع (ما تعارفنا على تسميته بالوحي)، وأصبحت رهينة بيد إرادة ورغبات الفقيه. ويوجد فرق ملحوظ بين المفهومين. فالتشريعات نصائح إلهية، في حين أن الفقه حوّل الوعي الباطن إلى قدوة يجب اتباعها. بتعبير آخر فرض رغبات الفقيه ولم يعرب عن حاجات المجتمع والأفراد. ونجم عن ذلك استبدال الشرائع بمجموعة من اللوائح والأحكام، وبهدف واحد لا ثاني له، وهو تعويم السياسة الدينية على حساب الدين ذاته، أو كما تقول ابن سلامة: الارتهان لهوية أمة متخيلة (ص42).
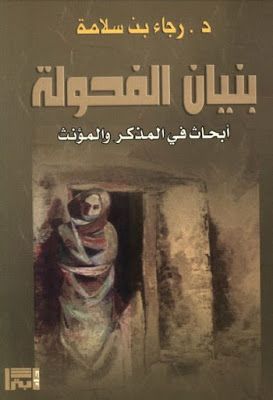 ويمكن القول إن انحطاط واقع المرأة لا يمكن تعديله بالشعارات التي رفعتها الحركات النسوية مثل المساواة (أو المساواة قليلة الدسم - المختزلة إلى ما تسميه ابن سلامة الإنصاف)، ثم الحق بالتصويت أو مطالب مضحكة ومدعاة للطرافة كقيادة السيارة، وارتداء أزياء لا تعمل على تجريمها وسوى ذلك (ص42). فالمشكلة هي في انحطاط الوضعية الاجتماعية والحقوقية لشعوب العالم الثالث بشكل عام. ولسوء الحظ أن معظم الشعوب الإسلامية تعيش ضمن المجال المجدي لهذه الحضارات نصف الميتة. فقد خسر فيها الدين وضعه الوظيفي (التحرر من أدوات التأويل والدخول بشراكة موضوعية مع السياق)، وأصبح جزءا من نظام الرقابة والعقاب، أو بتعبير ابن سلامة: عمل على إخلاء وتفريغ الفضاء العام وعلى زيادة دور آلة المحاسبة (ص40). حتى أنه في بعض الحالات لعب دور وسم إيديولوجي مع إعادة ترتيب لنظام الفوارق (ص40).
ويمكن القول إن انحطاط واقع المرأة لا يمكن تعديله بالشعارات التي رفعتها الحركات النسوية مثل المساواة (أو المساواة قليلة الدسم - المختزلة إلى ما تسميه ابن سلامة الإنصاف)، ثم الحق بالتصويت أو مطالب مضحكة ومدعاة للطرافة كقيادة السيارة، وارتداء أزياء لا تعمل على تجريمها وسوى ذلك (ص42). فالمشكلة هي في انحطاط الوضعية الاجتماعية والحقوقية لشعوب العالم الثالث بشكل عام. ولسوء الحظ أن معظم الشعوب الإسلامية تعيش ضمن المجال المجدي لهذه الحضارات نصف الميتة. فقد خسر فيها الدين وضعه الوظيفي (التحرر من أدوات التأويل والدخول بشراكة موضوعية مع السياق)، وأصبح جزءا من نظام الرقابة والعقاب، أو بتعبير ابن سلامة: عمل على إخلاء وتفريغ الفضاء العام وعلى زيادة دور آلة المحاسبة (ص40). حتى أنه في بعض الحالات لعب دور وسم إيديولوجي مع إعادة ترتيب لنظام الفوارق (ص40).
وهذه الصورة القاتمة هي تحصيل حاصل لما تعرضت له المنطقة من حالات تهجير ونزوح. ولا أشير لموجات الهجرة بسبب الحروب ولكن بسبب الكوارث. فإخلاء الريف من سكانه، ومحاصرة المدن بالمهاجرين من الأرياف ساعد على تبدل جذري في سلم الأخلاق. ولم تعد هناك أي علاقة انتماء للأرض وإنما التزام بنظام الإنتاج. ولا ضرورة للتذكير أنه نظام عسكري. حتى الشرائح المدنية تخضع لتراتب يشبه المفهوم العسكري بالواجب والانضباط، وهو ما ترى ابن سلامة أنه سبب لانتشار مقولات مغلوطة ونفعية مثل خصوصية الأمة وفرض هويات غير مرغوب بها (ص42). ولكن السؤال الشائك: عن أي أمة نحن نتكلم، وبالمنطق عن أي هوية؟؟..
لا يوجد لحينه أي اتفاق حول هذه الحدود. وتبدو لعين الناظر أشبه بتعويم رأسمال رأسمالي، فكل حد مرتبط بصورة نفعية ومؤقتة بحد آخر يدخل في تركيبه، مثل معنى جوهر الإسلام، فهو بمفهومه المعاصر مجرد طريق لتشكيل وعي مادي عن مسائل ميتافيزيقية.
ومن هذه الصدوع تسللت مفاهيم جهادية متناحرة لم تفعل شيئا غير زيادة مساحة الخراب والتخلف والازدواجية في السلطات، أو ما تقول عنه ابن سلامة: انفصام لدرجة الطلاق بين التشريعات والواقع الاجتماعي (ص41).
وعلى هذا الأساس تنظر لمشكلة الحجاب الذي تختص به المرأة وتعفي منه الرجل، ولكنها تقسم الحجاب النسوي لنوعين: حركي (خمار وفوقه جلباب- ص65)، وفضائي (يفرض إقامة جبرية على النساء في محميات لا تصل إليها عيون الذكور البالغين) وتقصد به على نحو خاص عزل نساء النبي عن الحياة العامة (ص58).
وأغتنم هذه المناسبة لتوضيح نقطتين.
الأولى أن الخمار تقليد اجتماعي معروف قبل الإسلام. وهذا باعتراف ابن سلامة التي بنت فكرتها على بحوث روزين لامبان المختصة بالثياب الدينية (ص65).
النقطة الثانية أن تضييق الحركة على النساء مذكور حتى في معلقة طرفة بن العبد المتوفى قبل البعثة بحوالي 40 عاما، وذلك في معرض كلامه عن البكهنة في حرمها المعمّد (المرأة البدينة بيضاء اللون التي لا تضطر لأداء أعمال سخرة عضلية). فقد كانت زينة ذوات الخدور لا تكتمل إلا بلون البشرة الأبيض. وهذا بالضرورة يتطلب ارتداء كساء فوق كساء أو جلبابا مع خمار. بالإضافة إلى الاحتماء تحت سقف يمنع أشعة الشمس والغبار. وأنا مع ابن سلامة أن الخباء كان علامة طبقية خاصة بالحرائر كما لاحظت في خطاب للخليفة عمر بن الخطاب مع جارية مكممة (ص67). وحين فرض الإسلام الحجاب على كل النساء لم تكن الغاية تحصين المجتمع من الفتنة، كما هو شائع، ولكن لتحقيق المساواة ولتحرير الإماء من علامة التبعية. لقد ساوى ما بين الحرة والأمة، وألغى الفروق بين من يملك ومن لا يملك. عدا ذلك لم تكن المرأة العربية تفتقد للتقدير لدرجة العبادة. وخذ اللات على سبيل المثال. كان لها معبد في الطائف يدعى بيت الربة، وله كسوة وحاجب، ويجاريها بهذه المكانة العزى ومناة، وهما بالأساس من آلهة الأنباط والآشوريين. وباعتقادي أن العرب أكرموا المرأة عندما اختاروا للحياة وللأرض والشمس صيغة تأنيث، وللموت واللحد والقمر صيغة تذكير. بتعبير آخر كانت المرأة واضحة ومعروفة ومأمونة الجانب، بينما الرجل كائن مجهول ومحجوب عن الإدراك والتجربة العملية ولا يمكنك أن تضمنه. ولا ضرورة للتذكير أن المؤنث في كل اللغات مبدأ يعمل على ثلاثة محاور:
الطبيعة المانحة، والأرض الحاضنة، واللسان الذي يلزم للتواصل ولبلورة حياة اجتماعية وإنسانية كريمة. وهذا المثلث وحده يكسر القاعدة الشريرة لعقدة أوديب ويخففها ببدائل تضمن لنا تصعيد الجانب المدمر من الغرائز. وبالنسبة لشرط اللغة لا يسعنا إلا ملاحظة طبيعته الثنائية. فهو يتكون مثل الآخر عند لاكان، من حالة شمولية (أحرف كبيرة) تحيلنا إلى اللسان أو القواعد الأساسية. وحالة نوعية خاصة (أحرف صغيرة) تحيلنا إلى الكلام. وعليه لا يمكن أن يكون القانون ذكوريا باستمرار، بل هو بالأساس اختراع أمومي له تطبيقات ذكورية. وهذا خير تعبير عن الطبيعة المتكررة للسان الأم، والحالة الاجتماعية المعزولة في بيئاتها للكلام واستعمالاته. بتعبير آخر إن الحالة الطبيعية في أي مجتمع هي رحمانية (تدين بالفضل للأم - بالتحديد الرحم) مع وجود مساحة للتطبيقات المذكرة. ومن هنا يبدأ التقابل المدمر بين المعاني الضمنية والألفاظ الظاهرة، ويمكنك القول بين سياسة البيت وسياسة الشارع، فكر الحضانة والرعاية وفكرة استنزاف الطبيعة واستثمارها. وإذا تورط العرب بمنطق ذكوري فهذا ليس مشكلتهم بل مشكلة تطوير الفكر الريعي بشكل عام، ولا سيما في حالة الديانات السماوية التي حصرت الربوبية والتأله بالرب والله والخالق (وهي مفردات تأخذ حصرا صيغة تذكير). ولا يفوتني هنا التنويه بخصوصية معنى “الفحولة”، فهو مجرد ترضية رخيصة للطبقات المعدمة التي لم تحصل على كفايتها من التعليم والثقافة، وتستطيع أن تشعر بخطره في أوقات الشدة حينما تكون المبادرة لغريزة الموت وما يرافقها من عنف وانتهاكات واستعمال مفرط للقوة.
ولا بد هنا من التفريق بين خطاب الجماعات الشعبوية وخطاب ذاكرة الشعوب الذي تحفظه الملاحم والسير والأمثال من الضياع. فالخطاب الشعبوي يتطور باتجاه واحد ودون أي بنية فنية، في حين أن للذاكرة الشعبية عدة صيغ وأشكال، وكلها تتفق على المساواة بين الجنسين. مثلا الساحرة امرأة لديها قوة خارقة، ولكن المارد رجل لديه عضلات فولاذية. ويمكن أن يتصارع الطرفان، وأن تنشب حرب بين امرأة استثنائية وسوبرمان، ويصبح كيد المرأة بمواجهة علنية مع جبروت الرجل.
إن الظواهر السلبية التي عانت منها المرأة طويلا هي نتيجة تخلف حضاري أو اختناقات اجتماعية. ولا علاقة لها بالعرب أو الإسلام. وإذا كنا نقر بتعدد الزوجات فالعرف المدني الأوروبي يقر بتعدد المعشوقات والمحظيات. وإن كنا نلجأ للزواج المدبر، فالغرب يعرف هذه الترتيبات سواء بين الأسر الحاكمة، أو بين العوائل البورجوازية التي واكبت أول ثورة في وسائل الإنتاج واستمرت حتى سقوط الرايخ. وتورد ابن سلامة عدة ملاحظات بهذا الاتجاه منها أن غطاء الرأس كان مستحسنا عند النساء والرجال منذ العصر الجاهلي، وتحول لفرض أو واجب أخلاقي منذ ظهور الطربوش في القرن التاسع عشر (ص70). وتجد أصداء هذه التحولات في الرواية العربية، سواء المكتوبة بعد ما يسمى بالثورات (المقصود انقلابات العسكر بعد مأساة 1948)، أو بعد اندلاع شرارة الربيع العربي. وتجد في الطورين أدلة على ظواهر عجيبة يندى لها الجبين مما تنطوي عليه من أحقاد وانتهاكات للقانون الإنساني ولبديهة وفطرة البشر، ولا سيما في روايات ظاهرة الحرب الإسلامية المقدسة. فقد رفعت الستار عن تشوهات نفسية عميقة لم تدفن المرأة تحت الأرض فقط بل شجعت على تسليعها واعتبارها مجرد قيمة جاهزة للتداول في السوق (وتشير ابن سلامة لعدة أمثلة من هذا النوع لكن في مجال الحفريات والدراسات. انظر ص 80 - 84). وتزامنت هذه الظاهرة مع موجة الرواية المثلية في أوروبا والأمريكيتين، وحولت المسألة لقضية حقوق طبيعية. بمعنى أنها نظرت إليها كجزء من إكراه الطبيعة على إلغاء نفسها وميولها. ويمكن لأي متابع أن يشعر بالدهشة كيف تتوازى مسائل الجنوسة في الحالتين: استعباد الإنسان من قبل أدوات التخلف أو تحريره بواسطة أدوات الصناعة. إن الفوضى الناجمة عن التخلف لا تقل شأنا عن الركود الناجم بسبب زيادة التقدم، وربما كانت أول لحظة هي نتيجة موضوعية لثاني لحظة. فأي أطروحة يرافقها أطروحة مضادة، وهو ما يدعوني للنظر للمسألتين على أنهما جزء من نفس المنظومة. وربما أبسط تفسير لذلك تجده في قانون الصدمة. فأثر التخلف لا يقل عن أثر الإفراط بالتحديث، وكلاهما ارتطام بالحاجز الزمني أو إقلاع بآلة الزمن وإن تعاكست الاتجاهات. والدليل على ذلك هو تطابق البنية الفنية وأدوات التصوير والمحاكاة في الحالتين. لقد وضعت هذه الوحدة السردية عاطفة الإنسان أمام الطبيعة وليس العقل، ولذلك كان التناقض بين عاقل وغير عاقل وليس بين ذهن ومشاعر. وساعد ذلك على زيادة الجرعة الدرامية أو الصراع لدرجة تناقض أساسي، ولم تنجم عنه مواقف انطباعية تشجع على التكهن والتأمل، وربما الدعوة للمصالحة. لقد تم تفكيك أي فلسفة تشجع على المصالحة وأصبح الطريق ممهدا لأن يلغي كل طرف عكسه. وأعتقد أن هذا الإلغاء أفاد أطروحة هنتنغتون المشؤومة في صراع الحضارات، فصحوة الحضارة الشرقية القديمة لم يكن يجاريها شيء غير صحوة الحضارة الغربية الصاعدة. وأعتقد أن المتضرر من هذا الصدام المسعور هو وعي النوع لذاته. فقد ظهر مفهوم نوعي غريب وشاذ لكل فئة، وتدخلت الإرادة الوهمية لفرض حقيقة مفتعلة، وربما لو تفاقمت هذه المساعي لتبدل توازن البشرية وأصبحنا أمام مشكلة في بيولوجيا النوع مثل مشكلة تلويث الجو والمياه، أو حتى ظاهرة الاحتباس الحراري. ولا أستغرب أن يأتي يوم ونجد أنفسنا فيه أمام نوع بشري غير معروف، فالإنسان الجليدي مختلف تماما عن الإنسان الحديث سواء بالبنية التشريحية أو حجم الدماغ، وهذا سينعكس على الواقع وأشكال تطوره. ويكفي أن نلاحظ النمط الجديد من الهجرات. إذا غلبت هجرة الأفراد على جيل التنوير في بدايات القرن الماضي، تغلب على الدفعة الثانية هجرات جماعية، وأغرب ما في الموضوع أن الاتجاه معكوس. الغرب الرأسمالي يوفر الرعاية للاتجهات المتأسلمة (ذات الاتجاه المتزمت) بينما توفر الإمارات والممالك العربية الملجأ لبقايا اليسار العربي. بلغة أوضح تحولت منطقة الخليج الناطقة بالعربية لأندلس جديدة، لم يبق فن لم يشهد نهضة، وكذلك بالنسبة لكل الصناعات الاستهلاكية ومنها السياحة والثقافة. بالمقابل تحولت العواصم التقليدية للشرق إلى نفق مظلم، وتحتله سلطات مشغولة بأوهامها. ودون أي تردد أجد أن الشرق التقليدي تحول لغربال أو بأحسن حال لمنطقة عازلة. بمقدار ما هو مشغول بمشاكل البقاء والضروريات هو أيضا معزول عن مستقبل العالم، والأسوأ عن هويته الأصلية والحقيقية، وربما هو حاليا شرق غير شرقي، لا يعرف نفسه، ويغطيه رماد موته البطيء. وفي هذا الجو لا يهم أي بنية، فهي بنية عقيمة ومعطلة، ولا يمكنها أن تكون واضحة، أو لها معنى بمضمون محدد. ولا شك أن الواقع الجريح سيتكفل بخصاء الدوائر الاجتماعية، لا فرق أنها مذكرة أو مؤنثة. المهم أنها معطوبة وجريحة، وتحتاج لتضميد محتوياتها المنهكة قبل أن تدلي بدلوها. وأي حديث عن جنس ثالث أو حريات مدنية سيكون موضوعا سابقا لأوانه. وأن نطالب للمرأة بحق التصويت والاقتراع هو في حقيقة الأمر أقل من نصف المشكلة. والمفروض أن نطالب أولا بالنزاهة في إجراء انتخاباتنا. وفي ظل الأنظمة القمعية لا يمكن تفعيل أي دستور، ناهيك عن تنشيط بقية الفعاليات، فدساتيرنا لهذه اللحظة مجرد حبر على ورق. وأفضل من يعبّر عن ذلك الصحف الوطنية. فالصفحة الأولى قصائد عشق ومديح للقيادات، والصحف الداخلية تعيش في حالة غيبوبة، كأن الصحيفة الواحدة موزعة على حلقات ودوائر مغلقة لكل منها دستورها ومرجعياتها. والتعديلات الدستورية نتيجة لمسيرة طويلة وشاقة، ويمكننا أن نتعلم خلالها المعايير الحديثة، وأن نعيد هيكلة عقولنا وأدمغتنا. وهذا ينطبق على الأنظمة العلمانية والمشيخيات على حد سواء. وإذا سلمنا مع رجاء ابن سلامة أن المرأة تتعرض لانتهاك دستوري وأخلاقي في منطقتنا، فهو جزء من الانتهاكات العامة التي تلحق بعلاقة الأب بابنه، ومدير المؤسسة بالعاملين لديه.
وباعتقادي إن جيل التنوير العربي كان مناصرا للمرأة أكثر من جيل التنوير الغربي. وأي مقارنة بين أعمال فنية لها عناوين نسائية تحسم المشكلة لمصلحة أول طرف مع أنه كان يضع شعرا أوروبيا مستعارا. بتعبير آخر مع أنه بجوهره ينادي بمحاكاة الغرب في تثوير الواقع تبقى الإيديولوجيا ببرقع نسائي واضح. وإذا أخذنا (زينب - 1913) لهيكل و (سارة- 1938) للعقاد على سبيل المثال لن نقابل غير بنات حقول خضراء مدللات أو سيدات صالونات مخملية. ولا يمكن أن تسجل أي خشونة تدين الرجل حتى لو أن المجتمع دون قلب ولا عاطفة. ولو تمهلت قليلا ستلاحظ أن المشكلة في مستوى الحياة وليس في ظرف الوعي، أو أن المواجهة كانت محتدمة بين المطلق والنسبي. بعكس حال مول (فلانديرز- 1722) لديفو أو (نانا- 1879) لزولا.
فكل شيء هنا ينصب على تأثيم المرأة وتذليل الرجل. ولا أعلم ماذا يمكن أن تقول عن هذه الإيديولوجيا الفنية. إنها عمليا لا تدعو لتمريغ واقع الجنسين بالوحل، ولكن لعلها تكتب مرثية لموت أخلاق وعادات وصعود بديل عنها. ويمكن أن تقول إن المرأة بنظر رواد التنوير الأوروبي كانت تلقي وزر ووصمة العار التوراتية على النساء، سبب طرد الإنسان من الجنة.
ولا يمكنني أن أجد في التقابل بين الجنسين أي خطأ استراتيجي. فالتصنيف شيء من طبيعة الأمور، والجينيالوجيا (علم الأنسال) موضوع قائم بحد ذاته، ويخدم تعريف الأشياء بصفاتها النوعية والوظيفية الخاصة. ومن الطبيعي أن المرأة هي كائن أو مخلوق غير الرجل (وهما ثنائية متقابلة - ص97). وأن يكون للمرأة اسم صفة يعني أنها كائن مختلف، ويتطلب مقاربة خاصة في معظم الأحيان. إن التقابل شيء والتمييز شيء آخر. ويتأتى العنف من أسلوب الفهم والاستيعاب والمقاربة. وهو شيء ينطبق على الجنسين. وأن تحدد عمل المرأة بواجباتها المنزلية(ص79) مثل أن تحدد للرجل القيام بأعمال عضلية وشاقة. (الحالة لا تختلف كثيرا عن واجبات الشاب البالغ والكهل أو الشخص القصير والشخص الطويل). وإن لم نعترف أن ثقافة العنف هي لدينا أخلاق موجهة ضد الذات والطبيعية وتعبر عن ردة الحضارة الجريحة على ظروفها التاريخية نكون قد أغفلنا جزءا هاما وأساسيا من حقيقة المشكلة. ومثلما لا أجد أي مسوغ للتحفظ على إدانة العنف المطبق على النساء (ص104) لا أفهم لماذا لا نعمم ونطالب بإدانة العنف المطبق على الإنسان الذي يعيش في ظروف قهرية. وأن نخص المرأة بهذا الطلب يعني أننا نميز بينها وبين الرجل ضمنا. والأجدى في الحقيقة المطالبة بشروط حياة كريمة وبعدم تطبيق أي عنف من الكبار على اليافعين، وعدم توريط الصغار بعمالة تتطلب جهدا يتخطى حدود عمرهم، سواء من الناحية العضلية أو الذهنية، وأن يشمل هذا الطلب البنات والذكور معا ودون تمييز. وبهذه الطريقة نكون قد ألغينا مشكلة الفصل بين الجنسين أو إقامة حزام عازل يحاصر البنات والنساء. فالمرأة ليست إيديولوجيا، ولا هي شيء فوق التاريخ، ولكنها نوع له وظائفه بقوة الطبيعة.
بوجيز العبارة: لحينه المرأة مثل الرجل ضحية لعنف اجتماعي يأخذ شكل البلطجة. وهذا النظام الذي يعتمد على الإكراه له عدة ترجمات واقعية بالأخص في الحواضر، أو ما يسمى المجتمعات المدينية، حيث يكون لكل حي عصابة تضبط أموره وتوزع الصلاحيات والحصص فيما بينها وكأنها دولة داخل دولة. لا أستطيع أن أقول إنها ما فيات عربية، ولكنها انحراف في النظام، ولا سيما في حال ضعف الدولة، وحصر اهتمامها على ضبط بعض المرافق، وترك ساحة الخدمات والكماليات لنوع من العرف أو الاتفاق الأهلي. إن الدولة الضعيفة تمهد الطريق أمام تنمر وتغول التكتلات الأهلية والمحلية التي يسودها تفاهمات غير مكتوبة ويصعب حصر طرائق عملها.
ويوجد أمثلة عن الانفلات الأمني، وإهمال الدولة له، في بعض المحطات غير الحساسة. وهذا ينطبق في بلداننا على العشوائيات، فهي دائما محرومة من عاطفة ورعاية النظام، ويوجد حالة مشابهة في أحياء المهجرين والمعدمين والأقليات العرقية في دول الشمال. ولا أعتقد أن النظام المتحضر عاجز عن ضبط هذه التجاوزات، وعلى الأرجح هي بالون اختبار، والعين الساهرة لا تتدخل إلا إذا وصلت الأحوال لدرجة معينة. وبهذا السياق أحيل لرواية “مذكرات من نجا” للبريطانية دوريس ليسنج، ورواية “شرف” للتركية إليف شافاق. في العملين متابعة لظروف إنضاج وتهيئة الفوضى قبل دخول الدولة على الخط والقضاء على الرؤوس المدبرة. ولكن الصبر والحنكة اللذين تلجأ لهما دول الشمال ليسا مطروحين للنقاش في بلداننا، وغالبا ما تتفاقم الأحوال، وتتحول لتصفية حسابات أولا بين البلطجية، ثم بين العوائل المتنفذة في كل منطقة. بمعنى أن النتائج تبقى داخل أسوار اجتماعية كتيمة لا تخترقها السياسة لأنها أصلا غير مهتمة بها. هذا إن كان في البلد المعني سياسة من الأساس.
وبظني إن منطقة الشرق الأوسط تنحو لتمييع أي شكل من أشكال السياسة باعتبار أنها فن الحكم، وتتحول بسرعة مرعبة لمجتمعات منقسمة على نفسها ومعصوبة، وبينها انقطاعات بنيوية. فالحكم في مجتمعات الداخل تحركه لغة ومنطق يختلف ويتعارض تماما مع المنطق الدبلوماسي أو النشاط الذي يستهدف الساحة الدولية.
كما تفضلت رجاء ابن سلامة لقد تطور القهر ضد المرأة لدرجة جناية، وأسبابه التاريخية البعيدة تشير لعمل إجرامي منظّم ناجم عن أحقاد دفينة، وهي نتيجة صراع مستميت على التسلط، وكل الحفريات تؤكد أن حلول الرجل مكان المرأة تلازمت معه تبدلات في شكل حياة النوع البشري بشكل عام. والفرق بين الدولتين.. دولة الأم ودولة الأب يشبه الفرق المؤسف بين معنى الرعاية والحراسة، ومعنى التملك والتسيد. ولكن إذا وضعنا إلى جانب ذلك نكوص الوعي في منطقة شعوب العالم الثالث لا يمكن أن لا تنتبه لتربيع الدائرة. إنه انتقام ذكوري دموي من دولة المرأة رافقه انفجار الغرائز البدائية التي تميز نشاط قانون الضرورة في مجتمعات التخلف. بل ويمكن القول إن الأسباب أحفورية وتاريخية. مثلا لم يتم التخلص من شجرة الدر لأنها امرأة بل لأنها امرأة تجلس على العرش. وغني عن القول أن القاتل هن من جواريها، نساء يقتلن امرأة غاشمة ولا مبالية. باختصار العنف في منطقتنا لا يوفر أحدا، غير أنه مزدوج بالنسبة للنساء.
ثم تضع ابن سلامة قائمة بانتهكات الدين ضد النساء. أو بالأحرى الوكالة الدينية أو الحلقات التي تتكفل بحراسة اللاهوت والميتافيزيقا. ولكن حقيقة لم أجد أي عيب فعلي في النصوص، فالأديان تلجأ للأساطير والترميز للترويج لنفسها. إنما تخلف الحضارة وقصور عقلية التخلف يحد من مرونة التواصل مع المعنى. فالتخلف لا يعتمد كما يفترض أدونيس على نقل وتمكين الأسطورة وكأنها واقع، أو التصورات وكأنها أحداث جرت فعلا، أو أعمال طبقها الإله بالفرض من فوق لتحت، أو من ذات علية إلى كتلة فيزيائية تؤدي عقوبتها على خطأ ارتكبه أبو البشر. وإنما يلجأ التخلف للمحاكاة، ويقلد أوهامه الذاتية قبل أن يقلد تصورات غيره (التقاليد). فالتخلف لاشعور جماعي تابع. وهنا أود أن أستعير من خليل أحمد خليل مخططه عن البنية الهرمية للقيادة عند العرب. في وقت الرخاء يكون التابع مساويا للمتبوع، لكن في أوقات الشدة تفصل الطرفين مساحة غامضة من الأفعال المؤجلة. ولذلك إن بنية التخلف ليست تبعية فقط، ولكنها ملغومة، وتزداد فيها الاحتمالات. ومن هذا الباب يمكن تفسير زيادة عدد الأعمال الانقلابية في منطقتنا. لم تكن تمر خمس سنوات دون تبدل دراماتيكي في السلطة سواء بالشكل (بين 1950 - 1970) أو بالمضمون (بعد 1970). وكان يتخلل ذلك مناوشات تصل لدرجة حروب محدودة أحيانا. وفي واقع من هذا النوع لا يمكن أن تساوي بين الإيمان والدين. فالدين واحد لكن أشكال الإيمان مختلفة. ويمكن أن تقول لا يوجد ولاء حقيقي بالسر، وتقتصر الطاعة على النفاق العلني المدفوع القيمة. ويبدو لي أن اضطهاد المرأة هو جزء لا يتجزأ من هذه البنية غير الإيمانية واللاهوتية التي تدين للتخلف وللطاعة المأجورة. وبرأيي إن الفحولة ترفع من مكانة المرأة كطرف مرغوب أو جائزة للاستجمام والسعادة. لكن دراما الصراع على التسيد والاستئثار هو الذي يبدل المعاني. ناهيك عن الأكاذيب والتلفيقات التي تضاف منهجيا وبشكل متعمد لإرضاء الدولة. ولا أعتقد أن أحدا لم يسمع بمشكلة صحيح البخاري والكم الهائل من الأحاديث المشكوك بصدقيتها ولكن المنسوبة للرسول والتي يقيس الفقهاء عليها أحكامهم وتشريعاتهم. وأن تجتهد على خلفية أسطورية وملفقة لا يختلف عن بناء دين لا علاقة له باسمه أو منابعه اليقينية. وعمليا لا يمكننا انتقاد الدين (ومن خلفه الفكر الديني) قبل غربلة الحقائق، وملاحظة أساليب تطورها وتحولاتها.
ويأتي آخر فصل بشكل مسك الختام. النهاية السعيدة التي تجرّأ كامو ورأى فيها انتحارا طوعيا، أو ميتة سعيدة. وأقصد بذلك التفاؤل بالحداثة العربية، وتقسيمها لأنواع: منسية ونهضوية ومعاصرة (ص149). ولا جدال أنه لدينا كم هائل من المقاربات لمشكلة الحداثة، ولكن هل نحن على وشك أن نفهم هذا اللغز الغامض؟؟!!.. إن ما كل ما فعلناه حتى هذه اللحظة هو البحث عن اسم لتفكيرنا ولأساليب المناورة مع هذا التفكير. وبالنسبة للحداثة تحديدا فهي رماد لأوراقنا المحترقة التي لا يسعني أن أرى فيها غير بقايا رومنسيات وميتافيزيقا. والمحوران بتناحر دائم، كل منهما يلعب بعروس الحداثة بطريقته، وبرأيي حداثتنا لا تزيد على مسرح عرائس أو خيال ظل. فالشكل الراديكالي أو الميلودراما المتواضعة من دعوات التحديث لا تزيد على استيراد الثياب الجاهزة، مفصلة في مخبر دريدا أو فوكو، وإن كنا من أنصار الحداثة الواقعية أو الاشتراكية الحديثة (ويسمى في بعض الحالات: “الطليعية” تهربا من الدخول بملف الإمبريالية الراعي الأول لكل هذه الصيغ) ستكون الأجهزة والأدوات من القاموس الماركسي (بنسخته الأوروبية غالبا)، لأن النسخ الأرثوذوكسية الشرقية وقفت ضد أي تحديث بشكل أعمى ولم توفر شتيمة لم تنعته بها بدءا من التحريفية المعاصرة وحتى الانحلال والتميع والمغالطة التاريخية (ص149).
ويوجد تحديث آخر معكوس بأقنعة تراثية، وهو ما بدأ يأخذ اسم تأصيل الحداثة أو تحديث الأصول. وهي معادلة طرفاها مغيبان بقوة الواقع التجريبي لأن أي معادلة لا يمكنها أن تقف بوسط الطريق وتختار أن لا تكون شيئا لتلعب دور المخلص والمطهر. وهذه هي حال كل النظريات القومية. دائما أقف أمام خلطتها عاجزا. فهي تتبنى فلسفة من كل بستان زهرة، وتسمي ذلك تأسيسا لهوية عروبية ثورية. ولكن لو وضعتها في أنبوب الاختبار ستنفصل لمكونات تلغي نفسها بنفسها. والواقع سيد الأحكام، فالعرق العربي يمر بنفق مظلم، ومثله العاطفة القومية برومنسياتها وطموحاتها، تتعرض لكبوات فظيعة، وأقله هي مرتهنة لأصدقاء غير عرب ليفضوا النزاعات البينية أو ليحسموها وفق إرادتهم.
وحالة تغييب الحداثة، أو قلة حضورها على ساحة حياتنا اليومية، تضعنا أمام معضلة يسميها فرويد الكمون. فالليبيدو لا يعرف كيف يعبر عن نفسه، وهو أيضا تحت مظلة ليس لها لون محدد، فهو خائف من المشكلتين الأساسيتين: قضية العمل وقضية المعرفة. ولذلك كل شيء يضيع في متاهات الاستهلاك. وهذا بدوره استهلاك رخاء أو استهلاك حرب. بمعنى أنه تعبير عن العدم بلغة الوجود. فهل يجب أن تستغرب إذا كانت المرأة موجودة في الخطاب الرسمي، ومفقودة من التجربة الواقعية أو البراكسيس. بمعنى أنها ليست متحققة في مجالات العمل؟.
ولم تفوت رجاء ابن سلامة الفرصة على نفسها، وأعلنت عن أقنعة حداثاتنا المبسترة وقليلة الدسم، بمعنى غير النافعة إن لم تكن الضارة (في كل أساليب تطبيقاتها)، حينما قالت إنها شيء بأسماء مستعارة، ونعتقد أنه يدل على أفق نهضوي لكنه يعتمد على ماهيات تعيق المعرفة التاريخية العلمية (ص149). وتضيف في السطور القليلة التالية: حتى أن كل هذه الأسماء الشائعة لا تشير إلى فكرة وصورة الخروج أو القطيعة أو التبدل الجذري (ص150)، بل تحولت لمشروع مجتمعي يروج لرواية رسمية أو شبه رسمية عن نهضة ميتة (ص153).
د. صالح الرزوق
...................
*بنيان الفحولة: أبحاث في المذكر والمؤنث. رجاء بن سلامة. 2005. ط1. دار بترا للنشر والتوزيع. دمشق. 174 ص.
















