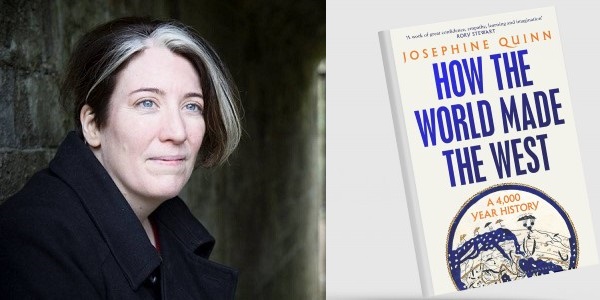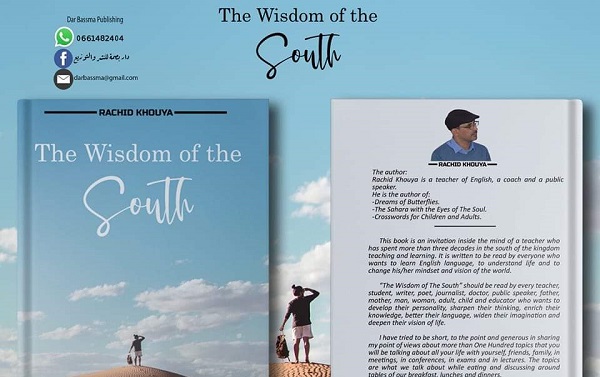صحيفة المثقف
من الخيمة.. متى كانت البداية؟

في حياتي حدث أن مررت ببعض الأماكن لأول مرة، لكنها بدت لي معروفة وكأني مررت فيها من قبل. هذه الومضة تنطفئ بسرعة فائقة لكنها تترك حيرة وتثير السؤال: هل جئت من حياة أخرى؟
كما روت لي الوالدة رحمها الله ولدت في الخيمة البدوية الأصلية المصنوعة من شعر الماعز، المغزول بأيدي النسوة والمأخوذ من القطيع.
الخيمة، هذا المجال المفتوح والمدى المطلق، يصعب الدخول إليها وكل شيء يخرج منها. أفضلها وأجودها ما غزلته بدوية على الكرميلة ومدته بيديها شُقة شُقة. عندما نوقد نار الحطب في داخلها يخرج الدخان من مساماتها ويبقى الدفء والحرارة. وعندما يتساقط المطر يسح الماء مع شعيراتها ولا يصلنا منه إلا الرذاذ الذي يرطب الجو في الداخل ويجعله ممتعا.
ما ألذ الحياة في الخيمة! .
في الغابة المجاورة كانت الثعالب تعوي في أوقات الصلاة بجوقات متناغمة وخصوصا في ساعات الغروب الأولى أو قبل طلوع الفجر بقليل. العالم كله تغير إلا هذا العواء الذي لا يزال هو نفسه.
بعد صرختي الأولى سقطتُ من يدي المرأة التي ساعدت الوالدة ساعة الولادة فالتصقت حبيبات التراب في لحمي الطري . دمجوها معي لتبقى ملتصقة بلحمي لليوم الثاني عندما فكت الوالدة الدماج لتُعَجّنني . وهي عملية تنظيف لجسم الوليد بواسطة العجين المغموس بزيت الزيتون.
وجدت الوالدة حبيبات التراب قد انغرست في لحمي الطري.
لم أختر الزمان ولا المكان، ولكنني ولدت.
لو خيروني لا شك أنني سأختار نفس المكان، ليس لان هذه البلاد أسعدتني وليس لأنني أحبها، وهي بالنسبة لي مهجة الروح، وإنما لأنني ككل أبناء جلدتي أخاف أن أفقد المكان ولأنني أقدس الحياة وارى أنها جديرة بالممارسة ولكن بدون عقد الأساطير التي تحول الوطن من حديقة إلى حظيرة، وبدون تزاحم الأمراض الوراثية التي تعمي البصر والبصيرة .
لماذا أقول ذلك وأنا اليوم لا ينقصني أي شيء، لا منصب ولا مال ولا أولاد أو أحفاد؟
ربما من باب الاعتذار للذين يضايقهم وجودي ووجود أمثالي في هذه
البلاد، بعد أن قرروا أنها حظيرة وليست حديقة.
وأنا كذلك لم اختر التصاق تراب هذه البلاد بلحمي منذ البداية. كانت
صدفة. مجرد صدفة. كنت أفضّل أن أولد في احد المستشفيات في غرفة مخصصة للولادة وتحت إشراف ممرضات وأطباء. وعلى الأسرة والشراشف البيضاء.
لكن ذلك لم يكن، وولدت هنا في قمة الجبل لأربي الغابة كما تربي الأم ابنها، ولأجتثها فيما بعد بأمر من العدالة في هذه البلاد. والسبب لأن الغابة تشكل متعة لي أنا الغريب عن هذه البلاد حسب التلمود وحواشيه.
أحب المكان الذي ولدت فيه ولا أدري لو خيروني أن كنت سأختار مكانا آخرا. الالتصاق بالمكان قد يكون بسبب الخوف من المجهول أو بسبب قلة الإمكانيات، أو الضعف، أو ربما الغريزة . بكل تأكيد هو ليس دليل قوة، فالطفل الذي يتعلق بطرف ثوب أمه دائما ولا يتركه، قد يكون طفلا غير مستقل وغير ناضج، أو قد يكون محاطا بالمجرمين والقتلة الذين يرون دماءه تسيل ولحمه يؤكل فيتهمونه هو بالسادية ويطالبونه هو بالكف عن إيذاء الآخرين. وهم محقون في مطلبهم فلماذا يرون مشهده المؤذي وهم يملكون القدرة على التعتيم على كل شيء؟
المكان كان وجعي الدائم وفرحي الذي لم يتم يوما بسبب وحشية هذا
العالم وعدوانيته تجاه الضعفاء أمثالي ممن لا يملكون مواقع القرار . إليه لجأ أجدادي هروبا من الظلم وفرارا من وجع الحرمان الذي لا يرحم ليشيدوا فيه مملكتهم المبنية على التقشف والقبول بالقليل . تلك المملكة التي تمتعت بكنزين نفتقدهما هذه الأيام وهما :الاكتفاء الذاتي والقناعة.
وهو عبارة عن جبال تعانق بعضها. أعلاها جبل الكمانة الذي سد الأفق دائما، وأجبرني على التطلع إلى السماء لتلافيه . كرش جبل الكمانة المندلق نحوي جعلني اشعر بالضيق دائما وبالخوف من وقوعي تحته يوما ما إذا كبر أو ترهل. لكنني تغلبت على هذا الخوف لأنني عشت في المفصل أو في أعلى نقطة في الوادي المتعرج الممتد بين بحيرة طبريا والبحر الأبيض المتوسط . إلى الشرق من هذه النقطة جرت مياه الأمطار إلى بحيرة طبريا حيث اغتسل المسيح عليه السلام، والى الغرب منها جرت إلى البحر الأبيض المتوسط الذي حمل من لبسوا عباءته عليه السلام وجاءوا إلى الشرق غازين طامعين. كنت أستطيع أن أكون متفرجا من هذا المكان. متفرجاً على هذا العالم الذي يشبه كثيراً الغابة المجاورة. لكنني لم أقدر. طموحي وشوقي للفرح دفعاني إلى معترك ما يدور حولي، ناسيا ما أنا فيه من روعة المكان. نعم نسيت روعة وجمال المكان وفقدت كل سني عمري التي مضت ولا يمكن تعويض هذا الفقدان.
كنت الشاهد على ذلك أكثر من ستين عاما، كنت أراقب هذا المشهد
كل شتاء، لكنني لم أنتبه له إلا وأنا أكتب هذه الكلمات. كم خسرت.!
انتبهت أيضا أن نقطة الماء عندما تسقط من السماء وترتطم بصخرة
تنفجر وتتفتت إلى شظاي.ا أما عندما ترتطم بالتراب فإنها تخترقه وتذوب فيه لحنانه وشوقه، أما عندما ترتطم بمياه متجمعة أو جارية فإنها تقفز إلى أعلى، وترقص رافعة رأسها فرحة بلقاء أبناء جلدتها.
طوال هذه السنين رافقني الخوف الشديد أن أفقد المكان، أن يضيع مني أو أن يأخذوه مني. كنت أتشبث به بكل ما أملك من قوة. هذا الخوف ألهاني عما للمكان من جمال وخصوصية أحسد عليها.
في بطن أمي اختبأت كثيرا. أكثر من تسعة أشهر؟ حاولت أن أظل هناك أقصى مدة ممكنة. لأنني كنت خائفا مما سيواجهني في عالم لم يعد لي أو ربما حتى يعود أولئك الذين تركوا كل شيء. أو ربما انتظرت لأولد في برنستون أو في جلاسكو او في سبيرلونغا أو في بيلغاردي أو ريف أنطاليا على الأقل. كنت أرى هذه الأماكن وأنا في بطن أمي . أحببتها كثيراً لذلك زرتها عندما كبرت لأحبها أكثر .
كنت أرى أمي وهي تمارس الأشغال الشاقة. كانت تحلش القطاني وحدها: العدس مئونة للعائلة، والكرسنة مئونة للقطيع. وتساعد والدي فتحصد جنبا إلى جنب معه ما يزرعه من حنطة وشعير. ثم بعد ذلك تعجن، تخبز، تغسل، تحلب الماشية وتحضر الطعام من لا شيء. حلب الماعز أهون بكثير من حلب الأبقار. كانت تحلب بقرتين أو ثلاثا فقط فحليب البقر أفضل للشرب من حليب الماعز والسمن المستخرج من لبن الأبقار أفضل من ذلك المستخرج من لبن الماعز. لبن الماعز ممتاز لصنع اللبنة بعكس لبن البقر، وممتاز لطبخه على النار فهو لا يفرط ويتحول إلى كريات صغيرة كلبن البقر. كانت الوالدة تضع الدلو على الأرض وتضغط بأصابعيها السبابة والإبهام على ثديي البقرة فيندفع الحليب منهما بقوة ويرتطم بقاع الدلو. أحيانا تضغط بكلتا اليدين معا وأحيانا بالتناوب محدثة في كلتا الحالتين موسيقى بإيقاع مختلف. أما حلب الماعز فتقوم به بطريقتين، إما بمسك الثدي براحة اليد والضغط عليه وإما بطي الإبهام إلى راحة اليد وبعدها مسك الثدي والضغط عليه ببقية الأصابع على راحة اليد والإبهام المعقوف عليها. شكل الثدي هو الذي يقرر الطريقة. كل يوم تحلب ما يقارب الخمسين رأسا من الماعز والغنم،
وبقرتين أو ثلاثا من الأبقار التي عودتها على الحلب.
بعد ذلك تمشي المسافات الطويلة حاملة دست اللبن على رأسها لتبيعه
في القرى المجاورة قبل أن تحتل "تنوفا" كافة المواقع. وتعود بعد الظهر لتجد الكثير من الأشغال بانتظارها . لم أساعدها في شيء وكانت دائما تضع يدها عليَّ لتطمئن أنني بخير. ربما كانت تعرف أنني قد اهرب .
لم تذهب الى طبيب وهي حامل بي ولم تكن عيادات في منطقتنا للنساء الحوامل ولا أجهزة اولتراساوند تمكن المرأة من التعرف على نوع الجنين إن كان ذكرا أو أنثى. لكن والدتي كانت تعرف أنها حامل بصبي لأن نساء القرية من ذوات الخبرة في هذا المجال واللاتي لا يخيب حدسهن أخبرنها بذلك. فزادت من نشاطها ولم تتدلل كنساء اليوم. زاد تعلقها بالحياة رغم نحافة جسمها ورغم أنها كانت تحس بالوهن والضعف الشديدين.
تغلبتْ على الضعف والوهن فهي قد اطمأنت أن والدي لن يتزوج من
امرأة أخرى لتنجب له ذكراً لذلك تعلقت بالحياة وكبر حلمها . وكنت أنا كل ذلك الحلم. لا أذكر الخيمة، عرفتها فيما بعد. كل ما أذكره أنني فتحت عيني على الحياة في بيتنا المبني من الحجارة في قمة الجبل . سبقني الى الحياة ثلاث بنات، توفيت واحدة وبقي اثنتان لتنضم إليهما ثالثة فيما بعد وتكون السبب في تغيير الكثير من مجريات الأمور في حياتي . كانت تحب أن تسبقني إلى كل شيء، حتى الموت سبقتني إليه رحمها الله.
***
حسين فاعور الساعدي