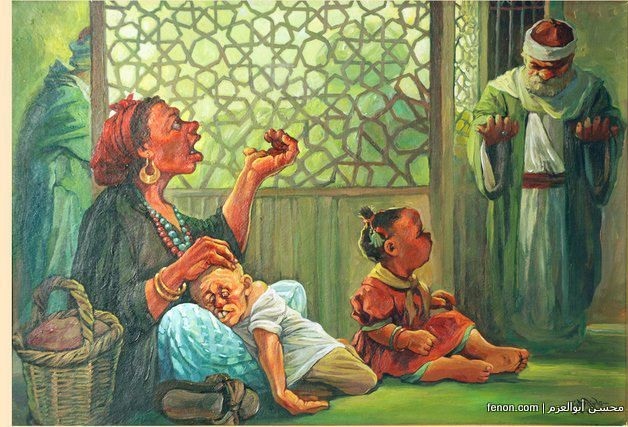صحيفة المثقف
نقائض التصوف (2): التصوف منهجاً وموقفاً
 عندي أن أكثر ما يصيب القوم من جراء دارسة الفلسفة وخلاف الفلاسفة هو التناكة العقلية والغرور الأجوف، وتسليط الأضواء على تزكية النزاع لا على إثراء الحوار. مع أن الفلسفة لم تكن يوماً نزاعاً بل هي في الأصل حوار قائم بين أطراف متناقضة على ناقش هادئ هادف بنّاء. فلماذا ورثنا التناكة العقلية واستبدلنا الحوار بالنزاع. هذه لوثة باطنة يلزم التخلص منها إذا صحت الفلسفة، وصلحت لمجتمعات عربية.
عندي أن أكثر ما يصيب القوم من جراء دارسة الفلسفة وخلاف الفلاسفة هو التناكة العقلية والغرور الأجوف، وتسليط الأضواء على تزكية النزاع لا على إثراء الحوار. مع أن الفلسفة لم تكن يوماً نزاعاً بل هي في الأصل حوار قائم بين أطراف متناقضة على ناقش هادئ هادف بنّاء. فلماذا ورثنا التناكة العقلية واستبدلنا الحوار بالنزاع. هذه لوثة باطنة يلزم التخلص منها إذا صحت الفلسفة، وصلحت لمجتمعات عربية.
هذا الذي يدعى (شريط) صاحب الفقرات التي اقتبسناها من كتابه "الفكر الأخلاقي عند بن خلدون" في المقال السابق الذى أوردناه تحت عنوان (نقائض التصوف)، كان يمثل بما ذكره موقفاً جائراً عدائياً ضد التصوف، ولم نقتبس منه تلك الفقرات السالفة لمجرد هذا الموقف الذي يعبر عن تفكير قطاع أسود عريض من الثقافة الإسلامية وكفى، ولكن اقتبسناها لنقض كثرة المفاهيم المغلوطة التي أستند إليها في دعوته لمهاجمة التصوف، مجرد الهجوم، بغض النظر عن تجاهل تعريفاته الدالة على منبعه في الدين والأخلاق، فهل التصوف اليوم مقبولٌ من بعض الأقلام أم مرفوض يستحق المقاومة؛ لأن ضرره - كما يُقال - على المجتمعات أكبر من نفعه؟!
لابدّ من التوقف عند أركان النظرة المنهجيّة لضرورتها في رفع التخبط عن أقوال الناس، وللخلط الذي يتبدَّى ظاهراً في أحكام الكثيرين من جرّاء مثل هذا الضباب الفكري الذي يسوقه كل مسئول أو غير مسئول عما يقول. ولنا أن نعتمد وجهة النظر التي يذكرها لنا على الدوام أستاذنا المرحوم زكي نجيب محمود في تبيان الفواصل الفارقة بين أنواع القول المختلفة بين ميدان وميدان؛ فالخلط بين تلك الأنواع يؤدي حتماً إلى فكر مهوش، مهلوس، إذْ يجعل صاحبه في موقف يتطلب من نوع معين أن يلتزم ما تلزمه أنواع أخرى، ومن هنا ينتج الاضطراب والخطأ.
وبخاصة حين يذكّرنا الباحث (عبد الله شريط صاحب الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون) بعبارات يسوقها جزافاً في غير تحقيق من أن الفكر السلفي أو فكر ابن تيمية أو الحركة الوهابية في الحجاز أو الحركات الإصلاحية في مصر والشام والجزائر تمكنت من الاستضاءة بأنوار المنهج العلمي أو الفكر العلمي الحديث على حد تعبيره، وأن هذه الاستضاءة النُّورانيّة مكنت المعادين للتصوف من المقارنة بين ما وصلت إليه شعوبهم من شلل عام، وما زخرت به الشعوب المتقدّمة من حيوية وحركة وإنتاج؛ لذا وجب التخلص من هذا الإرث المسموم (التصوف).
وبما أن الباحث يستضئ هو وأنصاره من التقدميين ممّن كان ذكرهم في سطوره، بأضواء الفكر العلمي الحديث في التخلص من ذلك الإرث المسموم؛ فاعتمادنا نحن على تلك الفوارق الفاصلة بين ميدان وميدان لأكبر ممثل لها في الفكر العربي المعاصر، وأكبر من كتب يُفرّق بين قول يقال في مجال العلم التجريبي وقول آخر يُقال (سداح مداح) في مجالات غير مجال العلم، وهو من بعدٌ لم يقل عن التصوف أبداً إنه فكر خرافي أو أن الفكر الخرافي إنْ هو إلا الأثر المباشر من آثار الفكر الصوفي، لذلك تجب مقاومته.
أقول، إنّ اعتمادنا على الخيوط التي كان نسجها أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود في مقال كان نشره بجريدة الأهرام بتاريخ (13/3/1990م) حلقة رقم (23) تحت عنوان (خيوط تلاقت)؛ جمعها فيما بعد في كتابه الأخير "حَصَاد السنين"؛ لتشييد أركان المنهجيّة العلمية، وللتبْصرة بضرورة الأخذ بالنقد التحليلي، له ما يبرره عندنا لاستخدام الباحث صاحب كتاب الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، فيما سبق مصطلح "الفكر العلمي الحديث".
ولعلَّ أظهر ما تظهر فيه حالة الخلط والاضطراب المنهجي هو تملك الحيرة التي كثيراً ما أحدثت فجوة تلتها جفوة بين الناس؛ أعني قلة العناية بتحديد الفواصل الفارقة بين قول يُقال في ميدان وقول آخر يجرى في حقل مختلف عنه، وإنْ كان ينتسب إليه بروابط النسبة سواء في الأصل أو في المصدر، الأمر الذي يدل من فوره على غياب الحد الأدنى من التفكير المنهجي.
فالعبارة التي يقولها صاحبها عن شيء؛ ليصف بها ذلك الشيء وصفاً يخلع عليه صفة خُلقية أو صفة جماليّة مثلاً ممّا يجعله مقبولاً أو مرذولاً إنما هى عبارة "خاصّة" بما يشعر به قائلها وليست عبارة "عامة" تلزم الإنسان، أينما كان وحيثما كان، بقبولها.
فأفرض مثلاً: أن تقاليد مجتمع معين تقضي بألا يُراجع ولد فيما يقوله والده، فليس هذا الحكم التقويمي بملزم لأحد إلا أصحابه؛ لأن الحكم في هذه الحالة لا يوصف بالصحة أو بالخطأ على نحو ما توصف الأحوال العلميّة مثلاً وأشباهها بل هو "حكم ذوقي " يُبنى على قيمة من قيم المجتمع المعين.
ولمّا كانت جميع الأحكام القيميَّة تتضمن الإشارة إلى "تفاعل" بين الإنسان وما يراه ويسمعه، وليست هى أحكام مقصورة على الإشارة إلى المرئي والمسموع وحده بغض النظر عن تفاعل الإنسان معه، كانت بحكم طبيعتها هذه قابلة لأن يختلف فيها الناس دون أن يكون ذلك الاختلاف دالاً على صحة الرأي عند أحدهم وخطئه عن الآخر؛ إذْ لا تناقض بين أن يعجب معظم الناس بغناء أم كلثوم مثلاً؛ وأن تجد قلة من الناس لا يشاركونهم هذا الإعجاب، وكل ما يمكن قوله في موقف كهذا هو "الإشفاق" على مَنْ لم يستطع تقدير مثل هذا الصوت الجميل.
فلئن كانت وجهة النظر التي يذكرها أستاذنا تتبنى رأيه في الوضعية المنطقية، يسوقه في تحديد الفوارق الفاصلة بين ميدان وميدان أو بين حقل علمي وحقل نظري مجاله الدين مثلاً أو سائر العلوم الإنسانية، فإنّ هذه الوجهة من النظر تحدّد لنا طبيعة الحكم الذوقي كمنهج يستند عليه التصوف، وبمثل هذا المنهج الذوقي في تقرير حكمه بارتداده إلى الشعور يتحدد عمله؛ فاتساع بؤرة الشعور؛ وليس ضيق مساحتها، هو عمل المنهج الذوقي كونه خاص لا عام كالأحكام العلمية كما هو الشأن في مجال العلوم الطبيعة أو العلوم الرياضية. والمنهج مهما كان علمياً؛ ومهما كانت درجة الضبط فيه، يتوقف النجاح في الاستفادة منه على مدى مطاوعته للموضوع ومدى قدرته على تطويعه.
ومن هنا، فليست جميع المناهج صالحة لجميع الموضوعات؛ بل قد يكون المنهج الواحد خصباً منتجاً في موضوع وعقيماً في موضوع آخر؛ والقول الفصل في هذا الشأن هو: أن طبيعة الموضوع هى التي تُحَدِّد المنهج.
ومن هنا أيضاً، فليس من الصواب مطلقاً اعتبار منهجية التصوف الذوقية خرافة أو جهالة إلا أن يكون صاحب هذا القول جاهل أو خَرِف، يستحق الإشفاق في الحالة الثانية، حالة التخريف. ويستحق الازدراء في الحالة الأولى، حالة الجهالة.
فالجاهل ليس بمعذور حتى يبرر حكمه، وعليه وزر من يقرأ له ولا يرد قوله من حيث جاء. فمن يظن أن الفكر الخرافي إن هو إلا أثر من آثار الفكر الصوفي لذلك وجبت مقاومته، وأن التقدم يكمن في تلك المقاومة، فهو ظن خادع أو موهوم مجرَّدٌ عن الحيوية الدينية والروحية فضلاً عن تجرده سلفاً عن المنهجية العلمية. يكفي الجاهل من ازدراء كونه لم يفرَّق بين دراسة مناهج الفكر الإسلامي، ولا يستخلص المنهجية التي يتبناها التصوف وهو ميدان يقوم على تذوق الحياة الدينية وتنطبق على علومه ومباحثه فضلاً عن إشاراته وقضاياه.
فالذين تذوقوا التصوف تذوقوه كشأن من يتذوق الفن الجميل، لحن موسيقى شجي أو صوت غناء ندي. وكما أن الصوفي صاحب منهج ذوقي فهو في الأصل صاحب "موقف فني" من حيث هو "موقف فني"، يهدف بالتأمل إلى المعرفة وحدها كما يهدف بالخلق إلى التعبير وحده. فإذا أمتدّ بعد ذلك إلى حيث تكتمل المعايشة العاطفية بتعاون عملي كان إذْ ذاك موقفين اثنين لا موقفاً واحداً؛ فهو فني حين يتأمل، وهو أخلاقي أو اجتماعي حين يعمل.
وهذا نفسه يصدق على الموقف الديني وعلى التصوف طبعاً. إن ملاحظة الواقع تضطرنا إلى التفريق في الموقف الديني بين جانب عملي يهدف إلى تنظيم المجتمع؛ وهذا هو (الدين السكوني) والأخلاق التي تقوم عليه هى أخلاق سكونيّة بتعبير برجسون: أخلاق القواعد العامة. ثم جانب تأملي غايته فهم الكون والحياة بالحدس والعاطفة، وهذا هو (الدين الحركي) والأخلاق التي تقوم عليه هى أخلاق التراحم والتعاطف.
فأما الجانب الأول فهو ينتمي إلى الموقف العملي. وأما الجانب الثاني فهو يمت إلى الموقف الفني بسبب وصلة، ومن أجل هذا؛ كانت تنعقد المقارنة دائماً بين الفن والتصوف، ومن أجل هذا؛ كان المتصوفون شعراء، ومن أجل هذا؛ كان الفنانون يحسون أنهم يتكلمون بلسان الله كما كان يقول بتهوفن.
فمن حيث "المنهج" ومن حيث "الموقف" لا يمكن أن يكون التصوف بمثل ما كانت عليه الحال من النقائض السابقة كما توهمها باحث الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون على العسف والتهور والغرور تماماً كما توهمها قبله أئمته ممّن سلقوا التصوف عنوة من أجل أفكار موجّهَة بألسنة من حداد.
وليس أغرب عندي من تخريج فاسد الدلالة لقول من يقول إن: "أدبنا اليوم في المشرق والمغرب يحاول أن يعالج هذا الإرث المسموم في عقول الشعب فلا يشق طريقه إلا بصعوبة"، ولن يشق طريقه أبداً لغياب الصلة الوثقى في الأذهان القاحلة بين الأدب باعتباره فناً والتصوف بوصفه فناً كذلك، ناهيك عن سقوط القيم.
ويعز علىَّ أن أرى غيبة القيم من ثقافتنا العربية، فشعوب بلا قيم كإنسان بلا معنى وكحياة بلا غاية ولا هدف .. وهل يُقَوِّم الفرد في مجتمعاتنا العربية إلا بمقدار ما لديه من دراهم؟!
(وللحديث بقيّة)
بقلم: د. مجدي إبراهيم