صحيفة المثقف
المثاقفة بين حسام الخطيب ونجم عبد الله كاظم.. قراءة في المنهج والمعاني (4)
 ولكن يجب علينا أن ننتبه لحقيقة أساسية تحكم منطق ومنهجية الخطيب وكاظم، أن نقطة البداية تنطبق على النهاية، ومركز هذه الدائرة هو محيطها أيضا، وبلغة مباشرة يعتبر المنهجان أن بعض الظواهر هي أكسيومات (أو بديهات) أو أقله هي تحصيل حاصل. ومن ذلك علاقة الرواية الستينية بكافكا. ويوجد في كتاب الدكتور حسام الخطيب فصل كامل يعقد به مقارنة بين رواية يتيمة لجورج سالم هي (في المنفى) ورواية كافكا (القضية). بينما يتابع الدكتور نجم كاظم مجمل أعمال كافكا ليحدد أسباب التطابق بين مصير أبطال الرواية الستينية ومعراج أو متاهة أبطال كافكا. ومثل هذه النظرة المخصصة عند الخطيب لم تكن بعيدة عن النظرة البانورامية لكاظم. فقد اتفقا أن أوضاع العرب والتمزقات الاجتماعية والسياسية وأساليب القمع التي عانى منها الكاتب العربي وجدت صداها في أعمال كافكا ولا سيما في الستينات (ص149). ولم تكن معاناة أبطال كافكا في أعماله الميتافيزيقية التي تعالج مشكلة الجفاف الروحي في مجتمعات إصلاحية معادية لأي نزوع ثوري غريبة عن رواية الستينات والتي مهدت لهزيمة قاسية عام 1967 وخرجت من رماد خسارة مهينة عام 1948. ومن نافلة القول أن شخصية الرواية العربية وجدت مفاتيح شخصيتها في هذه الفترة. وانتقلت من تقشير الطبيعة من أجل وصفها ومحاكاتها إلى تقشير النفس البشرية من أجل إعادة اكتشافها وثم إعادة تركيبها. أو ما يقول عنه الدكتور الخطيب (حرفيا): لمتابعة مشكلة الغربة الروحية للإنسان في إطار مفهوم البراءة والخطيئة الأصلية (ص141).
ولكن يجب علينا أن ننتبه لحقيقة أساسية تحكم منطق ومنهجية الخطيب وكاظم، أن نقطة البداية تنطبق على النهاية، ومركز هذه الدائرة هو محيطها أيضا، وبلغة مباشرة يعتبر المنهجان أن بعض الظواهر هي أكسيومات (أو بديهات) أو أقله هي تحصيل حاصل. ومن ذلك علاقة الرواية الستينية بكافكا. ويوجد في كتاب الدكتور حسام الخطيب فصل كامل يعقد به مقارنة بين رواية يتيمة لجورج سالم هي (في المنفى) ورواية كافكا (القضية). بينما يتابع الدكتور نجم كاظم مجمل أعمال كافكا ليحدد أسباب التطابق بين مصير أبطال الرواية الستينية ومعراج أو متاهة أبطال كافكا. ومثل هذه النظرة المخصصة عند الخطيب لم تكن بعيدة عن النظرة البانورامية لكاظم. فقد اتفقا أن أوضاع العرب والتمزقات الاجتماعية والسياسية وأساليب القمع التي عانى منها الكاتب العربي وجدت صداها في أعمال كافكا ولا سيما في الستينات (ص149). ولم تكن معاناة أبطال كافكا في أعماله الميتافيزيقية التي تعالج مشكلة الجفاف الروحي في مجتمعات إصلاحية معادية لأي نزوع ثوري غريبة عن رواية الستينات والتي مهدت لهزيمة قاسية عام 1967 وخرجت من رماد خسارة مهينة عام 1948. ومن نافلة القول أن شخصية الرواية العربية وجدت مفاتيح شخصيتها في هذه الفترة. وانتقلت من تقشير الطبيعة من أجل وصفها ومحاكاتها إلى تقشير النفس البشرية من أجل إعادة اكتشافها وثم إعادة تركيبها. أو ما يقول عنه الدكتور الخطيب (حرفيا): لمتابعة مشكلة الغربة الروحية للإنسان في إطار مفهوم البراءة والخطيئة الأصلية (ص141).
وبودي أن أضيف نقطتين عن كافكا:
الأولى أنه كاتب متكتم، لا يعطيك نفسه بسهولة. فهو يخدع القارئ ويترك له علامات تضلل وتشوش تفكيره. ومن العسير على أي قارئ أن يفهم ماذا يريد كافكا من تضخيم أوهامه. ولماذا يتبع الصدفة دون أن يؤمن أنها جزء من أقداره؟؟. وهذا يناسب رؤية الكاتب العربي في منعطف الستينات، فقد تخلى عن نفسه دون أن يكتشف أي طريق مضمون للبديل.
النقطة الثانية أن أعمال كافكا مفصلة، ولا تخلو من الحوار الصامت أو المناجاة مع الذات والآخر مثل أي ذهاني فقد معنى نفسه أو أنه يتوهم أن الأمنيات هي الواقع ذاته. لقد كانت الرغبات في أعمال كافكا بمرتبة المنطق أو العقل المفكر. وهو ما حول أفعالها لمجرد ردود فعل. وأعتقد أن هذا كان يخدم الكاتب العربي لتمرير سخطه على السلطة والمجتمع (أو التاريخ والحضارة) دون أن يخاف من المحاسبة.
وهذا لا يمنعنا من الإقرار أن تأثير كافكا شيء والمؤثرات الكافكاوية شيء آخر. وقد ألمح الدكتور كاظم لذلك بمعرض مناقشته كافكا. فهو مجرد علامة وجودية بالغت بغموض وميتافيزيقية واقع أبطالها. وما تسرب إلينا من هذه الأجواء يدين لكامو وسارتر بقدر ما يدين لكافكا إن لم يكن لبوهوميل هاربال، وهو تشيكي آخر يعكس كل أعراض كافكا باللامسؤولية عن الذنب والسقوط تحت أعباء الخطيئة الأصلية. ولا يغيب عن الذهن حالة قسطنطين جورجيو الذي كان سفيرا في الحكومة الرومانية الموالية للنازيين في فترة صعودهم. إنه لا يمكنك أن تقفز من فوق هذا الكاتب، فقد كان مناوئا لسياسة سايكس بيكو، وهرب بعد سقوط النازية إلى السعودية، وكتب فيها كتابه المعروف “محمد نبي الإسلام”. ولكن ما يهمنا في هذا السياق روايته “الساعة الخامسة والعشرون”. وهي حكاية مواطن روماني يعتقل بالصدفة وهو في الطريق لحفل زفافه، ويسجن مع اليهود في معسكرات الإبادة بشبهة أنه يهودي كما جرى مع بطل رواية “القلعة الخامسة” لفاضل العزاوي.
ومشكلة الصدفة المستحيلة أو القدر الأعمى هي واحدة من أهم اللحظات العصيبة التي بنت عليها الرواية العربية كل فلسفتها في الستينات. فقد كانت تعبر عن الدوافع المجهولة التي عقّدت مصير الأمة بعد سقوط دولة العثمانيين. وكانت غصة في قلب كل عربي أن يرى تركيا واليابان وقبل ذلك ألمانيا وهي تخرج من الهزيمة وتعيد تركيب ذاتها، بينما يدفن العربي نفسه في ركام الحضارات الميتة، ويغرق في الظلام والبرد مثل جميع أبطال كافكا وجورجيو. ولعل فشل مشروع الدولة الوطنية هو الذي قاد الباحثين للقفز من فوق المؤثرات التي تعبر عن رؤية وأجندا الدول الغربية. لقد انصب الاهتمام على أدباء المقاهي والخلايا النائمة. مثلا حلقة سارتر ودوبوفوار. حتى أن إدوارد سعيد في دراساته اعترف بفضل سارتر على تشكيل وعيه المبكر بالمعنى الوجودي لمشكلة الحرية. لكن لم يكن أحد يولي الوجودية الديغولية أي اعتبار. وغاب اسم أهم أقطابها مثل موروا ومالرو تماما. وتكررت المشكلة مع صوت التوري الإنكليزي جيفري آرشر. ولم نسمع به في بحث الدكتور كاظم مع أنه اهتم بمصير رواية الثمانينات.
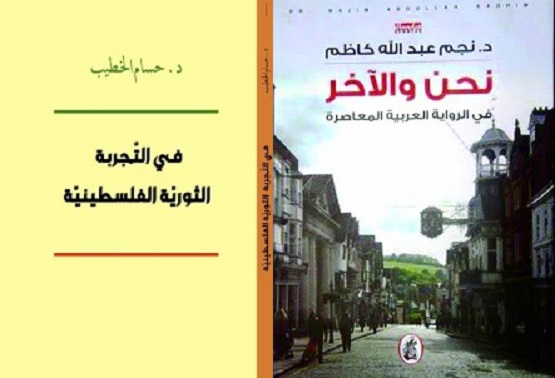
ولتفسير هذه الظاهرة يوجد عندي اقتراحان:
الأول أن هذه المؤثرات فرضت نفسها بشكل ميتافيزيقي. مثل آلية عمل صورة المدينة اليوتوبية أو مدينة الأمنيات (ما يسميه الإيطالي كالفينو: مدن الخيال). فقد كنا نخترع أسماء رومنسية لعواصم الميتروبول (مدينة الضباب/ لندن. عاصمة النور/ باريس). بينما فشلنا في إضفاء أي معنى جماهيري على المدن النموذجية (ومنها برلين وموسكو وهافانا).
الثاني طبيعة عمل الذاكرة المأساوية. فهي تبحث عن ما هو غير موجود، وبالسر تكيل اللوم والتقريع على على ضعف الواقع. وهو ما يسميه حمزة عليوي بـ “الجغرافيا التخيلية”، ويعمل بنظام التمثيل وآلياته (7) وليس بأسلوب الراصد والملاحظ. ولا شيء ينفع استعادة أو تنشيط الذاكرة مثل التمثيل، فهو تحويلي وله عدة عتبات. بينما الملاحظة تكون موضوعية ولا مجال للتمني أو إسقاط الرغبة فيها.
ولا شيء يوضح مثل هذا التحويل كالرواية. فقد دخل النوع في ما أود أن اسميه “أدب الدرجة الثالثة”. وهو كل ما يجد نفسه خارج ذاكرته وضمن ذاكرة هجينة وغير واضحة، وتتعرض لدورات غسيل وتبييض، وذلك بهدف التأسيس للسان يعبر عن المرحلة وليس عن الذهن، أو عن شروط المستقبل الموضوعي وليس شروط افتراضات الحضارة. وبعيدا عن الجدل البيزنطي لسان الرواية العربية لا يحمل جينات الثقافة العربية. وهو بامتياز ابن شرعي للسان أدب العالم الثالث، أو بأحسن الحالات لنمور آسيا. حيث أن الطبيعة تتآخى مع البشر وتشكل امتدادا لنشاطهم الليلي. بينما العقل يتآخى مع النهار ويشكل امتدادا لنشاط البصر فقط. ويمكن أن تقول إن الطبيعة في الرواية العربية تقدم للشخصيات والأحداث نقطة توازن. بينما النهار يحد من قدرة البشر على التحمل، ويضعهم مباشرة أمام مسؤوليات ظروفهم الاجتماعية. ومن هذه النقطة دخلت إلينا المؤثرات الوجودية والحداثة. فقد كان الترميز والإبهام أفضل دواء مسكن لآلامنا وجروحنا.
لا يمكن أن تجد أي أثر في الرواية للعقل العربي. حتى أن محاولات التأصيل تبدو لي اغترابية تماما مثل عباءة مستعارة. وفي مقدمتها الأسلوب الهمايوني للغيطاني. ويكفي في هذا المجال التذكير بمصير الثورة العربية. لقد غادرت المركز وانتشرت في الأطراف. وسرعان ما أصبحت حاملة لمعايير المعرفة الغربية. ولم يعد للمشروع العربي الأصلي أي وجود. وحل محله أجندا وطنية بعدة أسماء ومصطلحات. لكنها بشكل أساسي تعبر عن خلق مجال حيوي للأفكار المهاجرة. وما حمل اسم الدولة الوطنية في الغرب أصبح لدينا يعرف باسم الدولة القومية. لقد ضاعت أهداف الثورة بين عدة احتمالات: الأمة من طرف والدولة من طرف آخر. وتشكلت بالمقابل عدة مشروعات نصفها رومنسيات وطنية. ونصفها الآخر رومنسيات فنية. وهذا أقرب تعريف عندي لمشروع “الحداثة”. فهي مشروع دون أدوات.
لقد وجدت الرواية العربية نفسها دون واقع ملموس تتكلم عنه مثلما وجدت الثورة البلشفية نفسها في روسيا دون بورجوازية وطنية تساعد على إذكاء المواجهة بين الطبقات. وأعتقد أن حرق الثورة العربية لمشروعها الأساسي فرض على الرواية أن تدخل في نفس الفرن، أن تحترق لتعيش. والرواية الناطقة باللغة العربية في الوقت الحالي ربما هي ترجمة رديئة لكتاب “أعمدة الحكمة السبعة” للورنس. لا يمكنك أن تجد أي فرق بين بناء الشخصيات والحبكة في هذا العمل وبين مشروع عبد الرحمن منيف مثلا. كلاهما يستعمل علبة الأدوات نفسها. وكأن لورنس يترجم منيف أو العكس، منيف يترجم لورنس. ويكفي بهذا الخصوص أن نعلم أن قائد الجيوش العربية عام 1948 كان الجنرال غلوب. وأن مرشد حكومة الثورة العربية عام 1918 هو لورنس، الجاسوس الإنكليزي المدرج في المخابرات الجوية الإنكليزية باسم روس، والممنوع من نشر مذكراته بسبب سرية وحساسية المعلومات حتى عام 1955. لقد كان موضوع الرواية العربية مثل أسلوبها موحى به. وكلما حان الوقت للكلام عن الذات والهوية نجد أنفسنا أمام فراغ أو فجوة. وهذا وحده يضع ذاكرتنا في فضاء الذواكر المنهوبة أو المزيفة. ولعل مشكلة إنكار الدور الريادي لجرجي زيدان في اكتشاف شخصية حديثة ومعاصرة للرواية من خلال ذاكرتنا التاريخية، ومنح هذا الشرف لمحمد حسين هيكل مؤلف “زينب” دليل على رهان المثقف العربي على الغرب. لقد كان أسلوب “زينب” إصلاحيا لكن موضوعها هو الراديكالي. بعكس جرجي زيدان الذي اختار الأسلوب الراديكالي والموضوعات الإصلاحية.
وأغرب ما في هذا الموضوع أن البدايات التي تدين بوجودها للنثر العربي (الموروث - بلغة الدكتور كاظم في مشروعه النقدي) كانت بمعاييرنا ساقطة فنيا. وقاده ذلك ليقول عن “الرواية الإيقاظية” لسليمان فيضي أنها لم تمتلك الوعي الفني الكافي. ثم يتابع قائلا “إنها لم تتجاوز الموروث إلا بحدود”. ويقطع بصوت أعلى في كلامه عن محمود أحمد السيد حين يرى أن روايته “في سبيل الزواج” عمل فني متكامل لأنها انفصلت كليا عن الأشكال القصصية العربية الموروثة (كما يقول بالحرف الواحد). ولهذا الكلام معنى واحد أننا لا نكتب روايات. وأن الغرب يعيد إنتاج نفسه بعدة ألسن ومن بينها اللسان العربي.
وهنا أجد نفسي مضطرا للإشارة لعدة ملاحظات أو قرائن:
1- المشروع العربي سبق الرواية بالظهور.
2- كان المشروع العربي جزءا من بنية السرد العربية. كلاهما خرج من قاعدة ثقافية متأثرة بالغرب ومعادية عرقيا وثقافيا للشرق الذي حمل لواءه العثمانيون.
3- استيقظت الرواية العربية من سباتها مع مناداة أدباء العالم الثالث بالتحرر من تأثيرات الحلم الأمريكي وليس الأوروبي. ومشكلة البحث عن هوية بعد الاستقلال كانت موجهة بالأساس ضد توسع الأمريكين لا الأوروبيين. وكل برامج الزنوجة كانت تدور في إطار فرانكوفوني تحرري هدفه الأول هو إطلاق سراح العقل الأسود المهاجر من قيود العقل الأبيض المهاجر. كان الصراع بين موجتي هجرة. وليس بين طبقة السادة وطبقة العبيد كما كنا نعتقد. وأعتقد أن الفرانكوفونية كانت تؤازر هذه السياسة من تحت الطاولة لأنها أول ضحية للنفوذ الأمريكي. وقد اكتسبت الرواية العربية شخصيتها بعد أن اشتد ساعد رواية أمريكا اللاتينية. ولا ضرورة للتذكير أن الأدب الروسي لم يلعب دورا هاما. وقل نفس الشيء عن الأدب الصيني. ودون أي جدال كانت حضارات المشرق غائبة تماما عن المشروع العربي الذي تطور بدوره داخل جدران الكنيسة الأرثوذوكسية. ويمكن أن أنظر لهذه الحقيقة على أنها جزء لا يتجزأ من سخرية القدر. فالنظرية الإصلاحية مقبولة حتى عند السياسيين المحافظين. بتعبير أوضح حتى أحزاب حكومات الاستقلال تميل للكاثوليك والبروتستانت (بغض النظر عن الخلاف الروحي معهما).
4- ظهرت أول بوادر الرواية العربية بين الحربين. وهذا يعني أنها ولدت في ظل أعمق انكسار روحي يشهده العالم الحديث. وإذا كانت زينب رواية المرأة المكافحة في سبيل تحقيق ذاتها، فإن “أعمدة الحكمة السبعة” تكلمت بالنيابة عن المشروع العربي. وكان كلامها بلغة السلاح وليس بلغة العاطفة ولا القلب. وأضيف إن “زينب” هي إسقاط للذهن على الواقع، ولا يمكن أن تتعرف من خلالها على أحوال الريف ولا الفلاح المصري. بالعكس من “أعمدة الحكمة” التي عايشت تشكيل الضمير العربي الحديث، وواكبت علاقة الإنسان العربي مع بيئته. بتعبير آخر “زينب” رواية مكتوبة عن الواقع العربي من خارجه كأنها تتأمله من فوق لتحت. بينما “أعمدة الحكمة” هي متابعة دؤوبة لدرب الآلام الذي سارت عليه القبائل العربية في منعطف القرن الماضي. وفيما أ رى لم يكن لدى العرب سيرة فنية، بل مجرد محاكاة لطبيعة البيئة التي فرضت نفسها عليهم. أما الشطط (الخوارق والمعجزات) فهي البضاعة المستوردة من دول الجوار (الممالك التي تمتلك قدرة على تنشيط مخيلتها العلمية - أو الخرافية إن صحت العبارة). وكل السير التي تناقلها الرواة لعدة عقود هي موضوعة حتما في أوقات متأخرة وتحمل علامات وآثار أول صدمة حداثة (الرحلة من الصحراء والبادية الفقيرة بوسائل الاستجمام إلى المدن - الأكروبول- حيث يعبر الإعجاز عن نفسه بالثقافة والهندسة والخلاعة. وهي أول علامة لحداثة الاستجمام أو الاتجار برأسمال طبيعي). لقد كان عقل المرويات العربية في عينيه، فهو يفكر بما يدركه ببصره وليس بما يهتدي إليه بحكمته. حتى أنه لا يحتاج لأن يتخيل، فهو يشاهد بعينيه رابع المستحيلات كالغول والعنقاء والشيطان. وبلغة فرويدية مبسطة هو كائن خصائي. بمعنى أنه يسعى لخصاء المجهول بما يمتلكه من قدرات مادية ومحسوسة. ولذلك كانت الحبكة موزعة بكل الاتجاهات وتنمو دون ضوابط ولا معايير، وتتراكم وبشكل فوضوي يذكرنا بمشكلة ما بعد الحداثة (8). فهي فلسفة لها هدف مزدودج: اغتيال الموضوع وتصعيد الذات مثل لغة “زينب” الموشاة بالزخارف على طريقة الروكوكو. أما لغة “أعمدة الحكمة” فهي مثال نموذجي عن محاكاة الواقع النفسي لعلاقة البيئة بالأشخاص. لقد كانت لغتها تحترق بأتون الأحداث، ولا ترفع صوت أفكار الكاتب فوق صوت الشخصيات (وهذه هي إشكالية “زينب” وكل جيل الرواد، ما عدا جرجي زيدان). وأعتقد أن خطة زيدان هي مثل خطة لورنس. فقد بدأ الاثنان من داخل البنية (ما يسميه زيدان “فذلكة”، بمعنى استعادة أو ثرثرة)، قبل الانتقال لتجريد الواقع (بواسطة الانتقاء والتحديد) ثم شخصنته (بواسطة الحوار وبناء الشخصيات). ومن الواضح أن لورنس هو من كتب عن “المناظر والأخلاق العربية” وليس هيكل كما ورد في عنوان روايته، حتى لو أنها سبقت لورنس بما يقل عن عشرة سنوات بقليل. وبالمختصر المفيد يمكن أن تقول عن “زينب” أي شيء إلا أن أنها رواية عربية. وبنظرة واحدة من قائمة مؤلفات هيكل تعلم أنه كاتب متأسلم. ربما أضاف لعلبة أدوات الرواية لوحة مفاتيح عربية، لكن هذا المشروع كان غائبا عن ذهنه. وللأسف توجب علينا انتظار جاسوس إنكليزي لنتعرف على أنفسنا وعلى جرحنا الحضاري وغرفة الإنعاش التي نمر بها. ومنذ المقدمة يحدد لورنس الغاية من كتابه بقوله صراحة: هو عن اعتداء الحكم التركي الجائر على الشخصية العربية، وعن الذكريات العنصرية والسياسية والتاريخية للعرب (ص 16). ليضيف بعد أقل من سطر: إنه كان يبحث مع العرب في متاهات من الرمال عن شكل من أشكال الوطن. وإنه بذل جهده معهم لتحويل الواقع اللغوي المشترك لواقع جغرافي ملموس (ص 16). أو كما ورد بعد عدة صفحات: لتجسيد الوجود القومي العربي (ص 9) (59).
لقد حمل لورنس أعراض مخاض الرواية الغربية التي تكفلت ببناء وعيها الخاص عن عالمها. وبتعبير رامي أبو شهاب(10): كانت “أعمدة الحكمة” وعيا للذات ضمن شروط الواقع الحاضن. ويمكن تفسير ذلك بشبكة العلاقات بين الوعي المجرد وأساليب الإدراك. فالوجود يحتاج لمن يعقله فنيا، والظواهر الفنية بحاجة لمن يدرك أساليب نشأتها وظهورها أو خروجها من الوعي الباطن وتشكيلها للتمثيلات والمفاهيم. وبهذا المعنى يوجد لنظام المعرفة عند لورنس جانب ذاتي (أو فني ومعرفي) بالتوازي مع جانب موضوعي (أو واقعي). وهو ما لا يتوفر في الرواية العربية التي تدين بالجانب الأول من المعادلة لمرجعياتها المعرفية وليس لوضعها في الوجود أو لنزوع يتطور من تجاربها. ولذلك لا تخلو سيرة لورنس من عدة نقاط تشابه عجيب مع ذاكرتنا الشعبية، وبالأخص المشكلة الدرامية لأبي الفوارس عنترة، ومن ناحيتين: بسالته أولا، ثم تفكيره الدائم بحريته. ويمكن القول بسهولة إن لورنس هو إعادة كتابة معاصرة لشخصية عنترة. فهو مثله دائم التجوال بين المضارب في الصحراء، مهموم دائما بالبحث عن مصادر الكلأ والمياه العذبة، ويخرج من معركة ليدخل بمعركة. ويتخلل ذلك استعمال الدهاء والكيد للإيقاع بالعدو مع مواقف تدل على شهامة ومروءة عربية أصيلة. كان كلاهما بصورة نصف إله. والفرق بينهما أن لورنس يبحث عن حرية الجماعة بينما عنترة يبحث عن حريته الشخصية. وإن لم يكن لورنس ينظم الشعر ليفتخر ببسالته في الحروب فهذا لا يعني أنه لم يكن نرجسيا، ولكنه وظف الحساسية الشعرية باستعمال أشكال من التقابل والطباق بين جبروت الطبيعة الخلابة وضعف بني البشر. أيضا استبدل لورنس قصة هيام عنترة وعبلة بفكرة هيام العربي بأمجاده. وجهود عنترة للقيا عبلة توازيها عند لورنس مشاق البدوي للوصول إلى مستقبله. ومع أن الاثنين لهما مشروع وجودي، غير أن لورنس أقرب بمشروعه لما يعرف باسم روايات الطريق (بعد أن تضيف لها هدفا ساميا ونبيلا. وتجردها من القشور الميتة التي تخفي وراءها الهم النضالي). لقد بذل لورنس جهده لاختزال معنى العرق بمضمون سياسي معاصر هو المواطنة أو الهوية. لكنه لم يتمكن من إسكات اللاهوت الشرقي الذي تدخل بشكل حاسم في توجيه بنية روايته، ولا سيما باختيار فلسفة النهاية المفتوحة. وأدى ذلك بالضرورة لإلقاء جميع الشخصيات (من ناحية المعنى وليس الصور) في التيار الجارف الذي يدعوه أهل المشرق: القدر، وأحيانا الإرادة الإلهية (وتعود هذه الفكرة للظهور في جميع بواكير نجيب محفوظ تحت اسم مختصر وغامض هو: المشيئة).
إنه مهما اختلفت الآراء لا نستطيع أن نستبعد الأصول الاستشراقية للمشروع العربي، والرواية جزء منه. غير أن عمليات التحديث هي التي دفعت حكومات الاستقلال للنظر إلى المشرق بعيون غربية. ومثلها المشروع القومي، فهو أجندا تلفيقية مستعارة، نصفها من الرومنسيات الأوروبية الوطنية، ونصفها الآخر حزمة من الأفكار التي اشتركت عدة تجارب في انتاجها ومن بينها الواقع المحلي. أما بكم تدين الحداثة للواقع؟؟!!. ربما أقل من 10 بالمائة. وهذا ينسحب أيضا على موجة التنوير الأخيرة. فهي موزعة بين ليبرالية غربية (ماركسية رأسمالية إن صحت العبارة) وديمقراطية (دستورية). وبين هذين القوسين لا تزال الرواية العربية تعيد إنتاج ماضيها. مع تبديل طريقة استجابة العقل للعاطفة، من أسلوب المناظرة مع الآخر (كما في زينب وروايات المنفلوطي التي جاءت بعدها) إلى أسلوب المناظرة مع الذات (كما في مشروع جرجي زيدان) وهو من المشاريع المظلومة. والعدل يقتضي تصحيح الصورة. أن نعترف بدور جرجي زيدان في الريادة الفنية، وتحرير ذاكرتنا الفنية من الأفكار القديمة الجاهزة. وبالمقابل أن نضع المنفلوطي بسياقه التاريخي ونقر بخدماته الجليلة من ناحيتين.. كشف عيوب أخلاق التخلف. وكشف مصادر مؤلف “زينب”. فقد كان جريئا بما فيه الكفاية ليعترف بصوت مسموع أن سرديات التنوير هي تمصير وتعريب. وأن دورنا ينحصر بالدوبلاج أو نقل الأفكار والأدوات من بلد المنشأ لبلادنا. لقد كانت الرواية هي العلامة المكتسبة التي دلت على تعميق خط تحرير مجتمعنا العربي من نفسه، والإيذان بدخول المجتمع العالمي (أو عصر الحداثة). روايات المنفلوطي ليست إلا حلقة إضافية من اختراق أوروبا لقوانين عالمنا. بعد البارود والمطبعة كان لا بد من استبدال القوالب العربية للخيال بقوالب وصور فرنسية. وبالنظر لتاريخ نشاط المنفلوطي (توفي عام 1924) نستنتج أن مشروعه التلفيقي وئد يوم ولد مشروع لورنس التأسيسي.
5- مرت الرواية العربية بعدة محطات فشل. وعلى رأسها ما يعرف بالرواية الريفية. وأعتقد أن كل رواياتنا هي نتاج حضري وتكهنات مثقفين. ولا يوجد عمل واحد يصل لمرتبة “تورتيلا فلات” لشتاينبك في رهانها على الطبيعة الصخرية والرعوية. أو مرتبة “بيدرو بارامو” لخوان رولفو الذي وضع ثورة الفلاحين في سياقها الطبيعي. وما تبقى لدينا من أعمال نموذجية عن الريف هي إعادة تصور لريف متمدين، أو لمدن ذات أخلاق ريفية. وعمليا ليس لدينا رواية نقية. ومثلما كانت ثوراتنا مدجنة، وتعبر عن قلق دولي من واقع الشرق الأوسط، كذلك كانت الرواية. تحمل كل فوضى ولا يقين الوعي الباطن. ولكن بدواعي الحقيقة يمكن الكلام عن رواية بيئية هي نتاج عقل كوارث أو دايستوبيا واقعية. ويمكن ببساطة أن تجد في كل روايات المخاض الاجتماعي والسياسي صورة مباشرة لدايستوبيا لا تستطيع أن تحلم برعب أكبر وأوسع ما صورته. ويكفي هنا أن تتذكر المحنة التي لاقاها بطل “حارس التبغ” لعلي بدر، على سبيل الذكر، وهو يكافح ضد قانون الأرض المجهولة والواقع المعلوم. وما ترتب على ذلك من نزوحات متتالية، كل منها تعبر عن موجة تهجير إجباري طال المجتمع كله. وهذه هي نفس النغمة التي عزف عليها لورنس في “أعمدة الحكمة”. فقد كان مشغولا بالبحث عن موضوع غريب لشكل فني جاهز. وبلغة أخرى: وضع لورنس القضية العربية على سرير بروكست فني. وهذا هو جوهر التمثيل الاستشراقي بالضبط.
6- العلاقة بين الرواية العربية ومصادرها علاقة جدل تاريخي. وهي جزء من ظاهرة صراع الأجيال، وليس نفي المصادر. وبرأيي إن ما نسميه البحث عن هوية عروبية هو مجرد تعبير مهذب عن عقدة أوديب. إنها تعمل على نحر الأب (أو الشكل الأبوي) ولكن دون أي رغبة بامتلاك الأم. وربما تبدو لنا الرواية المعاصرة مثل ولد يتيم، كائن غير مسمى يبحث لنفسه عن مكان أو حدود لتجربته الوجودية. ومثل هذه البنية مختلفة عن تجربة العقل اللاتيني الذي يقوم على فكرة المغالبة. ويمكن أن تفهم من ذلك أن المضمون في الرواية العربية تحرري، لكن الأساليب كلها قمعية وبطريركية، وبعيدة كل البعد عن ظواهر التكوين (جينيتيكوس) التي يميل لها العقل اللاتيني بطبيعته (وبالمعنى الذي تكلم عنه لوسيان غولدمان / التكوينات الاجتماعية وليس الطبقات - صراع الأضداد وليس النزاع على مصادر الثروة). وبودي أن أضيف إن المشروع العربي الحديث ولد مع سردياته. ومثلما كان يدين بأدواته للمؤثرات الخارجية، دخلت هذه السرديات أيضا بمركبة عسكرية أجنبية. وهذا لا يلغي عروبة المشروع وشخصيته بقدر ما يؤكد حقيقة لا يمكن التغاضي عنها. أما كل ما سبق ذلك من محاولات فقد جاءت للتعبير عن مصير هجرة الكفاءات والعقول وتبرمها مما يفرض عليها من جيوب جامدة ومحرومة من الحس التاريخي ومنطق التطور.
***
وفي النهاية يطيب لي التنويه بحقيقة لم يكلف أحد نفسه أن يقف عندها وهي المعنى أو الحكمة المرجوة من هذه المؤثرات وطريقة عملها. هل جاءت عفو الخاطر أم أنها عملياتيا جزء من نظرية داروين في “أصل الأنواع” و“التنافس على مصادر الإضاءة”؟..
إذا كانت أول موجة نهضة عثمانية هي التي سهلت على العرب انطلاق أول موجة من موجات “التنوير”. وبالتالي دشنت ما يعرف بأدب الرحلات وما نجم عنه من روايات مبكرة ثم روايات “طلب المعرفة” و“صراع الحضارات”. وأمثلتها أشهر من نار على علم، ومنها “عصفور من الشرق” و”الحي اللاتيني” و”الظمأ والينبوع” (والأخيرة للسوري ابن حلب فاضل السباعي)، وهي من الأعمال المنسية أو المركونة في صندوقنا الأسود، وهو صندوق مفاجآت معرفية ودالة، فإن الحرب الباردة وصراع الإرادات، واتساع رقعة الحلم الأمريكي، هو الذي فتح لنا باب موجات التنوير الثانية. ومنها تدفقت هذه المؤثرات على الصعيد الفني والمعرفي أو على صعيد جماليات الموضوع. ولدي أكثر من سبب لأنتقل من تفسير هذه المؤثرات إلى تسميتها وتقنينها. وأجزم أنها شكل من أشكال تحديث المثاقفة. وهي الوجه الآخر للحداثة الأوروبية الميتافيزيقية. فقد بدأ مشروع تحديث أوروبا مع احتلال القدس، وكان مشروعا روحيا، ولكنه أصبح بعد قيام دولة إسرائيل مشروعا ماديا يدعو للتبرئة، ويضع الشرق في سياق فوق تاريخي وفوق واقعي، أو سياق فانتازي تخيم عليه أزمات الغرب وسقطاته وذنوبه. وهو بالضبط المعنى المعرفي لظاهرة الاستشراق. وبتعبير شيلبي باسيك shilpi Basak إن ما يجري هو مراوحة بين الشعور بالغربة المعنوية والانتماء لبقعة جغرافية غريبة تعزز على نحو كبير (ومن طرفي المعادلة) هوية الإنسان. وهو ما يعرض هذه الهوية لمجموعة من التناقضات: كالجذب والإبعاد والاغتراب والطمأنينة (ص11)(21). بمعنى أنها تمهد لتجسيد أوهامنا بشكل حقائق، و تحويل التجربة الحقيقية إلى ذاكرة. وهذا يساعد على استكمال مشكلة “وعينا الشقي” باليوتوبيا.
وإذا كانت رحلتنا للغرب بهدف التنوير والبحث عن القيم الروحية بين ركام المادة والمعرفة، فإن رحلة الغرب باتجاه الشرق كانت لترميم الجزء الميت من الروح، وللتستر على الذنوب والنوايا الحقيقية بستار من الغموض واللاتناهي. وهو ما تجده بأوضح أشكاله في مشروع هرمان هيسة ولا سيما: سدهارتا، ورحلة إلى الشرق، وذئب البراري. والعمل الأخير رواية نيتشوية تركت بصماتها على “الغرف الأخرى” لجبرا، كل غرفة تفتحها تقدم لك تفسيرا يخل بنظام المنطق ويضع الكائن أمام احتمالات مفتوحة على الرعب والشك.
د. صالح الرزوق
حلب / 2020
..........................
هوامش:
7- الجغرافيا التخيلية. جريدة تاتو.عدد 81. 2017. ص10.
8- أعتقد أن ما بعد الحداثة تعيد عقارب الساعة للوراء. فهي توطين لدكتاتورية الكاتب مقابل اغتيال عالمه. وأهم مثال تطبيقي معاصر تجده في روايات أولغا توكارشوك. وسبقها في الشعر مواطنها جيسلاف ميوش. لقد عمدت توكارشوك في النثر وميوش في الشعر لبناء عالم غير هرمي ينمو بشكل مريض ويعاكس مبدأ تقييد الصورة المعروف الذي وضعته جمعية فاراداي لأغراض اقتصادية منذ فترة ما بين الحربين. وأشهر من نظر لهذا الخطاب المعاكس هما فوكو ودريدا. فالنزوع الموسوعي الذي يغطي مراحل هامة من تطور البشرية في كل الاختصاصات يعبر عن رغبة مبيتة للشركات متعددة الجنسيات في تجاوز خطوط العزل المعروفة وبناء إمبريالية تقضم العالم. ويمكن القول إن نزوع قتل العالم ودكتاتورية الكاتب من الاتجاهات الميتافيزيقية التي لا تحتكم لمنطق العمل الجماعي وتؤمن بشمولية الأفراد أو مبدأ الإنسان الكلي. وبكل سهولة يمكننا مقارنة رواية “الطيران” لتوكارشوك مع الأغاني للأصفهاني أو رسالة الغفران للمعري. فهي تعمل وفق مبدأ من كل بستان زهرة، وتؤاخي بين أشكال الكتابة ابتداء من الخبر حتى القصة القصيرة، ودون تردد أجد أن حدود النوع لديها تدخل في عداد الحداثة السائلة أو الحداثة المستمرة التي بدأت مع شعراء بني أمية وتحولت لتجريب بين الأساليب والثقافات في العصر الذهبي للدولة العباسية.
9- أعمدة الحكمة السبعة. الطبعة العربية. المكتب التجاري. بيروت. 1963.
10- الأدب: الوعي والفينومينولوجيا. القدس العربي. عدد 8 أكتوبر 2020.
11-
Postcolonial English Literature: Theory and Practice. Edited by: Dipak Giri. Authors Press. 2018. India. pp223.
















