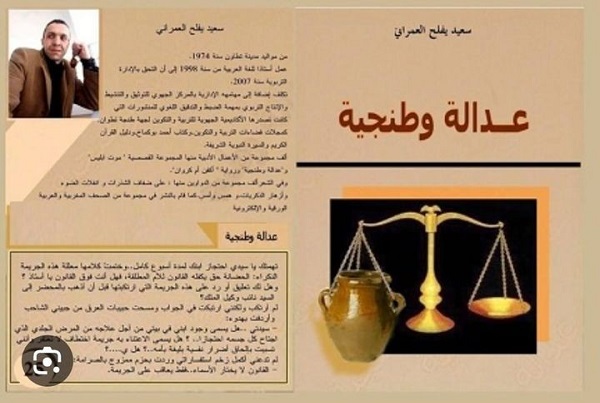صحيفة المثقف
وسوّاس المخدةِ .. المرأة والشيطان
 "وسواس المخدة"... ليس أفِيشْاً لفيلم سينمائي ننتظره بعد منتصف الليل على غرار أفلام البورنو. لكنه لقب أطلقه الإمام القرطبي صاحب "الجامع لأحكام القرآن" على المرأة، لأنَّها أغوت آدم وأنزلته من الجنة إلى الأرض (أبو عبد الله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآيِ الفرقان، الجزء الأول، تحقيق عبدالله التركي ومحمد رضوان، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 2006، ص457). المرأة تحديداً فيما يذكر من آراءٍ هي أنثى يسكنها الشيطان، فكانت موصوفة بالوسوسة في خدرها الذي قد يتسع لحدود المجتمع بضمان استمرارية التأثير والفتنة. وليست إقامة الشيطان داخل كل أنثى مصادفةً، لكنها إقامة أصيلة بفضل وثائق الاعتقاد والنصوص والتقاليد الثقافية. كما أن الشيطان بالنسبة إليها ليس ضيفاً، إنه صاحب بيت أصيل. فكل امرأة تخضع من قبل المجتمع لعمليات تفتيش وتنقيب في كامل جسدها وروحها ووجودها وسردياتها عن شيطانٍ ما. لأنها الوكيل الحصري - بعبارة معاصرة - لما يفعله الشيطان في الحياة وبخاصة إزاء الرجال، فلئن كان الشيطان لا يستطيع اقتحام مملكة الذكور، فإنَّ امرأة واحدة قمينة بتفكيك وهدم مملكتهم.
"وسواس المخدة"... ليس أفِيشْاً لفيلم سينمائي ننتظره بعد منتصف الليل على غرار أفلام البورنو. لكنه لقب أطلقه الإمام القرطبي صاحب "الجامع لأحكام القرآن" على المرأة، لأنَّها أغوت آدم وأنزلته من الجنة إلى الأرض (أبو عبد الله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآيِ الفرقان، الجزء الأول، تحقيق عبدالله التركي ومحمد رضوان، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 2006، ص457). المرأة تحديداً فيما يذكر من آراءٍ هي أنثى يسكنها الشيطان، فكانت موصوفة بالوسوسة في خدرها الذي قد يتسع لحدود المجتمع بضمان استمرارية التأثير والفتنة. وليست إقامة الشيطان داخل كل أنثى مصادفةً، لكنها إقامة أصيلة بفضل وثائق الاعتقاد والنصوص والتقاليد الثقافية. كما أن الشيطان بالنسبة إليها ليس ضيفاً، إنه صاحب بيت أصيل. فكل امرأة تخضع من قبل المجتمع لعمليات تفتيش وتنقيب في كامل جسدها وروحها ووجودها وسردياتها عن شيطانٍ ما. لأنها الوكيل الحصري - بعبارة معاصرة - لما يفعله الشيطان في الحياة وبخاصة إزاء الرجال، فلئن كان الشيطان لا يستطيع اقتحام مملكة الذكور، فإنَّ امرأة واحدة قمينة بتفكيك وهدم مملكتهم.
الكائن الوسواس في العربية هو الشيطان رأساً بشحمه ولحمه ورأسه وأخمص قدميه وذيوله. يوسوس، يخنس، ينفث في الآذان والروع، يفرق بين الناس، يبث الفرقة والضغائن. فما بالنا إذا كانت الأنثى عينها وسواساً. تلك هي بصمة الثقافة المتوارثة على كيان هش. كيان يحتاج دوماً إلى زوج أو محرم أو وكيل أو نصف شهادة أو قبر أو حفرة تزج بها. أي أنها امرأة تحتاج ختماً اجتماعياً لاهوتياً حتى تبريء نفسها أو تفلت من الملاحقة أينما حلت. وفي أي مرة تمارس حريتها أو وجودها عليها تقديم أوراق الاعتماد لدى سلطة خفية تتكاثر باستمرار. وليس أكثر هيمنة من سلطة الثقافة التي تعيد تشكيل مجتمعاتنا في كل مراحل التاريخ.
الوأد الرمزي
في ثقافتنا الجارية، يجب أنْ يلف جميع حيثيات المرأة حذرٌ وراء حذر.. هكذا تقول اللغة والأمثال والتقاليد. فالعلاقة – مثلا- شبه واضحة بين الزواج والقبر على قاعدة العادة العربية القديمة" الوأد". الاثنان يؤديان الوظيفة الاجتماعية نفسها. فالزواج كما تقول الثقافة يستر عورات المرأة، يغطي الفضائح المحتملة ببريق اجتماعي حافل (ظل رجل ولا ظل حيطة). هذا الاحتفاء بمن يُستِّر البنات في الأرياف والبدو والقرى وصولاً إلى المدن. لدرجة أن كلمة الزواج تأتي في عباراتنا المتداولة كمقابل للستر وعدم الفضيحة( ربنا يستر عليكِ يا ابنتي... كما يرد الدعاء على ألسنة الامهات لبناتهن). ويأتي الدفن (أي القبر) آلية للتخلص من العورات (بالتوصيف الديني) فيدُسها ولي الأمر تحت التراب إلى الأبد، لا يسمع لها صوتاً ولا يرى منها شيئاً. وعلى منواله جاء البُرقع والنقاب والشادور (أو الجادور بالفارسية) قبوراً متحركة بأجساد النساء.
من هنا كان وأد البنات قديماً من أفعال العرب، ولكن اختفت العادة مادياً وبقت رمزياً بصور أخرى. والوأد كعمل لا إنساني... لا ينهي حياة الأنثى فقط، بل يؤكد إذلالها كأثر متواصل على بنات جنسها وفكرتها في المخيلة الشعبية. وهو من أقرب الطرق إهالة التراب على العار الرمزي أيضاً الذي يظنه الرجل لاحقاً به. وقد وثق القرآن المسألة.." وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ظل وجهُه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألاَ ساء ما يحكمون"... فالوجه هو المرآة الاجتماعية التي ترى الثقافة فيها نفسها، وهي علامة الحيوان البشري على أنْ يكون إنساناً أو لا. وحرص القرآن على أنْ يقول عن الذكر وجهه مسوداً، أي مرآة الثقافة قاتمة سوداء، وليس هذا فقط بل يتوارى من الناس. والموازاة بين التواري من العار الاجتماعي ودفن المرأة في التراب واردة داخل النص القرآني كأفضل ما تكون الموازاة. وهي رمى المعنى بأن المرأة عار والتراب هو الذي يضمها وسيضم الجميع بالمثل.
فلا يمحو العار إلاَّ الدفن، والدفن كما لوحظ للأنثى وهي حية لا ميتة. وذلك كان رد فعل ثقافي للتبرؤ من الأنثى على نحو جذري. هكذا يظل " الوأد الرمزي" ممتداً – مع انقطاع العادة تاريخياً- بواسطة تفسيرات الدين والأشعار والآداب العامة والأمثال الشعبية والسياسة والهندسة الاجتماعية. وهذا البعد كما سنرى لا يقل عنفاً عن سابقه، فهو حتى أكثر حضوراً منه. لأنَّه واسع الانتشار ويلتحم بالمسلمات الدينية وسلطة النصوص في المجتمعات العربية. ويتردد حتى على ألسنة النساء أنفسهن راضيات طائعات!!
أيضاً "وسواس المخدة" ينقل دلالة النوم بجوار رجل هو الزوج داخل مخدعه. وتلك المحصلة بمثابة أصل الشرور في عقر دار الذكورة العربية الاسلامية. والوصف المقلوب المسكوت عنه أنَّ الرجل بريء تمام البراءة. هو الملاك النقي المتفرد في مقابل الشيطان. وهو المغرَر به، المخدوع دون قصد ولا إرادة منه. وإذا لم يقبل وسواساً بجواره سيظل بريئاً إلى قيام الساعة. وأنَّ المجتمع نزيه من كل تلوث عقائدي وفكري. وأنَّ الاخلاق تداهمها مخدات شيطانية تحمل وساوس ليلية من غرف نوم الفحول. وأنَّ الحياة على شفير الهاوية بفضل النساء ليس أكثر. لنراقب هذا التعمد في اتهام المرأة بكل الموبيقات.
السؤال الآن: فيما كان يفكر القرطبي وكل قرطبي لاحق أو سابق؟ لماذا يتحدث بلغة ثانية على اللغة الأصلية (النص القرآني)؟ الفكرة الواثبة أنَّ الكتابة والتفسير عملان جزئيان لواقع أكثر إكراها وعنفاً. ويبدوان (الكتابة- التفسير) حالتي استغراق في آلية تأليف موازٍ هو حضور المقدس وبدائله الثقافية. فالذكورة لها مركزية تزحف، تتسلق، على مصادر اللاهوت، بل تتوحد مع المقدس لتشاركه قيادة دفة الحياة في الثقافة العربية. وهذه التوليفات تترسخ في أحبار اللغة المتداولة على صعيد التداول. وبالتالي تستقر لدرجة البديهيات بواسطة الممارسة وطرائق التفكير والعلاقات الاجتماعية. وتنتهي اللعبة في عملية التفسير بأن تصبح التفسيرات أكثر أصالةً من الأصل، أكثر قداسة من المقدس. ذلك بعدما يزاحم النصوص الأصلية كتفاً بكتف، وخطوة بخطوة وسبقاً بسبقٍ.
المرأة قبل الشيطان
لنذهب إلى سياق الكلام مباشرة. يقول نص القرآن( قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكُلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين). القول واضح كأمر خارج الاختيار. وهو مخاطبة لآدم ككائن حي بدأت تتفتح حواسه. والزوج لفظ اشتقاقي من جسم الكائن الآدمي كما هو مشهور. وتسديداً للحواس ستكون عملية الأكل محتملة بموجب الغرائز بين الاثنين بلا تفرقة. ولهذا يعد الظلم الحاصل – بحال المعصية- بالتساوي ذاته. والغموض في الأمر لا يحتم الضرب بعيداً إلاَّ بنقل المضمون والنتائج.
هنا يجدِّل (يضفر) القرطبي معتقداته مع الأصوات الثقافية الجارية في الخلفية. فكعادة المفسرين القدماء يغرقون النص القرآني بالتفاصيل الجانبية (التشجير) وشواهد النثر والأدب والأقوال المأثورة وغير المأثورة والحكم وآراء الفقهاء و أهل النحو والصرف. بحيث لا يستفيق القارئ إلا وهو داخل متاهة التخريجات التي لا تنتهي. فالقرطبي يتحدث طويلاً عن السكن، معناه، حقيقته، مآله، زمنه، قوانينه، عاداته وآفاقه وطرائقه. وكذلك الفرق بين السكن والضيافة وغيره من ضروب الإقامة. هذا كله كي يمهد لنزول آدم وحواء من الجنة إلى الأرض. ويعتمد على شيء أبعد من اللغة في كون الوضع حكماً إلهياً. وتلك كانت نقطة مفصلية نحو الاقرار بما سيجري لأول مخلوقين لاحقاً.
أما الرابط بين ذلك وبين " وسواس المخدة "، فإن ما ينسحب على الحكم الأول يحب جريانه على كون المرأة بهذه الوضعية الشيطانية. وبالتالي ستكون دينياً وضعية مقبولة ومرحباً بها في المجتمع طالما كانت من الله. وفي الاثناء يتم ارهاق وعي المتلقي بإيعاز من قصد المؤلف مما سيعني امتثالاً خاطفاً للإحالة على ذلك المستوى مع تصديق المعنى. ويذهب القرطبي كذلك إلى تفسيرات كلمة" زوج" معتبرا إياها ذات مرجعية لاهوتية في المقام الأول. فلو لم ترد في النصوص والأحاديث ربما لم يقل شخص لامرأته زوجاً. بإشارة ضمنية أن الأحوال كانت حميمية من قبل الله (من نفسٍ واحدة). لكن المرأة من وحي نفسها وغرائزها انشقت عن ذلك مع انشقاق الشيطان. ليتوحدا بالنهاية في وسواس واحد.
وإذا كان الشيطان سيختفي بعيداً، فها هي المرأة قد أصبحت بديلاً داخل الغرف المغلقة في كل بيت. بالتالي هي أكثر نفاذاً من الشيطان. لو حضرت يحضر معها، وإذا غابت يأخذ طريقاً آخر. فما اجتمع رجل وامرأة إلاَّ كان الشيطان ثالثهما كما يقال دينياً. ولم يكف القرطبي عن تدعيم كلامه بأحاديث وآيات. فروي أيضاً عن نبي الاسلام أنَّ الملائكة سألت آدم لاختبار علمه بعد خلق زوجه ... أتحبها يا آدم قال: نعم. لكنها عندما سألت حواء أتحبينه يا حواء: قالت لا... وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبه. قالوا لو صدقت امرأة في حبها لزوجها لصدقت حواء...!!
والفكرة واضحة هنا في اعتبار الرجل صادقاً وله المكانة العُليا بينما كذبت المرأة وستكذب بنات حواء طوال عمرهن. أو على الأقل تراوغ في الاعلان عن طويتها وهي راغبة (كما يقال: يتمنعن وهن الراغبات). ولعل ذلك أسس للتصور الشائع عن النساء بكونهن غير واضحاتٍ. ولا يدري الرجال ماذا يردن بالضبط وانهن غير صادقات مهما قلن. ولئن كانت المراوغة السابقة في الجنة تحت عين ملائكة الإله، فكيف سيكون الحال في الدنيا. وبخاصة أنها وليدة الخطيئة من الألف إلى الياء.
القرطبي يؤكد ضمناً أن عباراته ظلال للنصوص الأصلية. فهو لا يفسر فقط، إنما يصارع للاستحواذ على القرآن. ولا يذهب إليه بعقله المتبحر كما هو مشهور عنه. بل يتوكأ -إلى درجة العجز- على جاهلية الثقافة حول المرأة. وهذا يعني شيئاً لافتا: اللغة الثانية كتفسير بمثابة الباب الملكي لعبور التقاليد العنيفة حول الأنثى. وأن كتابتها بروح التجرد الظاهري لا يبدي إلاَّ تجاور المعاني فقط. لكن الحركة الأخرى هي تأكيد أن القرآن يقول ذلك ويثبت التفسير ذلك على طول الخط. وأن الإيمان بقدسية النص يعاد حياكته (نسجه) ضمن العبارات المتداولة. فلم يفعل سوى إعادة تثبيت النص القرآني في أنسجة الكلام الاعتيادي.
ولذلك أطلق القرطبي على تفسيره " الجامع لأحكام القرآن". لم يطرح شروحاً لغوية ولا فقهية بأي قصدٍ آخر دون هذا الشمول الكلي لما يطرح. القصد إن ما سيقوله هو القرآن لا أبعد ولا أدنى. إنْ لم يكن التفسير حكماً في ذاته. وعليكم أنْ تعتبروه نافذاً كما هو النص الأصلي. مجرد تجميع وتهذيب وإبراز له. مغزي هذا أن التفسير خطاب بكامل المنطق الذي يطلق العنان لسلطة المعاني وتلقيها كما هي. لعلنا هنا نلحظ الزائدة التي يدخلها مفسرو القرآن. أي: تحول اللغة العادية إلى لغة مقدسة، إلى خطاب مهموس بقوة الأحاديث والمقولات والشواهد. وبدلاً من إدراك شروح الألفاظ، يلجأ إلى تكملة المعاني واغراقها بمخزونات الثقافة.
كلام الشيطان
في هذا السياق يذكر القرطبي قولاً مقصوداً (...إنَّ أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء ابليس إياها... وإنَّ أول كلامه كان معها، لأنها وسواس المخدة، وهي أول فتنة دخلت على الرجال من النساء...)( المرجع السابق، ص ص 457- 458).
1- ايراد لفظة أول لا دليل عليها في حق المرأة من قريب أو بعيد، إنما هي معنى شائع في ديانات سابقة. فالكلام كما ورد بالقرآن موجه إليهما معاً. فكما قيل عن النتيجة أنهما (أكلا) منها، أي أكل الاثنان معاً. وليس وضع حواء في البدء إلاَّ قتلاً ثقافياً أصلياً في البيئة الجاهلية. وهذا(القتل) يُغمس(يغمر- يعمد) في تفسير النص على أنه الحقيقة الثابتة. ثم يُصفى كسائل كان مليئاً بالشوائب ليصبح عملاً وفكراً قابلين للتكرار على نطاق التاريخ والاجتماع.
2- ربط الاغواء بالأنثى ليس صحيحاً. لأن النص وضعها بمفردها مع هذا الكائن الخفي(ابليس). برغم أن الرغبات توجد في ظل آدم الآخر. أي تعمد القرطبي بنزعته الذكورية إلى تغييب آدم، ليُحمل حواء كل آثار القصة حتى زمنه على الأقل. إذن كانت بكلامه ضحية مرتين من إبليس ومن صاحب التفسير نفسه(القرطبي). لكنه نسي أنه بذلك يدخل الله كطرف فاعل في الموضوع. فإبليس يستحضر نقيضه الذي خلقه. والنقيض ليس الإنسان الجديد بل الإله. فقد طرد من الجنة لأنه لم يطع كلامه حصراً.
3- مقولة" وسواس المخدة" أوردها القرطبي ليصرف التفكير في الحبكة الإلهية الدرامية. أو هي مقولة تشير إلى كيفية تحول القصة في ذهنية المفسر إلى صناعة بشرية. وكيف يتم تبريرها في الحياة الاجتماعية. الدليل أنها إلى الآن مازالت تخضع لعمليات مونتاج وكولاج خطابي وسردي. ومع ذلك تأتي الأنثى خلالها بمثابة الضحية الدائمة بمنطق السبب الكافي والعلة الفاعلة على كلام فلاسفة الاسلام.
4- جاءت المقولة (وسواس المخدة) مسبوقة بصيغة: التبرير الخطابي (لأنها الفاعل في الخطيئة بالتأثير على آدم). أي أن ابليس بدأ الكلام مع حواء لكونها( سبب الخطيئة وبالتالي ستكون وسواس المخدة). والتعبير هنا غير صادق بالمرة. فكيف ستكون المرأة وسواساً وهي تكلم ابليس لأول مرة. هل ابليس كان يعرف المخدات (الوسائد)؟ المقولة ملقاة على طاولة الخلْق الأول كنوع من الاتهام الصريح. ربما ليس فقط بإغواء آدم، بل بشيطنة الشيطان نفسه. كأن المرأة وراء انحراف ابليس وعدم سماعه للأمر الإلهي.
5- كانت حواء أول فتنة دخلت على الرجال. هذا اقرار بكون الذكورة تحكم حتى فهم النص الديني من منابعه الأولى. بل الأغرب أن الخيال الفقهي أيضاً متشرب بهذه المعاني. ولم يجد غير الأنثى فيما بعد للتنكيل بها كأنه يحاول القصاص من كل امرأة. فالنصوص الدينية محجوبة بكم هائل من التفسيرات التي تستنطقها بشكل مركزي ثقافي.
6- هذا تخريج لا يخلو من سياسات الجندر. لأن كل عملية لي لعنق السرد يصب لمصلحة سياسات اجتماعية معينة. فالمرأة رغم جناحها المهيض إلا أنها كان مصدراً لخوف اجتماعي عميق بعمق التأويلات الدينية. حتى التعليم على سبيل المثال يعتبر حرمان المرأة منه نوعاً أخيراً لهذه التخريجات. قد يقال إنها ظروف اجتماعية واقتصادية عابرة. صحيح هذا عامل متغير، لكن الأساس في المجتمع العربي هو الحط من قدر الأنثى. فهي كائن محروم من الميراث ومحروم من الحقوق والاختيار والمساواة ومن المكانة اللائقة بها وحتى محروم من العقل الاجتماعي و من الواجهة الإنسانية. ومحروم من الرمزية الفاعلة. إذن: ماذا بقي لها إلا الاستعمال الورقي؟
7- يفتح وسواس المخدة الزمن على مصراعيه للتخوف من النساء باستمرار. وفي سياق آخر يعتبرهن القرطبي (زينة) للإيقاع بالرجال. وهنا يفرغ المرأة ويجرف انسانيتها تاركاً جوفها لصفير الشياطين. (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة...) قول القرآن ذلك اعتبره القرطبي دليلا دامغاً لكون المرأة ألعوبة الشيطان. فالأخير- بحسب اعتقاده- هو من يزين للناس. وبدأ بالنساء كأول الزينة لأنهن الأقرب إليه.
القمع الأبوي
يؤكد القرطبي أن حب الشهوات ("من النساء "... بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن. لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء) أخرجه البخاري ومسلم. ففتنة النساء أشد من جميع الأشياء. هكذا ترك صاحب أحكام القرآن كل شيء: التاريخ، الأحداث الجسام، المجتمعات، الحياة برمتها.. وكانت النساء بمثابة صدارة الشرور.
بهذه الطريقة، مارس الفقهاء قمعاً أبوياً في قضايا المرأة، بدءاً من تحقير مكانتها وانتهاء بمسألة رفض ولايتها في المجتمع. مروراً بقضايا الحجاب والفتنة والشهوات والشرور. كلُّ ذلك مؤسس على نواة الأنوثة. بمعنى أن المواقف الجدلية والمبررات تبنى باعتبار الأنثى كائناً أقل من الذكر، بل أحقر الكائنات. وأنها مصدر لذته، امتاعه، تسليته وهي العقاب الذي يلحق بذاته أو يلحق بغيره. وهي بالتالي مصدر شقائه وتعاسته في الدنيا والآخرة. مع اعتبار الذكر خليفة الإله لا تقترب منه الرذائل وأنه منزّه عن الهوى.
هل علينا التوجس من كون مفهوم الإله ذكورياً؟ أي أن جميع الصفات المنسوبة إليه منسوبة بهذه المعاني الانسانية المعبأة بسلطة الذكور .... من الانتقام إلى الرحمة والعدالة والعلو والقداسة. كما كان مفهوم ابليس والشيطان ذكورياً أيضاً. فأغوى حواء بنفس الصفة الذكورية لا غير. ونحن نعرف أن ثقافة تضفي طابعاً ذكورياً على إلهها وشيطانها، فإنهما انعكاس لصور موجودة ومتعالية فيها. على طريقة صناعة الآلهة كيفما نتصورها وننحتها فيما يتم الاستعاضة أثناء الأفعال بالاسم. فالأوصاف الذكورية للإله استثمرت فيما يأتي بالهيمنة والاخضاع من خلال السياسة وكأن الفقهاء يرون الحاكم إلهاً وينصبونه كذلك ويضفون السمات المقدسة عليه. فالمرأة تحب زوجها باسم الدين، المجتمع يسير وفق اهدافه بالدين والخطورة أن التحقير من المرأة يتم بهذا الاسم أيضاً. وبات معروفاً هذا الدعاء للشيوخ بأن يصلح الله زوجات المؤمنين(اللهم اصلح زوجاتنا).
باختصار ليست الأنثى شيئاً آخر سوى الاغواء والخطيئة. حتى أنها تقطع الصلاة أو بالأحرى تبطلها. وهي العلاقة الحياتية بين الإنسان وربه. كحال الحديث المنسوب إلى نبي الاسلام " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ". وبصرف النظر عن صحته أو زيفه فقد جعل الكلام المرأة متساوية مع الحيوانات في هذه المرتبة. حيث تلحق النجاسة بمن يصلي. وذكر الصلاة جاء كعلاقة رأسية لا يقطعها إلا شيطان يضل عن طريق الله. فالأنثى هي نعجة الشيطان يتلبسها كيفما شاء. والكلب شيطان عقور والحمار أنكر الأصوات. ماذا يبقى في ذهنية المتلقي؟
إن الوضع المتدني للمرأة هو تخليق ثقافي لنمط الأنثى– الرغبة. فالمكر الذكوري الغالب على تفسيرات الدين يضع نماذج للأنثى ترى فيها نفسها شبحاً مقبولا ليس لبيئتها بل لله بالمثل. وأنه إذا ما التزمت بذلك سيكون ميعادها الجنة لا غير. حتى قيل في بعض العبارات المنسوبة إلى نبي الاسلام: "أيما امرأة باتت وزوجها عنها غير راض لن تشم رائحة الجنة". فالرجل في هذه العبارات ظل الإله وليس شقيق النساء. وبموجب تلك العبارة سيأخذ الرجل صراحة قدراته التاريخية على انزال العقاب بالمرأة. دون سبب، ولا مبرر كاف لخرق سلطة الإنسانية وسلطة الوجود جميعاً. ويبدو التأليه الذكوري بطرف خفي في صمت العبارة. غير أن ايقاع الخوف المعمول به ينقل المتلقي سريعاً إلى الأثر دونما أي استفهام.
وهي عبارة مدمرة لإنسانية المرأة لو أحاطت بها الثقافة وأكملت جوانبها في المجتمعات البشرية. هذا إذا كانت ثمة إنسانية قابلة للتقدير لدى النساء ابتداءً. فضلاً عن كونها تضع الذكر في مرتبة مقدسة. هل هناك اتساق اسلامي في ربط الحياة (دنيا وآخرة) برضى الرجال فقط دون شروط ولا مقدمات؟!
بالطبع ليس المجال مفتوحاً لكيان مستقل أسمه المرأة. والفكرة أيضاً لون من المحاكمة الدينية المؤصلَّة في الخطاب الديني. الغريب هو كونها تنطق بمسمى المتهم (المرأة) بينما الطرف الآخر هو الفاعل (الرجل) وهو أيضاً القاضي (الرجل). ثم ستكون العقوبة ممتدة إلى أقصى نقطة نتوقعها. وكأنَّ الذكر يفرض العقوبة فرضاً لا مناص منه. ولنترقب المعنى الخفيف الآتي متوارياً: أن المرأة إذا أرادت ان تحيا عليها إرضاء زوجها بكل الطبرق والسبل لأن نجاتها في الآخرة مرهونة بذلك رغم أن القدرة لله جميعاً. ذلك بصرف النظر عما يكون هذا الزوج. لأنَّ الله- فيما يعنيه القول ضمناً- سيقف صراحة معه وسيؤيده في جميع أفعاله وسيكون العقاب والثواب كما يريد!!
يجب ألا نغفل أن الذكورية تعلن مآربها بطريقتين مزدوجتين متواطئتين مع قوى المجتمع. فهي أولاً تعتبر الأنثى كتله حية من الرغبات المشتهاة. لترسمها وتشكلها كيفما تشاء. وفي عين الوقت ثانياً هي التي تعطيها وجودها الاجتماعي والمعرفي في صورة امرأة. حتى قيل إن المرأة آتية من المرء، الفرد. وهذ يحمل بعضاً من تدخل الذكر في حيوانية الأنثى وانسانيتها من عدمها. فالكلمة هذه لباس اجتماعي ثقافي فوق ما يغطيها من شعرها إلى أخمص قدميها. والفقهاء لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة، شاردة ولا واردة بجسد الأنثى إلاَّ ووضعوا لها ضوابط ومحاذير وأحكاماً ونواهٍ.
لو أفسحنا الستار قليلاً، فالمخدة ليست كيساً من قماش محشوا بالإسفنج أو القطن أو القش. هي حشو ثقافي معرفي تحت رأس ذكور العرب منذ الجاهلية إلى الآن. وفي هذا يبدو أن القرطبي يسمي شيئاً ما مقصوداً، ليس هو الكيان الأنثوي المختلف، لكنه يترك اللغة تتسع بما تتوقف عن الانتشار. إنها تكتب عباراتها كما لو كانت ومازالت تُكتب من قبل، أي تواصل الهدير الثقافي منذ فترة. وفي نفس الوقت لا تصدم القراء إلاَّ بحدة الألفاظ. تعرفهم كيف هم يفكرون الآن في حدود زوجاتهم. وما هي تربة الثقافة الدينية المترسبة في تصوراتهم اليومية.
إن كل إشارة نحو الماضي تضرب موعداً مع المستقبل. لذلك لم يكن المفسرون ساذجين عندما يأخذون هذه التوجهات الذكورية. وسواء اعتقدوا بصحة الدين لديها أم لم يعتقدوا، فلقد اُعتمدت ثقافياً كمسكوكات عقلية أضيفت إلى جسد الأنثى. ما من أنثى تمشي في سياق اجتماعي (لا أقول يومي) حتى تحوطها نظرات التوجس والريبة (تتطلع إليها العيون كما يقول القرطبي).
ولنلاحظ أنَّ الشيء الكامن في كلمات العنوان هو سلطة الجنس. وهي فكرة سحيقة التأثير في أدمغة البشر بكل تقلباتهم البدائية والقبلية والدموية أيضاً. والقرطبي كمفسر له سلطتان: سلطة المقدس وسلطة النظام الرمزي (= الثقافة). وإذا كان التفسير تأويلاً لنص القرآن، فالمفردات- المقولات- تستحضر كامل التراث. هذا المعبر عن منطق التهميش الفكري والاجتماعي مع المرأة. وعندما يصفها بهكذا أوصاف فإنه يحسم قضاياً كثيرة، ليس أقلها صناعة سياج من التحريمات حول خصرها وعقلها وكيانها الاجتماعي. ذلك كي يضمن ترويضها وجعلها طوع الذكر.
د. سامي عبد العال