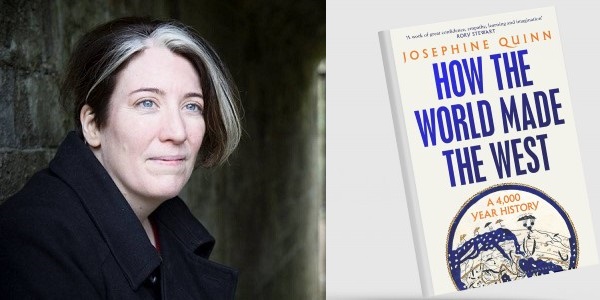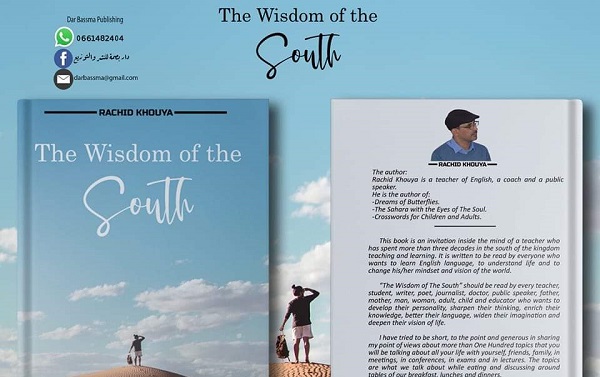صحيفة المثقف
محمد لمعمر: ما المواطنة؟.. دومنيك شنابر وكريستيان باشولييه

الومضة الأولى: استهلال
يمثل الباحثان دومنيك شنابر وكريستيان باشولييه امتدادا نوعيا للمفكرين الحقوقيين الذين عملوا على القيام بحفر جينيالوجي لمفهوم المواطنة، بحيث فككا مفهوم المواطنة، بوضعها في سياقها التاريخي، ووصلها بالفكر الديموقراطي الحديث المميز للحداثة السياسية والقانونية. فأسسا قولا حول أصول وأسس المواطنة، ومبادئ الحداثة السياسية والفردانية الديموقراطية، حيث الربط الجدلي بين التقدم الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي والقانون وميلاد الحداثة السياسية كفكر وممارسة، حداثة معبرة عن قوة العقل، في انتشال النفوس الآدمية من عالم الاحتراب والصراع إلى عالم التعايش والمواطنة العالمية. فالدعوة إلى إرساء ثقافة المواطنة يتطلب من وجهة نظر الباحثان ديموقراطية تربوية وتعليما ناجعا وفعالا، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الوضعيات التي يوجد عليها المواطن، وضعية يجب بالضرورة أن تكون موشومة بالوعي والإرادة والقدرة على الاختيار، في أفق تعزيز ثقافة الانتماء. فالديموقراطية والمواطنة وحقوق الانسان بمختلف اشكالها، تشكل وحدة منسجمة ومتكاملة لا تقبل التجزيء، وتلك نظيمة فكرهما وأنسوجة نظرهما، حيث الرؤية العميقة في الطرح والمعالجة، والميل إلى التريث وعدم التسرع في إصدار الأحكام وتوزيع الفهومات، منبهان، إلى أن المواطنة ليس مجرد أحلام طوباوية من فعل المخيلة، ولكنها ممارسة واقعية معها يتبدى الفعل والسلوك والتصرف وحيازة الحقوق في العالم المعيش، كالحق في التنقل والتعبير الحر عن الرأي، بدون قمع أو تعذيب أو تعنيف أو اعتقال. تعزز ذلك بالحقوق الذاتية كالحق في السكن، والحق في السعادة.
إن الباحثان يتقمصان دور الرائي الذي يستشرف مسار وصيرورة المواطنة من الاغريق إلى الأزمنة الحديثة، مؤكدان على أن المواطنة رغم تأسيسها على مبادئ الديموقراطية، إلا أنها سهلة الانعطاب بسبب غباء نظام سياسي، وظلم استبداد حاكم. معنى ذلك؛ أن المواطنة معرضة لعدة شوائب، وأمامها غياهب وغياهم ومهامه، تمس جذورها نتيجة أفعال لا إنسانية، كالعنصرية والعنف، لذلك، فالمواطنة لا تتأسس على فكر ماضوي مضى، ولا على الخيالي والطوباوي، وإنما على فكر واقعي، مؤسس على صخور صلبة، وليس على رمال هشة ومتحركة، مع ضرورة تجذير ثقافة المواطنة في المقررات التعلمية وصياغة القوانين الصارمة، والتعاقدات المعقولة، الخالية من الميولات الإيديولوجية النفعية.
وكأني بالباحثان يلهجان بضرورة إرساء دعائم ثقافة ديموقراطية حقانية تؤمن بالتعددية السياسية، وتحفظ الكرامة الإنسانية، وتنهل من فكر التسامح الأسس والمبادئ. وتحقيق ذلك، يتطلب الجمع بين تربية واعية وسلطة حاكمة وعادلة، وقوانين تحقق المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص. وعليه، فصاحبا الكتاب- قيد الدراسة- أسسا رؤيتهما بالانفتاح على روافد معرفية متعددة، كالانفتاح على علم السياسية والفكر الفلسفي النقدي خاصة مع الماركسية، والمقاربة الاجتماعية خاصة مع اميل دوركايم، لفهم عمق ثنائية الأفراد والمجتمع. بهدف تعميق النظر حول المواطنة كمفهوم مركزي في أطروحتهما مستحضران المفاهيم المجاورة والضرورية كالسياسة، والحقوق، والدولة، والديموقراطية، والمجتمع، والأفراد، والأمة، والتعددية الثقافية.
فما أحوجنا نحن العرب والمسلمين إلى أطروحة الكتاب حول مفهوم المواطنة، خصوصا في زمن التوترات السياسية، وبروز الطائفية والعشائرية خاصة في العراق ولبنان واليمن، والاعتقالات اللاقانونية لرجال الصحافة، وتلفيق التهم المجانية والتشهير بمن يخالف السلطوية سياستها، فمن الواجب إعادة النظر في مفهوم المواطنة. ولا عيب في ذلك، مادام الحديث عنها يدخل في باب المتاح للبشرية بلغة عبد الله العروي، ولأننا لسنا بدعا من الأمم والشعوب والحضارات، فمن حق العقل العربي أن يؤسس قولا حول المواطنة يتماشى والهوية والتاريخ والواقع، شريطة عدم الانغلاق على مفهوم الهوية، وفي نفس الوقت يكون منفتحا على الكوني والعالمي، لخلق منظومة فكرية عربية، لترسيخ ماهية الحقوق وكينونة المواطنة. نحتاج إلى التفكير الحقوقي الجماعي في أسس وشروط ومقومات المواطنة المغربية في ظل أزمة كوفيد 19، حيث صار الحق في الحياة مقدم وبقوة على جميع الحقوق، ففهم المواطنة لحظة تاريخية للوقوف على أعطابنا وأمراضنا الاجتماعية والسياسية والحقوقية والقانونية، والوعي العميق بعلاقة الدولة بالمواطن، والمواطنة بالتراث، والعلمانية بالمواطنة، والمواطنة وجدل الدين والدولة، الدين والسياسة.
الومضة الثانية: ماذا عن الكتاب؟
إن الناظر الممعن في كتاب ما المواطنة؟ يلف نفسه أمام كنز سياسي وحقوقي من 365 صفحة مقسم إلى أربعة فصول كبرى، خصص الفصل الأول للحديث عن الحداثة السياسية في الزمن الحديث وعلاقتها بالمواطنة، والفصل الثاني تطرق لأهم الانتقادات التي وجهت للثورة الفرنسية والفكر الثوري المتطلع لبناء المواطنة على مبدأ سيادة الفرد واستقلاله فكرا وعملا، على حساب المجتمع. بينما الفصل الثالث عالج مسألة المؤسسات الضامنة للمواطنة، وقضية الدولة الحامية ومسألة الشرعية السياسية وأصل السلطات. والفصل الرابع تم فيه النظر لمسألة الفردانية الديموقراطية. وكيف أن تضخم الحقوق الفردانية، يؤدي إلى إعادة ترتيب دور المؤسسات وتفكك الروابط الاجتماعية. وأخيرا الفصل الخامس الذي اثار قضية المواطنة في علاقتها بالأمة والحقوق الثقافية للفرد والجماعة. لهذه المعطيات يمكن القول إن الباحثان حاولا معالجة القضايا الآنية:
- في الأزمنة الحديثة صارت الأمة هي مصدر السلطات، ومعها تجذرت المواطنة فكرا وحقوقا وحريات. فمبدأ الشرعية السياسية مستمد من الأمة عن طريق الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية، بهدف ترسيخ مواطنة على أسس قانونية وعقلية وتعاقدية، بعيدا عن شوائب الطائفية والعشائرية.
- المواطنة الحديثة تتأسس على ضرورة حياد الدولة تجاه الطوائف والمعتقدات الدينية، فالمواطنة تنبني على مبادئ لا دينية ولا عرقية. خصوصا وأن المواطنة أنواع متعددة، فهناك المواطنة الإنجليزية التي تختلف عن المواطنة الفرنسية، اختلاف الديموقراطية التعددية عن الديموقراطية الأحادية، واختلاف الشروط والظروف الاجتماعية والتاريخية ومكانة التراث الموروث، وعلاقة الفرد بالمجتمع.
- جذور المواطنة فلسفي حيث النقاش حول أصل الحقوق، طبيعية أم تعاقدية، بموجب ذلك صارت المواطنة حقوق وواجبات وانفتاح المواطنين على بعضهم البعض، لذلك، يتم الحذر الشديد من الفردانية المتطرفة التي هي بنت الثورة الفرنسية.
- المواطنة تتجلى في الديموقراطية التمثيلية والمؤسسات السياسية والاجتماعية، والحقوق الثقافية، ووجود الدولة الحامية، والقوانين العادلة الضامنة لحق كل مواطن في التصويت والاختيار الحر. مع ضرورة الفصل التام بين السلط، تبعا لنظرية مونتسكيو.
لا شك أن المقاربة المنهجية ضرورية لفهم المحتوى الفكري والمضمون المعرفي لأي عمل، والكشف عن المسالك المنطقية التي طبقت في الكتاب وعبر مختلف الفصول، ومن يقرأ الكتاب بوعي وتبصر، يجد نفسه أمام كتابة شديدة الاتساق، عظيمة التنسيق، تفكيكها يتطلب التوسل برؤية معينة للكشف عن المعاني والدلالات الثاوية خلف الألفاظ، حيث يظهر الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي والشواهد التاريخية الكثيرة من الإغريق إلى العصور الحديثة، لتدعيم الرؤية وتقوية التصور، ولا شك في ذلك، لأن قضية المواطنة مشوبة بشوائب التبدل والتغير، توسيما واعتبارا واستشكالا. لذلك، فتفكيك المواطنة يتطلب التوسل بمقاربات فلسفية واجتماعية وسياسية، ولا نبتذل القول هنا، إن قلنا إن الباحثان نهلا من العلوم الرياضية بعض القواعد وعملا على تطبيقها تصريحا وتلميحان مثل الاستنباط الفرضي، الذي يتجلى في الانتقال من العام إلى الخاص، فهما يفككان المواطنة بشكل تدريجي ليصلا إلى إثبات فكرة تتجلى في ضرورة وجود ديموقراطية سياسية ودولة حامية وثقافة قانونية رصينة. وعليه، فالرؤية المنهجية يمكن تقسيمها إلى عدة ابعاد:
1-البعد الفلسفي- الاجتماعي، يتمثل في الحضور المكثف لمجموعة من المفاهيم الفلسفية والاجتماعية، كالحرية والحداثة والمجتمع والدولة والأفراد والمواطن... في أفق فك الاشتباك بينها.
2-البعد النقدي: (الهدم والتقويض)، يتبدى ذلك في عرضهما للنقد الماركسي حول الدولة البرجوازية، المستغلة للدولة والعمال، وعلاقة ذلك بنشوء المواطنة البرجوازية حيث التمييز بين من يملك ومن لا يملك، وعدم إحداث تماهي بين العامل والمواطن. فماهي انعكاسات الحداثة السياسية على مفهوم المواطنة في الأزمنة الحديثة؟ وما هي أسس ومبادئ الشرعية السياسية والمواطنة؟ وما مصدر السلطات؟ الملك كذات مستقلة أم سلطة لاهوتية أم مجموع المواطنين؟ وإذا كانت المواطنة تتحدد بثنائية الحق والواجب، فماهية ضمانة حيازة المواطنين لحقوقهم؟ وما الروابط بين المواطنة والدولة والديموقراطية والأفراد والمجتمع؟ وهل المواطنة كفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات الذات المستقلة ومطلب الاندماج في المجتمع احترام الفضاء العام؟ وماهي انعكاسات الفردانية الديموقراطية على المؤسسات التقليدية والقوانين العامة والحقوق الثقافية؟
فخذ بنا إلى المضامين الفكرية والمحتويات المعرفية.
المحور الأول: الحداثة السياسية، والأراضي البكر للمواطنة
يتحدث الفصل الأول عن الحداثة السياسية التي هي سمة الأزمنة الحديثة، بعبارة هيغل، حداثة تجلت في التغيرات السياسية والاجتماعية والحقوقية، التي رافقت الثورة الأمريكية حيث ميلاد الديموقراطية التمثيلية، والثورة الفرنسية التي أحدثت تغييرا بموجبه تم التمييز بين العصر القديم والحديث، رغم استمرارية حضور القديم في الحديث، فنشأة الحداثة أفضت إلى تشكل مجتمع جديد، سمته، المواطن والمواطنة. هذه الاخيرة صارت هي أساس ومناط الشرعية السياسية، تنظيرا وعملا، تبدى ذلك في المادة الثالثة من إعلان حقوق الانسان، حيث الأمة هي مصدر كل سلطة [1]. ففي في السابق خاصة في العصور الوسطى كانت السلطة تستمد من شخص الملك، كذات مطلقة في مقابل الشعب أو الجمهور الذي هو عبارة عن موضوع، هذا المنطق تبدل وتغير ببزوغ الفجر الرائع لشمس الحداثة السياسية.
صارت الأمة هي مصدر السلطة، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، ما هو إلا شعارات لترسيخ مبدأ سيادة الشعب، وأنه مصدر السلطات، حيث أصبح بالإمكان أن يعبر الشعب عن حريته وحقوقه، ويحتج على الظلم الذي يتعرض له، ويصوغ العرائض للمطالبة بحقه، فالحداثة السياسية إعلان عن ميلاد جديد لجملة من المفاهيم السياسية، كالمواطن والمواطنة، والشعب، وتجذير الدور المركزي للشعب باعتباره أصل ومنبع السلطة، رغم ميل بعض الأنظمة إلى المحافظة عن سلطتها التقليدية، وجعل الممارسة السياسية للسلطة من صميم عمل الحكومة. (لا يوجد دستور وإنما حكومة... فكل سلطة مصدرها الأمة... وكل السلطات مصدرها الشعب) [2].
إن الحداثة السياسية أدت الى إعادة النظر في طبيعة الحياة السياسية، فأساس الشرعية ليس الملك أو سلطة متعالية بعيدة عن الانسان، وانما أساسها الفرد، الأمر الذي افضى إلى نقاشات سياسية حادة وعميقة حول أصل السلطة. هل مصدرها الفرد المستقل أم الملك كمصدر تقليدي لكل سلطة أم أن مصدرها مجموع الأفراد؟ وما مكانة مفهوم المواطنة من كل تلك التغيرات؟
يؤكد الباحثان أنه رغم ظهور مفهوم المواطن كفاعل سياسي واجتماعي مشارك في إدارة الشأن العام، الا أن ميراث الملكية لم يختفي من الحياة السياسية، خصوصا في ظل إعادة تأسيس الهيئات السياسية عام 1789، وجعلها مستقلة في عملها، وترسيخ عملها عن طريق منهج سياسي محكم وممنهج، معنى ذلك أن العالم السياسي الجديد جعل الملوك في أوروبا خاصة في فرنسا، يعيدون ترتيب علاقة الإداري بالسياسي عن طريق تدعيم فكرة استقلالية الهيئة السياسية، بعيدا عن شخص الملك، بما في ذلك ضرب عرض الحائط امتيازات كبار الاقطاعيين و وسطوة الكنيسة[3]. وما ساعد على ذلك تأسيس رجال القانون لهيئتي الملك، وهي هيئة مستوحاة من التركيبة الوجودية للسيد المسيح، وبموجبها يقال بحق الملوك الإلهي، هذه التصورات خضعت لنقاش عميق وتم تجاوزها، بناء على شعار: مات الملك، يحيا الملك، غير أن الملك أقر استمرارية تلك الهيئة، وفي هذه الحالة فمصدر السلطة هو الملك، تصورات لم تعد مؤثرة في زمن الثورات والحداثة السياسية، التي أدت إلى تغيرات جذرية على مستوى الفهم والممارسة، وإعادة توطين مفهومي المواطن والمواطنة، وفق أسس سياسية جديدة.
الأمة/ الشعب/ مجموع المواطنين هي مصدر السلطة، ذلك هو شعار الحداثة السياسية وما ترتب عنه من ممارسات سياسية كتجاوز المصالح الخاصة، بحيث لم يعد المواطنين مجرد أفراد ملموسين متسمين بأصولهم التاريخية ومعتقداتهم الدينية وانتماءاتهم الاجتماعية، والتي تحدث التمايز والتفاضل في بعض الأحيان، وإنما أصبحوا مواطنين متساوين في المواطنة. هذه الأخيرة هي المبدأ الذي ينصهر فيه الكل، إنها المساواة المدنية والقانونية والسياسية، فالمواطن ليس ذات منغلقة ومتمركزة على ذاتها، وإنما ذات منفتحة داخل في علاقات تواصل مع الأخرين. انتماءه لفضاء اجتماعي ليس على أساس العرق أو الدين أو التاريخ وإنما المواطنة [4]. فالمواطن له خصائصه وخصوصيته التي تميزه، لكنه أيضا مندمج في المجتمع، غايته تكوين مجتمع المواطنين، في أفق بناء حياة سياسية واجتماعية وحقوقية مشتركة.
المواطنة الحديثة مرتبطة بالنظام الاجتماعي الجديد، الذي هو الأخر انعكاس للنظام السياسي، والمحدد سياسيا بمجموع المواطنين الذين يكونونه، معنى ذلك، أن ثنائية الخاص/ حياة المواطن الخاصة، والعام/ المجتمع، صارت الميسم البارز للحداثة السياسية وللمواطنة كفعل جماعي، وكل حديث عن المواطن في ثوبه السياسي والحقوقي يقتضي بالضرورة الحديث عن ثنائية الخاص والعام، علما أن الخاص يشير إلى حرية الأفراد في حالة اختلاف، بينما العام فهو التساوي في حقوق المواطنين [5]. بدون تفضيل أو تمييز، فجميع المصالح كانت تابعة للمصالح الخاصة، وفي ذلك انغماس في ذاتية الانسان، واعتبار الذاتية أساس الحق والفعل والحركة وبموجبه، نال بعض المواطنين حقوقهم بوصفهم مواطنين وحرمت البقية من ذلك، لكون بعض ليسوا مواطني المواطنة التامة، لأن المواطنة محددة بالمواطنين النشطاء، وعلى الجميع أن يبذل جهدا عقليا واجتماعيا للوصول إلى المواطنة وحيازتها حقيقة لا وهما [6]. فماذا عن الشخص الغير القادر على الوصول إلى درجة المواطنين النشطاء؟ هل تسلب منه المواطنة؟ وما علاقة ذلك بالشرعية السياسية؟
1- المواطنة والشرعية السياسية
إن مبدأ الشرعية السياسية مستمد من الامة ومن الشعب ومجموع المواطنين النشطاء، وهو مبدأ رسخ ضرورة الفصل بين الكنيسة/الدين والسلطة السياسية، أو ما يمكن الاصطلاح عليه بالفصل بين السلطتين الروحية ممثلة في الكنيسة، والزمنية المتجلية في الدولة، فصل تم نتيجة قيام البشر بتأسيس وتنظيم أنفسهم كسلطة سياسية، وصاروا مصدر السلطة لا الكنيسة[7]، علما أن مبدأ فصل الكنيسة عن الدولة ليس جديدا هنا، فقد سبق لجون لوك أن قال بذلك داعيا إلى جعل الدولة محايدة بغاية ترسيخ ثقافة التسامح حيال جميع الأديان والمعتقدات، والخروج من عالم الاحتراب والتقاتل حول من يملك الحقيقة الدينية والدخول إلى عالم الاحترام والتسامح واستضافة الأخر في الوجود. فالمواطنة تقتضي توطيد دعائم ثقافة التسامح والحوار والايمان بالاختلاف، وفصل الكنيسة/ الدين عن الدولة، والاحتكام إلى العقل لا على المعتقدات الدينية التي تؤدي على الاحتراب، وادعاء حيازة الحقيقة والفهم الصحيح لقضايا الدين.
أساس المواطنة الحديثة يجد نقطة ارتكازه في حياد الدولة تجاه جميع الطوائف والمعتقدات الدينية، بغية خلق عالم التسامح، وعليه فمبدأ فصل الكنيسة/ الدين عن الدولة، يعني في الصميم حديث عن ثنائية الديني والسياسي، ثنائية تشي بوجود واقع مريب موشوم بتداخل الديني والسياسي في أفق إعادة تنظيم الحقل الديني بتنظيم الكنائس/ الدين، وتحديد أدوراها الدينية والدعوية والأخلاقية وإبعادها عن السياسية، هذه الأمور ضرورية (لإدارة المجتمع الديموقراطي) [8]. ولا شك أن الحداثة السياسية لعبت دورا كبيرا في التأسيس لمواطنة حديثة، لأنها خطاب فكري عقلاني غايته الفصل بين النظامين الديني والسياسي. لكن، هل يستطيع الأفراد الذين لا يتأطرون ضمن دين واحد أو أكثر، الاجتماع وتنظيم وجودهم السياسي والاجتماعي والحقوقي بناء على أسس أخرى غير الدين؟ علما أن الدين في جوهره وسيلة لخلق روابط عقدية وأخلاقية تمتد إلى ما هو اجتماعي؟ بمعنى أخر أكثر وضوحا، هل يمكن قيام المواطنة على أسس لا دينية ولا لاهوتية؟
إن التساؤلات السابقة مرتبطة بالإقرار بسيادة المواطن، ومدى قدرة الأفراد على تحقيق المواءمة بين الاستقلال الذاتي للفرد والفروض والالتزامات الجماعية، خصوصا في ظل الضغوط الجديدة الملتصقة بالمجتمع الحديث، حيث كانت المناداة بتحرر الفرد. وهناك توجه ثان يرى بضرورة تقوية الجبهة الاجتماعية والجمعية لمواجهة المخاطر الناتجة عن ازدهار استقلالية الفرد لتدعيم الأعراف الاجتماعية وتماسك المجتمع [9]. نقاش سياسي عميق تم داخل المجالس الثورية ووفق حلقات (حيث تمحورت الأولى حول حقوق الانسان والمواطن أو بعبارة أخرى حول الحقوق الطبيعية والسياسية، والثانية الحقوق والواجبات. أما الثالثة، فدارت حول تنظيم المؤسسات السياسية والتمثيل) [10].
الاقتصار على القول باستقلالية الفرد، لإنشاء قول حول المواطنة، معناه، الانتصار للحقوق الطبيعية السابقة عن الوجود الاجتماعي المنظم بالقوانين، وذلك هو موقف أنصار الحق الطبيعي كجون لوك، وبالنسبة لهم الطبيعي يسبق المدني إلى درجة القول بأن حقوق المواطن تستنبط من حقوق الانسان باعتباره بشرا. وعلى الضد من ذلك يرى أنصار الحق المدني أن الحقوق الطبيعية هي النتيجة المترتبة منطقيا على الحقوق المدنية [11]. فالمسألة هنا، دائرة حول التأسيس والأسبقية، هل الطبيعي سابق عن المدني ويجب التأسيس عليه أم العكس؟ والملاحظ، أن مفهوم المواطنة أفضى إلى الحديث عن مفهوم المواطن الذي هو بالضرورة ذات طبيعية يجب التفكير فيها أولا، وذلك بمعرفة حقوقها الطبيعية التي كانت تتمتع بها قبل بزوغ فجر المجتمع المدني المنظم.
بناء على ما سبق يمكن القول، أن فكرة المواطنة لها جذور فلسفية وسياسية، تمت في إطار نقاش عقلاني حول أصل الحقوق الإنسانية، هنا يرى روسو أن حقوق المواطن هي التي تؤسس حقوق الانسان، بمعنى أن تحديد المواطن كذات طبيعية مندمج داخل المجتمع يؤدي إلى تشكل الحقوق، لأن الانسان لا وجود و لا قيمة له كإنسان، خارج المجتمع، فهذا الأخير هو الذي يمنح للمواطن حقوقه، ويحدد وضعيته السياسية والاجتماعية، عكس انصار القانون الطبيعي، فبتأكيدهم على الأسبقية الانطولوجية للإنسان، على المواطن، يرسخون مبدأ حرية الفرد وأسبقيته على المدني والاجتماعي[12]. بحيث تتقدم المبادئ على التنظيم الاجتماعي للسلطات عكس التيار الذي يقول بالحقوق المدنية والانتصار لفكرة التنظيمات الاجتماعية، وفكرة أن لا حرية بدون قانون يؤطرها. هنا تبرز لدينا مشكلة أخرى، متمثلة في القوانين في حد ذاتها. خاصة القوانين النازية مثلا التي تتنافى مع حقوق الانسان؟ بمعنى أخر، هل كل القوانين يمكن الاستناد عليها لإنشاء فكر سياسي وحقوقي؟ وأيضا ماذا عن اللاجئين والمقيمين بطريقة غير شرعية؟ كيف يتم التعامل معهم؟ هل بناء على مفهوم حقوق الانسان باعتبارهم ذوات إنسانية أم يتم نفيهم وتهميشهم؟ وهل إعلان حقوق الانسان، هو إعلان حول الانسان كإنسان أم إعلان خاص بإنسان معين ومحدد في الزمان والمكان؟
إن السير في اتجاه تحديد حقوق إنسانية محددة لمواطنة يتطلب الايمان بقدرة العقل على صياغة المبادئ التي تحدد الحقوق والواجبات، فلا معنى للحق في غياب الواجب، خصوصا في ظل الدولة المدنية الحديثة، (فكل ما هو حقي، هو أيضا حق للآخر، بحيث لا يمكنني المطالبة لصالحي بما لا يمكنني منحه للآخرين) [13]. إن الواجبات تظهر بشكل تلقائي عند الحديث عن حقوق الانسان، خصوصا وأن مفهوم المواطنة يحيل على انفتاح الفرد على محيطه الاجتماعي، حيث العلاقات المتبادلة مع المواطنين والآخرين. والتي تقتضي بالضرورة معرفة مجال وحدود وكيفية التصرف والانضباط لما هو قانوني، فواجبات كل مواطن مرتبطة بواجبات الآخرين، لذا، يجب توثيق الروابط الاجتماعية، كي لا تتسل الفردانية المتطرفة والمدمرة، مع ترسيخ فكرة أن قيمة المواطن لا تتحدد بمعرفته ونيله لحقوقه، وإنما بإدراكه لواجباته تجاه مجتمعه. وهذا ما أكده دستور 1839 الإنجليزي، حيث التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود بين أعضاء المجتمع، ويجب على هذا الأخير أن يزود المواطنين بالحاجيات الضرورية، وفي ذلك تأكيد على أهمية الحقوق الاجتماعية الناشئة عن مبادئ الحداثة السياسية [14]. وعليه، فأسس المواطنة الحقيقية، حتمية الوعي بثنائية الحق والواجب، وتزويد المواطنين بالوسائل الضرورية كالتعليم والحماية والعمل، على اعتبار الحماية الاجتماعية قضية مهمة، تفترض من حيث المبدأ وجود مؤسسات، لجعل المواطن يمارس سيادته، فبدون المؤسسات يبقى المواطن مجرد فرد صوري مجرد. وهنا تظهر المؤسسات التي تنقل الانسان من وضع الفرد الصوري المنغلق على كينونته إلى وضع المواطن، ومن ثمة ضرورة التساؤل عن كيفية تنظيم عملية الانتقال من الفرد-المواطن إلى تنظيم المؤسسات السياسية؟ فما ألية الانتقال؟
2- القارات الثلاث للحداثة السياسية: المواطن والديموقراطية والمؤسسات السياسية
إن الديموقراطية كنظام سياسي واجتماعي ليست وليدة اليوم وإنما قديمة قدم النظر الإنساني في قضايا الوجود الاجتماعي، غير أنها ديموقراطية مباشرة، متسمة بغياب فكرة توكيل الغير، لأن المواطن كان يعبر ويمارس حقوقه بشكل مباشر، قد يكون هو الحاكم والمحكوم في نفس الآن، بحيث يحدد طبيعة ونوعية العقاب الذي يجب إنزاله على الآخرين [15]. بل حتى اعلان حقوق الانسان أحدث نوعا من التوازي بين الديموقراطية التمثيلية والنسق السياسي داخل المجتمع. (وأن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة. لكل المواطنين الحق في أن يساهموا بشخوصهم أو بمن يمثلونه في صياغته) [16]. فالغاية من الديموقراطية التمثيلية تحقيق الانسجام والتوازي بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع، شريطة أن تكون القوانين واحدة وتسري على الجميع حماية وعقابا. هذا الانتقال من وضع الفرد- المواطن إلى وضع المؤسسات السياسية، تطلب جملة من التحولات السياسية والاجتماعية، والقانونية بالخصوص، لأن المؤسسة هي التي تسهر على تطبيق القانون وضمان سريانه لتوزيع الحقوق بشكل عادل ومتساو. وتلك هي سمات الحداثة السياسية التي ابتكرت فكرة التفويض والتمثيل، وأصبحت الجمهورية بموجبها نظاما سياسيا.
الديموقراطيون ابتكروا المؤسسات السياسية الضامنة لحق التمثيل كالانتخابات والبرلمان، فأصبح هناك من يمثل المواطنين مؤسساتيا، ولم يعد من المنطقي أن يأخذ الفرد حقه بيده، وإنما عن طريق من فوض له فعل ذلك مؤسساتيا وقانونيا. فالتفويض ألية ديموقراطية تمثيلية تقتضي من الفاعل السياسي عدم الانفصال عن الشعب، وضرورة البقاء على مقربة من الناخبين [17]. من أجل النقاش حول الصالح العام، هذا النقاش الشعبي هو الذي نقل الأمريكيون خلال عشر سنوات من الديموقراطية المباشرة التي مارسها الإغريق إلى الديموقراطية التمثيلية، وهو في الحقيقة انتقال من فكر العصور القديمة إلى عالم الحداثة السياسية التي هي بنت الأزمنة الحديثة. عكس فرنسا حيث وجدت صعوبات في عملية الانتقال من سيادة الفرد الذي اعتبر منبع الشرعية السياسية إلى تنظيم المؤسسات السياسية التمثيلية [18].
إن الديموقراطية التمثيلية، ألية سياسية لمأسسة العمل السياسي وعقلنته، رغم الصعوبات التي تعترضها والمتمثلة في عدم استيعاب بعض الثوار للتمييز الحاصل بين الحكومة والمجتمع، تمييز يشكل لبنة أساسية للنظام الديموقراطي الموجب للمواطنة الجماعية، فقد صارت السيادة للشعب وتلك هي قمة المواطنة. بمعنى أن الديموقراطية التمثيلية التي كانت في السابق مجرد فكرة فلسفية تمظهرت حديثا في الإرادة العامة لدى روسو. فقد كان هناك خلط واضح بين عمل الحكومة والمجالس النيابية المنتخبة مباشرة من الشعب، والتي أدت إلى شخصنة السلطة. لكن، دوام الحال من المحال، فقد تبدل ذلك الوضع السياسي وصارت الطاعة والولاء للقوانين، وعدم الانصياع لشخص بعينه. فحوى ذلك، إن ترسيخ المواطنة الحقة يتطلب وجود سلطة تستمد شرعيتها من الشعب كمواطنين قادرين على اختيار من يمثلهم في المجالس النيابية، ووجود قوانين من الواجب على الجميع الالتزام بها، فكل الأنظمة السياسية بما في ذلك الليبرالية عندما تشخصن السلطة تصبح هشة ومعرضة للزوال، وقد عصفت بأكثرها الثورات بسهولة وخير مثال على ذلك الملكية في فرنسا. فالنظام التمثيلي الحقيقي هو الكفيل بتوطيد دعائم المجتمع المؤسساتي في أفق ترسيخ المواطنة، فكرا وممارسة، وفي ذلك تجاوز للمجتمعات القائمة على الحكم الذاتي الفردي، حيث الملك أو من يمثله هو المصدر الوحيد للسلطة [19].
الحداثة السياسية المتجلية في الديموقراطية التمثيلية أحدثت توازنا بين إرادة المواطنين في الاختيار والمطالبة بالحقوق، وبين (ضرورة تنظيم المؤسسات السياسية لإدارة المجتمعات المعقدة) [20]. فالمواطنة الحقة هي سمة المجتمع السياسي الحديث، حيث المساواة وتمثيل الشعب بجميع طوائفه وفئاته، مادامت الديموقراطية التمثيلية هي أداة جعل المؤسسات السياسية مرآة المجتمع الحديث، وهنا نتساءل: هل الديموقراطية التمثيلية نظام سياسي واقعي تبدى في المجتمعات الحديثة أم أنه مجرد فكر سياسي صوري وطوباوي؟ وما علاقة الديموقراطية التمثيلية بمفهومي المواطن والمواطنة؟
3- المواطنة والديموقراطية التمثيلية
إن المواطنة مرتبطة بوجود نظام سياسي معين، موشوم بالديموقراطية التمثيلية حيث يصير الشعب هو مصدر السلطات والفصل والتوازن بينها، وفق تصور مونتسكيو ووجود الإرادة العامة من خلال انصهار الفرد والمجتمع. وهنا يمكن أن نستحضر نموذجين للمواطن: المواطن على الطريقة الإنجليزية، والمواطن وفق الطريقة الفرنسية.
الطريقة الإنجليزية تنبني على فكرة التعددية السياسية وفتح المجال للأنظمة والهيئات والطبقات والجماعات الخاصة لمواجهة النزعة الأحادية التي تعلي من شأن المواطن الفرد والمفروضة بالعنف في فرنسا. فالديموقراطية الليبرالية أشكال وأنواع والمواطنة أحد مياسمها، التي تعكس خصائصها الجوهري التي تميزها [21]. النموذج الإنجليزي يتأسس على ضرورة احترام تنوع الانتماءات والارتباطات الخاصة، التي نص عليها الميثاق الأعظم سنة 1215 حيث الحرص على مراقبة عمل الملك نفسه من قبل وفد من البارونات لمعرفة مدى التزامه بالتعهدات [22]. وفي ذلك تأكيد على أهمية الرقابة الشعبية/ المواطنة بمعنى أوضح، أن الملك ليس له صلاحية مطلقة، وإنما مراقب من طرف البارونات، الذين يفرضون شروطا على الملك، والتي تعد إعلانا عن نهاية الاستبداد الملكي، وترجيح كفة البرلمان. فسيادة الملك صارت مؤطرة ومحدودة بحقوق البرلمان، وهي ممارسة سياسية سمحت بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية كبرى، حيث إقامة المؤسسات الديموقراطية السياسية والتمثيلية، لزيادة ترسيخ المواطنة، ودعم تماسك النسيج الاجتماعي [23].
يعتبر الباحثان أن المواطنة تقتضي دمقرطة النظام البرلماني بالتدريج، ومنح حق التصويت لفئات جديدة وبمراقبة الشعب، حيث انتقلت السلطة من الهيئات التي توارثها الملك ومجلس اللوردات إلى مجلس عموم المواطنين، فتحول البرلمان وفق الديموقراطية التمثيلية إلى مكان لتأسيس الحريات وقيم المواطنة الحقة والتعبير عنها قانونيا، بدون اللجوء إلى الثورة، وهي المبادئ والمتغيرات التي استحسنها العقل السياسي الأوروبي الحديث القائم على فكرة الضوابط والتوازنات والمكابح، خاصة في بريطانيا، توازن بين سلطة الملك وسلطة البرلمان، بين الملك والشعب، وهو ما سماه دفيد هيوم بالميزان العادل بين جزأي الدستور الملكي والجمهوري[24].
وما يميز التجربة السياسية الإنجليزية في علاقتها بمفهوم المواطنة، سيادة القانون العام ووجود محاكم العدالة العليا وتكييف القانون ليتماشى مع الحالات الخاصة والاستثنائية لمسايرة الوقائع الاجتماعية والسياسية الطارئة، والتي تقتضي رؤية قانونية جديدة، وهو ما يفسر توجس رجال القانون من القواعد القانونية المستمدة من القانون الروماني العام والمجرد، وتلك ميزة الديموقراطية التمثيلية الانجليزية حيث ابتكار سلطات ناشئة ومضادة للقوى السياسية الرسمية والمؤسساتية لخلق التوازنات، وكبح جماح السلطات التقليدية كي لا تتحول إلى تعسف وشطط، وهو ما اوجب ضرورة احترام تنوع الانتماءات والارتباطات الخاصة، وترسيخ ثقافة المواطنة في جميع الفضاءات الاجتماعية والتربوية، علما أن للإنسان ميول سياسية تبدأ من الأسرة، لأن للروابط العائلية دور في توطيد العمل وحب الوطن وغرس قيم ومبادئ المواطنة لدى الناشئة، ومن الأسرة إلى الجيران إلى العلاقات الاجتماعية الشخصية الممتدة في المكان[25].
فالنموذج الإنجليزي يجد أساسه في فكر جون لوك ومونتسكيو، حيث تتبدى الحداثة السياسية الموجبة لضرورة حياد الدولة الديني، وأن مبدأ التسامح تجاه العقائد هو الذي يسمح بالتعايش بين مختلف الأديان والمعتقدات. ويضفي على الروابط الاجتماعية شيئا من التماسك. لذلك، تم اضفاء الشرعية على تعدد العقائد وبالنسبة لمونتسكيو المعجب بالتقليد الإنجليزي، يرى أن دستور الانجليز يضمن حرية البشر، ليس لكونهم قادرون على فعل ما يرغبون، ولكن، لأن لهم حق عمل كل ما تسمح به القوانين [26].
بينما النموذج الفرنسي يتسم بسيادة المواطن كفرد ظهر في المجال السياسي عن طريق الثورات التي تحولت إلى عنف. سيادة المواطن المستقل المستلهم من روح فكر روسو، حيث اعتبار التبعية للبشر مصدر لعدم تحقق المساواة وأن وجود أية هيئة وسطى بين الفرد والدولة، يفضي إلى التعسف وعدم جعل الفرد يستمتع بحريته، فالمواطن هو التعبير المباشر عن الإرادة العامة، بمعنى أنه حر ومستقل ومتحرر من الروابط والوسائط التي تجعله خاضعا للدولة، عكس بريطانيا. لذا، فالنموذج الفرنسي يعبر عن الديموقراطية الأحادية المناهضة للتعددية، فمصلحة المواطن لا تتماهى مع المصلحة العامة، وأن هذه الأخيرة ليست نتاج مصالح جميع الأفراد الحقيقيين، الأمر الذي ينعكس على مفهوم المواطنة [27]. (التي هي كيان غير قابل للتقسيم، يجب تنظيمها وضمانها بواسطة دولة مركزية تعبر عن الإرادة العامة التي توجد المجتمع) [28].
وعليه، فالمواطنة، ليست مجرد تصورات طوباوية لا تبرح مملكة الذهن، وإنما هي ممارسة واقعية، مرتبطة بتجربة سياسية لمجتمع ما، تتجلى المواطنة في الحرية التي هي احترام القوانين المفضية لاحترام الأشخاص، وضمانة ذلك، ضرورة الفصل بين السلط والحرص على توزيعها بشكل عادل، وعدم فعل ذلك، معناه، ظهور التعسف والاستقلال والمغالاة أو الشطط في استعمال السلطة. وكل سلطة يجب أن تتوفر على الأليات والوسائل القانونية الضرورية لعملها ومجال اشتغالها، فمثلا، يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة تماما عن باقي السلط، وأن التوازن بين السلط يتفق مع الروح العامة لأمة ما، وتلك هي نظرية توازن السلط والتعددية المنظمة. بحيث لم يعد العنف كقوة فيزيائية إلى جانب معطيات طبيعية أخرى هما أساس السلطة الشرعية، وإنما عن طريق الاتفاق كميثاق اجتماعي [29]. لكن، هل تم قبول هذه التصورات بشكل مطلق من طرف الفكر الثوري أم أن هناك انتقادات؟
المحور الثاني: المواطنة، وجدل الفرد والمجتمع والدولة الحامية
عالجا الباحثان في الفصل الثاني مسألة الانتقادات، التي رافقت اعلان سيادة المواطن، والتي طرحت مشكلات على مستوى تنظيم السلطات، فالقول بأن الأمة هي مصدر السلطة، معناه، أن الشرعية السياسية الحديثة عملت على زحزحة وخلخلت جميع التصورات التاريخية والدينية والاجتماعية التي كانت سمة المواطن الفرد، لأن المجتمع القائم على المواطنة والمساواة المدنية والقانونية يتعارض مع بعض المبادئ التاريخية والدينية والتي تتطلب معطيات أخرى للحديث عن المواطنة. فأساس المواطنة الحديثة ليس التاريخ أو العرق أو الطائفة أو الدين، وإنما المساواة أمام القانون، لذلك وجهت انتقادات للنزعة الفردانية والتي عملت على تذويب الفرد في المواطن في أفق التأسيس لمجتمع يرتكز على الفرد لا على المجتمع، وكان هناك تمييز بين الفرد والمواطن، والحاصل أن كل فرد هو مواطن بالضرورة، شريطة الحديث عن التساوي في الحقوق الموجودة في الواقع [30]. الأمر الذي جعل رواد الفكر الماركسي يفضحون زيف الثورة الصناعية المبنية على تضليل الجماهير والتطلع إلى ميلاد مواطنة برجوازية جديدة، وذلك مجرد وهم [31]. فهل حقا، هناك تمييز بين المواطن المعنوي المجرد والفرد التاريخي أم أنهما متماثلان ومتطابقان؟
1- الثورة الفرنسية: إشكالية المواطنة الملموسة والفرد المتطرف
إن الناظر الممعن والمتأمل في نتائج الثورة الفرنسية لسنة 1789، يلحظ حجم الانتقادات الموجهة للثورة الفرنسية، وكذلك المفكرين المعادين للثورة في مختلف البلدان الأوروبية حيث انتقدت العقلانية السياسية وفضح التعصب الإيديولوجي، ونقد التجريد والإرادة السياسية باسم الممارسة والتجربة والموروث، كل ذلك من أجل التأكيد حسب رؤية الباحثان على أن النظام الاجتماعي لا يتأسس على مبدأ الاستقلال الذاتي الليبيرالي للفرد، الذي هو مبدأ رسخته الثورة الفرنسية. فالتاريخ الجمعي مشروع تم لمواجهة الفكر الثوري الفرنسي، بغية إعادة بناء النظام الاجتماعي الواعي والعقلاني [32]. في أفق جعل السياسة مجال ومشروع عقلاني وبشري ليس لمواجهة المواطن المجرد والصوري، وإنما للقيام بعملية الدمج لخلق التنوع وتحقيق الحريات الحقيقية التي وصل إليها الانجليز تدريجيا بفضل ثورة 1688. والتي صارت الحقوق والحريات أعلى ضمانة من مثيلتها الفرنسية، بحكم أن هذه الأخيرة تنحو في اتجاه التجريد الميتافيزيقي والبعد عن الواقع والحياة الاجتماعية، عكس التجربة الإنجليزية التي تجذر معها الفكر الحقوقي المبني على الممارسات والتقاليد الموروثة [33].
إن الحريات المحسوسة تناسب المواطنة، عكسي الحريات المجردة، بمعنى أن مبادئ المواطنة لا تتأسس على التجريد والصورنة، لأن الحرية كمبدأ لتجل المواطنة ليست شرطا كافيا لجعل الجميع يشارك في تدبير الشأن العام، لذا، لا بد من وجود شروط سابقة عن الروابط التي رسخت داخل المجتمع. فالعلاقات الاجتماعية ليست عائقا لتحقيق واكتمال الطبيعة الإنسانية، وإنما هي شرط ضروري للأمن [34].
وفي ذلك نقد للتصورات التي تؤسس المواطنة وما يرافقها من حقوق على مبدأ الفردانية واستقلال الذات، كما حصل في الثورة الفرنسية، فالنزوع إلى الفردانية المطلقة طريق لتدمير التقاليد والمعتقدات ومختلف الروابط الاجتماعية التي تساهم في تحسين وضعية الفراد داخل المجتمع. لذا، يصعب هدم الموروث رغبة في بناء مجتمع جديد على أسس الفردانية المتضخمة. معنى ذلك، ضرورة الوعي بأهمية الظروف والعناصر والشروط التراثية المشكلة للمجتمع، والحرص على تقوية المؤسسات السياسية والاجتماعية والهيئات الوسيطة التي تضمن حق مشاركة الأفراد في الحياة الاجتماعية، وفي ذلك تحقق لمفهوم المواطنة وترسيخ الحريات الملموسة والإقرار بتراتبية اجتماعية. وغياب ذلك في فضاء اجتماعي، يعني حلول الطغيان والظلم الاجتماعي وجعل السلطة مجردة. لذلك، فالتجربة الإنجليزية حسب الباحثان طريق لانتقاد مبادئ الفردانية والسلطة الصورية، وعدم الارتباط بالموروث، فكل ثورة تدعي البدء من الصفر، نافية التراكم التاريخي مصيرها المحتوم، الانتهاء إلى الطغيان [35]. وهذا ما حدث للثورة الفرنسية، حيث وجهت لها انتقادات قاسية، من طرف مجموعة من الفلاسفة، كإيمانويل كانط وهيغل، بسبب تمجيدها للفرد على حساب المجتمع.
تأسيسا على ما سبق، يمكن القول مع الباحثان، أن الشرعية السياسية تتأسس أيضا على التقاليد الموروثة، وليس على المبادئ الفردانية المجردة، وهي شرعية تقتضي التغير الدائم للممارسة السياسية، والتأقلم الحذر مع متغيرات الواقع والفكر، أي أن المواطنة السياسية على الطريقة الإنجليزية تستلهم الدروس والمبادئ من التجارب التاريخية والتراث السياسي الموروث، والاحترام لاستمرارية المؤسسات والقيم الاجتماعية والأخلاقية. (وإذا كان الدستور الإنجليزي بناء رائعا.... فيرجع ذلك إلى أن تأسيسه هو ثمرة عمل دام عدة قرون) [36].
يعتبر الباحثان، أن كل ثورة إلا ولها فكر مضاد، وإذا كانت الثورة الإنجليزية مثلا قد تأسست كما سبق ذلك، على التراتبية الاجتماعية والاستمرارية التاريخية، فإن هناك من يذهب عكس ذلك معتبرا الشرعية السياسية والسلطة والمواطنة تتطلب حضور الإرادة العقلانية، حيث سيطرة العقل على السياسية والانصات للفردانية، واعتبار أنه يوجد نظام طبيعي سابق عن النظام الاجتماعي، وعن طريقه يجب احترام الطبيعة التي هي صنيعة الله، والمجتمع مجرد مرآة تعكس العناية الإلهية. فقوانين الطبيعة هي قوانين الله بحيث تعلو وتسمو فوق القوانين البشرية [37]. مضمون الكلام السابق، يترتب عليه قول سياسي، يتمثل في أن مصدر الشرعية السياسية فوقي ومتعال، حيث تمجيد القوانين الإلهية، والرفع من قيمتها مقارنة مع القوانين الإنسانية. والأنكى من ذلك، أن الحقوق والحريات تصبح تابعة ومرتبطة بما هو إلهي وطبيعي. والنتيجة مواطنة لاهوتية وليست مدنية أو سياسية محضة، وهو أمر يتناقض مع مضمون الحداثة السياسية، حيث سيادة الأرض على حساب السماوي والماورائي.
إن المواطنة الجديدة تقتضي مجتمعا جديدا، مبنيا على أسس وقواعد متفق عليها، وليس الانصات لنداء السماء والطبيعة، فوجود المجتمع، لا تمليه إرادة إلهية، وإنما عقد اجتماعي متوافق عليه بين جميع المواطنين. فإما أن يكون مصدر السلطة الحقيقي مجموع المواطنين، وإما أن يستلهم الملك أو الحاكم حكمه وسلطته من الله. ومن ثم فهو أساس السلطة، علما أن هذه التصورات اللاهوتية حول السلطة كانت حاضرة وبقوة في المجال السياسي، إلى درجة اعتبار أن الحرية هبة إلهية، وأن المجتمع ليس ثمرة عقد وجهد عقلي، وإنما هو إرادة إلهية. عكس ما يطمح إليه الفكر الثوري. فما هي أسس الحقوق الإنسانية؟
2- المواطنة وأسس الحقوق الإنسانية
يؤكد الباحثان، أن الحقوق الإنسانية تتأسس على مبدأ التراتبية، سواء تعلق الأمر بالأنظمة السياسية الديموقراطية أو الأنظمة الفاشية حيث تمجيد القائد أو الزعيم، ومبرر ذلك ضرورة وجود تراتبية طبيعية في المجتمع، هذا الأخير يتطور بشكل طبيعي، وأن النظم السياسية والمؤسسات تستقى من تلقائيتها الواقعية. والنتيجة، أن حقوق الشعوب لا تستمد من يقينيات لاهوتية، وإنما من تنازل الحكام [38]. والمجتمع هو في حد ذاته نوع من التراتبية حسب أرنست رينان حيث الكائنات البشرية غير متساوية، وتنجز عملها وفق قدرات طبيعية. ومن هنا، فهذا التوجه يعتبر الطبيعة كقانون إلهي، وأن نفيه وإنكاره، خطأ جسيم، انزلقت إليه الثورة الفرنسية. وهو ما يفسر معارضة الرومانسيون الألمان للثورة الفرنسية، بحجة البقاء من قرب الطبيعة والحياة وادانتهم الشديدة للكاثوليكية والليبرالية العقلانية والفردانية الأنجلوسكسونية [39].
استنادا إلى الباحثان يعتبر الرومانسيون الألمان، أن لا وجود لفرد في حد ذاته، ولا هو ولا عنصرا من عناصر الأسرة والدولة، فهذه الأخيرة كائن حي متسم بالحياة والوحدة المنسجمة والمثمرة، وأن لها الأولوية على الفرد، لأنها دولة عضوية، حصيلة الوحدة والفيدرالية المتوازنة. تحتفظ للجماعة الوسيطة بين الأفراد والأمة بمكانتها، فالمجتمع بمثابة جسم خاضع لتراتبية طبيعية حسب هيردر Herder، يترتب على ذلك، أن لا وجود لفرد مستقل عن المجتمع، فكل فرد هو عضو بالضرورة ويشغل حيزا اجتماعيا وسياسيا، وله وظيفة مرتبطة بالمجموع مما يستدعي أسبقية الجمعي على الفردي [40]. وعليه لا وجود لفردانية جافة وعقلانية منغلقة، والمواطنة الحديثة ستكون نتيجة تلك التصورات حيث اندماج الفرد في المجتمع ومعرفته لدوره ووظيفته وواجباته، أي أن المواطنة حقوق وواجبات، ومرتبط بالتغيرات الاجتماعية والفكرية والسياسية. فالفرد ضئيل وهش خارج المملكة الاجتماعية. والفكر السياسي تطور الثوري، تطور بشكل ملحوظ، خاصة مع ظهور مجموعة من المفاهيم، كالواقعية والبراغماتية والاحتفاء بالمحسوس والتجربة في مواجهة التصورات العقلانية المجردة والجافة، وإحياء التقاليد الفكرية التي تجذر الفرد في الجماعة والانغراس في تاريخ وأرض لمواجهة نزعات اقتلاع المواطن.
إنه النقد الحديث الذي واكب متغيرات العصر، نقد مسألة المساواة المطلقة بين البشر، ونقد المشاريع السياسية القائمة على العقل، دون الارتباط بفكرة التراتبية الطبيعية، ساعد على ذلك بزوغ فجر العلوم الإنسانية والاجتماعية التي كشفت اللاوعي الفردي والجمعي وإبراز حدود العقل، في مقابل التراث الموروث وتأثير اللاوعي الجمعي على سلوكات وتصرفات وأفعال البشر [41]. إن النقد الموجه لمفهوم الفرد المجرد عرف انطلاقة جديدة مع فلاسفة الاجتماع، خاصة مايكل ساندل، وشارلز تايلور، ومايكل والزر، وأن الفصل بين العام والخاص ليس كافيا لتحقيق ديموقراطية حقيقية. لذا، لا بد من الاعتراف بالمواطنة، ليس بهدف الكرامة، وإنما الأصالة والشرعية، فالبشر ليسوا مجرد مواطنين مجردين، وإنما أفراد واشخاص محسوسون وملموسون، مواطنين لتاريخ وثقافة. ومن الضروري الاعتراف بذلك، فتجريد المواطن لا يحقق مواطنة. لأن الانسان لم يعد هو مقياس كل شيء [42].
وعليه، فالمواطنة لا تتأسس على فكر ماضوي فقط، ولا على فكر مثالي وطوباوي بعيد عن المجتمع ومتغيرات الواقع، وإنما استنادا إلى مبادئ الحداثة السياسية، حيث المساواة المدنية والسياسية والقانونية التي ينادي بها كل المواطنين. تعزز ذلك المادة الأولى من إعلان حقوق الانسان والمواطن التي تقول: " يولد الناس ويعيشون أحرارا متساوين في الحقوق، ولا يمتاز بعضهم على بعض، إلا فيما يختص بالمصلحة العمومية) [43].
3- النقد الماركسي: وجدل الديموقراطية والمواطنة
إن المواطنة الحديثة لم تعد مجرد مقولة صورية، وإنما صارت مرتبطة بالظروف المادية والاجتماعية، والتي فرضت حضور النقد الماركسي، حيث فضح الدولة الدستورية الليبيرالية، كألية لترسيخ نوع من الخيال البسيط لتوطيد المواطنة البرجوازية، حيث الغش والتضليل. فالنقد الماركسي يعتبر أنه لا توجد حقوق انسان خارج نطاق حقوق المواطن، على اعتبار انه لا يوجد تمييز بين حقوق الانسان وحقوق المواطن، فالإنسان هو مواطن وعضو داخل المجتمع البرجوازي، حيث يصعب الحديث عن الحرية كحق إنساني. فالفرد الحر داخل المجتمع البرجوازي، هو ذلك المنعزل والمنغلق على ذاته والمستلب عن عمله [44]. فهل يمكن الحديث عن مواطنة متساوية في هذه الحالة؟
وحسب الباحثان، أن كارل ماركس لا يشكك في الديموقراطية، لأنها كنه كل دستور سياسي، منتقدا في نفس الوقت الشكل الذي اتخذته الديموقراطية الازدواجية، بين المجتمع المكون من أفراد حقيقيين، وبين الدولة باعتبارها أداة البرجوازية، لذلك، وضع ماركس مفهوم الانسان التصوري المجرد [45]. فالديموقراطية التي تتحقق عبرها المواطنة، هي تلك التي يتحد فيها العامل والمواطن. بمعنى أن ننظر للمواطن كعامل له حق التمتع بعمله ومنتوجه الخاص، وفي اعتراف بمواطنته. ومن عيوب الثورة الفرنسية، أنها لم تساعد على جعل الانسان يحقق ذاته في داخله كعامل ومواطن، فتحقق ذلك واقعيا، يتم عبر تغيير شروط الاقتصاد والظروف المادية، وليس تحرير الانسان من الوهم الديني. إنها الدعوة للمواطنة الحقيقية المتمثلة في نقد الثورة الفرنسية، وإعطائها معنى حقيقي وواقعي يتماشى ورغبة الانسان كمواطن في إثبات ذاته عن طريق منتوجه. الديموقراطية الحقيقية تتجلى في أن تعطي للظروف المادية للأفراد أهمية قصوى، لجعلهم يتمتعون بحرياتهم. فلا بد من وجود مجتمع ديموقراطي حقيقي يستكمل المواطنة التي ظهرت اثناء الثورة الفرنسية [46].
والحديث عن الديموقراطية في علاقتها بالمواطنة، حديث عن مبادئ وشروط تعبر عن تشكل أنظمة تاريخية متطورة، من الديموقراطية اليونانية المباشرة، إلى الديموقراطية البرجوازية في العصر الحديث، لكنها داخل النظام الرأسمالي تبقى ديموقراطية محدودة ومبتورة ومزيفة وخادعة وجنة للأثرياء على حساب المقهورين في والمعذبون في الأرض، وفخ خادع للذين يتم استغلالهم ومما ساعد على ذلك، نشأة التناقضات بين المساواة الإسمية المجردة [46]. وآلاف القيود المانعة التي تجعل البروليتاريين مجرد عبيد. فعن أية مواطنة وكرامة بشرية يمكن الحديث هنا؟
إن المواطنة الحقيقية تقتضي توفير الدولة للوسائل المادية كرامة الوجود البشري، والحق في التعبير والكتابة، وفي حرية الاختيار السياسي [48]. والتعهد بحماية العامل في عملهن وتوفير العمل لجميع المواطنين، وعلى قدم المساواة، وجعل الكل يتمتع بحق التجمع والاضراب، والمطالبة بالحقوق، أو ما يعبر عنه، بالحقوق- الحريات، التي هي من مكتسبات الثورة الفرنسية، فالحقوق- الحريات تضمن حقوق المواطنين قبل وجود سلطة الدولة كحرية الفكر والتعبير والعقيدة والاجتماع، وهي حقوق تمت تنميتها مع روح الثورة الفرنسية حيث الاعتراض على التعسف الملكي، وصياغة الضمانات القانونية لحماية الحقوق. فالقانون صار هو الر جع والمؤطر نقرأ ذلك في إحدى مواد إعلان حقوق الانسان المادة7: (لا يجوز إلقاء الشبهة على رجل أيا كان ولا القبض عليه ولا سجنه إلا في المسائل التي ينص عليها القانون وبموجب الطرق التي يذكرها) [49]. وأيضا في المادة8: (لا يجوز أن يعاقب القانون إلا العقاب اللازم الضروري). غاية الحقوق- الحريات وفق رؤية الباحثان، الحد من توغل وتدخل الدولة، ومن ثمة فالحقوق هي الشروط والعناصر التي تؤدي إلى الانتقال من المواطنة الصورية والشكلية إلى المواطنة الحقيقية، حيث الممارسة الفعلية في الواقع [50]. لكن ما هي ضمانة أن ينال الناس حقوقهم وتترسخ المواطنة لديهم؟
4- المواطنة والدولة الحامية
الدولة الحامية، دولة مدنية تأسست بغرض حماية الحقوق والحريات بشكل ملموس. وتعمل على تحسين الظروف المادية الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى وضع أسس المساواة السياسية والقانونية التي تفضي حتما إلى وضع أسس الروابط الاجتماعية والشرعية السياسية. بمعنى أخر، أنه بدون الحديث عن الظروف الاقتصادية والانطلاق منها، يصعب تحقيق المساواة، والمواطنة الملموسة والنتيجة صعوبة وجود مواطن سيد نفسه. لذا، فكل حديث عن المواطنة يتطلب الارتكاز على عمليات إنتاج وظروف مادية تضمن الكرامة، علما أن المواطنة الحقيقية تعني أن لكل مواطن الحق في أن تيسر له الدولة الحامية سبل تحقيق الحاجيات الضرورية بشكل لائق، وتجعله يحوز الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية، ونظرا لأهمية ذلك، فالدولة تستعين بجميع الوسائل لإعادة توزيع الثروات بشكل عادل [51]. إن الدولة الحامية هي أساس المواطنة وكل المشاريع السياسية والقانونية، بحيث توائم بين النظام السياسي وعمليات الإنتاج الاقتصادي، حسب أدم سميت، تمزج بين في توليفة عجيبة بديعة بين متطلبات الفعالية الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية وفي ذلك تحقيق لمتطلبات القيم الديموقراطية [52]. ومن سمات الدولة الحامية، أنها راعية للمواطنين، ليس على طريقة رعاية العصور الوسطى، وإنما رعاية قانونية وسياسية وحقوقية، حيث الأمة هي مصدر السلطات، والديموقراطية هي منطلق أية عملية سياسية واجتماعية، ترسخ وجود المؤسسات نظرا لدورها المحوري، دولة الحماية الاجتماعية وإعادة توزيع أرباح النمو الاقتصادي، تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، وتعطي معنى سياسي واجتماعي وقانوني للمواطنة [53].
فالتغيرات السياسية أدت إلى كثرة التنظيرات حول المواطنة فمثلا عالم الاجتماع الإنجليزي توماس همفري يميز بين ثلاثة أبعاد للمواطنة: فهناك المواطنة المدنية التي هي بنت القرن 18م، وتتلخص في ممارسة المواطن لحقوقه وحرياته خاصة الحرية الشخصية وحرية التعبير وحرية التملك التي تضمنها الدولة الحامية. وهناك المواطنة السياسية التي تأسست في القرن 19م وتعرف بممارسة الحقوق السياسية، كالحق في التصويت والمشاركة في الحياة السياسية. وهناك المواطنة الاجتماعية التي نشأت في القرن 20م وتميزت ببروز الحقوق- الغير المادية، كالحق في الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والعمل [54]. والملاحظ أن تلك الحقوق المحددة لطبيعة ونوعية المواطنة، ليست تراتبية بشكل ألي، بمعنى ليس دائما أن الحقوق المدنية سابقة عن الحقوق السياسية والاجتماعية، فالمسألة مرتبطة بالظروف الاجتماعية والقانونية لبلد ما، فمثلا في بعض البلدان ونتيجة لوجود نظام سياسي معين، تكون الحقوق الاجتماعية سابقة عن بقية الحقوق، بحيث يتم إهمال منطق التماهي والتمايز بين مختلف الحقوق، غير أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر سنة 1947 وضع الحقوق- الحريات إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي جعلت فكرة المواطنة المحسوسة ذات محتوى اقتصادي واجتماعي. وعليه، فالمواطنة صيرورة تاريخية وسيرورة اجتماعية تفاعلية، تستوجب تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية لحيازة الأفراد لحقوقهم. فهل للمؤسسات دور في توطيد دعائم المواطنة؟ فخذ بنا للفصل الثالث، لنفصل الكلام تفصيلا.
وفي معرض حديثهما في الفصل الثالث عن دور المؤسسات، يعتبر الباحثان أن المواطنة ليست فكرة جامدة، ولكنها بناء فكري حي، متغير تبعا لتغير السياسي والاجتماعي والحقوقي والتاريخي، تبدل مستمر، سيال وبدال، حيث الصدامات بين الآراء وحدوث توافقات بين القوى الاجتماعية والسياسية، وهذا ما يدل على تعدد أشكال المواطنة تبعا للمبادئ والتقاليد التاريخية الخاصة بكل بلد، وقد سبقت الإشارة في الفصل الأول كيف أن المواطنة الإنجليزية تختلف عن المواطنة الفرنسية، اختلاف الأسس والمرتكزات الفلسفية والسياسية. والحقيقة أن المواطنة لا تؤدي على تنظيم المجتمع إلا إذا تجسدت في شكل قواعد قانونية ومؤسسات اجتماعية، وعدم فعل ذلك، يعني بقاء المواطنة في حدود الصوري والتجريدي [55].
إن المواطنة الحديثة تتميز بكونها تنحو في اتجاه الكونية والعمومية، استنادا على التصويت كعملية وألية لكشف معنى المواطنة حيث يساهم التصويت المؤسساتي في حل الصدامات والنزاعات بين المجموعات السياسية، بدل اللجوء إلى العنف [56]. فغاية التصويت كفعل سياسي، ليس اختيار القادة والفاعلين السياسيين، وإنما هو عملية ترمز للمجتمع السياسي الحديث، المتسم بعمق الروابط الاجتماعية، المحددة لمصير الجماعة، يفتح المجال للتجارب السياسية المتعددة. بحيث يصير كل مواطن مساو للأخر، ويصبح صوت الانسان ألية للفعل وإضفاء الشرعية على النظام السياسي، ويتحقق مبدأ التأسيس الذاتي والفردانية الجماعية والمنظمة، وتتحدد المعالم الكبرى للمجتمع، كنسق ينشأ عن طريق التفاعل بين المواطنين، وليس اعتباره مشروع إلهي أو طبيعي. فالتصويت وسيلة لخلق جماعة المواطنين، وسر من أسرار المساواة الملموسة العاكسة بشكل واضح لمعنى المواطنة [57].
يؤكد الباحثان أن المواطنة الحديثة تجعل كل مواطن مهما كان لونه، يحس بذاته وبوجوده الخاص، فيتحرر تلقائيا من نزعة الخوف الجاثمة على كينونته، ويترسخ في وعيه مبدأ المقاومة، فيستعمل صوته بشكل واع، وتلك إحدى تجليات المواطنة، حيث زوال العنصرية وتحقق مبدأ المساواة. فالتصويت مرآة عاكسة للمواطنة، وبه يتحدد الانتماء إلى مجتمع سياسي. وعليه، لا نستغرب إن سمعنا عن النقاشات الداعية إلى ضرورة منح التصويت للأجانب، لأنه لحظة احتفال سياسي، وما يرافق ذلك من طقوس، كوجود صندوق فارغ ومعزول ومحاط بهالة من التقديس القانوني، يتوسط القاعة مثله مثل المذبح أو الهيكل وسط الكنيسة، هذا التقدم السياسي والحقوقي يدل على قداسة معنى المواطنة بقداسة ألياتها وشروطها ومتغيراتها الانتخابية [58].
زمن الأزمنة الحديثة، زمن المواطنة المتغيرة والمفتوحة لجميع الأفراد وبدون تمييز، بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والتاريخية والدينية، فالمواطنة قيمة وجودية لضم الأفراد والشعوب، وجعلها تتجاوز جميع الاختلافات، في أفق تكوين وحدة منسجمة، فهناك فئات كثيرة كانت مهمشة في بعض المجتمعات- اليهود في ألمانيا النازية مثلا- لكن منح التصويت لها، جعلها حائزة للمواطنة. علما أن المواطنة لا تتحقق بشكل كامل، وهذا ما جعل العقل السياسي الثوري يصوغ فكرة المواطنين النشيطين والفاعلين، لتأكيد أن المواطنة مخاض وصيرورة، متدرجة معرضة للانتقادات من أجل تطويرها وتثويرها وتنويرها. فالحق في التصويت لم يكن متاحا للجميع، غير ان الظروف السياسية والاجتماعية والفكرية جعلته من حق الجميع، لأن ما يؤسسه كوني وعمومي [59]. غير أن المتمعن في مضمون متن الباحثان يلفي نفسه أمام فكرة جديدة مضمونها ان فكرة المواطنة في الزمنة الحديثة والمعاصرة تمر باختبار وامتحان عسيرين خاصة ما يتعلق باستبعاد من ليسوا بمواطنين- كالمقيمين واللاجئين- الأمر الذي يفرض تحديا على العقل السياسي، بغية التفكير في بناء منظومة مفاهيمية جديدة من صميم فكر المواطنة العالمية، وإزالة المفاهيم ذات الحمولة العنصرية والاستبدادية كالشمولية والاستبعاد [60].
إن المجتمعات المؤسسة على المواطنة منفتحة على الأجانب والغرباء، مقارنة مع أشكال التنظيم السياسي الأخرى، إذ يمكن حيازة جنسية البلد الذي يقيم فيه الانسان، شريطة إبعاد المحددات والموجهات الثيوقراطية، بحيث لا يتطلب الأمر اعتناق دين الدولة الرسمي، فمن الصعب مثلا الانتماء إلى الشعب اليهودي بناء على الدين، لكن، من الممكن الانتماء إلى إسرائيل، رغم عدم اعتراف الحاخامات بهم كيهود [61]. لذلك، فتطور المجتمعات والدول رافقه تطور الحقوق السياسية والاجتماعية والقانونية، المر الذي انعكس على الأجانب الموجودين بشكل قانوني داخل بلدان إقامتهم، بحيث صيغت التشريعات القانونية لمنحهم حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، ويعد ذلك، تأكيد على فكرة المواطنة العالمية، بموجبها يتمتع الأجانب بجميع الحريات الفردية أو الحقوق المدنية، فلهم حرية التنقل والزواج، والتعبير عن الرأي، معنى ذلك، أن مجمل التشريعات الخاصة بالحقوق الاجتماعية أٌقرت وأصبحت مضمونة قانونيا [62]. لكن ما الطريق لترسيخ ثقافة المواطنة داخل المجتمع؟
إن سيادة المواطن تتطلب نقاشا عميقا يترجم إلى مؤسسات سياسية، وتسبق ذلك وضع برامج تعليمية وتربوية هادفة وناجعة، لغرس مبادئ المواطنة الحقة، على اعتبار أن التعليم هو أساس المشروع الديموقراطي، بحيث يساهم في جعل الأفراد يتمتعون بالقدرات الضرورية المؤهلة للمشاركة في الحياة العامة، فالمدرسة هي النموذج الأمثل لمؤسسة المواطنة، وهذا ما يفسر كون الديموقراطية اليونانية كانت حكرا على الأثرياء من المواطنين بسبب غياب المدرسة، لذا، فالمواطن القادر على ممارسة حقوقه بشكل ملموس مرتبط بالديموقراطية نظرا لتوفر الفضاءات التربوية والتعليمية[63].
مباشرة بعد الثورة الفرنسية صار الحديث عن المعلمين المؤسسين لتأسيس الأمة، كون هذه الأخيرة هي مصدر السلطات والسياسة الشرعية، وكمثال على ذلك، فالمدرسة في فرنسا هي مدرسة المواطن، وأنها أداة سياسية في خدمة الجمهورية. لذلك، ركز عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم على ألأهلية الجوهرية للمدرسة، في التشكل والتكوين المعنوي للبلاد، من أجل أن يترقى الأفراد، ليصبحوا مواطني المستقبل على نحو أفضل. وعليه، فللمدرسة عدة وظائف، فهي تقدم اللغة والثقافة الإيديولوجية للدولة وذاكرة تاريخية مشتركة، وأنها أيضا تساعد على تشكل مساحة خيالية لصورة المجتمع السياسي، فنظام المدرسة مماثل في جوهره لنظام المواطنة [64]. لذلك، ألا يؤدي مبدأ سيادة المواطن إلى فردانية متضخمة قد تعصف بالمؤسسات التقليدية؟
المحور الرابع: الفردانية الديموقراطية وإشكالية المواطنة
يعالج الباحثان في الفصل الرابع قضية الديموقراطية الفردانية ذات الأساس والمنشأ الديموقراطي، بمعنى أن الفردانية بنت الديموقراطية كون هذه الأخيرة ليست مجرد نظام سياسي، السيادة فيه للشعب أو مجموع المواطنين، ولكنها ثقافة تعيد المواطن الفرد إلى ذاته، تجعله في بعض الأحيان يتمركز وينغلق على ذاته، ذلك أن الثورة الفرنسية لم تنتج نظاما سياسيا جديدا وحسب وإنما أفرزت روابط اجتماعية حديثة، حيث حل مفهوم المواطن محل كل المفردات. ظهرت المواطنة المجردة الداعية إلى المساواة، هذا التغيير العنيف أدى إلى تبدل ملحوظ على مستوى التراتبية والدمج الاجتماعي [65].
إن المواطنة هي أصل ومصدر العلاقات الاجتماعية، غير أن السعي في اتجاه تحقيق الموازنة والتوفيق بين الفرد- المواطن ومتطلبات الحياة الاجتماعية عملية صعبة ومعقدة، يتجلى ذلك في علاقة الحق بالفردانية الديموقراطية. فالحق هو ترجمة عملية للقيم الاجتماعية المتعارف عليها، حق افضى إلى البروز الحديث لمفهوم الحق الذاتي على حساب الحقوق الموضوعية الأخرى. خصوصا وأن القانون الأوروبي اعترف بحقوق الأشخاص للمساهمة الفعالة والحقيقية في بناء الشخصية القانونية [66].
ويعتبر الباحثان، أنه رغم سعي بعض الفلسفات إلى نفي الحقوق الذاتية (ليون دوجي) فقد تمت إعادة توطين الحقوق الذاتية والحرص على تنميتها جراء المتغيرات العالمية والمتمثلة في الحرب العالمية الثانية، وأيضا كرد فعل تجاه مآسي ونتائج النازية، حيث ترسخت مجموعة من الحقوق الذاتية الجديدة، كالحق في المبنى محور عقد الايجار، والحق في السكن للأفراد، وترتيب المسؤوليات الناتجة عن حوادث الطريق لضمان الإصلاحات. وأن لكل فرد الحق في احترام شبهة البراءة. وعليه فالحق الذاتي يشمل التعرض للحياة الخاصة والتعرض للحرية وللأسرار المهنية [67]. فمن حق كل فرد اللجوء للعدالة إحقاقا للحق وحيازة الحقوق الذاتية، حيث بالإمكان أيضا الاعتراف للطفل بحقه في التعبير. وقد تطورت الحقوق الذاتية وتضخمت خاصة في الولايات المتحدة الامريكية، حيث تفضيل اللجوء إلى المحاكم في كل القضايا الاجتماعية [68].
إن تضخم القضايا المعروضة على المحاكم قد يضعف النصوص القانونية، ويجعلها هشة، لأنه يصعب بناء على الحقوق الذاتية إعادة تعريف وترتيب حاجات البشر، وفق تراتبية مضبوطة ومحددة المعالم، كالحق في العمل/ والحق في السعادة، والحق في الطفل، والحق في الاجهاض بمعنى تضخم الذاتي والفرداني على حساب الاجتماعي والأسري. لذا، فالحقوق الذاتية، افرغت القانون الموضوعي من محتواه الأمر الذي تطلب نوعا من المواءمة، وتنمية القوانين الخاصة والاستثنائية، والتي تزيد من غرق الحياة الاجتماعية وتعقدها، خصوصا وان أهل الاختصاص هم من يحق لهم الكلام عن مختلف القوانين باعتبارهم أهل الاختصاص والكفاءة وكل مناقشة عامة وعلانية تعلي من سيادة الفرد تبدوا ضبابية [69]. لأنه حسب رؤية الباحثان يصعب وضع حدود متفق عليها حول الحقوق الذاتية، لأن قوة الفردانية مستمرة، إنها كالنهر الجارف، أضف إلى ذلك أن تضخم الفردانية يضعف المؤسسات الوطنية بحيث لم تعد المؤسسات التقليدية كالمدرسة والنقابة تفرض سطوتها وسلطتها على الأفراد بشكل مطلق [70].
إن وجود السلطة يفرض على كل فرد المطالبة بحقوقه الطبيعية والاحتماء بمعتقداته الشخصية، رافضا أية سلطة تقليدية، فالحديث عن أزمة التعليم وأزمة النقابات وأزمة الكنائس مظهر لتجلي العلاقة الجديدة بين الفرد والمؤسسات، إنه الانفجار العنيف للفردانية على حساب المؤسسات وكل اشكال السلطة. فحديث الفرد المناهض للسلطة جعله يبرر سلوكه لجعل شخصيته تزدهر، ليصير صاحب حكم ذاتي مستقل [71].
غياب المعايير الواضحة، أدى إلى تمييع الحياة الاجتماعية الفردانية، حيث تشظت الشرعيات معلنة عن تأثير الفردانية، وأصبح الحوار والتوافق في جميع الفضاءات هما أساسا العلاقات الاجتماعية. فالتفاوض هو أساس الروابط الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب حماية الحقوق الذاتية نظرا لعدم تساوي أطراف التفاوض بين المواطن الأجير وصاحب الكفاءة، فعلى المؤسسات أن تحمي أكثر الناس ضعفا [72]. وأنه من الضروري تدخل الدولة كسلطة وقوة عامة لتأكيد المساواة في الحقوق وتطبيق ذلك بفعالية خاصة في المجتمعات المتباينة، وعدم تدخل الدولة يؤدي إلى ظهور النزعات العنصرية والعرقية وخرق قيم الجماعات. وعليه، يجب صياغة التشريعات الخاصة وتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع بشكل فعال داخل الحياة الاجتماعية. لكن، ما علاقة المواطنة بالأمة؟ وما هي شروط حيازة الفرد والجماعة للحقوق الثقافية التي هب بنت الزمن الحديث؟
المحور الخامس: الأمة والمواطنة واشكالية التعددية الثقافية
إن الأمة هي الإطار العام الذي تكونت داخله الشرعية السياسية والممارسة الديموقراطية، ومن تمت فإن هناك علاقة وثيقة بين المواطنة والأمة. فعبر التاريخ اقترنت المواطنة بمطلب الاستقلال الوطني وباسم قيم المواطنة المجسدة لتاريخ الأمة ثارت الشعوب المستعمرة مطالبة بالحق في الاستقلال. لذلك، كثيرا ما يتم الحديث عن المواطنة والقومية وهو ما يفسر مطالبة الشعوب بالحقوق الثقافية الخاصة بالأمة، فنشأت الحركات العمالية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ التعددية الثقافية في ظل المجتمعات الصناعية. 283 ولا شك في ذلك، لأن كل مجتمع متعدد الروافد الثقافية والجماعات، من حيث الجنس والوسط الاجتماعي والدين الممارس. لذلك، لا بد من إدارة جيدة للتعدد الثقافي والاثني والتحكم في جميع العناصر المتباينة داخل المجتمع، بحيث تغدوا المواطنة ألية لإدارة التباينات الثقافية، وتوطيد مبدأ التسامح وحماية النطاق الشخصي المتمثل في الميولات النفسية، والانتماءات الخاصة والمشاركة في ممارسة الدين بحرية واستخدام اللغة الأم.
إن إدارة التباينات تتجسد في ضرورة التمييز بين الخاص والعام، والجمع بين المساواة المدنية والسياسية للمواطنين مع احترام الارتباطات والانتماءات التاريخية والدينية المميزة لجماعة ما، في أفق ضمان وحدة المجتمع المشتركة. فتبعا لمبدأ المواطنة صارت التعددية الثقافية حقا من حقوق الانسان. خصوصا وأن مسألة التعددية الثقافية ظهرت إلى الوجود الغربي بسبب هجرة العاملين من بلدانهم إلى بلدان أخرى أجنبية، الأمر الذي فرض ضرورة الاعتراف بحق الأقليات الثقافي والديني، خاصة تلك الفئات التي اضطهدت بسبب اللون والدين، وقد تعززت الحقوق الثقافية في إطار النقاش العميق الذي فتح حول الاشكال التي ينبغي ان تكون عليا المواطنة الحديثة. فمادامت الجماعات منضوية داخل المجتمع ومشاركة بالفعل في الحياة المشتركة والقيم الجماعية، فيجب الاعتراف لها بجميع الحقوق الثقافية، شريطة احترام النظام العام. فدولة القانون المتسمة بالديموقراطية الحديثة تضمن الحقوق الثقافية.
إن الحقوق الثقافية، جزء لا يتجزأ من الحقوق الفردية والجماعية، التي هي من سمات الحداثة السياسية. علما أن الحقوق الثقافية لا تعني الحق في القراءة والفن والمعرفة، وإنما أن تكون للفرد حياة ثقافية خاصة، يسعى إلى تنميتها بوجود ومعية الأخرين، داخل مجموعة معينة، ويجب على العقل السياسي المدبر إبداع شروط وقواعد التوفيق بين الحرية والمساواة بين جميع المواطنين، بمعنى أن إدارة التنوع الثقافي تتطلب أليات جديدة تختلف عن تلك التي كانت سائدة. فلا بد من وجود ديموقراطية ثقافية حقيقية، تحفظ كرامة المواطن ثقافيا، وتستوعب الجماعات التي لها ثقافة تميزها مع تجاوز العوائق التي تفتح باب العنصرية والتمييز والسلطوية ودمج الجماعات التي تم تهميش عاداتها وتقاليدها والسماح لها باستعمال لغتها الخاصة. ولها الحق في ان تخلد أعيادها ومناسبات وطنها الأصلي.
يؤكد الباحثان أن بعض البلدان الليبيرالية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع تدبير الاختلافات والاعتراف بالتعددية الثقافية والتأقلم معها، لذلك، هناك مخاطر تهدد الحقوق الخاصة والتي يمكن الاصطلاح عليها بالجماعانية، حيث تطرح مشكلة حرية الأفراد، فالتأكيد على حق الفرد الثقافي قد يحصره داخل مجموعة تضيق من حريته الشخصية، خصوصا وأن المجتمع الحديث ينظر للأفراد على أن لهم أدوار اجتماعية متعددة، ومن حقهم الانتماء والتماهي مع مرجعيات يختارونها بأنفسهم. أضف إلى ذلك خطورة الاندماج الاجتماعي المطلق للفرد في جماعة يرسخ لدى الذاتية والمصالح الخاصة على حساب ما يجمع ويوحد المواطنين. بحيث يغدوا الفرد في هذه الحالة منغلقا على ذاته، ولا يتزود من الأخرين بالوسائل الضرورية للانفتاح، علما ان تلك الجماعة ليست أبدية فهي صيرورة متجددة. بمعنى أوضح، أن الاعتراف العلني بالحقوق الثقافية للجماعة ليس دائما إيجابيا، فيمكن أن يقود على التشظي والتجزيء الاجتماعين خصوصا إذا كانت الجماعة منغلقة.
إن غياب الضوابط الديموقراطية الضابطة للتعددية الثقافية يفضي إلى التجزيء الاجتماعي، لذلك، يجب التقريب بين الجماعات حفاظا على وحدة المجتمع ودوام تماسكه، وأن الاعتراف العلني يجب أن يكون مشروطا بانفتاح كل جماعة على المجتمع وليس الانغلاق، لأن بإمكان تلك الشروط أن تساعد على تأسيس وإقامة المواطنة المختلفة والمميزة. ومن شروط الاعتراف بحق الجماعة الثقافي، ألا تفترض سيادة على الأفراد وأن تترك لهم حرية الانضمام والانسحاب، مع تأكيد الباحثان أن الاعتراف يشمل أيضا العناصر الثقافية المتوافقة مع منظومة حقوق الانسان، وأن المعايير الداخلية للجماعة يجب أن تنسجم والقيم الجمالية السائدة في المجتمع، وفي ذلك ضمان للحق المتساوي بين الجماعات دون أن تطغى الواحدة على الأخرى.
محمد لمعمر
أستاذ الفلسفة، وباحث في فلسفة القانون
.................................
الهوامش:
[1] دومنيك شنابر وكريستيان باشولييه، ما المواطنة؟، ترجمة سونيا محمد نجا، الطبعة الأولى (القاهرة، المركز القومي للترجمة 2016)، ص. 27.
[2] مصدر نفسه 28.
[3] نفسه، ص 28.
[4] مصدر نفسه، ص 30.
[5] نفسه، ص 31.
[6] نفسه، ص 31.
[7] مصدر نفسه، ص، 31.
[8] مصدر نفسه، ص 32.
[9] مصدر نفسه، ص 33.
[10] مصدر نفسه، ص 34.
[11] مصدر نفسه، ص 33.
[12] مصدر نفسه، ص 35.
[13] مصدر نفسه، ص 36.
[14] مصدر نفسه، ص 37.
[15] مصدر نفسه، ص، 38.
[16] مصدر نفسه، ص 39.
[17] مصدر نفسه، ص 40.
[18] مصدر نفسه، ص 40.
[19] مصدر نفسه، ص 41.
[20] مصدر نفسه، ص 43.
[21] مصدر نفسه، ص 41.
[22] مصدر نفسه، ص45.
[23] مصدر نفسه، ص46.
[24] مصدر نفسه، ص47.
[25] مصدر نفسه، ص50.
[26] مصدر نفسه، ص51.
[27] مصدر نفسه، ص48.
[28] مصدر نفسه، ص 48.
[29] مصدر نفسه، ص101.
[30] مصدر نفسه، ص102.
[31] مصدر نفسه، ص103.
[32] مصدر نفسه، ص104.
[33] مصدر نفسه، ص106.
[34] مصدر نفسه، ص،107.
[35] مصدر نفسه، ص108.
[36] مصدر نفسه، ص109.
[37] مصدر نفسه، ص109.
[38] مصدر نفسه، ص110.
[39] مصدر نفسه، ص 111.
[40] مصدر نفسه، ص113.
[41] مصدر نفسه، ص115.
[42] مصدر نفسه، ص117.
[43] مصدر نفسه، ص118.
[44] مصدر نفسه، ص119.
[45] مصدر نفسه، ص120.
[46] مصدر نفسه، ص121.
[47] مصدر نفسه، ص 128.
[48] مصدر نفسه، ص123.
[49] مصدر نفسه، ص125.
[50] مصدر نفسه، ص،126.
[51] مصدر نفسه، ص128.
[52] مصدر نفسه، ص129.
[53] مصدر نفسه، ص129.
[54] مصدر نفسه، ص 177.
[55] مصدر نفسه، ص178.
[56] مصدر نفسه، ص179.
[57] مصدر نفسه، ص181.
[58] مصدر نفسه، ص183.
[59] مصدر نفسه، ص185.
[60] مصدر نفسه، ص187.
[61] مصدر نفسه، ص189.
[62] مصدر نفسه، ص190.
[63] مصدر نفسه، ص152.
[64] مصدر نفسه، ص253
[65] نفسه، ص255.
[66] نفسه، ص255.
[67] مصدر نفسه، ص256.
[68] مصدر نفسه، ص257.
[69] مصدر نفسه، ص 258.
[70] مصدر نفسه، ص 159.
[71] مصدر نفسه، ص260.
[72] مصدر نفسه، ص 262.