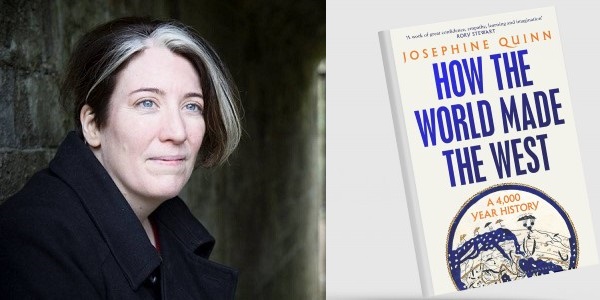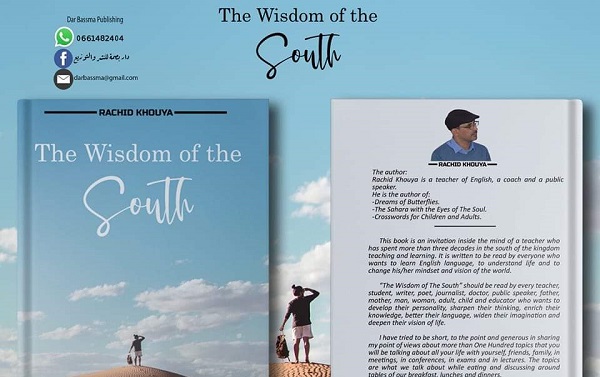صحيفة المثقف
علي صالح جيكو: هناء....
 فَتَحتْ الباب وإرتمتْ على المقعد الخلفي، قالت بصوتٍ مُتهدج ومتعب:
فَتَحتْ الباب وإرتمتْ على المقعد الخلفي، قالت بصوتٍ مُتهدج ومتعب:
الى منطقة الدورة، ثم صمتت ..
لم تسألني عن ثمن الأجرة، مثلما يفعل سائرالركاب، ولم أسألها بدوري..
فتحت زجاج النافذة بمقدار ثلاث أصابع، تنفست بعمق، ثمَ أرخت عباءتها الى كتفيها، بان شعرها الناعم القصير، أحسست كأني والسيارة، قد غطسنا في بحيرة من المِسك، أو إقتحمنا غابة من الورد الجوري، لا أعرف أي عطر، يفوح منها؟
المرآة الداخلية تعكس نصف وجهها الأسمر الجميل، غمازة خد واحدة، نصف صدرها وفخذها الأيسر، خشيت أن أعدل من وضع المرآة، الأمر الذي قد يعطي إنطباعاً سخيفاً عن تطفلي وفضولي .
لا تثيرني كل إمرأة، ولا أمتلك معايير واضحة للجمال، ولست ممن يقعون في شراك الحُب وحبائلة بسهولة .
فمزاجي مُتقلب هوائي، أشعر بالإختناق لمجرد التفكير بالزواج والحياة المُملة الرتيبة، رُغم عشقي للمرأة وولهي بها، كأي رجل، وربما أكثر من الكثير ..
أحبها بعيدة، بعيدة، وقريبة قريبة، لا أريدها أن تدنوا كثيراً من أسوار حريتي، أحبها مثل الزهرة، أملّي عينيَّ من ألوانها، وأنعش روحي بضوع أريجها عن بعد ..
لكن هذه المرأة، بملامحها الجميلة، تشع إنوثة عجيبة لا تقاوم، زادت الجلابية الرُمانّية، المُطرزة بخيوط ذهبية، تحيط فتحة الصدر والأكمام، من حسنها وبهاءها.
كانت تنظر من النافذة وتتحسر، فتحت حقيبة يدها الجلدية، بعثرت محتوياتها بعصبية، ثم أعادت البعثرة لمرات عديدة، وفي لحظة، توسعت حدقتا عينيها وصاحت:
عُد بي على وجه السرعة الى شارع فلسطين، المكان الذي صَعَدت منه ..
أجبتها بنبرة، تساير حيرتها، وتتضامن مع غضبها الذي لا أعرف سببه:
حاضر يا آنسة، سأستدير من أقرب تقاطع، ونعود الى شارع فلسطين ..
قالت مُحدثة نفسها بصوت مسموع:
إبن الكلب، سرقَ بطاقتي وشهادة الجنسية، لكن سأريه من أنا !
لم أفه بكلمة، ولم أسألها عن سبب العودة، بعد أن قطعنا نصف الطريق الى منطقة الدورة؟
خشيت أن تصب شيئاً من غضبها عليَّ وعلى تطفلي، الملعونة لها سطوة عجيبة، أخافتني !
إدخل الى هذا الشارع، دخلتْ، أخرج من هذا الشارع، خرجت،
توقف هنا، توقفتْ ..
منزل كبير، بحديقة تحفها أشجارالنارنج والرمان والتوت، ألقت عباءتها على المقعد وهي تهم بالنزول، إنتظرني هنا، سأعود حالاً ..
سألتها:
إلى أين أنت ذاهبة يا آنسة؟ هل بمقدوري مساعدتك؟
زمجرت غاضبة: آنسة بعينك، أين نحنُ في الشام؟؟ هذا ليس من شأنك، لست ناقصة مصائب، إنتظر وحسب.
نزلت مسرعة، دفعت باب الحديقة الواطيء وراحت تهرول في ممر الطارمة، تابعتها بعينين مذهولتين، أرداف ممتلئة وخصر نحيل وطول متوسط، لم أنتبه إلى هذا الحسن، الذي كان يتوارى خلف العباءة المعطرة.
عادت بعد لحظات، وقد زاد هياجها، كأنها خرجت للتو من معركة، يتبعها رجل يرتدي بيجاما و فانيلا بيضاء داخلية، أظهرت كرش كبير وشعر كثيف على ذراعيه وزنديه وصدره .
أمسك بيدها وهو يصرخ بصوتٍ عالٍ، غاضب: هناء، إسمعي، هناااااء ..
نفضت يدها بقوة وحررتها من قبضته، ثم صفقت الباب بوجهه، صياحه وغضبه، لم يجديا نفعاً، بإخافة هذه اللبوة وكبح جماحها !
ظل الرجل صامتاً وهو يراقب صعودها الى السيارة، لم أتبين ملامحه جيداً، يبدو أكبر منها بكثير ..
من يكون ياترى؟ أخوها، أبوها، أم زوجها؟، لا أدري لِمَ اشفقتُ عليه في داخلي؟!
عُد بي الى الدورة ..
إنطلقت بسرعة تحاكي توترها، رسمتُ على وجهي إضطراب وجديّة، لا تخلوان من نفاق .
لم ترتد عباءتها الملقاة على المقعد، سحبت سيكارة ( كِنتْ ) من علبة في حقيبتها، أشعلتها بعصبية، من ولّاعةٍ شبه فارغة .
سأريك من أنا يا إبن العاهرة !
قالتها وهي تحدق في إتجاهي، سرت رعشة خفيفة في جسدي، مَن تَعني؟!
أنا،أم ذلك الرجل المسكين المُبتلى بهذه الحلوة، المجنونة؟
لطمت فخذها، صاحت وهي تكز على أسنانها:
سأريك من أنا يا إبن شُكرية ..
حمدتُ الله لأني لست إبن شكرية!، إذاً، أبو كرش هو المقصود !
عادت تتطلع من النافذة وتنفث الدخان بهدوء، التبغ يمتص غضبها وتوترها، يجعلها تستكين وتهدأ !
رمت عقب السيكارة من النافذة، ثم راحت تبحث عن شيء في حقيبتها من جديد، سمعتُ خشخشة سلسلة مفاتيح وربما بعض الحلي الذهبية وأقلام أحمر الشفاه؟
فتحت سحاب جيب صغير داخل الحقيبة، إستلت منه ورقة مطوية، فَردت طياتها، وإنهمكت في قراءتها بصمت.
أسرعتُ في هذه الاثناء، الى تعديل وضع المرآة لتشمل وجهها كله، إختلستُ نظرة خاطفة الى عينيها، اللتين إلتمعتا بحزن، وفاضتا بدمع ساخن، سارعت الى تجفيفه بمنديل ورقي كانت تضغطه في كفها .
لمستُ في وجهها شيئاً من الوداعة والطفولة، ربما تعاني من حياة مريرة، صيرتها هذه النمرة الشرسة؟!
طوت الورقة وألقت نظرة ساهمة في الفراغ، ثم تطلعت بها لبرهة وأعادتها الى موضعها في جيب الحقيبة الصغير.
أصبحنا فوق منتصف الجسرالمُعلق، الشمس الخريفة تغمر بسناها ودفئها النهر والنخيل والبيوت الغافية على أكتاف دجلة، بعد ليلة مطيرة باردة .
حدثتُ نفسي بصوتٍ مسموع وأنا أُنزل زجاج النافذة الى النصف:
الجو رائق ودافيء هذا اليوم، كُدنا نغرق البارحة، لم يتوقف إنهمار المطر طوال الليل!
لم تعر كلماتي أي إهتمام ..
إستلت سيكارة ثانية،حاولت إشعالها، لكن غاز القداحة نفذ تماماً .. رمتها وهي تلعن..
هل لديك قداحة أو علبة كبيرت؟
قدمت لها سيكارة مارلبورمع علبة كبريت، لم تمانع، أشعلتها، سحبت نفساً عميقاً،
حارّة المارلبورو، لكنها تلائم ظرفي .. شكراً لك .
أعادت لي علبة الكبريت، قُلت: بإمكانك الإحتفاظ بها، لدي واحدة أخرى ..
أشعلتُ سيكارة لي أيضاً، ورحت أدخن بصمت ..
عندك أغنية؟ وياريت تكون حزينة، قالتها وهي ماتزال تُسرّح بصرها عبر النافذة ..
لدي بضعة أشرطة تسجيل، لا أظن أنها تلائم ذائقتك؟
وما أدراك بذائقتي؟!
صحيح، كيف تسنى لي أن أكلمها بهذا الشكل، تبسمت ورحت أداري حرجي، قلت: العفو، أنا (دقة قديمة) أحب كل ماهو قديم، لا تجذبني موسيقى وغناء هذا الجيل ..
خذ هذا الشريط، غزلان، صوتها شجن، يجمع القديم والحديث .. صدحت الأغنية (غفا رسمك بعيني من الصبا لليوم) لسعدي الحلي، بصوت غزلان، له وقع آخر ..
ما بك لا تتكلم؟
أنا؟!، أجل أنت ..
أخاف ..
مم تخاف؟ شكلك مو خوّاف !
أخاف أن تُسمعيني شيئاً، ألعن من الذي سمعته قبل قليل !
وما الذي سمعتهُ مني؟
قُلتِ لي (آنسة بعينك!) ..
إنفجرت بضحكة ناعمة، سرت عدواها إلي، فرحتُ أقهقه معها ..
شكراً لك، أضحكتني و قلبي ممتليء بالغيظ والحزن .!
الحمد لله أنكِ ضحكتي، الضحك يُسريّ عن النفس ويبعث السعادة في القلب ..
لم ترد على كلامي، وكأن ما قلته لايعنيها، تطلعت نحوي بنظرة محايدة، لم أفهمها، هل إتفقت معي أم إعتبرت ما قلته هراء ومجاملة تافهة؟ لاأدري!
خيم الصمت علينا من جديد، ونحن ندخن ونستمع الى صوت غزلان، خشيت الوصول الى منطقة الدورة، دون أن أتعرف عليها بشكل كاف، شغلتني فكرة وصولها ورحيلها بعد لحظات، ربما لن تتاح لي فرصة ثانية لرؤيتها، وقد لا نلتقي بعد هذه اللحظة ابداً؟!
فكرت أن أستفزها، لعلها تبوح لي بشيء من حكايتها، التي أثارت فضولي وشجوني في آن واحد !
قُلتُ:
لا أكتمك سراً يا سيدتي، خشيت أن تتوسع رقعة الخلاف التي شهدتها، بينك وبين ذلك الرجل الضخم، الى الحد الذي...
حد ماذا؟! قُل ..
أن يمُدَّ يده، لا سامح الله ويضربك .
يضربني؟! (ههءءءءءء ) مَطّتها بالنغمة المصرية، مَنْ؟
خراعة الخضرة هذا؟ ليته فعلها، كنت سأكسر له يده وأجعله أضحوكة للناس.
إهدأي يا آنسة أرجوك، قلتها بنبرة لاتخلو من خبث ومشاكسة !
ضَحكتْ: يبدو أن (الآنسة بعينك) أعجبتك؟
في الحقيقة لا، لكني إحترت بِمَ أناديكِ؟ لا تعجبك الآنسة ولا السيدة ولا المدام ! ههههه
إسمي هناء ..
قُلتُ: هناء؟ إذاً عاشت الأسماء .
أنا علاء ..
قالت: عاشت الأسامي يا سيد علاء ..
ضحكنا من جديد، مسحت عينيها الدامعتين، ثم عادت الى صمتها الأول !
سرى في داخلي شعور بالألفة، إحساس يوحي بأنك تعرف هذا الشخص، وإنك إلتقيته في زمان ومكان ما!
في حلم، في يقظة؟ لاتدري، لكنك إلتقيته !
صرتُ أؤمن بأن الأرواح تنسجم، تتجاذب أو تتنافر، بفعل قوة خفية، غامضة، تتحكم بها وتسيرها .
وإلا، إلى مَ تنسب شعورك بالراحة والإنسجام مع شخص تقابله لأول مرة، وتنشرح معه حتى دون أن تكلمه؟!
وإحساسك بالضيق والإختناق وكأن جبلاً يكتم على صدرك، وأنت تلتقي شخصاً آخر، للحظات ولأول مرة أيضاً، حتى دون أن تكلمه؟!
هذا ما حصل لي مع هناء !
إذ حتى في لحظات توترها وأوج غضبها وإنفلات لسانها، لم يخالجني إحساس سلبي تجاهها، أبداً.
على العكس، كنت مشفقاً عليها ووددتُ في سري أن أمد لها يد العون، بعيداً عن النوايا التي تغلف أحياناً شهامتنا المزعومة بمساعدة إمراة طارئة، تمتلك مثل هذا الحسن والجاذبية.
بدت لي في العشرين من عمرها، سمراء حنطية أقرب الى البياض، متوسطة الطول، ممتلئة بلا ترهل، عيناها صغيرتان بلون البندق الفاتح، تلتمعان بذكاء وبعض المكر والشراسة، تمنحانها سطوة ورهبة، حينما تغضب، وتبعثان إشارة صارمة وواضحة، لكل من يجازف بالدنو منها، مفادها: أن قف عند حدك.
أظن أنكِ عانيتِ حياة قاسية وظروف مريرة، يا هناء؟
قالت:
وجدتُ نفسي في المكان الخطأ، مع الشخص الخطأ، لا أدعي بأني كنتُ ساذجة، وأن أهلي أرغموني على الزواج، بالعكس، فكل ما جرى، كان بإختياري وإرادتي .
كُنتُ في السابعة عشر ولدي فسحة من الحرية تغبطني عليها الكثير من قريناتي، وضعنا المادي لا بأس به، بإمكانك أن تقول متوسط .
تقاعد والدي وإيجار مُشتمل ملحق ببيتنا، يغطيان تكاليف الشهر ويفيض أحيانا، أمي طيبة ومُدبرة، لي أخ شقيق، وأختان من زواج أبي السابق، صلتي بأخواتي شبه مقطوعة، آخر لقاء بيننا كان يوم وفاة أبي، كُنت حينها في العاشرة من عمري.
رأيته أول مرة، قرب مأكولات الساعي، في ساحة بيروت، كنت صحبة أمي وأخي عدنان، نقف على الرصيف في إنتظار سيارة أجرة، كان الوقت عصراً، والتاكسيات شحيحة في هذه الساعة من النهار.
أنزل شخصاً أمام واجهة المطعم، ثم إنطلق بسيارته السوبر البيضاء، إجتازنا بضعة أمتار، توقف فجأة، ثم عاد مسرعاً وكأنه نسي أمراً، أو سقط منه شيئاً في المكان الذي غادره !
لكنه توقف إزائنا وسأل والدتي بصوت محايد رصين: تاكسي؟ تنتظرون تاكسي يا أختاه؟
ردت أمي بنبرة جافة متعثرة: أجل، ننتظر سيارة أجرة، لا أظنها سيارتك!
لا تغركم المظاهر يا أختي، أعمل على هذه السيارة بالاجرة بعد الدوام، والشخص الذي أنزلته قبل لحظات، كان راكباً عادياً.
لا أعرف ما الذي دعاني الى التدخل في تلك اللحظة، ربما قسمتي السوداء؟ ورغم إحساسي بذات الشعور الذي راود أمي، لكني همست بأذنها:
الرجل لن يأكلنا، نحن في وضح النهار يا أمي، حثثتها على الصعود، فصعدنا.
لا أخفيك، كنتُ مأخوذة بالسيارة الفارهة ومظاهر الغنى الواضحة على ثيابه وعطره وساعة يده وخاتمه، لم يكن بديناً مثلما رأيته اليوم، كان ممتلئاً وعليه مسحة من الوسامة، كنتُ أظن، مثل أي فتاة بعمري، لا تمتلك تجربة كافية في الحياة، بان المال والغِنى، هما مصدر السعادة وينبوعها السحري.
حكايتي ليست فلم هندي أو عربي، البيت الذي رأيته هو بيته، لم تزاحمني حماة أو يتدخل أحد في شأني وحياتي ..
قاطعتها بسؤال غبي، لا أعرف كيف إنفلت مني:
نسوانجي، أكيد نسوانجي، له زوجات وعشيقات، إكتشفتِ أمرهن لاحقاً؟
يا ريت كان نسوانجي، ياريت، قالتها وهي تنزل زجاج النافذة الى أقصاه، تطلعت الى نقطة بعيدة في مكان ما، من المدينة، وفي لحظة تنبهت وكأنها كانت مُنومة مغناطيسياً، وأحست بأني كنت إستدرجها للبوح عن أسرارها والإعتراف بماضيها، فصاحت غاضبة والشرر يتطاير من عينيها البندقيتين الجميلتين:
كيف تسمح لنفسك بأن تلقي علي مثل هذه الأسئلة؟!
كلكم من طينة واحدة، أنزلني هنا فوراً، مدت يدها المرتجفة في حقيبتها، جَعَّدت ورقة نقدية فئة الخمسة دنانير وقذفتها بوجهي !
أنزلني هنا بسرعة، اللعنة عليكم جميعاً، اللعنة.
***
علي صالح جيكور