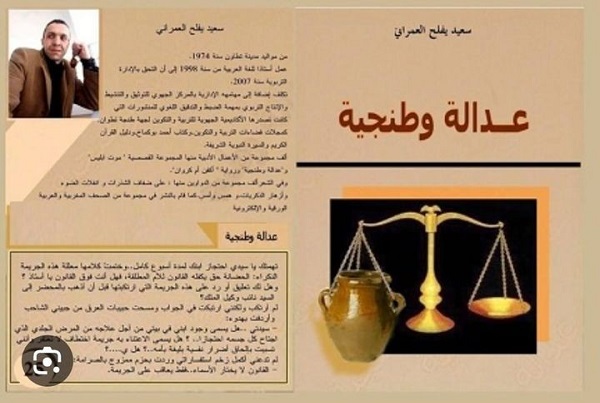صحيفة المثقف
مجدي إبراهيم: الفلسفة والموضوعية
 الناسُ قد تعودوا في عالم البحث العلمي أن يركزوا بحوثهم إمَّا على الشخصيات أو على القضايا؛ فيأتي بحث الباحث منهم منصباً مثلاً على شخصيّة فكرية بعينها؛ ليجعلها مدار اهتمامه يدور بها على جوانبها المختلفة سيرة وحياة فكرية في إطار هذه السيرة، ثم من خلال تلك السيرة تبرز أمامه القضايا التي يتناولها صاحب الشخصية المدروسة ليسلط عليها الباحث جوانب الضوء فيما عساه يظهر فيها مما قد وقف عليه من أفكار ومواقف. أما حين يكون التركيز الغالب على القضايا؛ فإنه يغفل جوانب السيرة والحياة الفكرية، ويجعل تركيزه قائماً على الرأي في معالجة القضية التي هو بصددها من حيث هى فكرة، غاضاً الطرف عن صاحبها.
الناسُ قد تعودوا في عالم البحث العلمي أن يركزوا بحوثهم إمَّا على الشخصيات أو على القضايا؛ فيأتي بحث الباحث منهم منصباً مثلاً على شخصيّة فكرية بعينها؛ ليجعلها مدار اهتمامه يدور بها على جوانبها المختلفة سيرة وحياة فكرية في إطار هذه السيرة، ثم من خلال تلك السيرة تبرز أمامه القضايا التي يتناولها صاحب الشخصية المدروسة ليسلط عليها الباحث جوانب الضوء فيما عساه يظهر فيها مما قد وقف عليه من أفكار ومواقف. أما حين يكون التركيز الغالب على القضايا؛ فإنه يغفل جوانب السيرة والحياة الفكرية، ويجعل تركيزه قائماً على الرأي في معالجة القضية التي هو بصددها من حيث هى فكرة، غاضاً الطرف عن صاحبها.
والواقع أنه لا تنفصل الشخصية بحال عن قضيتها، كما لا ينفصل البحث العلمي نفسه، وإنْ تجرَّد الباحث غاية التَّجَرَّد، عن الدمج فيه بين الشخصيات والقضايا؛ لأننا نعلم بداهةً أن لكل شخصية قضاياها التي تشغلها ولكل قضية شخصيات أبرزوها على ساحة الحياة الفكرية، يكمّل اللاحق ما توقف عنده السابق، ويضيف عليه و يزيد، أو يسدَّ القصور الذي سبقه إليه أقرانه وتجرَّدت له همته؛ موضوعاً في الاعتبار ما استجد من طوارئ الأحداث وما تغير من نبض العصر وحركة الحياة اليوميّة.
لا شك تجيء تلك الإضافة علامة بارزة على الشخصية نفسها من جانب، وعلى القضية من جانب آخر؛ فمن حيث كونها علامة بارزة على الشخصية؛ فإنه لا يستطيع أحد أن يتحدَّث في قضية ما، فضلاً عن أن يكتب فيها، ما لم تكن شواغله الباطنة، عقلية أو وجدانية، هى البواعث التي حركته نحو تناولها والبحث عنها والكتابة فيها، ناهيك عن المواقف الأخلاقية التي تقوم بين الكاتب وقضيته، والشخصية واهتماماتها؛ مما كان تقرَّر عنده سلفاً إزاء ما هو مهتم به.
هنالك جوانب في الشخصية هى نفسها الجوانب التي تجعل من القضية الشاغلة مواطن اتفاق بينها وبين ذلك الذي كتب فيها وسلط عليها الأضواء .. ما لذي جعله يميل إلى هنا ويترك ما دونه، يكتب في هذا ولا يستهويه سواه، يعكف على هذا العلم وَيُفرِّعه على غيره من قضايا بعينها؟ حتى إذا ما تعرضت ادْراكاته إلى علم غيره لم تجد ما يسعفها فيه، ما الذي جعله يفعل ذلك إلّا أن تكون ثمة حالة من الوفاق الباطني بين الشخصية والقضية؟
فإذا نحن وقفنا على دواعي هذا الوفاق أدركنا حالة التَّوحُّد بين الشخصية وموضوعها؛ وإذن ليس ثمة موضوعية على الوجه الذي يحدّده العلم من معنى كلمة موضوعية كما تتحدد في مجال العلوم الطبيعية والرياضية.
هذا عن الإضافة إلى كونها علامة بارزة على الشخصية نفسها. أمّا من حيث كون هذه الإضافة علامة بارزة على القضية؛ فلا توجد قضايا مطروحة على الساحة إلّا ويوجد معها الأشخاص الذين يطرحونها، فلن تطرح القضية نفسها بنفسها، ولا تطرح بغير ما وَرَدَ عنها في السابق.
ومن هنا شَاَعَ بيننا القول المأثور ونحن بصدد تعليم مبادئ البحث العلمي في العلوم النظرية الإنسانية بضرورة مراعاة شخصية الباحث فيما عساه يتناوله من موضوع مبحوث كخطوة منهجية أوليّة يمكنه فيما بعد التعمق فيها، يصقلها بالدراسة وينبتها في تربة صالحة للغرس والإنبات، تبرز فيها إضافته العلمية من حيث الرأي والتوجه والأصالة والمعرفة. ناهيك عن المنهج المستخدم في مجال النقد والمقارنات؛ فإنا لنعتقد أن أفضل المقارنات ما كان بين المتباعدين في البيئة والزمان؛ لأن التشابه بين أبناء البيئة الواحدة والزمن الواحد لا يميز الأضداد، ولا يكشف علة الاختلاف أو التوافق، ولكننا إذا قارنا بين اثنين تفرقهما البيئة والزمان ثم رأينا علامات التشابه بينهما واضحة وكشفنا عن علة التوافق؛ فهو الدليل القاطع على فعل العلة التي يشتركان فيها؛ وإبراز الهوى الذي سيطر على نفسية كل منهما .. وهى علة واضحة لسبب مشترك في هوى إنساني موجود.
هنالك تكون القضية دالة من الوهلة الأولى على كل مَنْ كَتَبَ فيها من طريق تلك الإضافة العلمية (بمنهج المقارنة والنقد أو غيرهما إنْ شئت)، وما عليك إلاّ أن تتبع جذورها المعرفية؛ لتواجه طابوراً من الأشخاص الذين كتبوا فيها أو أشاروا إليها مجرد إشارة؛ أضافوا أو نوَّهوا، وتلتقي بأفكار فيها كانت مهمة من هنا أو من هناك غير مفصولة عن أصحابها، وغير منسوبة إلاّ للذين كان لهم قصب السَبْق في معالجتها جيلاً وراء جيل.
انفصال الموضوع عن الذات في العلوم الإنسانية النظرية يدل من الوهلة الأولى على غيبة الوعي بكل تأكيد، وبخاصّة فيما لو كانت تلك العلوم هى من قبيل العلوم التي تمس جوانب العقيدة الدينية وتشغل وجدان المؤمنين بها؛ فلن تكون القضية إذْ ذَاَكَ مفصولة عن الشخصية ولا الشخصية تجيء بمعزل عن القضية التي تتناولها. وربما كان هذا الانفصال يمثل على المستوى الخُلقي خطورة شديدة؛ لأنه يعزل الوعي عن الذات، ويقدح في مصداقية الشخص الذي يثير قضيته وهو غير مؤمن بها ولا مؤمن بما يثار حولها، ناهيك عما إذا كان يكتب فيها أصلاً، وبالتالي يجعل الموضوع في ناحية، والمتحدِّث أو الكاتب في هذا الموضوع في ناحية أخرى، ويحلو له أن يسمي هذا أو ما يشبهه بالموضوعية العلمية وهى عندي غيبة غارقة في الوهم بكل تأكيد.
وهمٌ؛ لأنه يفهم الموضوعية العلمية خطأ، وبطبيعة الحال هذا كله شيء، ومراجعة الأفكار ومناقشتها شيء آخر؛ فليس معنى أن تكون القضيّة مستقرة في وعي صاحبها أو الفكرة المعروضة ممزوجة بحياة كاتبها أن يقوده ذلك إلى التعصب لها ورؤيتها هى فقط في حين لا يرى سواها؛ فمثل هذا التعصب نفسه هو كذلك ضد الوعي؛ لأنه ضد منطق العقل؛ وكما يكون ضد الوعي وضد العقل، يكون كذلك ضد الوفاق الأيديولوجي بين النظر والتطبيق أو بين القضية والشخصية المتناولة مما يعكس إغراقاً في الذاتيّة على حساب الموضوعية التي هى أولى خطوات البحث العلمي؛ الموضوعية بمعنى التجرُّد والنزاهة في الحكم وقبول الرأي الآخر المخالف وتوسيع دائرة الوعي حول ما هو مطروح.
وهنا تجيء الموضوعيّة لتفرض نفسها على بساط البحث العلمي؛ فلا سبيل من هذه الجهة إلا بالأخذ بها مادام كل شيء عرضة للمراجعة والنقد والنقاش شريطة أن نفهم بدايةً كيفية ممارستها من طريق الحوار الهادف البنّاء، وإبرار الجوانب السلبية التي تؤثر على الموضوع كما تقدح بذات القدر في صاحب الموضوع نفسه كونه يتحدَّث بما لم تكن قناعاته وافية بما لديه عن موضوعه؛ الأمر الذي يسبب هوة سحيقة وسيعة بين ما يقوله وما يسلكه أو بين عقيدته وتطبيقاتها العملية.
ومن الموضوعية أيضاً أن نقول بداهةً؛ إن إيُماننا بالوعي، مطلق الوعي، يُقرر : إنه لا توجد الأشياء في عالم الأعيان مستقلةً عن ذواتنا العارفة؛ لأننا لو قلنا بذلك لأنكرنا القيم، مطلق القيم، وعزلناها عن الحركة والفاعليّة والحياة.
رمز الفكرة الأخلاقية هو المطلق الحقيقي، والشيء في ذاته، الأمر الذي جعل من فيلسوف كبير مثل "كانط" ينادي بصدارة العقل العملي نصّاً وروحاً؛ فالأخلاقيّة غاية وسيلتها الإرادة الخالصة، والكون هو شرط النشاط الأخلاقي ونقطة ممارسته، وإذا وجدت عقبات في سبيل تحقيق هذا الشرط، فليست العقبة إلَّا فرصة مناسبة لبذل المجهود، وما الذهن إلا مرحلة تتيح له النمو والتطور والصقل مع فاعلية هذا الفعل الحر.
لذلك؛ كان التفلسف هو إقناع المرء نفسه بأن الوجود الواقع ليس بشيء، وأن الواجب هو كل شيء.
ومعنى أن نتفلسف: أن نتبيَّن بطلان العالم "الظاهراتي" مُفارقاً لماهيته المعقولة؛ وأن نرى في عالم الأعيان، لا معلولاً لعلل غريبة عن عقلنا العملي؛ بل نتاجاً للأنا ذات الموضوع.
فليس هناك من علم سوى علم الأنا، أو الوعي، أو الوجدان. والمعرفة ليست في جملتها ولا في جزء منها، نتاجاً للإحساس؛ بل هى كلها من صنع الأنا العارفة، ومن خلق الأنا العارفة. والتفلسف والمعرفة والعلم هى إنتاج الحقائق لا الاهتداء إلى حقائق جاهزة.
ومن الناس من ليس لديهم إلا شعور ضئيل بالقيمة الأخلاقيّة للإنسان ومدى استقلاله؛ لأنهم ضحيّة أوهام خدّاعة وعبودية عقليّة. مثل هؤلاء لا يملكون الشخصيّة الكافيّة ولا الاستقلال اللازم كيما يكونوا فاعلين ومؤثرين؛ لأنهم فقدوا الاندماج الكلي بين العالم الخارجي والذوات العارفة؛ فإذا المعرفة لديهم، مع هذا الفقدان، لا تتجاوز السطح الخارجي والقشرة البرّانيّة. أما الرجال الواثقون بأنفسهم والذين يؤمنون بأنهم متميزون عن غيرهم من الكائنات الطبيعية الحيّة، فهم وحدهم القادرون على الفاعليّة والتأثير .. أي أنهم القادرون على الاندماج الكلي بين العالم الخارجي والذوات العارفة. وهنا تجيء المعرفة فوق الموضوعية بمراحل، تتجاوزها وتعلو عليها إذ تصدر من وعي الذات بعرفانها ولا تصدر حكماً فكرياً من خارج وكفى.
من هذا الفعل وذاك التأثير؛ جاءت الصدارة للفكر الذي يختاره المفكر، أو للفلسفة التي يؤمن بها، أو للقضية التي يطرحها أو بالطريقة التي يعرضها للناس على قناعة وحَبُور. ومن أجل هذا؛ كان اختيار الشخص لأي ضرب من ضروب الفلسفة وقضاياها متوقفاً إلى حد كبير على أي صنف من الرجال عساه يكون؟
معنى هذا؛ أن فلسفة كل إنسان تعتمد في الغالب على طبعه واستعداده وميوله، أي تعتمد على قناعاته، وعلى مدى ارتباط هذه القناعات بمعارفه التي تشكلت منها. ومن الموضوعية - لا ضدها - قبولها كخطوة منهجية نحو التحقق الفعلي؛ فلو سلّمنا تسليماً قطعيّاً بوجود الأشياء في عالم الأعيان مستقلة عن ذواتنا العارفة، لكان معنى ذلك إنكار الوعي الإنساني برمّته. ولكن العكس أيضاً يكون صحيحاً؛ فإنّ اتحاد الأشياء في عالم الأعيان بذواتنا العارفة، أو على الأقل: تمثّلها لهذه الذوات يُعلي من شأن الوعي، ويبلغ به درجات غير عاديّة من الإدراك العالي لا العادي. والحقيقة التي يتجاهلها أكثر الناس خاصّتهم قبل عامتهم هى أن صاحب الدعوة إلى فكرة ما، كائنة ما كانت هذه الفكرة : في الدين، وفي التصوف، وفي الفلسفة، وفي الفن، وفي الأدب، وفي القيم، وفي مسائل التقدّم أو في مسائل المصير .. إذا هو لم يخضع حياته الشخصيّة لما يدعو إليه، فتعكس شخصيته قضيته، وإيمانه على المستوى النظري يجسّده واقعه العملي، جاءت دعوته من الأثر الضعيف في حياة الآخرين بحيث تصبح تلك الدعوة (طق حنك) كما يقول السوريون، تصبح هباءً منثوراً .. كأن لم تكن!
وتلك هى خطورة حملة الأقلام من أصحاب الدعوات وأصحاب الرسالات في العلم والفن والفلسفة والدين والقيم، وفي كل مهنة، وفي كل رسالة، خطورة تبقى على مدار العصور والأحقاب الزمنية المتلاحقة فضلاً عن أثرها السيئ على صاحب الدعوة نفسها. العقيدة في ناحية، والعمل في ناحية أخرى، الخطاب الأيديولوجي في كفة، والممارسة الفعلية في كفة مقابلة. هنالك هُوّة فاصلة بين النظر والتطبيق، الأمر الذي يقدح في الوعي عموماً فضلاً عن ما يسببه انفصال الموضوع عن الذات من ازدواجية المعايير الخُلقية.
***
إذا نحن نقلنا هذه المفاهيم؛ بما فيها من فكرة الوعي، إلى دائرة التصوف، وجدناها محققة في أكثر الذين درسوه، وتوافروا على دراسته بصدق، فانعكس منه على شخصياتهم بموجب القضايا التي أسهموا فيها وأدلوا بدلوهم في تنظيرها وإماطة اللثام عنها. فلم تنفصل الشخصية بحال عن قضيتها، بمقدار ما أنعكس ذلك على الشخصية نفسها من الوجهة الأخلاقيّة فظهر لديهم ما أطلقنا عليه "حالة الوفاق الباطني" بين الشخصية والقضية؛ الأمر الذي جعل التّوحُّد بين الشخصية وموضوعها علامة إسهام حقيقي لا مناص من تسليط الضوء عليه؛ لكشف آثاره فضلاً عن منطلقاته وبواعثه في الكاتب قبل الموضوع.
يُقَاسُ الوعي بمدى اتصاله في نفس الكاتب بالموضوع المطروح سواء من جهة العلم أو من جهة الأخلاق؛ فليس يكفي في هذا الحقل المعرفي أن تعلم وكفى، أو أن تحيط علماً بالموضوع من كل جوانبه وأطرافه دون أن ينعكس ذلك على شخصيتك ليتحوّل علمك بالشيء نظريّاً إلى معرفة محققة في الواقع الفعلي. ليس يكفي العلم فقط ما لم تكن المعرفة مَجْلىَ من مجالي العلم الذي تبحث فيه؛ فإذا كان العلمُ كرؤية النار مثلاً فالمعرفة كالاصطلاء بها. ومن أجل هذا؛ جاءت التفرقة في علم حدود أحكام الألفاظ الصوفيّة واضحة وضوح الشمس في ضحاها بين المعرفة والعلم؛ فكان أكثرهم مع التفرقة يفضل المعرفة على العلم، وبعضهم في القليل النادر يفضل العلم على المعرفة، لكن المعرفة في عبارة الصوفية هى : العلم الذي لا يقبل الشك بوجه من الوجوه، إذا كان المعلوم ذات الله وصفاته. سِرُّ المعرفة هو "التوحيد" والتنزيه المطلق لله : حياته، وعلمه، وقدرته، وإرادته، وسمعه، وبصره، وكلامه، عن التشبيه بصفات الخلق؛ لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وموضوع المعرفة عند الصوفية هو : ذات الله وصفاته وأفعاله، وهو أسمى موضوع لأسمى معرفة. وأداتها : كما هو معروف محقق لديهم هو القلب لا العقل. وحقيقة التوحيد هى : باطن المعرفة، وهو سَبْق المعروف إلى مَنْ به تَعَرَّف، بصفة مخصوصة، بحبيب مُقَرَّب مخصوص، ولا يَسَعُ معرفة ذلك الكافة ... وإذا تناهت عقول العقلاء إلى التوحيد تناهت إلى الحيرة : أي تناهت إلى حيرة المعرفة. هذه الحيرة المعرفية ليست من ميدان الفلسفة، ولا تدل الفلسفة عليها لا من قريب ولا من بعيد، ولكنها حيرة من نوع آخر لا يتمثله العقل الفلسفي بوجه من الوجوه؛ هي حيرة يضمنها عرفان. وعرفانٌ تستولي عليه الحيرة من جميع أطرافه. هذه الحيرة نفسها معرفة !
أوّلُّ الدلالة المباشرة على الوعي العالي في حقول المعارف الذوقيّة هو المعرفة بالله من حيث دلالتها على التوحيد، ومن حيث أداتها المعرفية. فلو أن أحداً قال : في أي مقام تصحُّ المعرفة الحقيقية؟ لكانت الإجابة قاطعة : في مقام الرؤية والمشاهدة بسرِّ القلب. ولكَ أن تلاحظ هنا أن المعرفة الحقيقية تحدث في مقام الرؤية والمشاهدة بسرِّ القلب. لاحظ ثلاث كلمات معرفية رئيسة هى "المعرفة" ثم "المقام" الذي تجري فيه، ثم هناك سر القلب، أي ذلك المستودع الجوَّانيِّ الباطن الذي تقوم فيه المعرفة رؤية وشهوداً؛ لترى الوعي هنا وعياً عالياً ليس بالعادي، وأن مجرى هذا الشهود مرهونٌ بارتقاء هذا الوعي إلى حيث مرَاقيه الروحيّة الخالصة؛ ليتم من خلاله العرفان المؤسس على المضمون الديني : معرفة الله ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً.
فلا تحدث المعرفة حين تحدُث وهى بَرَّانيَّة غير ممدودة بوجود روحي محقق في العارف على التحقيق. فلا بدّ لها من رؤية، ولا بدّ لها من شهود، ولا بد لها من قلب عارف يحفظ السِّر ويلاقيه؛ فسِرُّ القلب هو الذي يستوعب المعرفة الحقيقية ويتغذى بها بمقدار ما لديه من رؤية وشهود. إنما يُرَىَ ليُعْرَفْ؛ ولأن المعرفة حقيقة تكون في باطن "الرؤية"؛ فيرفع الله تعالى الحجب فيريهم، أي يُرِىَ عارفيه نور ذاته وصفاته من وراء الحجب ليعرفوه، يرفع بعضها لا كلها لكيلا يحترق الرائي كما قال بعضهم بلسان الحال :
ولو أَنْيِ ظَهَـرْتُ بِلَا حِجَابِ ليَتَمْتُ الخَلَائِقَ أَجْمَعِيِنَا
وَلَكِنَّ الحِجَابَ لَطِيِفُ مَعْنَىَ بِهِ تَحْيَاَ قُلُوبُ العَاشِقِيِنَا
وبمقدار الدلالة المباشرة على الوعي العالي في حقول المعارف الصوفيّة جاءت التفرقة منهجياً بين العارف والعالم؛ فكان مما أطلق عليه شيوخ الصوفيّة - كما يَروي الهجويري- اسم المعرفة على كل علم متصل بعمل تعبُّدي وحال رَبَّاني : حالُ العبد ها هنا مع الله يدل على علمه. وفي هذه الحالة لا يسمى صاحب الحال عالماً ولكن يسمى "عارفاً". أما اسم العلم فيُطلق على كل فن خَلَىَ من معنى رُوُحَاني وعمل تَعَبُّدي؛ أي خَلَىَ من ذلك الاتصال بين نفس الكاتب والموضوع المطروح، أو خَلَىَ من تلك الحالة التي أطلقنا عليها في السابق بحالة " الوفاق الباطني" بين الشخصية والقضية. وعندهم : أن صاحب هذه المعرفة لا يسمى عارفاً ولكن يُسمى "عالماً"؛ فالعلم بالشيء هاهنا بَرَّانيٌّ لا يدُلُّ على وعي عالٍ, فضلاً عن قلة دلالته على وعي أصلاً لا هو بالعالي ولا هو بالعادي. وعليه؛ فمن عَرَفَ معنى الشيء وحقيقته يسمونه "عارفاً". ومن ألَمَّ بعبارات منطقية وحفظها بدون إدراك حقيقة روحانيّة فهو عالم وكفى، عالم بالشيء غير عارف به. العالم قائم بنفسه. والعارف قائم بربه.
ليس التصوف إذن قراءة نظرية يفني فيها المتصوف عمره بين قيل وقال؛ وإنْ كانت فاعلية القراءة كونها عملاً ذهنياً لا يُستغنى عنه بحال، ولكنها في الوقت نفسه ليست هى المطلوبة في ذاتها حتى ولو كانت موجهة إلى كتب الصوفية أنفسهم، فلن تكون من أهل القرب والوصال وأنت تكتفي بالقراءة في كتب الصوفية صباح مساء، لكن بمجرد أن يتحول فيك ما تقرأ إلى عمل مستمر هنالك يصحُّ أن تكون جديراً بلقب صوفي، وفي الوقت ذاته أيضاً ليس بصوفي من يستغني عن المعارف النظرية ولا عن التوجه المعرفي الذي يمنع الجهالة ويدحر الركود إلى البلادة العقلية؛ لأن الصوفي من هذه الجهة طالب علم فوق كونه طالب تصفية؛ ولأن التصفية تحتاج إلى استبصار لإزالة غشاوة الباطن؛ فلابدّ له من بصيرة تهيئ المطلوب كونه غاية سامية تنال بالعلم أولاً ثم بالعلم ثانياً على الموافقة والتبصرة.
إنه؛ إذا كان المطلوب وجه الله تعالى؛ فليس أصعب إنْ في التصور وإنْ في العلم من مهبّة الاستعداد للوصول إليه. وإذا كانت المشقة على قدر الغاية صارت تقتضي أهبَّة الاستعداد للوصول إليه تعالى أن يتكرر معنا القول بأن التصوف ليس قراءة ولا كتابة بمقدار ما هو علاقة باطنة يُحسن فيها العبد مسيرة الطريق وفق منهج الذوق والشعور والاستبصار، ويرتقي خلال المسيرة إلى حيث إصابة الغاية من الطريق نفسه ثم يُسقطها فيكون إذْ ذَاَكَ مع الله دَوْمَاً بلا علاقة. إلى مثل هذا كانت إشارة طاووس العلماء الجنيد بن محمد البغدادي إلى التصوف : أن يكون العبد فيه بلا علاقة.
تتأتى معرفة الله بالإشراق والانكشاف والإلهام (انظر قلبك؛ لأنَّ ملكوت السَّموات والأرض فيك) هكذا يقول الصوفي. والنظر إلى القلب يدعو باستمرار إلى "الجهاد الباطن" أي : إزالة غشاوة القلب مما ران عليه من مكتسبات الشرور والآثام. وإنه لقول يدلُّ من الوهلة الأولى أبلغ الدلالة على هذا الوعي العالي : وعي الصوفي المُحَقِّق الولي العارف وليس هو بوعي سواه. أبحث - إنْ شئت - عن ملكة التعلق : فيما عَسَاَكَ توجهها؟ أفي شغل دائم لا ينقطع بعلم الأسباب، أم في شغل العلم بالله؟ فلئن كانت الثانية فقد صارت بعيدة بعيدة بعد أن كانت قريبة قريبة. ولئن كانت الحالة الأولى فلقد أورثت صدأً على وجه القلب فكانت مانعاً كثيفاً من تجلي الحق فيه؛ فانقطع.
الغريب في الأمر، أن قبول مجلى تجلي الحق أو عدمه يرجع إلى القلب، فلو كان على القلب صدأٌ لم يعد يقبل جهة الحق .. لماذا؟ لأنه ببساطة شديدة كان قبل غيرها، أي قبل الاشتغال بالأسباب فاستغرقت طاقة النور القلبي بكليّتها؛ فحُجب.
والاشتغال بالأسباب صدأ قلبي .. بالتعبير القرآني البديع هو (الكنّ، والقفل، والعمى، والرَّان).
فإن قلت : فما بالُ العقل؟ ألم يُعرف الحق بالعقل؟
أقول لك مع ابن عربي : مدارك العقل محدودة بحدود ما يدرك من الأمور على جهة : الجوهر، والطبع، والحالة، والهيئة. ولا يدرك العقل شيئاً لا توجد فيه هذه الأشياء. وهذه الأشياء لا توجد في الله تعالى، فلا يعلمه العقل أصلاً من حيث هو ناظر وباحث؛ لأن نظر العقل من حيث برهانه الذي يستند إليه هو الحسّ أو الضرورة أو التجربة الحسية. وكلمة الضرورة تعني من حيث ما يُعلم لديه بالضرورة، وهذا لا يكون إلا لوقائع عينيّة.
يقدح الدليل العقلي في العلم بالله، ويعجب المرء حين يرى الفلاسفة المسلمين يقدّمون أدلة عقلية على وجود الله. ألم يقرأوا حديث رسول الله، صلوات الله عليه : إنّ القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد ... وفيه : إنّ جلاءها ذكر الله وتلاوة القرآن. ثم هل خلت أنظار الفلاسفة من قلوب تعقل، في أنفسها، عن الله دليله؟
أيحتاج وجود الله إلى دليل غيره؟ أتحتاج معرفة الله إلى دليل سواه؟
شَغَلَ الفلاسفة أنفسهم، وشغلونا من بعدهم، بحجب الأدلة العقلية، ولم يتحققوا قيد أنملة أن معرفة الحق متجلاّه على الدوام بغير انقطاع لا يُتصور في حقها حجاب عنّا، غير أنّ مجلاها القلب الصافي عن لوثات التكدير، الخالي من ظلمة حجب الأسباب. وعلى الله وحده، توفيقه ورعايته، جلاء القلوب التي صدأت من كزازة الدنيا ومعاطب الأسباب.
ومن ذلك ترى؛ منهج الوصول إلى هذه المعرفة يقوم على تنظيف القلب والسّر إلى حيث الوصول بهما على ضوء المنهج الذي يحكم صاحبه ويحكمه صاحبه في موضوعه المبحوث.
ومن المؤكد أن هذه الدلالة نفسها تجمع إلى جانب الأساس المعرفي أساساً أخلاقياً من الدرجة الأولى؛ فالأخلاق لا تنفصل عن المعرفة بل هى ثمرة من ثمارها تقوم عليها أصلاً وتأسيساً وتتأسس في رحابها وتنعكس سلوكاً على صاحبها نتيجة معرفته؛ فليس أصدق من عارف ظهرت لديه المعرفة فأثمرت الأخلاق؛ وليس أعلى من رجل القيم الذي دَلَّتْ معارفه على خُلقه واقعاً وتحقيقاً في ميدان الجهاد.
بقلم : د. مجدي إبراهيم