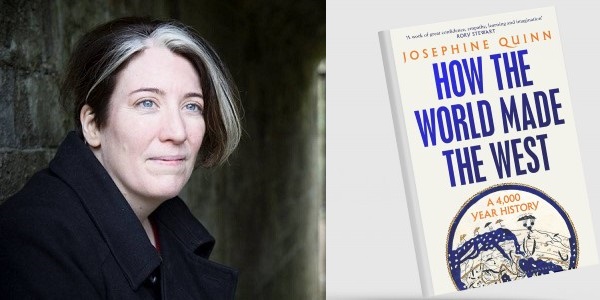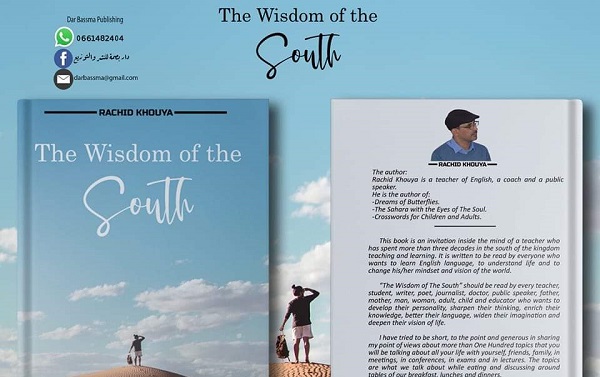صحيفة المثقف
مجدي إبراهيم: وادي الحُمَقاء (3)
 كانت هذه المقالة التي دبَّجها يراع الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه في إذهاب غمِّ القلب، ترى فيها أن الوادي الذي يهيم فيه "الحمقاء" هو وادي دعوى الإرادة في غير محل لقيام الإرادة؛ فالحمقاء هم الذين يريدون غير إرادة الله باعتمادهم على أنفسهم فيما يريدون فلذلك قال الجيلاني: "فلا ترد غير إرادته؛ وغير ذلك منك تمن، وهو وادي الحُمَقاء"؛ لكن هذه الإرادة إذا كانت على النحو الذي قرَّره الشيخ تصبح طلباً للكمال، وطلب الكمال صفة من صفات الروح الإنساني، ولازم من لوازم تطلعه الروحاني؛ بل هو النتيجة الملازمة لكل تلك العواطف والميول والقوى التي ركبت في هذا الفؤاد الخفَّاق الساكن بين الجوانح: طلب الكمال طلب للتحرير للنفس وتأكيد للذات من جانب المعرفة؛ لأنه مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ؛ ولأنه طلبٌ لحقيقة الإنسان الوجودية الأصيلة فيه؛ فمتى تحرَّر، وجد نفسه وشهد حقيقته ولازم إنسانيته.
كانت هذه المقالة التي دبَّجها يراع الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه في إذهاب غمِّ القلب، ترى فيها أن الوادي الذي يهيم فيه "الحمقاء" هو وادي دعوى الإرادة في غير محل لقيام الإرادة؛ فالحمقاء هم الذين يريدون غير إرادة الله باعتمادهم على أنفسهم فيما يريدون فلذلك قال الجيلاني: "فلا ترد غير إرادته؛ وغير ذلك منك تمن، وهو وادي الحُمَقاء"؛ لكن هذه الإرادة إذا كانت على النحو الذي قرَّره الشيخ تصبح طلباً للكمال، وطلب الكمال صفة من صفات الروح الإنساني، ولازم من لوازم تطلعه الروحاني؛ بل هو النتيجة الملازمة لكل تلك العواطف والميول والقوى التي ركبت في هذا الفؤاد الخفَّاق الساكن بين الجوانح: طلب الكمال طلب للتحرير للنفس وتأكيد للذات من جانب المعرفة؛ لأنه مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ؛ ولأنه طلبٌ لحقيقة الإنسان الوجودية الأصيلة فيه؛ فمتى تحرَّر، وجد نفسه وشهد حقيقته ولازم إنسانيته.
على أننا هنا نفرق بين الإرادة في مجال المعرفة، والإرادة في مجال العلم، وبمقتضى هذه التفرقة نستطيع القول بأن الإرادة في ذاتها شيء، وإدراك الإرادة شيء آخر؛ فجميع ما يمكن أن يدركه الإنسان قد يدركه بفعل العلم لا بفعل الإرادة العارفة. وفعل العلم بعيد عن التحقيق؛ لأن علمك بالشيء غير تحققك به.
العلم بالشيء شيء يختلف عن المعرفة به فيما لو كانت المعرفة تستلزم إدراكاً موصوفاً بالتحقق. قد تعلم الفضيلة، وتعلم عنها الكثير لكن علمك هذا شيء غير إدراكك له. وكلمة إدراك تعني هنالك التحقق بالمعروف؛ فالتحقق طريق (= إدراك) يوصل إلى المعرفة، في حين لا يمكن أن يصل الإنسان عن طريق العلم وحده إلى المعرفة ذات التحقق الفعلي؛ فمتى يكون الإنسان عالماً، ومتى يكون عارفاً؟
في الأول؛ عندما يكون الإنسان عالماً ينبغي أن يكون موصوفاً بالعقل والإدراك المنطقي النظري، بينما إذا هو اتصف بالإدراك السلوكي الفعلي والحقيقة الروحانية، أي طبق النظر على العمل، وجمع التحصيل العقلي مع الفعل التجريبي، غير مقتصر على الإلمام الخارجي البرَّاني بالعلوم بغير أن تقوم فيه لطيفة روحانية تؤكد مثل هذا الإلمام، عند ذلك يكون عارفاً لا لشيء إلا لأنه قد تحقق؛ ومعنى كونه قد تحقق أنه عاش التجربة وتذوق حلاوة الحال، وتبيَّن من طريق تجربته معالم الحياة الفعلية الموصوفة له من سبيل العلم وكفى، لكنه لما عاش عَرَفَ، ولما أختبر ذاق، ولما جرَّب تحقق؛ فوصفه تجريب، واختباره تحقيق، وتذوقه مقاساة الحياة شعوراً منه بوجوده الفعلي وحقيقته الأصلية؛ فهو من هذه الجهة يمكن أن يكون عالماً، لكن علمه هذا ليس إدراكاً برانياً من الخارج وإنما هو تحقيق، أي معايشة من الباطن بقيام الحقيقة الروحية فيه، وهو في نفس الوقت يكون عارفاً؛ فالمعرفة والعلم يلتقيان في ولوج "التحقيق" الفعلي والممارسة الواقعية.
تغلب على المعرفة الإرادة ولا تغلب الإرادة على العلم؛ فإذا كانت المعرفة تستند إلى "التحقيق" والمعايشة والحياة، كانت تقتضي أن يكون صاحبها مريداً سالكاً، ذوَّاقاً للطريق الذي يمضي فيه على بينة وعلى بصيرة، وكان من اللازم اللازب له في كل حال أن تكون إرادته سابقة على أفعاله؛ فهو هنا يفعل الفعل لأنه يريده، ويترك هذا الفعل أو ذاك لأنه لا يقع تحت إرادته، وجميع الأفعال المتروكة بالنسبة له إذْ ذَاَكَ لا تقع تحت الإرادة الموجَّهة لاختبار السلوك العملي؛ فالمعرفة من هذه الجهة غير العلم، إذا نحن شرطنا للمعرفة أن تكون الإرادة أحدى مكوناتها الأساسية؛ ثم شَرَطنا تباعاً للإرادة أن تجيء متصفة بأوصاف التحقق الفعلي المرهون بالسلوك المقرون بالفاعلية التي يتحرر فيها المرء من عشوائية الاتجاه بصدد اختيار الأفعال أو تركها، أو بالأحرى يتحرَّر بمقتضى تلك الفاعلية من عشوائية الاختيار.
أما العلم، فما هكذا تكون أوصافه ولا أشراطه : شأن العلم إدراك عقلي وكفى، يغلب فيه النظر العقلي ولا تغلب فيه الإرادة؛ كأن تعلم عن الدين كثيراً لكنك في ذاتك لن تصبح متديناً ما لم تتحقق بالمعرفة في الدين، يعني يتوافر لك جانب الإرادة القائمة على السلوك العملي والممارسة التطبيقية؛ هنالك تخضع العلم للتطبيق؛ فيجيء التطبيق هو الآخر إدراكاً باطنياً لكل حركة معرفية، هو مدد العلم ولا شيء غيره، وهنالك يمكن لك إدراك ما لا يتسنى لك إدراكه بفعل العقل وحده ولكن بفعل الإرادة والتحقيق.
إذا تمَّ للمُدْرِكْ مثل هذا الإدراك، عرف من فوره طريق الحرية؛ لأنه كان عَرَفَ ذاته. وطريق الحرية واحد بوحدة "الذات" لا يتغير ولا يتبدل وفق تلك المفاهيم المتقدمة التي تحمل قيماً غير القيم المتعارف عليها ظاهرياً؛ لا بل هو فوق حدود المفاهيم جميعاً، وفوق قيودها وسدودها وحواجزها. الحرية هنا فوق المفهوم؛ لأن المفهوم قيد وحد، حاجز هو وسد؛ فإذا كانت قيم الحرية تتعدد بمفاهيم القيم واختلافها وتضاربها أحياناً عند أصحابها؛ فهى من أجل ذلك قيم وضعيّة لا تعرف الانفتاح ولكنها تنحصر في المفهوم، وتنحسر في التصور، إذْ لو كانت قيم الحرية مأخوذة ممّا تقدَّم من طريقها المفرد الواضح تحرراً من هوى الإرادة في كل مرغوب فيه، وكانت تحرراً من كل عوائق "الذات" في تحررها؛ لاتفق الجميع على تحديد معنى "القيمة" التي تحدُّ الحرية ولا تدع لمعناها حداً إلا وربطته بالقيمة وأدخلت عليه طريقاً يمكن أن يكون مأخذه سهلاً بمقدار ما يكون طريقه أيسر وغايته في التوجُّه سمحاء !
هل نعيد هنا مقولة الكواكبي مرة أخرى :" قد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة، أن يحول ميلها الطبيعي من طلب الترقي إلى طلب التسفل، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت، وتألمت كما يتألم الأجهر من النور، وإذا ألزمت بالحرية تشقى، وربما تفنى". وهل لنا أن نقارن بينها وبين فعل التحرر هنا؟ وهل هنالك استبداد أسوأ من استبداد النفس على صاحبها واستبداد النفوس المتسلطة على أممها بفعل التسفل والانحطاط؟
مشكلة الحرية في بلادنا أنها تختلف باختلاف الأفراد الذين يزعمون لأنفسهم أو يظنون عندها قدراً من التحرر، وهى في الحق الذي لا مرية فيه أنها مكبلة بقيود الهوى مقرونة بتحقيق المنفعة الخاصة بالأشخاص بعيداً عن التجرد والنزاهة.
من أجل ذلك؛ فلن تكون هنالك حرية ما لم يكن هاهنا في الأصل تحرّر عن القيود الجوَّانيَّة المكبلة برغائب في النفوس مستشرية على غير ما من شأنه أن يكون متوقعاً ممّا عساه ينحدر في أعماق وعينا بهاته النفوس.
ومثله؛ إنّ التقديس الذي نتوخاه ليس تقديس النفوس ولا الأهواء ولا المنازع الخاصة ولا آفات النفس الظلمانية بل هو تقديس "القيمة" في مظانها ومواطنها إذا ما كانت القيمة علوية وكانت أهدافها مستمدة ممّا هو مقدس لا يُمَسُّ الحقائق المصفاة بفعل الهوى أو بفعل النزوع الذاتي المعبأ بالآفات الشخصية والأوهام الذاتية الأنانية. وكل ثورة على "المقدس"، ذي المصدر الإلهي باسم الحرية إنْ هى إلا عبودية للنفس فيما لا عساه تدرك، عبودية للنفس بكل ما في النفس من آفات وأمراض وأوهام تعيش فيها وتتمثلها حتى الرمق الأخير. وإنْ هو إلا عماية وضرب من ضروب الظلمة والضلالة ليس يسعي المرء إلى الخلاص منها وهو مقيد وأسير. كل ثورة على "الوحي" النزيه الحر المقدس ما هى إلا خدمة للهوى الفتاك وضلالُ يقود إلى الضلال!
إن فهم المقدس والاجتهاد في الترقي إليه، ومحاولة تأويله واستخراج مراميه ودلالاته، وإبراز أفقه الواسع الرحيب شيء، ثم التحرر منه وإقحام العقل المحدود لنقده بحجة أنه مقدس، ونقد المقدس لا يستثني منه عمل العقل، شيء آخر! كل محاولات التحرر من قداسة المقدس ذي المصدر الإلهي والتي تتم بواسطة بعض العقول المعزولة عن ملابسة جوهر الإيمان وحقيقته الباطنة إنْ هى إلا محاولات باغية من نفوس ظلمانية وقر فيها الضلال حتى منتهاه. وبغي الناس للناس بغير الحق مردود على الناس أنفسهم، إنما هو بغي بغير الحق على أنفسهم :" يَأيُّهَا النَّاسُ إنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلى أنفُسِكُم، مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّنيَا، ثُمَّ إلينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلون" (يونس : آية 23).
تلك المحاولات إنما هى محاولات تعيش في ظلال العبودية للنفس لا العبودية لله، وعبودية النفس عبث فكري فوق كونه اعوجاجاً باطنياً لا ينمُّ إلا عن قصور في الرؤية وخواء في التفكير والتقدير، ما إن تقرأها وتصبر على قرائتها إلا وتشعر من فورك بالقذارة الفكرية، إنها ليست بحوثاً يغلب عليها عامل الاجتهاد لبلوغ الحقيقة، ولكنها أمراض نفسية باطنة تحكمها لوثات فكرية ظاهرة لا تزول إلا بزوال أصحابها، إذْ ليس لها علاج لأن صاحبها ليس بجاهل حتى يعلم، ولكنه ضال ومنحرف، وغارق إلى أبعد الحدود في الضلالة والانحراف. لا ريب كانت محاولات تعيش في ظلال العبودية للنفس لا لله، وهى من ثمَّ ظلال لها من الأبعاد الذاتية التي تخدم المآرب الشخصية الخاصة الباغية ما من شأنه أن يمنع تحقيق الحرية في أدنى أمد من آمادها المتشعبة الممتدة.
وعليه؛ فالحرية الحقيقية لا تعني ممارسة الأهواء والخزعبلات الشخصية ولا القدرة على تنفيذ ما يستطيعه الفرد بغير رقابة داخلية من عصمة "الضمير" المبطون في أعماقه الجوَّانيَّة، أو حتى رقابة خارجية، والرقابة الخارجية ليست شيئاً على الإطلاق بغير معونة وإمداد الرقابة الداخلية : رقابة الضمير الحي اليقظ ورقابة الفاعلية الروحية. إنما الحرية الحقيقية تعني معرفة الذات، ودوام البحث عن الذات، والقدرة على امتلاك الذات، والتحرر من عبادة الأصنام والأوثان التي نعبد فيها صباح مساء، وكشف أسرار البذرة الإنسانية : السرِّ الإلهي العجيب في الجوهر الإنساني ثم التحرر من كل شيء يعوقه ويقف حجر عثرة في طريقه.
وبهذا وحده تتم الحرية؛ إذْ يتمُّ معرفة الوجود الإنساني، ويمكن أن يجيء معه حكم الممارسة حكماً صادقاً وفعالاً ليس يشك فيه مجرب بوجه من الوجوه؛ لأن الحرية تجربة وممارسة قبل أن تكون إطاراً نظرياً وكفى. الإطار النظري بعيد عن التحقيق والمعايشة والحياة، لا يشكل من الحرية شيئاً ذا بال ولا يحقق في الضمير عصمة ولا شعوراً بالتبعة. قد يجيء الإطار النظري معرفة سطحية معزولة عن الوجود، ولكن هذا كله على صعيد النظر الذي يخلو من الفاعلية والتطبيق سهل المأخذ قريب المورد.
ويبقى السؤال: أين هى الأمانة التي تتوافر في الفرد القادر على حفظ الأمانة؛ لممارسة فعل الحرية؟!
(وللحديث بقيّة)
بقلم : د. مجدي إبراهيم