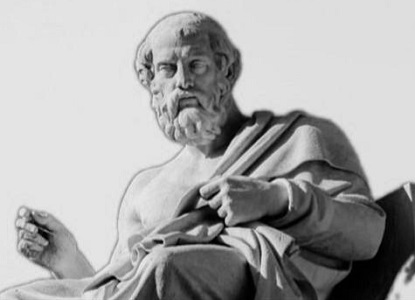صحيفة المثقف
عصمت نصّار: تهافت مشروع الجابري واجتراء خطابه
 يبدو أن مفكرنا لم يستطع التخلص من مواطن الاضطراب والتناقض في خطابه؛ وذلك لأنه صرح مؤكداً - غير مرة - على أن علة عجز التراث العربي الإسلامي عن القيام بدوره كألية محافظة على النهوض والتجديد وإعادة البناء يرجع إلى بنائه وبنيته؛ فهو من وجهة نظره مجرد ركام من المعارف اللغوية البيانية أو المعتقدات الحدسية العرفانية أو العقائد البرهانية الدينية المتشابكة من حيث الشكل والمتضامنة من حيث البنية والمتون، وجميعها لا يقوى على اللحاق بالعلم المعاصر. ومن ثم؛ فالتراث لا جدوى من تقويمه وإحياءه، ويرجع ذلك لعطب بنيته وعجزها عن التواجد في ثقافة ما بعد الحداثة المعاصرة.
يبدو أن مفكرنا لم يستطع التخلص من مواطن الاضطراب والتناقض في خطابه؛ وذلك لأنه صرح مؤكداً - غير مرة - على أن علة عجز التراث العربي الإسلامي عن القيام بدوره كألية محافظة على النهوض والتجديد وإعادة البناء يرجع إلى بنائه وبنيته؛ فهو من وجهة نظره مجرد ركام من المعارف اللغوية البيانية أو المعتقدات الحدسية العرفانية أو العقائد البرهانية الدينية المتشابكة من حيث الشكل والمتضامنة من حيث البنية والمتون، وجميعها لا يقوى على اللحاق بالعلم المعاصر. ومن ثم؛ فالتراث لا جدوى من تقويمه وإحياءه، ويرجع ذلك لعطب بنيته وعجزها عن التواجد في ثقافة ما بعد الحداثة المعاصرة.
وأقصى ما يمكن فعله حيال هذه البنية الوافدة من الماضي هو التأويل والقراءة النقدية التفكيكية حيث العقل الحر الذي لا يحتكم إلا إلى (الواقع والوعي والشعور)؛ وذلك لأن مفهوم العلم البرهاني المعاصر أختلف تماماً عن مفهومه في كتابات الصوفية أو أقيسة الفقهاء أو أدلة المتكلمين أو مبررات الفلاسفة الذين حاولوا التلفيق بين المنقول والمعقول.
ويمضي "الجابري" في مغالطاته فيزعم أن التراث العلمي للحضارة العربية الإسلامية - كما أوضحنا سابقاً - قد نشأ منفصلاً ومعزولاً عن الفكر العقدي. ومن ثم كان هو الأجدر وحده بالإحياء والتواصل مع أليات التقدم؛ الأمر الذي يبرر إقبال مفكري أوروبا وعلمائها وفلاسفتها على ترجمته ودراسته ثم تطويعه وذلك منذ القرن الحادي عشر. ولعلَّ ابن رشد وابن الهيثم وأبو اسحاق البطروجي هم أفضل النماذج لهذا التراث الذي يجب علينا إحياؤه - دون غيره - في رأيه.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي زعم بأن التراث العلمي العربي الإسلامي كان بمعزل عن باقي أروقة الثقافة الإسلامية؟ ومن الذي ادعى أن ابن رشد جحد المنقول والشريعة انتصاراً للفلسفة والحكمة العقلية الخالصة؟ ولو سلمنا بهذا الاعتقاد الخاطئ فما هو العائق الحقيقي أمام "الجابري" حيال الفكر الموروث مادام هو يعتقد بأن العلم كان منفصلاً عن الدين، وأن الإسلام لم يعادي العلماء كما تصورت الكنيسة في العصر الوسيط؟
أضف إلى ذلك أن كتاب أبا حامد الغزالي (تهافت الفلاسفة) لم يقض على الفلسفة، ولم يعطل العلم كما ادعى الجابري - وعشرات المستشرقين من قبله - ولم تمنع الثقافة السائدة قلم ابن رشد للرد عليه في كتابه (تهافت التهافت).
والحق أن مشروع الجابري لم يستطع تبرير حملته على التراث الذي لا يخلو بطبيعة الحال من مواطن الإخفاق ومواضع الانكسار ومواقع التخلف وغير ذلك من معوقات النهضة وهي الأمور التي ناقشها وحللها وقومها وعمل على إصلاحها عشرات النهضويين المحدثين وقادة الفكر في الثقافة العربية الإسلامية بداية من حسن العطار، إلى ذكي نجيب محمود, فجميعهم لم يتطرف في نقداته بنفس القدر الذي وجدناه عند مفكرنا الذي ادعى بأنه صاحب مشروع نهضوي معاصر. ومن أقواله في ذلك: "إن هذا الاتجاه التجديدي الذي عرفته الأندلس والمغرب، والذي بقى لمدة تزيد على ثلاثة قرون, يغالب ذلك التيار الجارف، تيار التداخل التلفيقي المكرس للتقليد في عالم البيان، وللظلامية في عالم العرفان، وللشكلية في عالم البرهان. أقول أن هذا الاتجاه التجديدي قد بقى يتيماً في عصره. لقد كان بمثابة لهيب الشمعة الذي يتوهج لحظة انطفائها، أن رياح التاريخ، تاريخ العلم وتاريخ التقدم كانت قد تحولت إلى أوروبا فبقى العقل العربي محكوماً بنفس السلطات التي أفرزتها عملية البناء الثقافي العام التي شهدها عصر التدوين، والتي كرستها كـ "بنية محصلة" عملية التداخل التلفيقي التي دشنها الغزالي، واكتملت مع الرازي ومازال مفعولها قائماً إلى اليوم".
ثم ينتقل "الجابري" إلى قضية غاية في الأهمية ألا وهي ثنائية قراءة المتون واستيعابها ومعنى النص ودلالته ومقاصده التي أنتجها العقل الديني الظاهري، والمعنى الباطن العرفاني، والمقصد البرهاني للعقل الجمعي من جهة، والتأويل التفكيكي للنص الذي ينتجه الأنا الحر في ثقافة مغايرة وظروف مختلفة من جهة أخرى، ويقصد بذلك أن من شروط النهضة - المرجوّة في مشروعه - تمرد العقل الحر على تلك التفسيرات أو التأويلات السلفيّة للآيات القرآنية.
ويريد من ذلك اعتبار تفسيرات وشروح السلف قيوداً باليه يجب التحرَّر منها؛ ليظل النص المقدّس حياً بإلهام من تأويلات الأنا وقناعتها. ويقول في ذلك : " نعم، نحن نعرف أن العقل العربي قد تكوّن أساساً من خلال التعامل مع النص (في التفسير واللغة والكلام...) ونحن لا نطعن في هذا؛ لأنه على أية حال معطى تاريخي لا معنى للطعن فيه، ولكن الشيء الذي يجب أن يكون موضوعاً للفحص والنقد هو ذلك المسلك الذي سلكه الأقدمون في فهم النصوص والذي يقوم على أسموه ب "الاستنباط" بيانياً أو عرفانياً. لقد تعاملوا مع الألفاظ وكأنها منجم للمعاني وأخذوا يطلبون منها ما يريدون، أي ما يستجيب لآراء ونظريات جاهزة هى آراء المذهب سياسياً كان أو عقدياً أو فلسفياً أو عرفانيّاً. هنا تنتزع اللفظة أو العبارة من سياقها لتتضمن معنى جاهزاً، وبما أن مصداقية المذهب تتوقف على النجاح في جعل النص الديني يتضمن ما يقرره من وجهات نظر؛ فإن كل الفاعلية العقلية تتركز حينئذ في تطويع اللفظ لجعله يتضمن آراء المذهب, وذلك هو التأويل".
ويضيف "الجابري" أن تأويلات الأقدمين قد تعددت تبعاً لميول أصحابها (أشاعرة، معتزلة، مرجئة، شيعة، ظاهرية، خوارج) ويعني ذلك أن كل هذه التأويلات مجتمعة لا يمكن الحكم عليها بأنها برهانية عاقلة أو يقينية ثابته متفق عليها، ومن ثم فقيودها تخضع لقواعد الاحتمالات والممكن والظن. وعليه لا حرج على العقل التفكيكي - في عصر ما بعد الحداثة - التحرر منها كلية أو تعديلها أو نسخها. ويقول في ذلك : "هنا مع سلطة السلف يفقد العقل كل سلطة من عنده، ويفقد سلطته هو نفسه كفعالية قائمة على ربط المسببات بأسبابها ... هذا العقل لا يعرف اللزوم المنطقي، ولا يصدر عن مبدأ السبيبة؛ بل عن مبدأ التجويز ... وهكذا؛ فالفقيه أو النحوي أو المتكلم أو الناقد البلاغي أو العارف أو العرفاني أو غير هؤلاء ممّن تكون عقولهم داخل الثقافة العربية وحقولها المعرفية يخضعون في تفكيرهم، وبهذه الصورة أو تلك وبهذه الدرجة أو تلك، لسلطة اللفظ وسلطة السلف والقياس وسلطة التجويز".
وخلاصة الأمر أن مفكرنا يريد إخضاع النص المقدس المتمثل في القرآن، وصحيح السّنة للقراءة التفكيكية متجاهلاً بذلك خصوصية تلك النصوص. فإذا كان الهدف من القراءة استجلاء المعاني فهو من الأمور الميسورة ذلك بفضل المعاجم الدقيقة التي تحرت المعنى المختلف على دلالتهِ بمنهج استقرائي محاكي للواقع المعيش للنص؛ فالقرآن والحديث لم يكتبا بلغة مهجورة أو مطلسمة كما أن الإحالات الإشارية والاصطلاحات الرمزية وردت بها في أضيق الحدود. واذا انتقالنا لمقصد الآيات؛ فستكشف اجتهادات المفسرين أن غايتها مدركة ومراميها مفهومة كما أن تعدد اجتهادات المُفسرين والمؤولين لم تتباين أو تتعارض إلى درجة التناقض، وذلك بفضل النسق العام الشرعي الذي يحكمها. أضف إلى ذلك إعلاء المجتهدين لمنهج تفسير القرآن بالقرآن واتفاقهم على أنه لا يجوز إعمال الرأي أو الاجتهاد في تأويل نص قطعي الدلالة أي واضح بذاته.
ويبدو أن "الجابري" انتصاراً إلى نهج ما بعد الحداثة أراد التشكيك في علوم القرآن الضابطة لمفهوم نصوصه أو مقاصدها. أمّا الألفاظ المختلف على دلالتها في النص القرآني وصحيح السنة، فهي لا تشكل قضية على النحو الذي صوره مفكرنا، وقد فاته أن علة عظم قضية قراءة النصوص وتأويلها في الديانتين اليهودية والمسيحية ترجع إلى عدة أسباب لا نجدها في النص القرآني مثال (تحديد لغة الوحي، سلامة المتن، الغموض، الرمزية، وكثرة الإحالات الإشارية). ذلك فضلاً عن تباين الترجمات واختلاف الفرق والمذاهب حول بنية المتون.
ولعل كتابات شلاير ماخر (1768م - 1834م) ومارتن بوبر (1878م - 1965م) وكاي نيلسن (1925م - 2021م) في هذا السياق خير شاهد على أن تأويل النص المقدس يعد من أكبر القضايا في فلسفة اللغة، وفلسفة التاريخ، وفلسفة اللاهوت، وفلسفة الدين في الفلسفة الغربية المعاصرة.
وأعتقد أن "الجابري" تأثر تأثراً كبيراً بكتابات فلاسفة الدين اليهودي، والمسيحي، وخلافاتهم حول إشكالية الناسخ والمنسوخ، والوحي الإلهامي وغيبة الوثائق، وغير ذلك من الموضوعات غير مطروحة في ثقافتنا الإسلاميّة.
(وللحديث بقيّة)
بقلم : د. عصمت نصّار