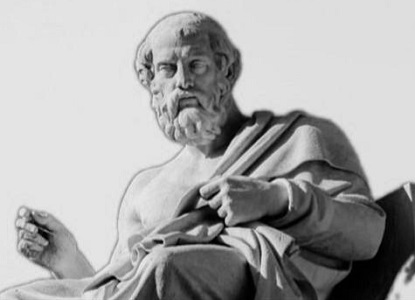صحيفة المثقف
سامي عبد العال: لِمَنْ تُقْرَع أجْرَاسُ الفلسفةِ؟!
 في بعض مناسباتها العالمية مع كلِّ عامٍ، ربما يبزغُ السؤالُ التالي: هل تحتفل الفلسفة بنفسها؟! ومن ذا الذي بإمكانه حضور الاحتفال؟ بل وكيف سيتم الاحتفال ابتداءً؟!... الفلسفة بخلاف أي نشاط عقلي لا تحتفل بذاتها (أو هكذا يتم). لا تحتفل كعجُوزٍ بلهاء (أمُ العلوم قديماً) تُطلق صيحات الظفر (الزغاريد) بعريس شاب (العلم - التكنولوجيا) تطَّلُعاً لأحفادٍ جُددٍ. فهي من تلك الجهة (شمطاء عاقر) لا تلد، ولم تحاول مرة ثانيةً في هذه الاتجاه إلاَّ على استحياء بعدما تطورت العلوم معلنةً العصيان العنيف في أحايين كثيرة. إذ لم تخلو مقدمات للعلوم المعاصرة من" نقد قاسٍ" للفلسفة، كأنَّها تحاول الثأر المكبوت تاريخياً من الأم الرؤوم في وقت من الأوقات (وما أكثر عقوق الأبناء!!).
في بعض مناسباتها العالمية مع كلِّ عامٍ، ربما يبزغُ السؤالُ التالي: هل تحتفل الفلسفة بنفسها؟! ومن ذا الذي بإمكانه حضور الاحتفال؟ بل وكيف سيتم الاحتفال ابتداءً؟!... الفلسفة بخلاف أي نشاط عقلي لا تحتفل بذاتها (أو هكذا يتم). لا تحتفل كعجُوزٍ بلهاء (أمُ العلوم قديماً) تُطلق صيحات الظفر (الزغاريد) بعريس شاب (العلم - التكنولوجيا) تطَّلُعاً لأحفادٍ جُددٍ. فهي من تلك الجهة (شمطاء عاقر) لا تلد، ولم تحاول مرة ثانيةً في هذه الاتجاه إلاَّ على استحياء بعدما تطورت العلوم معلنةً العصيان العنيف في أحايين كثيرة. إذ لم تخلو مقدمات للعلوم المعاصرة من" نقد قاسٍ" للفلسفة، كأنَّها تحاول الثأر المكبوت تاريخياً من الأم الرؤوم في وقت من الأوقات (وما أكثر عقوق الأبناء!!).
حدث هذا تدريجياً حتى تخلت الفلسفة عن دور الرقيب أو التلصص المعرفي، ولاسيما مع الابداع الفلسفي (الراهن) كحالةٍ كونيةٍ تستحث إنسانية الإنسان وتفكك حتميات الفكر والمعرفة والأيديولوجيات والمذاهب وترتاد مناطق المسكوت عنه في المجتمعات والثقافة وتطرح ما هو مجهول في عوالم الافتراض. بل قطعت الفلسفة أشواطاً بعيدة عن هذا المعنى كذلك، إذ غدت تتضمن أفكاراً تهدم نفسها بنفسها (أي غدت طريقاً نوعياً في هدم ما تقول وتبني)، ثم تتجدد ذاتياً وفقاً لألياتٍ ومعايير التفلسف الحُر. أي أعادت الفلسفة النظر بنفسها فيما كانت تمارسه، وهذه المهمة باتت تمثل ألف باء التفكير الفلسفي، حيث شرع الفلاسفة في تحديد أُطر أكثر رحابة وجذرية لإنسانيتنا الراهنة.
إنَّ الفلسفة قدرةٌ خاصةٌ على كشف مناطق العتَّمة في حياتنا، ترمِّم الوجود الإنساني بوصفها دعوةً عقليةً مفتوحةً لما يُشبع فضولنا الأوسع. حين يتفلسف المرءُ، فهو يُفسح مجال نشاطه مُلبيَّاً نداء ما هو إنساني داخله. ولا يعود دون تجديد أُطره النسقية التي ترى الأطراف من أعلاها إلى أدناها. عليه أنْ يستحق مرتبة الإنسان الحر كماهيةٍ لوجوده الحق، وألَّاَ يكون مجرد كائن خالٍ من الحياة والمصير. إنَّ امتلاء إرادتنا الحرة وعقلنا الخلاَّق- بافتراض ذلك- شرطان لا غنى عنهما لاستقبال الزمن. ولكي نوجد على خريطة الحياة، لابد أن نضع ما نصنع بعمومية اللفظ قيد التساؤل.
المجتمعات (التي تعترف بمساحةٍ للفلاسفة) هي مجتمعات تتمرن يومياً على المصير وكيف تتوقعه وبأي سيناريو سيتحقق، (أليست الفلسفةُ - أفلاطونياً - تمارين قاسية على الموت، الذي هو الحياة وجهاً لوجه؟!). إذن الفلسفة ترمق أخطار الوجود البشري كآثار غائرة تهجس بمشكلاتها الخاصة، لأنَّ تفكيراً فلسفياً يطلعنا على مستوى الضرورة في أعماقنا وكيف تتحول. إنَّ الحياة الغُفْل نومٌ عميق وكوابيس بحجم التاريخ الزاحف كثعبان الأناكوندا المفترس (Eunectes) أو أفعى الكبرى القاتلة (Naja).
وقد لا يخطئُنا الصوابُ إذ نقول إنَّ الفيلسوف مُروِّض ثعابين بالدرجة الأولى (ثعابين المفاهيم والعقائد المتطرفة والأخيلة والانماط العنيفة والأفعال الكبرى التي تخيم في حقبة من الحقب التاريخية). إنَّه كفيلسوف يخرجها من أدغال الثقافة والسياسة والأحداث مترقباً شراستها وتحولها وكيف تعيش في المجتمعات. ويعرفنا الفيلسوف أيضاً- وسط هذه الظروف- كيف تلدغ وخطورة السموم التي تحملها. هناك سموم تدمر الأعصاب، وهناك سموم تحدث شللاً، وأخرى تسمم الدم، وغيرها تسبب عماءً لا مهرب منه، وهناك سموم تقتل على الفور، وهناك سموم تبقى بالجسم فترات طويلة!!
ما أكثر ثعابين التخلَّف والفوضى والعنف والإرهاب والاستعباد والقهر والديكتاتورية التي تلدغ مجتمعاتنا الإنسانية في لحمها الحي. أشياءٌ تضرب بأذيالها أنسجة الحياة وتتمدد حيث لا نلتفت إلى جذورها وأبنيتها الغريبة. الفلسفة تدربنا حثيثاً حول تلك المسألة: كيف نفكر بهذا الكُّل الذي يتكون، وبأية صورة نلتقط تعقيده وانفكاكه على صعيد عام. التفكير هنا كالإحساس الغريزي (للأحياء) بحركة الحياة والموت في دورانهما الأقصى. أي العيش وفق الكل كما كان اللوغوس logos لدى هيراقليطس يطلق العنان لحياة الحكمة الدالة ومعرفة الفيزيس (الطاقة النامية physis) في جميع الكائنات.
إنَّ هناك قانوناً كلياً يربط الكائنات المختلفة ويربطنا بأخطار تاريخية نصنعها بأنفسنا عبر المجتمعات المعاصرة. مثل زيف الوعي وانتشار الجهل واحتقار العقل وبلادة أنظمة الدول وركود التعليم وتضخم الأوهام وأسواق التفاهة وشراهة الاستهلاك وافقار العقول وعُري المشاعر وتحول البشر إلى كائنات بلهاء. هي إفرازات وفضلات لا نستطيع تجنبها للأسف وكذلك لا نعيش دونها. تلك الأرجوحة البشرية المتناقضة التي تغطي جوانب العصر. فالثقافة ليست تراكما محايداً هنالك خارج إمكانية العودة خلال حياتنا من أبواب خلفيةٍ، لكنها كيانٌ حي ضخم نصنعه ليتحول كالثعبان الذي يلتهمنا مرة أخرى. الفيلسوف هو من يحمل مزماره صافراً ولاعباً على علاماته وتوجهاته أمام الجماهير، بحكم أنَّ كل فلسفة لا تخلو من مهمة ترويض الشراسة الموجودة في آفاقنا الإنسانية.
ها أنا اتخيل هؤلاء الحُواة (لنلاحظ فيها دلالة الحياة والاحتواء والحي والحيل) الذين سيقفون في ساحات عامة وسيتحلق حولهم الناس مشدوهين ومضطربين، بينما هم منهمكون في اخراج الأفاعي انسياباً من الجراب والشقوق والرقص معها. وكأنَّ هؤلاء يؤدون طقوس عالية الدقة والمخاطرة والسرية. كلُّ فيلسوف مبدع له القوة والاحتمال ذاتهما أمام الجماهير لإخراج بواطن التصورات والأفكار من مخبأها الغامض. كان الفلاسفة في أصالتهم اليونانية مشائين عظاماً، ولائهم للأقدام والأقدار والخطوات وما تحققه من أفكار رغم كونهم يخاطبون العقول. وأبداً لا يختلط لديهم الحذاء بغطاء الرأس، حيث لا يليق بأي انسان أن يكون الغطاء جهلاً بالمفاهيم أو وعياً آسنا خارج عصره (كحال السلفيات الدينية والديكتاتوريات السياسية الراهنة).
لعلَّ لغتنا الحية التي نتوارى خلفها هي جراب الوجود الإنساني (كل شيء في جوف الفرا). فليس أعقد تركيباً وأكثر خصوبة لموطئ الوجود والتاريخ من اللغة. وليس يفعل بها ويصنع منها شيئاً ذا قيمة (لو نتخيل) قدر ما يطلق الفيلسوف صيحات العقل كرَّحالٍّ (مشَّاءٍ) في دهاليز وشوارع المدن باحثاً عن المجهولات. تلك التي لا ندركها بسهولة من أول وهلةٍ ولكنها تؤسس لعالمنا وتواصلنا وتقنياتنا وعلاقاتنا العمومية. وهي بعض المهمة التي قد يؤديها حالياً الفكر الإنساني العميق على بعض صفحات (الفيسبوك وتوتير وانستجرام وغيرها).
فهذه (الأدوات- الوجُوه) هي كتاب الوجود الراهن (لوغوس الواقع الافتراضي). يمكن لكل انسان أنْ ينعكس فيها، بيد أنها تُؤسس لحرية الفهم والاختلاف والشفافية. إنَّ بعض وسائط التواصل الاجتماعي هي شوارعنا التي فتحناها في أقاليم الكون الخيالية، هي بمثابة الوجوه البديلة التي نقابل بها الآخرين صباحَ مساء. ورغم كمية التلون والتنكر المنطوية عليها إلاَّ أنها وسائط ربما في يوم من الأيام ستجدد وظائف الفلسفة. وربما سيأتي اليوم الذي تشهد فيه وسائل التواصل الاجتماعي (فلاسفة جوالِّين افتراضيين) يطلقون أفكاراً تحرر الإنسان من عوامل قصوره. وسيكون هذا الانسان منصتاً فاعلاً لنوع من العقلانية الافتراضية التي تؤثر عليه أكثر من السياق الذي يعيش خلاله.
إنَّ السكوت عن المجهول حولنا هو صمت مريع حول: ماذا سيحدث غداَ؟! رغم أننا فلسفياً ربما ندرك أنَّ كل إمكانية تأتي من هنالك وأنَّ لها علامات يجب سبر غورها وتحيُّن قدومها بأي وقت مثل تحين الثمار المنتظرة!! فاستنطاق الصمت الذي يملأ ما يُوجد هو المهمة التي تنتظر المتكلم وفق قواعده. لأنَّ أي صمت لا يحتاج ضجيجاً وإلاَّ لهرب إلى شقوق الواقع وأحداثه. الصمت له أبلغ الكلام شريطة حُسن التعامل معه وإطلاق معاني مبتكرةٍ لاصطياد خلساته النادرة.
الفلسفة تضيء كالنور الآتي من بعيد دون أنْ تزاحم الآخرين على الظهور. المزاحمة هي اشتراك بين أطراف في شيء معروف وقابل للتكرار وممكن تعميمه. بينما ترفض الفلسفة على وجه الإجمال الاثنين (المزاحمة وهوس التكرار)، فهي ضد أي ابتزاز فكري وكرنفالي باسم العقل. لو أنَّ فكراً قد زاحمَ فكراً آخر، فلا يجرى الأمر سوى بالاقتتال المنطقي، وسينقل الوضع إلى صراع وجودٍ. وسيكون الفكران نوعاً من العنف بينما واقع الحال يقول إنَّهما وجهان ثريان لاختلاف العقول. الفلسفة – من ثم- استثناءٌ غير قابل للمزاحمة من جهة الأصالة العقلية تبصُراً وكشفاً. هي تتجنب الشيء المعروف: لكونه ليس حقيقياً على الدوام، وقد يصبح عبئاً أمام الانسان. وكذلك تنتقد الشيء القابل للتكرار، لأنَّه يواري سوءة الفكر باعتباره أشبه بمركبة نقل عام!!
الفلسفة في كلِّ زمنها احتفاءٌ حُر من غير أنْ تفعل، احتفاءٌ دون طقوس شكلية، فالعتمة حين تُضّاء (على طريقة مصباح ديوجين اللائرثي) إنما تعدُّ ضرباً من الإبهار الاستثنائي. حالياً الواقع الافتراضي virtual reality هو مصباح ديوجين المتأخر، ففي أي وقتٍ يُضيئ العالم كلَّه، وفي أي مكان يتحرك مثيراً الدهشة والخيال والهواجس والأخطار. وفي هذا ستكون الفلسفة فعلَّ ابهار عقلي واحتماله الافتراضي الفذ. النشاط الفكري الحي يجعل وجودنا أكثر ثراءً وزخماً من ذي قبل. وكأننا نتعدد لحد التباين في حياتنا الفردية. الفلسفة بذلك ستضع مسيرتها ومسيرتنا العقلية تحت أنوار مختلفة كما لو كنا نراهما لتوِنا فقط.
إنَّ اجراس الفلسفة ستُقْرع على هيئة نواقيس هذه المرة، لأنَّها ستواجه في مجتمعاتنا العربية صدوداً غير مبرر. دوماً نقول للآخر المتكلم أو الفاعل في مضمار الأفكار: " بْطّل أيا هذا فلسفةً ". وترجمة العبارة ثقافياً هي (أنَّ الفلسفة باطل)، أي كُّفْ عن التفكير ولا تناقش ولا تحاور ولا تطرح ما تريد. لأنك إذا فعلت ستدخل دائرة الباطل والباطل عادة كان زهوقاً، وإنْ انتقدت، فستحل عليك اللعنات الحاضرة والغائبة إلى قيام الساعة. والخلط واضح بين معاني الدين والفكر، حتى أنك لا تستطيع التساؤل لمجرد المعرفة: (يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إنْ تبدَ لكم تسؤكم) كما يعمم الفقهاء والمتحدثون في الشئون العامة أحياناً. فلقد تمَّ تحريم وتجريم الأسئلة السياسية والفكرية والاجتماعية، رغم أنَّ القرآن لا يقصد النهي عن الأسئلة الفكرية والحقيقية تحديداً!!
فالسياق المنهي عنه تبدَّل ثقافياً حتى شمل هذه المجالات الحياتية بفعل الأنظمة المستبدة والداهسة لوعي الإنسان. وبالتالي كما ييتم الترديد: ليكُّن وضعك أيها الإنسان كما أنت: سامعاً مطيعاً خانعاً بلا رفض ولا تذمر. وكأننا نتحدث لأموات وليس لأحياء. لنلاحظ في هذا المناخ: أن خطباء الدين يتحدثون لأموات يشهدون كلامهم على الملأ، بينما رجال السياسة يُسْمِعُون من في القبور، أمَّا رجال الإعلام، فيلقنون الجماهير دروساً في الوطنية والهوية كشيوخ يلقنون أمواتاً إجابات لملائكة العذاب. ثم يأتي هؤلاء المسؤولون الرسميون أو أولئك كالسائلين: "ناكر ونكير" أثناء عذاب القبر ... من ربُك السياسي؟ من تؤيد في دائرة السلطة؟ ما دولتك؟ وما هو نظامك السياسي؟ لماذا لعنت ظروف الحياة مرةً بعد مرةٍ؟ وهل عصيت الحاكم الواقف فوق كتفيك يوماً ما؟ هل خرجت على النظام العام ولو في خاطرك؟! .... والإجابات معروفة بحسب التلقين الثقافي للأدمغة الفارغة.
كيف تحتفل الفلسفةُ إذن بمنجزاتها؟! نحن العرب حاضرون فلسفياً بلا فرح ولا انجاز ولا موضوع (لا عريس ولا عروس) إلاَّ بحكم الزمن فقط (والمثل الشعبي يقول: العروسة للعريس والزفة للمتاعيس، أي لهؤلاء المتفرجين). الفلسفة لدينا بهذا الحال يحب أنْ تكون تمارين لإحياء الموتى وإزالة كآبة الواقع. فلئن كان اليونانيون القدماء يتدربون فلسفياً على الموت من باب العزاء النفسي والعيش في حالات الاطمئنان والسكينة، فالمجتمعات العربية يجب أن تتدرب فلسفياً على الحياة. عليها أنْ تعيش عصرها، أن تُفعِّل حاضرها إلى أقصى مدى وتدخُل نطاق الثقافات العالمية بإسهامات تليق بإنسان العصر.
على الفلسفة لدينا أن تكون بمثابة فن إحياء الأرض الموات بلغة فقهاء الإسلام (إحياء أرض العقل وأرض الثقافة وجدب الحياة)، أي أهمية بعث الوعي من الأجداث التي تكبل حركته تاريخياً وكأنَّها قدرٌ مشؤوم!!
سامي عبد العال