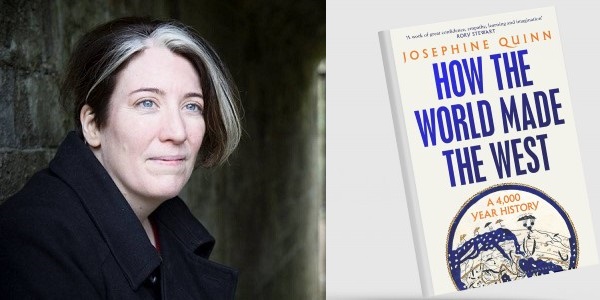صحيفة المثقف
مجدي إبراهيم: القصدُ المُجرُّد
 المنهج الذي نتوخَّاهُ ونحرصُ عليه هو أنه من واقع النصوص نثبت الآراء. ولا نثبتها جزافاً بغير فحص النص والوقوف على دلالاته؛ فقراءة النص الأصيل في عيونه الأولى هى التي تكوِّن الرأي الصحيح. أمّا الآراء التي تأخذ بالتقليد والمحاكاة للغير، أيّا كانوا وكائناً من كانوا؛ فلا يعوّل عليها عندنا قيد أنملة؛ لأنها ببساطة شديدة لا تكشف عن تجربة مع المقروء، ولا تعطي معاناة صاحبها مع النص الأصيل يعوّل عليه ولا يعوّل على سواه.
المنهج الذي نتوخَّاهُ ونحرصُ عليه هو أنه من واقع النصوص نثبت الآراء. ولا نثبتها جزافاً بغير فحص النص والوقوف على دلالاته؛ فقراءة النص الأصيل في عيونه الأولى هى التي تكوِّن الرأي الصحيح. أمّا الآراء التي تأخذ بالتقليد والمحاكاة للغير، أيّا كانوا وكائناً من كانوا؛ فلا يعوّل عليها عندنا قيد أنملة؛ لأنها ببساطة شديدة لا تكشف عن تجربة مع المقروء، ولا تعطي معاناة صاحبها مع النص الأصيل يعوّل عليه ولا يعوّل على سواه.
من تلك اللفتة المنهجية التي تقرَّرت عندنا نتناول كتاب "القصد المجرَّد في معرفة الاسم المفرد"؛ فهو من مؤلفات ابن عطاء الله التي تخدم فكرة التوحيد، وينضمُ إلى ما كتبه في "الحِكَم". لم يكن الرجل ممَّن يتركون أوقاتهم بغير خدمة. الوقت هو "العبودية" عنده وعند غيره من الصوفية المحققين. والعبودية على الحقيقة معرفة التوحيد وممارستها، التي هى فيما يقول ابن عطاء الله "أكسير الزيادة، وكيمياء السعادة، وقاعدة كل قدم وحال ومقام، وأسُّ أصول دعائم الإحسان والإيمان والإسلام: معرفة التوحيد المُجرّد عن إضافة التقييد المحفوظ عن تصميم التقليد الموصوف بعلم الأسماء والصفات، الجامع لذكر معاني اسم الإلهية.
ولما كان شرف العلوم على قدر شرف المعلوم، وشرف العالم على قدر شرف علمه، صار لا شيء أشرف من الحق وطلبه، ولا شيء أشرف من معرفة الحق في الدنيا، وفي الآخرة بالنظر إلى وجهه.
وعلم التوحيد موقوف على معرفة الواحد وصفة وحدانيته. ومن لم تفده المعرفة علماً بالله وبصفاته في حقيقة توحيده، فهو محجوب، والمحجوب مفقود.
يبدأ الكتاب بالقسم الأول يحصر فيه الآيات التي وردت فيها اسم "الله"؛ ليتكلم في اشتقاقه وأقسامه، وذكر تفصيل حروفه وتعلق أقسامه ومقتضى أحكامه، إذْ كان القصد المجرد، قسمين: الأول هو: الذي يدور حول "الاسم" (الله)، وفيه نلحظ شهود "وحدة الوجود"، أو توحيد المشاهدة، وفيه كذلك أقسام الأسماء وهى أنواع أربعة سوف نذكرها تباعاً في هذا الكتاب. أما القسم الثاني من القصد المجرد؛ ففي معرفة فضله وشرف قدره وشرح معاني أسراره واختصاص فوائده وذكره؛ لكأنه بهذين القسمين يُطلعنا على شقيِّ المعرفة؛ ليثير فينا في القسم الثاني، قسم "الذكر" الشوق إلى التطبيق، هنالك معرفة قبل العمل، وهى الجزء الخاص بالعلم، المفروض تحصيله لكل من أراد السلوك، والتي يغلب عليها الطابع النظري، فهى من وادي المعرفة النظريّة.
وهنالك معرفة بعد العمل، وهى من روافد المعرفة الوهبية الخالصة، وهى معرفة الذاكرين الذين يعرفون معاني أسرار الاسم المُفْرد واختصاص فوائده والاطلاع المباشر على فضله وشرف قدره. وفي القسمين نجد الجانبين: جانب المعرفة النظرية، وجانب التطبيق والسلوك والممارسة. وهذا الجانب الأخير ممّا يقود إلى المعرفة الاختصاصية بفضل من الله وتوفيقه، وهو موضوع القسم الثاني من الكتاب.
ــ القسم العملي (الذكر):
ولنبدأ بما جاء في هذا القسم؛ القسم العملي (الذكر) قبل أن نتكلم في القسم الأول: لقد سبقت الإشارة حين قلنا إن هدف ابن عطاء الله من المعرفة هو التطبيق؛ حتى ولو كانت تلك المعرفة تتعلق بالاسم المفرد "الله"، فالقصد المجرد من المعرفة هو ممارسة حياة روحية بعينها تطبيقاً لهذه المعرفة، ولا يمكن أن يكون هناك تطبيق بغير ذكر دائم لا مقطوع ولا ممنوع لهذا المعروف. قال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا" (سورة الأحزاب: الآية 41 - 42). وقال عز وجل:"الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ" (سورة آل عمران: الآية 191)، وفي الحديث عنه، صلوات الله وسلامه عليه، عن الله تعالى:"من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين". ولمّا سئل صلوات الله وسلامه عليه: أي الأعمال أفضل يا رسول الله قال: "أن تموت ولسانك رَطْبٌ بذكر الله"؛ وعليه؛ فالاشتغال بذكر الله، فيما يرى ابن عطاء خَاصَّة، من أفضل العبادات، وعليه يبني المؤلف القسم الثاني من قصده المجرّد في معرفة الاسم المفرد، ويسوق الشواهد والدلائل لتأكيد أن الذكر سبب المعرفة كما أنه سبب الوصول، وأنَّه مفتاح الطريق إلى الله على الحقيقة.
ومن إشاراته أنه يذكر أن من تخصيص هذا الاسم المفرد بالذكر، أنه ما من لفظة بالذكر من "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" إلاّ وفيها تخصيص، وإشارة، ومعنى، وفوائد عجيبة، وأسرار وحكم، مع ما يضاف إليها من علوم ومعارف جليلة. فهاهنا "قُلْ" إشارة إلى الأمر. و "هو" إشارة إلى الإثبات لوجوده. و"الله" إشارة لاسم ذات الألوهية. و"أحد" إشارة لإفراد الأحَدِّية. و"الله" إشارة لذكر الاسم المُفْرد للتوحيد. و"الصمد" إشارة لتنزيه الذات عن نفس البشريّة. أما "لم يلد"؛ فهى إشارة إلى كمال التنزيه عمَّن سواه. "ولم يُولد" إشارة إلى إثبات الأزلية والقدم؛ ونفى السَّبقيّة والحدوث والعدم؛ وهى إشارة إلى عدم الضد، والشبيه، والنظير، والكفو، والند.
ويروح ابن عطاء فيعرض للذكر ثلاثة مقامات: ذكر باللسان، وهو ذكر عامة الخلق. وذكر القلب وهو ذكر خواص المؤمنين. وذكر الروح وهو لخاصَّة الخاصة به ينفرد العارفون في أحوالهم الروحية العجيبة، وبه يتمتعون في رحاب الحضرة بخطابات التأنيس؛ وذلك لأن هذا الذكر هو هو ذكر العارفين بفنائهم عن ذكرهم، وشهودهم إلى ذاكرهم. ولذاكر هذا الاسم المفرد (الله) حالات ثلاثة أيضاً: حالة الوَله والفناء، وحالة الحياة والبقاء، وحالة النعم والرضا، ولكل حالةٍ رجالُ ذاكرين.
وهكذا؛ فالكتاب كله مليء بالنوادر والإشارات. الهدف منها حثُّ العارف على كثرة الذكر؛ إذْ "العارف يتأسف في وقت الكدر على زمن الصفا، ويَحنُ إلى زمان القرب والوصال في حال الجفا، هو من الذين قال فيهم عليّ، رضوان الله عليه، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى". فالذكر تطبيق للمعرفة وشروع في التوحد مع المعروف والاستغراق فيه، والزيادة منه فضيلة شرعية وكل فضيلة فيه داعمة للتوجه القلبي. والقسم الثاني من الكتاب كالممارسة للمعرفة: هو بمثابة الجانب العملي من الحياة الروحية، أو هو العمل والعبادة، وفيها يكمن التحقق بالاسم المفرد قصداً مُجَرَّدَاً خَالِصَاً لا شك فيه.
ــ شهود وحدة الوجود:
وإذا رجعنا إلى القسم الأول، والذي نعنونه بعنوان (شهود وحدة الوجود)؛ والذي ذكرنا فيه أنه يدور على الجملة حول فكرة عميقة في التصوف هى "توحيد المشاهدة" على لغة ابن عطاء الله واصطلاحه الصوفي؛ أو "وحدة الوجود" على مذهب ابن عربي وتصوفه؛ فإنّ الذي يقرأ ابن عربي وابن عطاء، يجد تقارباً من الوهلة الأولى من حيث الذوق الصوفي والوعي بالمدارك التصوفية العليا.
الذوق يعطي التقارب والتشابه والالتقاء، ويدلُّ بالمباشرة على وحدة الروح التصوفية في الإسلام من أول وهلة. إنّما التفرقة النظرية تعطي الاختلاف؛ فهناك اختلاف بين المدرستين نظرَّياً: مدرسة ابن عربي فلسفية موغلة في التفلسف والمعرفة النظرية المستقاة من طريق الاكتساب؛ فإذا أردت فكراً فلسفياً صوفيّاً خالصاً؛ فلتتجه إلى ابن عربي فمصادره الفلسفية وخاصة "الأفلوطينية" أظهر من أن ينكرها أحد. وأمّا مدرسة ابن عطاء الله فسُّنية الاتجاه، المصادر الخارجية فيها بعيدة، ونسبتها إلى الغزالي والمكي والقشيري، والتصوف السُّني خاصّة، أكبر وأدق من نسبتها إلى اتجاهات فلسفية خالصة كما سبقت فيما تقدَّم الإشارة إليه.
المصدر الإسلامي غالب على اتجاه المدرسة الشاذلية ذات الاتجاه السُّني المحافظ، اتجاه الغزالي، الذي أكده ابن عطاء الله ورعاه فيما كتب وألف؛ ولكن هل كانت وحدة الوجود عند ابن عربي خالصة المصادر الخارجية بعيدة كل البعد عن المصدر الإسلامي؟
لم يقل أحد بهذا إلا من خبط في التصوف خبط عشواء، وتحدث بكلام غير مسؤول؛ بل الذي يجعل التقارب مشهوداً بين ابن عطاء الله السَّكندري وابن عربي؛ هو وحدة الرُّوح التَّصَوفيَّة في الإسلام، وتأسيس وحدة الوجود على دعائم ذوقية، على التجربة الصوفية، وأنت إذا قلت "تجربة صوفية" غلَّبت المصدر الإسلامي فيها على سائر المصادر الأخرى. قدَّمت مصدرها الإسلامي وأخَّرت المصادر الخارجية، قَدَّمت مضمون التجربة، وأخرت شكلها ومظهرها الخارجي؛ إذْ المتصوف المسلم في الغالب، لا .. بل من المؤكد يعوّل في تجربته الروحيّة على مضمونه الديني ينتسب إليه.
ولمّا كانت التجربة الدينية الصوفية لا تقوم على الثقافة، ولكنها تقوم على العمل بمقتضى المضمون الديني، وعلى الهداية النبوية: القَولية والفعلية، الباطنة، والظاهرة؛ فإنها ممّا لا ريب فيه تستوحي الدين الذي تنتسب إليه، والعقيدة التي تدين لها بالولاء.
فالمتصوف المسيحي يتكئ على دينه وعقيدته. واليهودي نقطة انطلاقه عقيدته. والبوذي لا يستقي تجربته من مصر القديمة. ولكنه يستقي تجربته الصوفية من تعاليم بوذا. والهندوسي يتمسك بتعاليم كتبه المقدسة ولا يتركها إلى مقدس آخر يراه. وهكذا يكون حال الصوفي في الإسلام يدخل التجربة وليس في ذهنه عقيدة ولا دين سوى عقيدة الإسلام وديانته. فإذا قلت: فما بالُ التأثر والتأثير؟ لا أقول لك: إنّه مجرد تشابه شكلي وكفى، وبخاصّة إذا تعلق الأمر بالمطالب الروحيّة العامة وحقائق الخلود؛ ففيها يكثر التشابه وتصعب التفرقة. ولكن أقول لك: إمّا قبل التجربة وإمّا بعدها؛ فلو كان قبلها يترك المتصوف كل تأثير خارجي وينتمي في التجربة إلى "المضمون"؛ إلى الدين الذي ينتمي إليه، ولو حَدَثَ بعدها يظل المتصوف على كشوفاته حال التجربة، والذي يُدْنِيِهُ من متصوف آخر ينتسب إلى دين مختلف أو ثقافة مغايرة هو: فَرْضُ التشابه .. ليس إلاّ.
أمّا في بطن التجربة؛ فليس في قلب المتصوف إلاّ عقيدته الدينية التي ينتسب إليها ويدين لها بكل الولاء، وليس له إلا مضمونه العقدي يتكئ عليه ويستبطن خوافيه.
ومن الخطأ على هذا: القول بأن التجارب الصوفية كلها من حيث المصدر واحدة، أي نعم! قد تتشابه جميعاً شكلاً ينقصه المضمون، لكن مصدر العقيدة الدينية مختلفٌ لا شك فيه.
ومن هنا؛ فقد يتشابه تصوف ابن عطاء الله مع تصوف ابن عربي في اتحاد الهدف وتوحُّد الغاية، وقد يتفقا كل الاتفاق في انتساب التجربة إلى الدين الواحد والعقيدة الواحدة، وقد لا تفرّق في الجوهر الباطني العميق بين "توحيد المشاهدة" في تصوف ابن عطاء الله السَّكندري، وبين "وحدة الوجود" في تصوف ابن عربي بالمفهوم الإسلامي لا بالمفهوم الهندوسي؛ وبخاصّة لو وضعنا في الاعتبار دعائم الذوق المؤسس لفقه الطريق، وقيامه ناهضاً عاملاً في جوف صاحبه مرتكزا بالجملة على دعائم عقيدته الدينية، ولكن مع كل هذا يظل الاختلاف بينهما نظريّاً من حيث الشكل، جائزاً مقبولاً في كل تصوِّر معقول.
هذه مدرسة وتلك مدرسة، هذا اتجاه وذاك اتّجاه. كان هذا من الضرورة بمكان قبل أن نَقْدِمَ على حديث ابن عطاء في توحيد الشهود في هذا الكتاب الذي نعرض أهم محتوياته. يرى ابن عطاء الله أن:"لا إله إلا الله دائرة بين النفي السالب والإثبات الموجب؛ فالنفي السالب لجميع صفات الحدوث والنقص والعدم، والإثبات الموجب لجميع صفات التنزيه والكمال والقدم؛ فمن نظر إلى وجود الحق بعين القدم ونظر إلى ما سواه بعين الحدوث والعدم؛ فقد شاهد أزليته. وقال:"ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله". ومن نظر إليه بعين البقاء، ولخلقه بعين الفناء؛ فقد شاهد سرّ أزليته، وإذ ذاك يقول: "ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله بعده". ومن نظر إليه بعين العلم والقدرة، وللخلق بعين الجهل والعجز وقصور المنّة؛ فقد شاهد فعله وإحاطته وهنالك يقول:" ما رأيت شيئاً إلاّ رأيت الله معه".
وأصلُ المشاهدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فيما يرى المؤلف، الأول: مشاهدة فعل بفعل. الثاني: مشاهدة صفة بصفة. الثالث: مشاهدة ذات بذات، فمن نظر إلى الحق بالحق تجلت له الأسماء والصفات، وسريانها في المكونات، والعلم في المعلومات. ومن نظر إلى الأشياء بالعلم ظهرت له الصنعة في المصنوعات، والأفعال في المفعولات. ومن نظر بالله لا به انقطعت الإضافة وتلاشت المحدثات، وفنيت العبارات والإشارات".
وفي المشاهدة الأخيرة تعبير دقيق عن: حال الصوفي في تجربته وتحققه قطعاً بمراتب الشهود، كما أن فيها تعبيراً عن "وحدة الشهود" في التصوف السُّني، وعن "وحدة الوجود" كما هى عند ابن عربي ولكن بدلالتها الإسلامية؛ فكل الأشياء قائمة بالله؛ فمن نظر بالله، لا به أي لا بنفسه، غاب في الفناء عن الأكوان وانقطعت في حقه الإضافة وتلاشت المحدثات، ثم لم يستطع التعبير ولا الإشارة، وهذه أوصاف التجربة الصوفية في خصوصيتها، يلزم عنها الفناء ضرورة، أو هى نفسها تجربة الفناء محققة وواقعة، وفيها يتقرّر لدينا توصيف شهود ابن عطاء وشهود ابن عربي بأنهما: "شهود لوحدة الوجود".
هذا هو الاصطلاح الذي نرتضيه للتوفيق بين "توحيد المُشاهدة" عند ابن عطاء ومن جرى مجراه في التصوف السَّني، وبين "وحدة الوجود" الروحيّة الصوفيّة عند ابن عربي والجيلي والصدر القونوي، ومن جرى مجراهم من تلاميذ وحدة الوجود؛ نرتضيه لأن نصوص ابن عطاء نفسها تثبته ولا تنفيه؛ بل تكشف عنه القراءة المتأنية في ظلال تلك النصوص.
ــ معاني الأسماء الإلهية:
ثم يتوسّع ابن عطاء الله في معاني الأسماء الحُسنى؛ فيورد تقسيم العلماء إليها على أربعة أقسام، وفي كل قسم منها دلالة من الصفة على الاسم. الأول: منها هو ما يدل على "الذات الكريمة الجليلة المنزهة القديمة العظيمة". وذلك كل ما دلت التسمية به على وجود ذاته وهو راجع إلى نفسه. كموجود، وذات، وإله، وقديم.
والثاني: وهو راجع إلى صفة ذاته القديمة. وهو ما لا يقال إنه هو ولا إنه غيره. وذلك كل ما دَلَّت التسمية به على صفة ذات نفسه كالحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام.
والثالث: وهو راجع إلى صفة أفعاله. وهو ما يُقال أنه غيره والاسم فيها غير المسمى، وذلك كل ما دَلّت التسمية به على صفة فعل من الأفعال؛ كبارئ؛ ومصوِّر، وخالق، ووهاب، ومحيي، ومُمِيِت، ورازّق.
والرابع: وهو راجع إلى صفة التنزيه، ويُقال إنه هو هو، والاسم والمسمى فيها واحد، كأسماء الذات، وذلك كل ما دَلَّتْ التسمية به على نفي النقائص كلها عنه تعالى؛ كعزيز، وجبار، ومتكبر، وكبير، ومولى، ومتعال، وذي الجلال والإكرام، وجليل، وعظيم، وعليّ، ومؤمن، ومهيمن، وغني، وقدوس، وسلام.
لكنما الاسم المفرد، فيما يرى ابن عطاء الله، وعلى حد تعبيره، إنّما هو جامع لجميع الأسماء كلها، وهى شارحة له ومشيرة إليه، ومعبرة عنه ومشاركة له، وهو متضمنٌ لها على وجه الإجمال. والعالم كله: علويه وسفليه، بما فيه من عجائبه وغرائبه، صادر عنه (أي عن الاسم المفرد، جل ذكره)، وهو على قسمين (أي العالم): عالم أمر، وعالم خلق. بيد أن عالم الأمر هو الحاكم على عالم الخلق، إذ كان يلي اسم الألوهية في المرتبة العليا.
ولم يكن ابن عطاء وحده هو من أشار إلى تلك اللفتة؛ بل سبقه إليها كثيرٌ من العارفين ممّن كتبوا مصنفات فيها كالقشيري في "التحبير في التذكير". وابن عربي في "النور الأسنى بمناجاة الله بأسمائه الحسنى". والغزالي في "المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى". وقلّدهم ابن قيم الجوزية في "شرح أسماء الله الحسنى". ولكن ابن عطاء تفرد بينهم بخصوصية التجربة المشحونة بعطايا الذوق الفاعل صدوراً ووجوباً ومستنداً وتقريراً.
فلئن تعدَّدت الأسماء الإلهية؛ فالمقصود منها واحد، وهو الله، فكل الأسماء هى صفته ونعته، وهو أولها وأصلها. وهنا تفوح رائحة وحدة الوجود من كلام ابن عطاء، ولكنها وحدة وجود إيمانية إسلامية من الدرجة الأولى، أو كما قلنا ذوقية، فهى من أول وهلة تشتم فيها عبق الإيمان ومذاق التجربة وحلاوة المعاناة في سبيلها. ليست هى بالطبع كوحدة الوجود "البراهمانية" الهندية، وليست كوحدة الوجود المادية، ولكنها وحدة وجود روحية تقدم "الله" على العالم، وتجعل التصور تحت رهن الفكرة الإلهية؛ فكل ما في الوجود مخلوق لله، وليس للعالم قيام بذاته من ذاته؛ فوجوده لولا الله إلى زوال، فهو عدم محض عدم.
ولكن ابن عطاء يعبر عن هذه الفكرة ـ التي تبدو وكأنها "وحدة الوجود"، وهى في الواقع محض إيمان ـ بمذاقات التجربة الإيمانية الحيّة التي يلزم عنها في الغالب ردُّ كل شيء إلى الله، والتصرف في الأكوان بمقتضى العبودية له، وإسقاط التدبير معه، بمقدار ما يلزم عن معاناة هذه الأذواق القول بوحدة الوجود بمفهومها الإسلامي بعد التخلص المُفروض من واغش الروعونات والآفات.
وذوق الإيمان الخالص لا ينقبض عن لقاء وحدة الوجود، ويحتم القول بها لا كنظرية فلسفية بل كتجربة دينية صوفية؛ إذْ أنه:"لا نزاع في أن فكرة وحدة الوجود (Pantheism) في أساسها وليدة فرط إيمان تدفع إليها عاطفة قوية وشعور فياض، وهى لهذا تلائم كبار الصوفية والروحانيين".
ولئن كان ابن عربي هو أول واضع لمذهب وحدة الوجود في التصوف الإسلامي؛ فمن المؤكد أنه مذهبٌ يقوم على دعائم ذوقية أساساً.
وعليه؛ نكاد نجزم أن وحدة الوجود فيما لو أخذت بهذا التخريج فهى ليست سُبَّة للقائلين بها، ولا هى بالتهمة التي يفر منها قاصديها، ولكنها محض ذوق يتأسس على الإيمان، ويتجاوب مع فكرة التوحيد التي تقتضي إسقاط التدبير؛ فإذا عَرَفتَ التوحيد حق المعرفة أسقطتَ التدبير معه، ومضيت في طريق العبودية على البصر بالله وهو أعلى مراقي التفويض؛ بل لا نجاوز الصواب فيما لو قلنا إنها العبارة الصحيحة عن التصوف الحقيقي بلا أدنى شك. يقول ابن عطاء الله السَّكندري في نص ممتاز من هذا الكتاب:" والأسماء كلها سَرَت في العالم سريان الأرواح في الأجسام، وحَلَّتَ منه محل الأمر من الخلق، وَلَزَمَتْهُ لزوم الأعراض للجواهر. فإنه ما من موجود، دَقَّ أو جَلَّ، عَلا أو سَفَل، كثف أو لطف، كثر أو قلَّ، إلاّ وأسماء الله (جل وعز ذكره) محيطة به عيناً ومعنى. ومقتضى اسم الألوهية جامع لجميعها، كالأسماء المحيطة بالعوالم. المنقسمة إلى أمر وخلق، وكان لها مقام الروح من الجسد. ومن لطف الله تعالى أن أظهر من علمه وقدرته بهذا الاسم ما احتملته عقول خلقه؛ ليصل حبله بحبلهم، وبفضله فطرتهم التي فطرهم على معرفته".
فلئن كانت تتجلى في هذه العبارات معاني وحدة الوجود؛ فهى لا تتجلى إلا من فيض الإيمان يُذَاق ذوقاً ولا تتجلى من عطايا النظر؛ بل من معاناة التجريب، تعطيه البصيرة المنتجة المثمرة؛ فهى من الإيمان بمكان بحيث لا تنفصل عنه ولا تفهم على الحقيقة بغيره.
وتجدر الإشارة إلى أن الكلام في معنى كلمة "لا إله إلا الله" هو هو الكلام نفسه في التوحيد؛ قد استغرق كتباً ورسائل من القدماء، كان أهمها بالإضافة إلى قصد ابن عطاء المُجَرَّد، كتاب "معنى لا إله إلا الله"؛ لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 794 هـ)، والكتاب قام بتحقيقه والتعليق عليه والتقديم بفصل عن "أضواء على كلمة التوحيد"؛ على محيي الدين علي القره داغي، طبعة دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس سنة 1984م، وهو يتناول معنى كلمة التوحيد من حيث اللغة، والبيان، والإعراب، والكلام، وأهل الإشارة.
تلك كانت أهم النقاط التي تضمّنها كتاب ابن عطاء الله "القصد المُجرَّد في معرفة الاسم المفرد"، وإنما أطلنا الكلام عنه؛ لأنه من أكثر كتبه جلالة وتفرُّداً على أقل تقدير من ناحية الموضوع الذي عالج فيه مع كتابه "الحكم العطائية"، مسائل التوحيد، وشغل نفسه بهذا الموضوع إلى درجة لم ينصرف فيها إلى موضوع سواه، ولم يستطب البحث في غيره.
(وللحديث بقيّة)
بقلم: د. مجدي إبراهيم