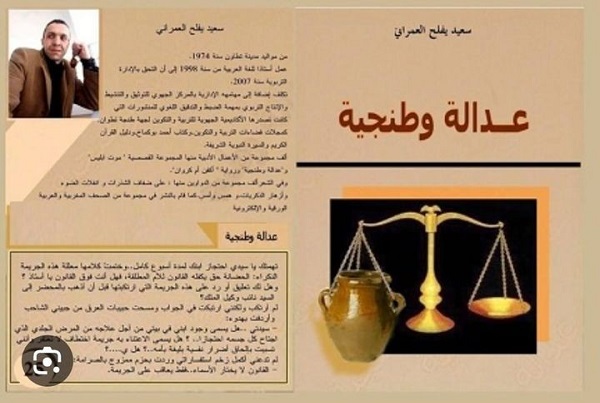صحيفة المثقف
مجدي إبراهيم: إرادةٌ ضد الإرادة
 بإزاء خصوصيّة الخطاب المعرفي الصوفي، نقلة من خطاب المشايخ إلى خطاب المريدين، تظهر السّمة البارزة التي تميّز الفوارق بين خطاب وخطاب. ففي الحالة الأولى، خطاب العارفين أنفسهم لأنفسهم، يأتي التعبير في شكل رمزي وأفق روحي وفضاءات إشاريّة. في هذه الحالة يستحيل الانفصال بين العبارة والإشارة؛ بسبب أن الإشارة كالروح والعبارة كالجسد. والعلاقة بين العبارة والإشارة كالعلاقة بين الظاهر والباطن؛ فظاهر العبارة هو ما تدل عليه من حيث وضعيّة اللغة. وباطن الإشارة هي ما ترمز إليه من حيث هي لغة إلهيّة، حتى إذا كان أهل الظاهر يتوقفون عند العبارات ومعانيها التي تعطيها قوة اللغة الوضعية، وجدنا العارفين ينفذون إلى ما تسير إليه لغة الإشارة من معان وجوديّة وإلهية. من أجل ذلك؛ اتّخذوا من الرمز وسيلة للتعبير عن لغةٍ ليست بالعادية ولا بالمألوفة. وإذا تسألنا عن علة استخدام الرموز والإشارات لم يكن هنالك مبرر أقوى ولا أقنع من أحكام التجربة الصوفية وفروضها؛ إذ كان التعبير بالرمز هو وحده الذي يُقابل الحالة الصوفية التي لا تكيفها عبارة عاديّة ولا يسعها لفظٌ معتاد.
بإزاء خصوصيّة الخطاب المعرفي الصوفي، نقلة من خطاب المشايخ إلى خطاب المريدين، تظهر السّمة البارزة التي تميّز الفوارق بين خطاب وخطاب. ففي الحالة الأولى، خطاب العارفين أنفسهم لأنفسهم، يأتي التعبير في شكل رمزي وأفق روحي وفضاءات إشاريّة. في هذه الحالة يستحيل الانفصال بين العبارة والإشارة؛ بسبب أن الإشارة كالروح والعبارة كالجسد. والعلاقة بين العبارة والإشارة كالعلاقة بين الظاهر والباطن؛ فظاهر العبارة هو ما تدل عليه من حيث وضعيّة اللغة. وباطن الإشارة هي ما ترمز إليه من حيث هي لغة إلهيّة، حتى إذا كان أهل الظاهر يتوقفون عند العبارات ومعانيها التي تعطيها قوة اللغة الوضعية، وجدنا العارفين ينفذون إلى ما تسير إليه لغة الإشارة من معان وجوديّة وإلهية. من أجل ذلك؛ اتّخذوا من الرمز وسيلة للتعبير عن لغةٍ ليست بالعادية ولا بالمألوفة. وإذا تسألنا عن علة استخدام الرموز والإشارات لم يكن هنالك مبرر أقوى ولا أقنع من أحكام التجربة الصوفية وفروضها؛ إذ كان التعبير بالرمز هو وحده الذي يُقابل الحالة الصوفية التي لا تكيفها عبارة عاديّة ولا يسعها لفظٌ معتاد.
فرضت الحالة الصوفية وجوداً من الخيال ليس له مقابل من اللغة الوضعيّة الاصطلاحيّة، ولا يمكن كشفه إلا في ظلال التجربة؛ إذ تسفر التجربة عن ارتقاء الحالة الروحيّة وهي بالطبع حالة معتمدها القلب ولا تخاطب العقل؛ بل تخاطب الشعور الوجداني العميق، إذ ذاك تخلق هذه الحالة معادلاً من الخيال الخلاق إذا هو شاء التعبير عن عالمه لم يجد لغة لفظيّة عادية كلغة الوضع والاصطلاح تعبّر عنه؛ فيلجأ إلى الرمز ويتخذ من الإشارة الرمزيّة لا العبارة العادية وسيلة للتعبير.
هذا هو مبرّر الرمز الصوفي عندنا وتلك هي الحالة الأولى.
وفي الحالة الثانية فيما لو كان الخطاب مُوجّهاً إلى المريدين تبرز الدلالة التعليميّة التربوية، ولا يقتصر الخطاب البارز على هاتين الخاصتين فقط من حيث إنهما تربية وتعليم وكفى، ولكنه يشمل اللفتة إلى علوم الترقية؛ بموجب التعليم وموجب التربية.
وإذا كانت دلالة الخطاب تجئ أقوى في شكله الرمزي لأنه مفتوح لا تخصيص فيه، ليس لفضاءاته سقفٌ محدود، فإنه يكون بين المشايخ على قدر أحوالهم باعتبار أنهم بمقتضى التجربة نفسها تعززت لديهم مفاتحه ومفاهيمه، فاستبصروا مغاليقه المُلغزة، وأصبح الأمر بالنسبة لهم (إشارة) لا (عبارة)، لكنه حين يتّجه إلى المريدين بنقلة التربية والتوجيه تكون العبارة الخاصّة بهذا الخطاب أفصح وأبلغ ممّا كانت عليه الحال في جهة الإشارة المُلغزة.
ولكن هَبْ أن العُرفاء استوجبوا الحديث بالعبارة وحدها بدلاً من الإشارة فيما لو سارت الأمور بالضد، فما الذي يحدث؟ إذ ذاك ينقلب الوضوح إلى خفاء وغموض ويقترب الإلباس من تحقيق مراده، وبالأوْلى أن يحدث العكس. غير أنه غموض لا يقضي على حيوية الخطاب بمقدار ما يفتح منافذ نشطة عديدة لاستنباط معانيه. وبمقدار ما يرتد إلى تربية الأذواق الدنيا، والصعود بها من درجات الضعف إلى مراحل القوة، يحقق الخطاب أغراضه ويفتح قنوات توجُّهاته بحكم التربية والتعليم. وإنما تجئ حالة الغموض لا فيما يصدر عن إشارات العارفين؛ بل في الحالة التي يكون عليها مُتَلقي الخطاب، السالك نفسه، لأن المُخَاطب يستلزم أن تتهيأ حالته لاستقبال أي عبارة أو إشارة تصدر من القمم العليا إلى الأذواق الدنيا. وفي الغالب كل عبارة أو إشارة على هذا النحو مُوجّهة من القمة إلى القطاع العريض تستلزم أدب التسليم الذي لا حائل فيه بين الشيح والمريد، بمعنى أن هذه الحالة تقتضي إرادة فانية في إرادة الشيخ، كيما يتم الفهم عنه بالمباشرة.
وأول شرط لفهم الإشارة - حتى على غير المريدين - هو التعاطف، وهو أول واجبات التسليم، ولا شرط للتعاطف إلا إسقاط الإرادة من حيث إن معنى كلمة مريد هو من لا إرادة له، لكن هذه "اللاإرادة" هى في نفس الوقت قمة "الإرادة" غير أنها مرهونة بالتعليم وبالتربية وبقوانين الصحبة المعمول بها في أدب السلوك.
لقد كان على المريد أن يفهم دلالة الخطاب الموجه ذوقاً لفقه الإشارة فيه، وبمجرّد تفهمه إيّاها بالاستعداد الموازي، يكتشف خصوصيتها. وخصوصية الحصول على الشيوخ الحقيقيين؛ فإنهم أعزاء لا وجود لهم مقدار عزة علومهم ومعارفهم، وعزة الطريق الذي يتنسبون إليه ويدينون له بالولاء.
ولا عجب، وليس للمريد إرادة أصلاً، ليست له إرادة ولا اختيار؛ لأنه أراد الطريق، ومادام قد أراد الطريق فلا ينتظر منه - على أقل تقدير في المراحل الأولى - أن تقوم نفسه بحظوظها، أو تكون له نفسٌ أصلاً. ومن فرائض الطريق: أن يسقط إرادته في إرادة شيخه لكيلا تكون هنالك إرادة له أصلاً. إرادة المريد هنا هى هى إرادة الشيخ، إذْ كانت هى هى إرادة الله: يُفنيها مختاراً في إرادة شيخه حتى إذا استوثق من هذا، ولا بدّ له، كان ذلك بمثابة الشفاء والترياق، قال:
ورَاقبَ الشَّيْخَ في أحْوَاله فَعَسَىَ
يَرَىَ عَلَيْكَ منَ اسْتحْسَانَهُ أَثَرَاً
ولمّا كانت قلوب المشايخ ترياقَ الطريق، صار مَنْ سعد بذلك (أي من أسعده الله بمعرفة شيخ؛ لأنه من النادر وجود مثل هذا الشيخ) تمَّ له المطلوب وتخلص من كل تعويق في مسارب الطريق ومزالقها؛ لأن سلوك مثل هذا الطريق من الصعوبة البالغة يندر معها وجود الشيخ فيُسلم له القياد. وقد أجمع السادة على أن من "قال لشيخه لمَ لا يفلح في الطريق، لأن (لمَ) هذه، دالة على بقاء النفس وبقاء حظوظها ورعوناتها فضلاً عن دلالتها على قلة الأدب التي لا يجوز معها صفاء الحال ولا وراثة العلوم الشريفة. من أجل ذلك، يُوصي ابن عطاء الله بالاجتهاد في مشاهدة هذا المعنى، فعَسَى الشيخ يرى على تلميذه من استحسان شأنه وارتقاء حاله أثراً، حتى أن بعضهم قال:"من أشدّ الحرمان أن تجتمع مع أولياء الله تعالى ولا تُرزق القبول منهم. وما ذلك إلاّ لسوء الأدب منك". ويؤيد هذا المعنى ما قاله في شذرة "الحِكَم": " ما الشأن في وجود الطلب، وإنّما الشأن أن تورث حُسن الأدب".
تعني إشارة "الحكم" أن الشأن المعتبر عند العارفين لا يكون في وجود الطلب لحوائجك من مولاك، وإنمّا الشأن أن يرزق العبد حسن الأدب مع الله، مع مَنْ خَلَقَهُ وسّواه، بتفويض الأمر إليه والرضا بما قَسَّم والاعتماد عليه. ومن حسن الأدب: أنْ لا تنقلب مناجاته لربّه لعلِّةٍ حظ في دنياه؛ بل تكون لأجل المناجاة خالصة عن دواعي الحظوظ.
وهنا قد تلتبس معنا إشارة "الحِكَم" مع عبارة "عنوان التوفيق"، ولكن هذا الالتباس يتلاشى تماماً حين نعرف أن حُسن الأدب مع الخالق يجمع تحته حُسن الأدب مع المخلوقين، وفي مقدّمة هؤلاء المخلوقين أن يكون الأدب عنواناً ظاهراً ودليلاً على الباطن المستور، ومُوجَّهاً ناحية الشيخ الذي هو حقيقٌ بالمحبّة والخدمة والولاء:"واعلم أن السعادة ـ هكذا يقول ابن عطاء الله ـ قد شملتك من جميع جهاتك إذا عَرَّفَكَ الله تعالى به وأطلعك عليه؛ فانّ الظفر به أعَزُّ من الكبريت الأحمر". ومن أجل ندورة الحصول على الشيخ ومعرفته وعزة وجوده في الطريق؛ قال في "الحكم": "سبحان مَن لم يجعل الدليل على أوليائه إلاّ من حيث جعل الدليل عليه، ولم يوصِّل إليهم إلاّ من أراد أن يوصله إليه"؛ إذْ لا دليل على الله سواه، ولا وصول إليه بغيره، وكذلك أولياؤه.
ولمَّا كان الوصول إلى الله تعالى، لا يكون إلاّ بالعناية والاصطفاء والخصوصِّية، ويستحيل أن يكون بطلب أو سبب؛ كان أولياؤه المخصوصون بالقرب منه كذلك. وإنه ليذكر عن شيخه أبي العباس المرسي قوله: "معرفة الوليّ أصعبُ من معرفة الله، فإنّ الله معروف بكماله وجماله، ولكن متى تعرف مخلوقاً مثلك يأكل كما تأكل، ويشرب كما تشرب". ثم قال:"وإذا أراد الله أن يعرِّفك بوليّ من أوليائه طوى عنك وجود بشريَّته، وأشهدك وجود خصوصيته ". ومن الواضح أن تشديد الشَّاذليَّة على عزِّة الطريق وعزة أهله تشديداً يُعْرَف من خلاله ندورة وجود الشيخ، لدليل على صِدْقهم في طريق الله من جهة، وعلى وقوفهم أمام الأدعياء الذين ينتسبون على كثرتهم إلى التصوف، وهم ليسوا منه في شيء.
أقول؛ نظراً لندورة وجود الشيخ وقلّة الحصول عليه؛ وهو بالقطع الدليل والمرشد؛ فمقتضى مقامه أن يلزم المريد الأدب بين يديه؛ وهو أقلُّ القليل.
وهكذا تمضي القصيدة فيما لا يقل عن ثلاثة وعشرين بيتاً، ناهيك عن تخميس ابن عربي لها لتجيء درة نفيسة في آداب الطريق. وهكذا يمضي شرح ابن عطاء الله السَّكندري لها مستشهداً بحكمه تارة، وبأشعاره تارةً أخرى ليُضفي على القصيدة الغوثية أدباً فوق أدبها، ورقيَّاً فوق رقيَّها، ومعرفة بأخلاق الرجال وصدقهم وتآلفهم وارتقاء نظرهم وسلوكهم وأنوار معارفهم ممّا من شأنه أن يدعو للعجب والإعجاب والتأثير. فأما العجب؛ فلهذه النظرة الجُوَّانيَّة الباطنة التي تجمعهم جميعاً، مع اختلافهم وتباعد أزمنتهم وأمكنتهم على طريق واحد وغاية واحدة وهدف واحد. وأما الإعجاب؛ فلهذا الوفاء للسابقين من الأشياخ وفاءاً يكادُ ينقطع معه النَّظير؛ ممَّن جَرَتْ كلماتهم، وهم الأسلاف البررة، مجرى الغذاء الروحي لأخلاف كانوا على ديدن الصدق وتوهج التَّلقِّي، فتربّوا، من ثمَّ، بالكلمة وكفى التربية بالكلمة أصلاً لمن رَهَفَ عنده الإحساس ودق.
وأمّا التأثير؛ فلتلك الحاسَّة الشعورية الملآنة بعبق الأذواق والمواجيد، والصارخة بمعاناة التجارب وفواتح الروح والضمير، والتي يرق لها القلبُ المكلوم ويتأثر فيها وبمقتضاها وجدان القارئين.
إذا كان عنوان الكتاب في "أدب الطريق"، فمن المؤكد أنه يهدف في مجموعه إلى فكرة ابن عطاء الله السَّكندري الجوهرية: إسقاط التدبير، من طريق الأدب، إنه يحدِّثنا بما يؤكد فكرته هذه، حين يقرّر أن لله عباداَ خرجوا عن "التدبير" مع الله بتأديبه الذي أدَّبهم به، وبتعليمه الذي علَّمهم إيَّاه، فَفَسَّخَتْ الأنوار عزائم تدبيرهم، ودَكَّتْ المعارف والأسرار جبال اختيارهم، فنزلوا منزل الرضا فوجدوا نعم المقام فاستغاثوا الله واستصرخوا به خشية أن يشغلهم حلاوة الرضا، فيميلوا إليها بمساكنة أو يجنحوا لها بمُراكنة".
فهؤلاء الذين تأدَّبوا بأدب الطريق، هم لم يتأدَّبوا به من تلقاء أنفسهم بأنفسهم، ولكن الله تولى تأديبهم في سابق عنايته؛ فكانوا مع الله في كل حال، حتى: "فسَّخَتْ الأنوار الإلهية عزائم تدبيرهم ودكدكت المعارف والأسرار جبال اختيارهم". فإذا هم في منزل الرضا يجدونه نعم المقام، خافوا على أنفسهم أن تشغلهم حلاوة الرضا فيسكنوا إليها فاستغاثوا الله منها ليغيثهم: أن لا يسكنوا إلى حلاوة ونعيم أبداً سوى حلاوة نعيمه (هو) والقربة منه (هو) دوناً عن سواه. وابن عطاء في تصوفه لم يكن ليخرج عن أدب العبودية بحال.
ولعلك ترى في هذا كله أنه يدور حول تلك الفكرة المبدعة، الجليلة، الجميلة، الصافية، الرائقة، ويجند قلمه مخلصاً في كل ما كتب خدمة لهذه الفكرة العلويّة وتخليصاً لها من شوائب العوالق والأغيار. إنّ فكرة "إسقاط التدبير" لهى ـ فيما نرى ـ أبدع وأجلَّ ما ترك التصوف من آثار؛ وإنها لروح هذا "الفن" إذا صحَّ أنْ هنالك روحاً لكل فن، فيما لو تحقق منها السالك: لب لباب التصوف السُّني هذه الفكرة غير منازع .
بقلم: د. مجدي إبراهيم