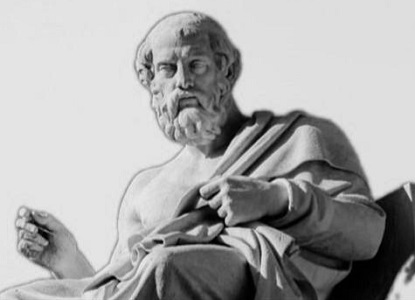صحيفة المثقف
إميلي س. دافيز: العلاقات الاستعمارية ومشكلة المرأة البيضاء
 ترجمة: صالح الرزوق
ترجمة: صالح الرزوق
ترتبط جينيالوجيا المقاومة في روايتي أهداف سويف ونايانتارا ساغال بمصر والهند، وتشترك بتجارب اقتصادية وثقافية تسيطر عليها الإمبراطورية البريطانية. وقد تغلغلت السيطرة البريطانية عن طريق مصانع شركة بريتيش إيست إنديا (شرق الهند البريطانية)، وتبع ذلك تبادل تجاري كثيف منذ القرن السابع عشر، وتم تسمية الهند مستعمرة بريطانية في أعقاب حركة التمرد في الهند عام 1857. وفي نهايات القرن التاسع عشر، أصبحت الهند جوهرة لا تقدر بثمن في التاج البريطاني، ليس لأنها قدمت المواد الأساسية مثل القطن والتوابل، ولكن أيضا لأنها وفرت تيارا مستمرا من المتطوعين للجيش، وكانوا قوة لا غنى عنها لبقاء الحكم البريطاني في أرجاء الإمبراطورية. وكان الجنود الهنود غالبا إما يشكلون قوات احتياط أو إمداد للقوات البريطانية في بقية المستعمرات، ومنها مصر على سبيل المثال.
وبعد مقتل الضابط البريطاني جورج غوردون في السودان عام 1885 على يد قوات تابعة للمهدي، وهو قائد ديني أعلن الاستقلال وشكل دولة منفصلة، تم إرسال جيش مكون من جنود مصريين وبريطانيين وهنود بقيادة هوارشيو كيتشنير لفرض السيطرة، واستعادة ما سيعرف لاحقا في عام 1898 بأرض مصر والسودان الإنكليزية.
وقد ضعف دور الحكم البريطاني في الهند على نحو محسوس بعد الحرب العالمية الأولى، حينما اندلعت على مستوى وطني الاحتجاجات بسبب المجزرة التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين في أمريتسار عام 1919، وهو ما قدم الدافع للحركة الوطنية البورجوازية. ولكن التيار الجارف بدأ حينما طلبت حركة “خروج الهند” بقيادة الزعيم غاندي الاستقلال عن البريطانيين مقابل التعاون معهم في الحرب العالمية الثانية. ووافقت بريطانيا، التي أثخنتها الجراح في الحرب، على هذا الشرط، وتكونت دولتان مستقلتان جديدتان هما الهند والباكستان في 15 آب عام 1947.
وبدأ تاريخ مصر الاستعماري بعد فترة وجيزة، وتضمن طيفا معقدا من القوى الأجنبية. فقد رزحت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية لعدة قرون، ثم وقعت بين أيدي جبيش نابليون عام 1798. ولكن القوات المصرية تلقت الدعم من الجيش البريطاني، وتمكنت من دحر الفرنسيين بعد ثلاث سنوات من الصراع. ومع أن مصر، وخلال ثمانين عاما تلت، لم تكن رسميا مستعمرة فرنسية أو بريطانية، فقد وجدت نفسها على نحو متزايد تحت سيطرة اقتصادية للحكومتين الفرنسية والبريطانية، وديونها المستشرية كفطر الغابة، وعلى وجه الخصوص في عهد الخديوي إسماعيل (الحاكم المعين من قبل الإمبراطورية العثمانية)، أجبرها لقبول إدارة اقتصادية تعاون فيها الفرنسيون مع البريطانيين. ولاحقا قاد الكولونيل أحمد عرابي جماعة من الوطنيين المصريين للقيام بانقلاب عسكري على الخديوي توفيق في نهايات عام 1881. وقدمت هذه الخطوة للقوات البريطانية المبرر لتحتل مصر رسميا عام 1882، وكانت تهدف من وراء ذلك للتحكم بقناة السويس، ومنع القوات الاستعمارية المناوئة من فرض سيطرتها على مصر واستعمارها. ثم نشبت الحرب العالمية الأولى، وحولت السلطات البريطانية مصر في عام 1922 من محمية إلى ملكية دستورية، كخطوة مصالحة وكمحاولة يائسة لاحتواء الثورات الوطنية. ولكن احتفظت بالجيش وقطاع الاتصالات بيد البريطانيين. ولم يحصل في مصر قطيعة اقتصادية مع الفرنسيين والبريطانيين حتى قيام حكومة ناصر، واستلامه السلطة عام 1952. فقد أمم قناة السويس، وطرد القوات البريطانية، ونفى الملك فاروق وأعلن قيام الجمهورية.
ولا أريد من أحد أن يفهم أنني أعتقد أن كلا من مصر والهند سارتا بمسار متماثل في ظل الاستعمار البريطاني، حتى قيام الثورات وتحقيق الاستقلال. والحقيقة أن هذه الجينيالوجيا تؤكد وجود تمايز في روابط مصر والهند مع الاستثمارات الاستعمارية البريطانية، فقد اتخذتا موقعين مختلفين، وأحيانا متعاكسين، وذلك ضمن الأسرة الاستعمارية. مع ذلك رغم هذه الفروقات الواضحة في تطور تاريخ المقاومة الوطنية، وتطور ظاهرة الاستعمار، توجب على مصر والهند أن تكافحا ضد الاقتصاد الاستعماري والتبعية الثقافية التي اتكأت بشكل واسع على مجاز ورموز معينة، هي تحديدا ما اتفقنا على تسميته باسم “الاستشراق”.
كان الاستشراق (ولا يزال) مهووسا بفكرة مركزية وهي افتراض وجود عقدة جنسية عند الذكر “المحلي”، الذي يعتقد أنه يحمل رغبة جارفة بالمرأة البيضاء الغربية. وترى روايتا سويف وساغال بشكل مباشر، مع مجاز استشراقي آخر، ظهر تقريبا في كل سياق استعماري في نقطة من النقاط - إن المرأة البيضاء الكولونيالية مهددة من السلطة الاستعمارية، وتهددها بنفس الوقت. كان من المقبول للنساء البيض القدوم للمستعمرات بأعداد كبيرة في نهايات القرن التاسع عشر لسد النقص في “التحضر”، وما قد يسببه ذلك من ضغط على المستعمر البريطاني. ولكن تمثيل صورة المرأة البيضاء في المستعمرات لم يكن بنية مستقرة، فهي مثل بنية الرجل الاستعماري، تشير لمخاوف وتخيلات كولونيالية وليس لمجرد حضور واقعي وفعلي. بهذا الصدد لاحظت آن لورا ستولير Ann Laura Stoler في “المعرفة الجنسية والسلطة الإمبريالية” أن موقف بريطانيا، من فكرة النساء البيض في المستعمرات، قد تبدلت بتبدل السياسات الاستعمارية نفسها. وعليه في بواكير القرن الثامن عشر كانت المستعمرات تصور على أنها شديدة الخطورة على المرأة البيضاء، وكان المستعمر البريطاني يفضل اتخاذ تدابير لتوفير خادمة وخليلة من النساء المحليات لإرضاء ميوله الجنسية و“احتياجاته” المحلية التي تعتني بها عادة الزوجة البيضاء. ولم يكن يسمح للضباط أن يتزوجوا حتى يتموا فترة محددة بالخدمة، وغالبا تبلغ ثلاث سنوات أو ما يزيد على ذلك. وبنهاية القرن التاسع عشر، هذا السلوك المعياري، أصبح ينظر له كسلوك غير متحضر وله احتمالات خطيرة. وللتأكد أن الرجل الأبيض يحافظ على “نقاء” هويته البريطانية في فترة الخدمة بالمستعمرات، أصبحت السياسة الرسمية تشجع النساء البريطانيات على الهجرة مع أزواجهن أو للاقتران برجال يخدمون العلم في الخارج. وبتكوين “بريطانيا مصغرة” بشكل بيوتات في المستعمرات، خدمت المرأة البريطانية البيضاء هدفا أساسيا وهو حماية وإعلاء شأن التسلسل الهرمي الذي خشي عليه المسؤولون بشكل جدي، ولا سيما بسبب نظام المحظية وما نجم عنه من أطفال مهجنين ومزدوجي العرق. ومع أن النساء البيض كن يعتبرن أساسا حاميات لنقاء العرق البريطاني في المستعمرات، سرعان ما انتقلن لتمثيل المخاطر التي لحقت بالمشروع الاستعماري. إن تصوير النساء البيض وكأنهن عرضة لخطر العنف، وبالأخص العنف الجنسي، الذي يمكن للرجال المستعمرين (بفتح الميم) أن يقترفوه قد خدم بتوحيد المجتمعات البيضاء ضد أولئك الذين يحكمونهم، وبالتالي ساعد على تثبيت وفرض الحدود العرقية، وهو ما كان الموظفون الاستعماريون يقلقون منه. هذه الحدود كانت قابلة للعبور في عقود سابقة، وفضفاضة، ولا تقيد التواصل بين الحاكم والمحكوم. وقد قالت فرون وير Vron Ware:”أصبح أمن النساء البيض في الإمبراطورية مشكلة إيديولوجية مستمرة، مرتبطة بشدة بشرعنة السلطة الاستعمارية”. وبتعبير آخر: أصبحت حالة النساء البيضاوات في المستعمرات ترمز لمصير سيطرة الثقافة البريطانية نفسها. ونتيجة ذلك تزايدت المخاطر المعلنة الموجهة للنساء البيضاوات مع ظهور علامات تدل على المقاومة الوطنية للحكم البريطاني، ورسمت بالتالي حدودا تاريخية نوعية لكل مستعمرة على حدة. وتمثيل الذات الكولونيالية ثقافيا في وقت الأزمات كان عقدة تاريخية وجغرافية، وعليه إن أوصاف الرجل الهندي الخطير والمعبأ بإيحاءات جنسية قد يختلف عن الصور الاستشراقية للخطر الجنسي في مستعمرات الشرق الأوسط. وبتعبير جيني شارب Jenny Sharpe رمزية المرأة البيضاء بشكل ضحية جنسية محتملة للرجل الهندي قد برزت أولا بعد ثورة الهند عام 1857، وتم تعويمها بشكل أداة تحريك وتعبئة موجهة للمجتمع الأبيض بعد أزمات لاحقة عانت منها السلطات البريطانية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر مشكلة ميثاق ألبيرت عام 1883 (*وثيقة أجازت للقضاء البريطاني في الهند بإصدار أحكام ضد رعايا بريطانيين إن كانوا غير أوروبيين) وما تبعها من عصيان في أعقاب مجزرة أمريتسار عام 1919.
وهكذا أمكن تبرير واتباع القمع الوحشي لعصيان الوطنيين المعارضين للكولونيالية بحجة أنه ضروري لحماية نساء وأطفال بريطانيا في المستعمرات. وبالمقارنة مع الهند البريطانية، كان هناك القليل من النساء البريطانيات في مصر في بواكير القرن العشرين. ولذلك كانت المرأة البيضاء أساسا رمزا للحريات التي حرمت منها النساء في “الثقافة الإسلامية الأحادية والظالمة” جدلا.
طبعا إن هذه البلاغة كانت مبطنة بالتعالي والتزوير. مثلا استعمل اللورد كرومير، القنصل البريطاني العام غير المحبوب شعبيا والمعروف في مصر في بدايات القرن العشرين، هذه البلاغة عن حريات النساء البيضاوات حتى بعد أن قطع التمويل الذي كان متاحا لبنات المدارس في مصر وساعد بكل قوته في دعم جمعية معادية للأنوثة في بريطانيا هي: نادي الرجال ضد حق اقتراع النساء.
ومع أن الوضع المهدد بالخطر ساعد على تلاحم البيض في بعض الأوقات حينما تعرضت السيادة البريطانية لتحديات ومعوقات، فقد تلقت النساء البريطانيات الملامة على انحدار الإمبراطورية البريطانية. وفي الهند كانت شخصية الممصاحب (*السيدة البيضاء) برهانا على عنصريتها في المستعمرات، وكانت تقارن بالدور المقابل للرجل الكولونيالي. وبتعبير جين هاغيز Jane Haggis كانت المرأة البريطانية في الخيال البريطاني الشعبي هي“التي تسببت للبريطانيين بفقدان إمبراطوريتهم، وللأصدقاء المحليين بالاستلاب من خلال كبريائها المثير للشفقة وغيرتها الجنسية”. ولكن النساء البيضاوات لسن مشكلة فقط في حال تورطن كثيرا ببلاغة التعالي الكولونيالي. هن أيضا مشكلة إن لم يتورطن بها على الإطلاق. تقول كوماري جايا واردينا Kumari Jayawardena “النساء البيضاوات حارسات للعرق، ومن لم تمتثل لهذه الصورة ينظر لها كخطر موجه للسلطة الاستعمارية. ومن لهن صديقات محليات كن تتهمن - بالتغول - وأي نشاط اجتماعي مع الرجل المحلي ينظر له كما لو أنه خيانة عرقية”. وليس مدعاة للدهشة أن التمثل المزدوج للنساء البيضاوات كمنظفات عرقية وملوثات عرقية قد فشل بوجه الإطلاق للاعتراف بدور العقدة التي لعبتها المرأة البيضاء في المستعمرات البريطانية. لقد ذهبت المرأة البيضاء إلى المستعمرات لأسباب متعددة. بعضهن لسبب تبشيري أو بدافع الاشتراكية الداعية للتضامن والمساواة، وغيرهن دفعهن الأمل بالرفاهية المادية أو إغواء السرديات الاستشراقية التي ضخمت من الجانب الروحي المعزو للتصوف الديني. والنساء المبشرات غالبا تنتمين للأخويات الدولية، وهي أساس تدخلهن بالسياسة الجنوسية في المستعمرات، وهو ما عارضه المواطن المحلي، امرأة كان أو رجلا.
وفي نفس الوقت تساوى التحالف والصداقات السياسية بين الوطنيين الذكور في المستعمرات مع نشاط البيضاوات لتحرير المرأة وأصبح المجالان متكافئين على حساب المزيد من التورط بمشكلة التضامن النسوي الذي يهمل الحدود العرقية. وحينما نصل للترتيبات بين الأعراق، نكون أمام واحد من احتمالين: إما أن فكرة الجنوسة الكونية تفتح الطريق لمعاداة الإمبريالية، أو أن التكافل الوطني يمهد للجنوسة، وهذه مشكلة معروفة حتما منذ دراستي للروايات الجنوب إفريقية سابقا.
ماذا جعل رواية سويف أو ساغال متميزة بضوء هذه الأنماط التاريخية، في حين أن رمانسياتهما بين الأعراق تبدو مثل تعبير متخيل عن تحالف سياسي بين المرأة البيضاء / الرجل الكولونيالي، فقد كانت تتدبر شؤونها لتتجنب الجانب التبشيري والوطني على حد سواء.
تبرز الكاتبتان متكاتفتين جزئيا لأنهما تمثلان نوعا من أنواع التضامن الذي يمكننا رؤيته في معظم التفاصيل التاريخية - المرأة البيضاء المعادية للإمبريالية والرعايا المؤنثات المستعمرات.
بالتأكيد تهدف سويف لاستنتاج أنواع جديدة ومقاربات عابرة للحدود الوطنية والمراحل التاريخية، وذلك بواسطة استيعاب الرومانس الاستعماري في “خريطة الحب”. والتمثيل يصبح الموضع الأساسي لمثل هذه العلاقات الحميمة في رواية سويف، فالشخصيات تهمش ضمن الإشكاليات السياسية الوطنية، وفي هذا الحين تلتفت لوسائط تتراوح بين الحبكة والترجمة وحتى الانترنت للبحث عن خطاب مقاومة بديل. وتعود للخلف وتعبر عدة أجيال لتركيب تحالفات مع النساء الأخريات، وهي تحالفات سياسية وفنية صلبة متخيلة عابرة للتاريخ.
ولوصف كيف أن هذه الشخصيات المعاصرة تفقد نفسها في حكايات أمهاتها، تعمل سويف على إضفاء طابع درامي على الشدة المؤثرة والمتعة الخاصة وكلاهما تقدمة من الرومانس، وذلك فقط لتفسير وتوضيح كيف أن هذا التأثير يوفر الرافعة اللازمة لتجديد الفعل التراكمي (*الجماعي).
***
....................
– الترجمة عن كتاب “إعادة التفكير بأنواع الرومانس: تقارب الثقافات الأدبية الدولية المعاصرة. منشورات بيلغراف ماكميلان. 2013. ص 66 - 70.
* إميلي س. دافيز Emily S. Davis كاتبة أمريكية. تعمل بمرتبة أستاذ مساعد في جامعة ديلوير. مهتمة بشؤون الرواية في جنوب إفريقيا وتأثير المجتمع والجندر على أساليب الكتابة.