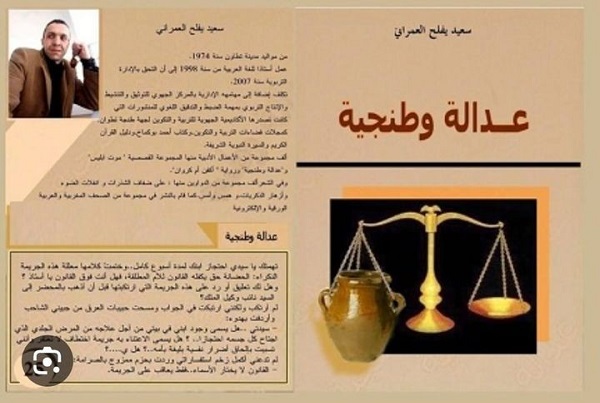صحيفة المثقف
سامي عبد العال: ذهنية الإفتاء والإرهاب
 أصبحت الفتوى من أدوات الدولة الحديثة لضبط أمور الاعتقاد والإيمان، ومن وقت لآخر، يتم الاستعانة بمؤسساتها للتغلب على المشاكل كالإرهاب والعنف وتحديد مسارات التدين. ولذلك لا تسمح أنظمة الدول العربية والاسلامية بترك هذا المجال دون الهيمنة عليه وتسييسه في غالب الأحيان. لأن قضايا الاعتقاد والأفعال (وما هو جائز أو ممنوع شرعاً) في الحياة تلامس قضايا السياسة. والإفتاء بهذا هو الصيغة الباقية من علاقة الدولة بالدين ويعد وظيفةً فوق الشعوب وتحت (إبط) السلطة مباشرة.
أصبحت الفتوى من أدوات الدولة الحديثة لضبط أمور الاعتقاد والإيمان، ومن وقت لآخر، يتم الاستعانة بمؤسساتها للتغلب على المشاكل كالإرهاب والعنف وتحديد مسارات التدين. ولذلك لا تسمح أنظمة الدول العربية والاسلامية بترك هذا المجال دون الهيمنة عليه وتسييسه في غالب الأحيان. لأن قضايا الاعتقاد والأفعال (وما هو جائز أو ممنوع شرعاً) في الحياة تلامس قضايا السياسة. والإفتاء بهذا هو الصيغة الباقية من علاقة الدولة بالدين ويعد وظيفةً فوق الشعوب وتحت (إبط) السلطة مباشرة.
لو نتذكر فكرة (أكشاك الفتوى) في مصر (أو ما يماثلها في مجتمعات أخرى) حين أطلقت حملاتها لتقاوم التطرف وترد على أسئلة الناس (الزبائن)، كان يجب التساؤل إزائها: هل ستُغيِّر الفتاوى البناء الفكري للإنسان؟ كيف يؤسس الإنسان أفكاراً بواسطة حُكمٍ فقهيٍّ قَلَّ أو كَثُر؟ وهل ترتهن نشأة الإرهاب وتمدُّده بفتوى، وبالتالي ستنتهي بإطلاق فتوى مضادة (حروب الفتاوى)؟! الأسئلة هنا حيوية طالما تطرح ظاهرة الفتوى أمام التحليل. وهي كذلك بقدر ابرازها لمفاهيم وخلفيات مؤثرة على انماط الاعتقاد. من تلك الناحية يتطلب الإفتاء نقداً بنائياً لمعرفة أية مضامين تحركه على صعيد العقل في المجال العام. وما هي الأُطر النظرية التي تدعمه وفي ذات الوقت تحُول دون اعتباره أساساً للخطاب الديني؟!
القضية تجسد هذه المفارقة كالتالي: أنَّه بصدد الإفتاء الديني يدخل في إطاره ما ليس دينياً بالضرورة، وفوق ذلك فإنَّ رجال الدين يراقبون كافة جوانب المجتمعات (شتى أمور الحياة)!! وتلك لحظة الوصاية المتناقضة (بين بين) بأبعادها المعرفية والأخلاقية داخل اللاهوت. وهي كذلك تفترض خلطاً عجيباً يجعل الافتاء وعظّاً لا يخلو من نفْسٍ عنيفٍ. والعنف بهذا الوضع يستثير ردود الأفعال. لأنه كامن في التصورات وعملية المراقبة، إذ لا ينتهي دون إثارة ردود فعل آخر... وهكذا يقع الافتاء داخل دائرة متبادلة بين الأفعال والردود التي لن تتوقف.
بدايةً فإنَّ أصحاب الفتاوى يؤمنون بقدرة الإفتاء على تحصين الأفراد ضد الاستقطاب والتطرف وأعمال العنف. حيث يقولون أنَّ الفتوى مهمة لتبيان ما هو مجهول من الدين. وأنَّها وسيلة خطابية لإبراز جوانبه الداعية للتسامح والمشاركة وقبول المختلفين. وبناءً عليها يمكن اتخاذ الآراء التي تيّسر للمتدينين اتجاهات سلميَّة دون نزعات التَّشدُد. أي تعدُّ الفتوى- من وجهة نظرهم- مدخلاً لحل مشكلات اجتماعية واخلاقية وغيرها.
وهذا الأمر يفشل إذا حاول الوصول إلى نتائج ملموسة في أرض الواقع. باعتباره سيختزل عالم الإنسان وملكاته في التلقي السلبي لجوانب الدين. وسيتعامل مع هذا الإنسان بمنطق (الدابة - البهيمة) التي تُسحب كيفما شاء صاحبُها. وتذهب إلى تخويفه بمواجهة القوة الميتافيزيقية (الله) لكيلا يقترف ما يخالف الشرع. ويبدو الإنسان بالنسبة إليها كائناً طائشاً بلا كوابح. وهو في جميع الأحوال ينبغي إمساكه بمقابض صارمةٍ تجنباً للتطرف.
لكن عندئذ: هل ذلك الإنسان له طاقات إبداعية أم مجرد كتلة من الغرائز العمياء؟!
إذا كان الإنسان كذلك، لماذا تُعلِّق (ذهنية الافتاء) عليه آمالاً في تغيير واقعه؟! كان أحرى بها ترك هذا (الحيوان العدواني!!) إلى مصيره البائس. ولتبحث الفتاوى عن متلقٍ يقبل الدين إجمالاً دون اعتراضٍ. وتلك العملية لذهنية الإفتاء تتعامل معه كما تعامل الإرهاب بالضبط تجاه ضحاياه. فالجماعات الإرهابية تُخضِّع أفرادها لعزل شعوري ونفسي وحياتي. ذلك لأجل قطع علاقاته المعتادة بالحياة. ولهذا كثيراً ما يجيء على ألسنة هؤلاء فكرة: الميلاد الجديد: الإنسان المغاير، بالنسبة للمنخرط في صفوف الجماعة عما كانه سابقاً من إنسان عاديٍّ. أي تناقضت حياته وتغير خط سيرها بالكلية.
حتى عندما نسأل أشخاصاً يحيطون بالمتطرفين: كيف ارتكب هؤلاء جرائمهم، يتعجبون إزاء الطفرة الشاذة التي حدثت لهم. وعادة ما يبدون اندهاشاً من كونِّهم ودعاء ومسالمين وأنهم يفعلون الخيرات كسائر الناس. وما كان ليتوقع منهم ما فعلوا. ولئن كانوا قد خرجوا عن الأطوار المألوفة فقد جاء ذلك محتوماً بالولادة ضمن العزل والإقصاء. لأنَّ هناك بناءً كلياً ملاصقاً لهذا. أقصد البناء حول اعتبار المتطرف هو الأعلى في مقابل الأسفل. هو الرباني في مقابل الشيطاني. هو المؤمن في مقابل الكافر. هو المرغوب في مقابل المكروه. هو الخالد في مقابل الفاني.
وأنَّ التقابل يجب أنْ يُحسم لصالحه وإلاً سيكون مُقصراً في حق الله والدين. هذا هو الذي يدعوه – بكل إلحاح – كي يتجاوز حاجز الجسد. ومن ثم يصبح قنبلة موقوتة تنتظر نزع الفتيل في أي وقت. ليكون بينه وبين الجنة تفجير نفسه وحسب.
وتلك هي المسؤولية البديلة التي تلقي في وجدان المتطرف وخلّده. مما يشعره بخفة الحياة كلها بجوار مهمته المقدسة. ومع العبادات واللقاءات التنظيمية يستقر الهدف داخل أعماقه وينطبع بحواسه وتكوينه النفسي. فتغدو حركاته وهمساته وأفكاره تمثيلية (أي أدائية) تعكس حركة الجماعة والتنظيم في أدق التفاصيل. ولذلك هناك امتثال تام لما تقول الجماعة، وثمة خضوع لها بإرادته الذاتية ولو كان مترتباً عليها قتل نفسه (تحت بند الجهاد).
هكذا سيتم تعبئة الارهابيين بكم هائل من التصورات والأخيلة التي تقبل العنف. بحيث يستطيعون اخراجها ثانية أمام المخالفين في شكل تفجيرات أو أعمال قتل. وتلك الجماعات تحتقر، تقزم، تحجم الإنسان وتدمره داخلياً كشرطٍ أولي لما تمارس. فليس الفرد إلاَّ قالباً أخيراً كقنبلة جسدية، كوسيلةٍ لإرهاب المجتمع. وأنَّه بلا إرادة حرة ... وعلى الجماعة أنْ تهيمن عليه. في المقابل ينبغي أن يسلم كيانه إليها كلما حان الاحتياج إليه.
إذن الآلية نفسها التي يعمل بها الإرهاب هي التي تستعملها ذهنية الإفتاء. ولذلك لن يوجد هناك اختلاف إذا أراد أصحاب الفتوى محاربة التطرف. فالمطلوب من الإنسان إلغاء عقلة في الحالين. وألاَّ يتمرد ولا يستمع سوى لأقطاب الجماعة ومشايخ الفتوى على السواء. وأن يمتثل لفئة ليس لها غير اصدار الأوامر والنواهي. ولا يغيب عن بالنا أنَّ ذلك يدعم أفراداً خاملي القدرة على التطور الفكري السليم. وما يصنعه الإرهاب والإفتاء هو تفريغ العقل من أية ثقافة خارج إمكانية الانقياد. وإذا كانت ذهنية الإفتاء – كما يعتقد أصحابها- تسهم في المجال العام بشيء ذي أهمية، فهم يجانبون الصواب، إنها تقدم للسياسة قوالب بشرية مفرغة الأدمغة لكن الأهم أنها عديمة التفكير المبدع.
وإذا كان ما يميز المرء هو إنسانيته، فإنَّها تستأصلها ببث كراهية الآخرين. وجعله في حالة انكار دائم لهم من باب التكفير. لأنَّ الفتوى ترسخ الحدود الدنيا للآراء الدينية وليست بعيدة عن الأهواء (كآراء شخصية). بمعنى أنَّ هناك حدوداً يجب ألَّا يتعداها المرء. وطالما كون الإنسان إنساناً لن يستطيع الالتزام بتلك الحدود مهما تكن. وبالتالي، فإنَّها ترسخ الجوانب التعويضية في حركته وسيكولوجيته. أي يستبدل هذا المرء المفقود منه (الحسنات) بمنطوق الفقهاء بإمكانية المغفرة. وحالةٌ كهذه تجعله في وضعية إنكار دائم لما فعل. بدليل أنَّ الإنسان نادراً ما يعترف بالخطأ وما ارتكب من قبائح. مما يؤكد ابراز الجانب الآخر الذي قد ينفلت في هيئة عنف نتيجة هذا الجانب الاختزالي. لأنَّ كلَّ إكراه على النفس له علاقة بانفجار التوجه نحو الآخر. فلكل فعل (قمع ذاتي هذه المرة- تسامح) ردُّ فعل إزاء شيءٍ مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه بحسب اسحاق نيوتن.
ولهذا تجد الإرهابيين أشدَّ الناس غلظة تجاه الآخرين. بل تجد المتدينين إجمالاً لا يخلون من تلك الخاصية المزدوجة. فالعنف قد يخرج عبر السلوك كما يتضح في اللغة والسلوكيات الاجتماعية وعبر مفاهيم الثقافة والتواصل. لكم بجانب تالٍ قد يكون مكبوتاً، حبيساً داخل شرنقة الطقوس والعبادات الدينية. وما لم يمتلك الفرد قدرة ذاتية كبيرة (لفلترة) هذه الرواسب ستكون هي (أي الرواسب) أداة الانتقام التعويضي. في شكل فرض الآراء فرضاً لا مناص منه. حينذاك يمثل الدين مهمازاً لتحريك الإكراهات التي تتحول تجاه موضوع مقصود لذاته.
والغريب أنَّ الدين يعترف بهذا التوصيف: فهناك اسباغ الوضوء على المكاره. وهناك الانقطاع عن الشراب والطعام والمعاشرة الزوجية إلى حين كحال الصيام. وهناك القول بأنه لن يشاد الدين أحداً إلاَّ غلبه، فأوغلوا فيه برفق. من تلك الناحية ربما يعد الدين عنفاً مقنناً بالنسبة للمؤمنين. فالزناد تحت تصرف الإنسان، وهو المتحكم في علاقاته يوجهها بحمولاتها المعيشة.
من هنا تنطوي الفتوى على عدة أشياء:
أولاً: المرجعية. إذ بتكرار الفتوى في أغلب الأحيان تتأسس مرجعيةٌ دينية ما ضمن الثقافة. هي التي لا تضبط حركتها الذاتية فقط بل تحدد آفاق (المستفتِّي والمستفتَّى) وما بينهما من حياة عامة. لأن اشتغال الاثنين يستهدف تلك الدائرة قصداً. وبخاصة أنَّ الفتوى لا تتم بانفرادها الديني. لكنها تدعو المتلقي ضمنياً لتكملّة الفتوى بأشياء أخرى متعلقة بجوانب سلوكية وذهنية وكونية. مثل وجوب الطاعة والفهم والاتباع لمضامين الحكم تجاه الإنسان والعالم. و القضية هنا تُجمل عادة باسم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والنتيجة الضرورية لذلك قبول مرجعية الفتوى بلا نقاش.
وسواء أكانت نصوصاً أم تفاسير أم تخريجات لأحكام وشروح، فإنَّها تتلخص في قوة رمزية يشعر بها المتلقي في الواقع. وتبدو الفتوى كأنَّها تجر جسماً ضخماً من أدبيات الدين وشروحاته ونصوصه وشيوخه ومذاهبه.
وعادة لا تحضُر المرجعية بنفسها. إذ تتوقف على الأداء الإفتائي. والأخير بمثابة الذهنية التي تمارس الفتوى لمن يطلبها. وعلية ستكون الذهنية محوراً رئيساً في التأثير. لأنَّ الفتوى كلام وأدلة على قضية من القضايا مصحوبة بالترجيح لما ينتهي إليه الحكم. وعليه سيحتل القائم بالعمل – بصيغة الجمع - مكانةً في فضاء المجتمع. وربما تتقلص دونها أيةُ مكانة أخرى. لأنَّها تبعاً لوظيفتها تأخذ تلك المساحة. ولا تنفصل عنها طرائق التعبير وأساليب الكلام وطرح القضايا الدينية. وهذه الأشياء مهمة بالنسبة للموضوع من جهة تقاليد الإفتاء وأساليبه. بدليل الحرص على المقابلة الشفاهية بين المستفتَّى والمستفتِّي وجها لوجه. وأيضاً الحرص على قراءة الوجوه قبل قراءة الأفكار.
المرجعية التالية هي المتون الشفاهية وثقافتها. وبخاصة تعاليم الدين. وهنا توجد موروثات خاصة بطراق بناء الفقه وأصوله وقياساته. تلك التي ظلت كما هي طوال عصور كثيرة. ورغم تطورات المعارف والمجتمعات والأفكار إلاَّ أنَّها ظلت كما هي لم تمس. والنصوص الفقهية لم تأخذ بجديد العلوم والتحولات المعرفية. فالعلوم الإنسانية قد تقدمت تقدماً كبيراً في فهم الإنسان وتكوينه واختلافاته. والفقهاء يعتبرون الفقه علماً مستغلقاً على أهله. وأنه لو أخذ بنتائج العلوم الإنسانية سيفقد مضامينه التاريخية والدينية. هذا إنْ لم يكونوا قد كفَّروا اتجاهات الفلسفات ورموز المعرفة الإنسانية!!
ثانياً: الحُكم... أخطر ما تؤكده الذهنية السابقة هو اعتبار الدين حكماً شرعياً وكفى. والمسألة المستفتى عنها أشبه بالصداع يحاول المرض أخذ جرعة دواء عاجلة للخلاص منه. ولعلنا ندرك خطورة الحكم عندما نعرف أنَّ شخصاً يمكن أن يقتل آخر بمجرد تكفيره. فالحكم بات لا رجعة فيه.
لكن هناك خاصية أخرى ربما تأتي من مقارنة ذلك بمقولة قانونية تقول: الحكم عنوان الحقيقة. فالحكم داخل الفتوى هو الحقيقة ذاتها. وهنا المعضلة: طالما أن شيخاً قد أفتى – مثلاً – بعدم جواز مصافحة غير المسلم، فالحكم الفقهي هو الحقيقة!! ولكنه ليس حقيقة عادية. إذ يتفنن صاحب الفتوى في اخفاء نفسه خلف الكلمات والعبارات وواضعاً إياها بلسان السماء مباشرة. فيكثر من قال الله كذا وكذا... ويعقب ويعضد عباراته بأحاديث قدسية ونبوية. وطبعاً فإن الإنسان البسيط يصدق ما يقول من أول وهلة. وبلا مراجعة يأخذ هذه الأفكار على أنها كل الدين. لأنَّ الذهنية الإفتائية لا يهمها بالمقام الأول سوى السمع والطاعة.
فالحكم الفقهي كشيء أساس يعني نفاذاً للقرار الكامن فيه. كل حكم بفتوى يجري كقرار دون مرافعة. عكس ذلك معناه مناهضة الشريعة وهدم الدين والتشكيك في المقدسات وازدراء مرجعية الأمة كما يقال. وبالتالي يتحول الحكم من كونه مساحة خلاف وحجاجٍ إلى لاهوت سياسي بامتياز. وبدلاً من كونه حكما فردياً لشخص أراد معرفة ما يقوله الدين، يصبح مسؤوليةً تاريخية اجتماعية عن الواقع.
ذلك يحدث.. بينما هذا العالم المفترض وراء الحكم والتابع له لم يتحقق ابتداءً. بمعنى أن ذهنية الفتوى تسقط الواقع من حسابها. وقد تنطلق في مسيرتها على انقاض الإنسان كإنسان. فيبدو الحكم باتاً في ضوء معايير أخلاقية أو صورية و تناظرية. بينما القضية تحتاج إلى معالجة فكرية تلتحم بالحياة. فلو تصورنا أن ثمة رفضاً لإحدى الفتاوى واعتبرها البعض جائرة فإنَّ العلة في كيف استنبطت وبناء على أية قرائن قد وافقت أو ناقضت الشرع؟ هنا يغفل عن هذا ليمثل الرفض عصفاً بالدين ومحاربة الأمة!!
هكذا قد يتحول الحكم فجأة إلى اتهام. والحقية أنه اتهام لأنه الوجه الثاني لقبوله. فاذا كان الحكم مقبولاً فإن عكس ذلك ليس رفضاً بل اتهاماً (وإخراجاً من دائرة الدين).
ثانياً: سلطة الخطاب. إذا كانت الفتاوى تقدم معرفة، فإنها ترتهن بالخطاب الكامن فيها. على نحو دقيق تتوجد بكل فتوى خطاطة للوعظ والإرشاد. بينما تضمر آفاق المعرفة كثيراً. والسبب أن هناك ما ينبغي اتيانه من أحكام بناء على الإفتاء.
وليست المسألة واضحة بسهولة من تلك الزاوية. فالفتوى مبطنة عادة بنبرة وعظية لكنها طويلة الأمد. وهي ناتجة عن الزعم بامتلاك الحقائق والفصل في صحتها من خطئها. ولو حللنا هذا الجانب لوجدنا كون الخطاب الديني يحمل التقاليد الممتدة لمئات السنوات في تاريخ الشريعة الإسلامية. فلا يميل إلى الحوار في إطار قضايا الحياة واشكالياتها. إنه يعطي فتاوى وراء فتاوى من خلال تمجيد أجيال الصحابة والتابعين وتابع التابعين .
وبعض الخطاب يؤكد: أنه على المسلمين إذا أرادوا مواصلة حياتهم أن يواصلوا حياة السابقين أيضاً. إذن عندما سيذهب أحدهم لاستفتاء شيخ سينال خطاباً مضمراً بما ينبغي فعله وما لا ينبغي. بالتالي فإن ثمة أكراها على قبول الآراء بما تحمله من انحيازات فكرية وأيديولوجية.
والخطاب بهذا المنحى يسيَّس تبعاً للسلطة الحاكمة. أبرز المواقف في هذا الاتجاه ما يردده الشيوخ بأن ما تمر به بلد كمصر نتيجة الذنوب التي يرتكبها المصريون. متناسين أن هناك أسباباً موضوعية وتاريخية وسياسية كرست الاستبداد والفقر والتخلف طوال سنوات. وهناك دول عربية أخرى يحتل الافتاء فيها مرتبة أعلى من مرتبة المؤسسات السياسية. وأغلبها الممالك والإمارات التي تمسك سلطتها بمقبض الدين والقبيلة.
ثالثاً: الغاية.. غاية الافتاء هو تمتين وضعية الدين من خلال عرض تفاصيله ومسائله الجزئية. لكن ذلك الهدف يمثل طريقا لغاية أبعد. هي إحكام هيمنة صورة معينةٍ من الاعتقاد على الحياة العامة. وبالتالي فالتطرف ليس فقط ما يعد عنفاً وإكراها في مخاطبة الآخرين والتواصل معهم، لكنه ما يختلف عن هذا الاعتقاد السائد كذلك. وعليه فإنَّ سيادة المذاهب الدينية في أغلب المجتمعات الاسلامية تقوم على هذه الوظيفة الضمنية. وكثيراً ما اسهمت الفتوى العامة هذا المعنى وكأنها تغلب رأياً دون آخر. وهي بذلك ترتكب عنفاً أيضاً لأن هذه العمومية ليست لها ولن تكون.
وطالماً خرجت إلى ذلك محتمية في الاعتقاد السائد فإنها تزاحم أهداف السياسة والمجتمع في ترسيخ السلطة السائدة. وفي أغلب الأحوال تنقلب إلى خطابة غائية من وراء الأفعال السياسة بل تستبقها إلى أغراضها. إن فتاوى البنوك والأموال جميعها تصب في مصلحة السياسات التي تخدم الدول بعد الربيع العربي كما كانت من قبل.
رابعاً: الأفكار... إنَّ الارهاب لم يأت بين يوم وليلة. ولم يصبح الإرهابيين كذلك على نحو خاطفٍ. إنَّهم كما أشرت نتيجة تربية فكرية بالمعنى الحرفي. والجماعات الاسلامية بخلاف الكوادر منها قائمة على الحضانة النفسية لأفكار داخل تربة الجماعة. وكأنها فترة حضانة طبيعية طويلة انتظاراً لأن تفرخ في الأدمغة والعلاقات. ولهذا فإن جميع تلك الأفكار تزيح سواها بشكل مادي. وتدخل معها في صراع عنيف في الواقع الاجتماعي والثقافي.
وكم من حالةٍ رأينا فيها فتاوى تكفيرية من جماعات الإرهاب يرد عليها بفتاوى أخرى من إفتاء الدول. الفتاوى أمام ذلك عبارة عن حكم ولا تؤسس أفكاراً. بل تغيب معاني التفكير قصداً لصالح توجه وسلوك على الإنسان أنْ يأتيهما فوراً. كما أنَّها تكشف عن كيفية الاعتقاد وما هي طبيعته. لكنها لا تسهم في تجديد ولا ابداع خطاب مغاير, لأنها تحافظ بحقيقتها الأصولية على إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.
بينما مقاومة التطرف تحتاج إبداعاً إنسانياً في رؤى الحياة وقضايا الثقافة وجذور التفكير. والأهم غرس أفكار إنسانية تنهض على احترام الآخر وتنوعه. واعتبار الدين مهما كان اعتقاداً خاصاً أو عاماً لا يناوئ سواه. لأنه من المستحيل الحياة دون تنوع، وإلاَّ فهذا ضد حقيقتها. وأية سياسة للفتوى تتجاهل ذلك فهي تكرس الصراع والعنف بصرف النظر عن العناوين التي تحملها.
سامي عبد العال