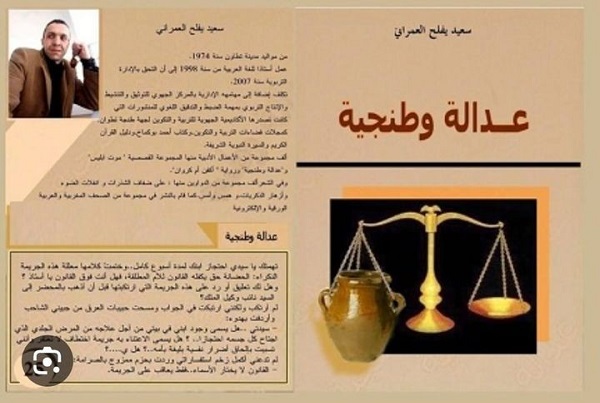صحيفة المثقف
عصمت نصَّار: الجابري والقرآن ورحلة الرجوع
 منذ قرابة أربعة أشهر أو يزيد قد دعيت من قبل لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة للتحدّث في ندوة عن (الإلحاد والاجتراء والتطرّف العقدي)، وأثره على تشكيل عقول الشباب في مصر وذلك استكمالاً لندوة سابقة قد عقدتها في 2019م بصحبة الأستاذين الصديقين "مصطفى النشار و"رمضان بسطويسي" عن: "مفهوم الإلحاد وأبعاده الفلسفية"، وما يترتب عليها من مظاهر الجموح والجنوح في الثقافة العربية.. وقد عقدت النية على أن أركز كلمتي هذه المرة عن أسباب الاجتراء وعلة التجديف في الفلسفة العربية الإسلامية المعاصرة، ولاسيما بين المثقفين وقادة الرأي من المفكرين، وشاءت الظروف تأجيل انعقاد هذه الندوة إلى أجل غير مسمى، وباتت الخطوط العريضة والمحاور الرئيسة لهذا الموضوع تدعوني - من حين إلى آخر- للبوح بها وتناشدني بل تحرضني على الكتابة عنها، فلم أجد فرصة أفضل من تلك المقالة لأتحدث فيها بإيجاز عن علة اجتراء من نتهمهم بالمروق في حياتنا المعاصرة من الكُتاب والباحثين.
منذ قرابة أربعة أشهر أو يزيد قد دعيت من قبل لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة للتحدّث في ندوة عن (الإلحاد والاجتراء والتطرّف العقدي)، وأثره على تشكيل عقول الشباب في مصر وذلك استكمالاً لندوة سابقة قد عقدتها في 2019م بصحبة الأستاذين الصديقين "مصطفى النشار و"رمضان بسطويسي" عن: "مفهوم الإلحاد وأبعاده الفلسفية"، وما يترتب عليها من مظاهر الجموح والجنوح في الثقافة العربية.. وقد عقدت النية على أن أركز كلمتي هذه المرة عن أسباب الاجتراء وعلة التجديف في الفلسفة العربية الإسلامية المعاصرة، ولاسيما بين المثقفين وقادة الرأي من المفكرين، وشاءت الظروف تأجيل انعقاد هذه الندوة إلى أجل غير مسمى، وباتت الخطوط العريضة والمحاور الرئيسة لهذا الموضوع تدعوني - من حين إلى آخر- للبوح بها وتناشدني بل تحرضني على الكتابة عنها، فلم أجد فرصة أفضل من تلك المقالة لأتحدث فيها بإيجاز عن علة اجتراء من نتهمهم بالمروق في حياتنا المعاصرة من الكُتاب والباحثين.
ولعلّ أشهر تلك الأسباب هو الانضمام إلى جماعات إلحادية أو محافل ماسونيّة أو تبعيّة بعض الفلسفات الفوضوية، والنهوج التي استنتها فلسفات ما بعد الحداثة، مثل "نقد النقد"، و"قراءة القراءة"، و"التأويل الحر"، و"أنسنة الدين"، و"النزاعات البنيوية والتفكيكية"، و"ما بعد الدين"، وغير ذلك من أفكار واتجاهات نقدية لم تفرق بين الكتب المقدسة والأعمال الأدبية والفنية التي ذاعت على ألسنة رواد أوهام المسرح من المفكرين الأوربيين.
ومع احترامي وتقديري لهذه الأسباب المجتمعة إلا أنني أرى أن الأقلام الجادة والمتطلعة لغداً أفضل، والساعية للتجديد والإصلاح لها أسباب مختلفة عن سابقتها في الاجتراء، والشطط، والتجديف، وتتمثل في (أزمة المفكرين وإحباط المبدعين وغيبة الرأي العام القائد وانتشار الوعي الزائف في الرأي العام التابع) وذيوع الجماعات الراديكالية، والتطرف العقدي.
فقد عان الكثيرون من أصحاب الخطابات الحداثية في الثقافة العربية من الإخفاقات التي وقعت فيها المجتمعات العربية الإسلامية، ولا سيما عقب نكسة 1967م إلى الحادي عشر من سبتمبر 2001م، تلك الحقبة التي كان معظم المفكرين الشبان العرب يعانون فيها من مرارة اليأس، والإحساس بالدونية، والتهميش والشك في أصالة التراث، فانغمس بعضهم في الجماعات الراديكالية الدينية، وارتمى البعض الأخر في أحضان المستشرقين أملاً في اقتفاء أثر الأوروبيين في تفسير الواقع المعيش، والخروج من الأزمة الحضارية، ونقض الموروث الذي أثبت فشله في إصلاح ما فسد.
ولعلّ "محمد عابد الجابري" كان من ضمن هؤلاء وقد صرح بذلك في مقدّمة كتابه "مدخل إلى القرآن الكريم" طبعة (1)،2006م. ولسوف نقف على تلك الملابسات بشيء من التفصيل وذلك لتفسير وتبرير تراجع مفكرنا عن معظم الآراء المُجترئة التي صرّح بها منذ عام 1980م، وهي البداية الحقيقية لمشروعه المتوهم. والجدير بالإشارة أن رحلة تراجع المفكرين الحقيقيين عن اجترائاتهم: شكوكهم أو آرائهم المغلوطة أو انضوائاتهم المغتربة وانتماءاتهم الشاذة - لم تكن سهلة أو مفاجئة، لذلك لأنها وليدة معاناة نفسية، وصراع أفكار، ومعتقدات. ويصحبها جميعاً اضطراب في سياق الخطاب يصل إلى حد التناقض، ونكوص ثم جحود لما كان عليه، ودفاعُ عما ذهب إليه.
ومن يتابع تاريخ المراجعات الفكرية في الثقافة العربية الإسلامية سوف يلاحظ ذلك في كتابات "منصور فهمي" و "طه حسين" و"خالد محمد خالد" وغيرهم من الذين ضاقوا بجمود الاتجاه المحافظ الرجعي، وعدم قدرة الكثيرين من الأزهريين، وأئمة المنابر المدافعة عن الدين على الرد بمنهج عقلي على المجترئين، والطاعنين في الموروث العقدي؛ ذلك فضلاً عن محاربتهم لمعظم خطابات التجديد في النصف الثاني من القرن العشرين.
وأحسبُ "محمد عابد الجابري" - كما أشرت - من هذا الفريق فقد تتلمذ على كتابات المستشرقين وساير الاتجاهات المعاصرة في فلسفة الدين، وكانت قراءاته في كتب التراث سطحية بالقدر الذي لا يمكنه من الحكم الراجح أو الوصول إلى الرأي السديد، وذلك في الفترة من 1980م إلى 2001م، وسوف نتتبّع هذه الرحلة في كتاباته : فلم ينتحل "الجابري" نهوج غلاة المستشرقين في كتاباته الأولى - ولا سيما "أرنست رينان" - في قراءة القرآن فحسب، بل - حاكاهم أيضاً- في المراوغة وسبك الحقائق بالأكاذيب، بالإضافة إلى ارتدائه حُلل وملابس لا تتفق في مظهرها مع مخبرها، ويبدو ذلك فيما صرّح به من خطوات قد انتهى إليها في الدَّرب الذي سلكه نحو الفهم الحقيقي للنص القرآني، فادّعى انتصاره للبرهان العقلي، مؤكداً أن المعرفة العقلية البرهانية هي جوهر النص القرآني، ومن ثم يجب استبعاد القراءات البيانية والعرفانية إذا ما أردنا الوقوف على مقصد الوحي، والابتعاد تماماً عن التأويلات الكلامية التي حاولت ربط النّص القرآني بواقعات كونية أو نظريات علمية؛ لأنها لا تعدو في نظره إلا إقحام للوحي في أمور لم يتطرق إليها. كما نجده في كتابه (تكوين العقل العربي) يٌلح على ضرورة الفصل بين ما يراه أنه يعبر عن العقل الإلهي، وما جاء في النصوص القصصية القرآنية، وذلك أن القسم الأول معقول بطبعه ومقبول للفهم والاستيعاب، أمّا القسم الثاني فيحتاج إلى مراجعة شأنه شأن أسباب النزول والإحالات الغنوصية والأخبار الغيبية، وزعم أن هذا النهج وتلك الخطى ما هي إلا تحديث لضرب "ابن حزم الظاهري" و"أبي الوليد بن رشد"! الأمر الذي قاد مفكرنا إلى التعامل مع القصص القرآني بالمنحى التأويلي الباحث عن المقصد أو الغرض من التنزيل في فترة زمنية معينة وفي سياقٍ بعينه، فهي آيات في نظره غير برهانية ويجوز فيها التأويل الذي لا تخضع له نصوص الوحي المُعبّرة عن عقيدة التوحيد والنبوة والتسليم بوجود اليوم الآخر.
ونجد مفكرنا في كتابه (فهم القرآن الحكيم) ط (1)، 2008م، يؤكد على وَحْدَة النّص القرآني، وأنه يشتمل على حكمة عقليّة يمكن إدراكها في ضوء أسباب التنزيل؛ الأمر الذي يتعارض تماماً مع دعوته للفصل بين الآيات الخاصّة بالعقيدة وغيرها من الأخبار والعبادات. ثم يزيد الأمر تعقيداً عندما يدعو لإعادة تقسيم القرآن الكريم تقسيماً موضوعياً واعتباره نصّاً تاريخياً في دلالته ومقاصده.
أضف إلى ذلك كله، رفضه التام لكل القراءات التأويلية السابقة عليه بحجة أنها قراءات سلفية ذاتية مجافية للعلم، والعقل الحر، ومن ثَم سوف تظل عاجزة عن الإتيان بجديد تعين المجتمع العربي الإسلامي على الخروج من نكباته المتتالية، وتخلفه عن مصاف الأمم الراقية، وركب الحضارة. ويقول عن الألية التي تحرك مشروعه سواء في قراءة التراث بوجه عام، أو قراءة النّص المقدس على وجه الخصوص (جعل المقروء معاصراً لنفسه ومعاصراً لنا في الوقت ذاته)، ولعلّ هذا التصريح الذي كتبه في مقدمة كتابه (مدخل إلى القرآن الكريم) يوقعه في لجة الاضطراب والتناقض؛ فالمنحى التفكيكي لا يعبأ بمؤلف الخطاب، ولا بالثقافة التي أنتجت النص المقروء، كما أن الجمع بين الحدس الذاتي في إبداع النّص، والتأويلات المختلفة في بنائها، والمتباينة في بنيتها لا يقود الأنا المبدعة إلا إلى التشويش، والتأثر غير الإرادي بسلطات القراءات الأخرى. أضف إلى ذلك كله تعمد "الجابري" الإتيان بمصطلحات تحول بين القارئ ومقاصد مشروعه التنويري، وتجمعه مع عصبة المرتابين والمشككين في الثوابت العقدية، أي تدفع قراءه لاتهام "الجابري" بالإجتراء والتجديف.
نذكر من هذه المصطلحات: "اللامعقول العقلي"، "المعنى الساذج للنبي الأمي"، "حدَث الوحي المحمدي"، "العقل القرآني"، ويضيف قائلاً: (وقد تمكنا من إيقاظ الحيويّة التاريخية التي لابدّ منها لجعل موضوعنا معاصراً لنفسه أي القرآن ومعاصراً لنا في الوقت ذاته... كانت استراتيجيتنا، - وستبقى- تقديم قراءات لموروثنا الثقافي تفسح المجال لعملية التجديد من الداخل، تلك العمليّة التي هي وحدها القادرة على إتاحة الفرصة لنا لإعادة البناء. فعلاً، العملية طويلة وشاقة، ولكنها جادة).
ونألف "الجابري" يعود متراجعاً عن جموحه وجنوحه عما أقره واصفاً الوحي القرآني بأنه أكثر الكتب المقدَّسة تحيزاً للعقل وذلك لتحرره من آفتين:
أولهما سلطة الكهنة. وثانيهما عتامة الخرافة، ويقول (والحق أن ما يميز الإسلام - رسولاً وكتاباً - من غيره من الديانات هو خلوه من ثقل "الأسرار" التي تجعل المعرفة بـ "الدين" تقع خارج تناول العقل. إنّ المعرفة الدينية في هذه الحالة من اختصاص فئة قليلة من الناس، هم وحدهم "العارفون" المتصلون بالحقيقة الدينية، وهم وحدهم رؤساء الدين ومرجعيته ورُعاته، والبقيّة رعية ومقلدون، أمّا "الرئيس الأول" المؤسس للدين فيوضع في الغالب في مرتبة بين الألوهية والبشرية، وأحياناً يرفع إلى مستوى الألوهية. وأمّا النصوص الدينية فتعتبر رموزاً مليئة بأسرار لا يتولى تأويلها وفك ألغازها إلا "العالمون" بفك الرموز وتأويل الأحلام. ربما كان هذا من خصوصيات الدين في جميع الثقافات، ومن المؤكد أن الإسلام قد عرف تيارات تلتقي بصورة أو بأخرى مع هذا النوع من التصوّر للدين تيارات تنتمي إلى الموروث الديني الحضاري الذي كان يقع خارج الدعوة المحمديّة كما اكتملت عناصرها وتحددت آفاقها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمّا الدعوة المحمدية نفسها - نبياً وقرآناً - فلم تعرف "أسراراً" من هذا النوع، إذ لم يوجد فيها بوصفها "دعوة" ما يدعو إلى اعتبار العقل قاصراً عن معرفة أي شأن من شؤون الدين الذي تدعو إليه.
بل بالعكس لقد كانت حياة الرسول وتعاليم الكتاب (القرآن)، موضوعاً مفتوحاً لإعمال العقل. كانت تجربة الوحي مرفوعة بمعاناة نفسية ووجدانية حاول الرسول تفسيرها عقلياً، وذلك بتقريبها إلى ظواهر نفسية واجتماعية معروفة في عصره هي نفسها تلك التي اتهموه بها خصوم الدعوة المحمدية منذ ابتداء أمرها... قد لا نجافي الصواب إذا نحن قلنا مع بعض القدماء: أنه ما من آية في القرآن إلا من ورائها سبب لنزولها. ومن هنا قال كثير منهم إن القرآن إنِّما نزل مفرقاً منجَماً على مدى يزيد عن عشرين سنة لأنه كان ينزل على مقتضى الأحوال. ولم يكن "مقتضى الأحوال" مقصوراً على ناحية من نواحي الحياة التي عاشها النبي وخاضها مع صحابته والمؤمنون به، بل كان يشمل السّراء والضراء، وشؤون العيش، وقضايا السلم والحرب، والمنازعات، والتحالفات، والمعاهدات...إلخ.... أن القرآن يؤكد للرسول وصحابته، ولخصومه كذلك أن القرآن وحي من عند الله، وأنه ليس من افتراء محمد ولا من إنشائه، وأنه لا يمتلك أن يزيد فيه أو ينقص، بقدر ما كان محمد بن عبد الله مؤمناً في قرارة نفسه أنه "نبي ورسول يوحى إليه".
وأعتقد أن من يطالع هذه الكتابات "للجابري" سوف يتردد في تصديقها أو نسبتها إليه، وذلك لأنها أقرب ما تكون لموقف الاتجاه المحافظ المستنير، ومدرسة "حسن العطار" و" محمد عبده" و"مصطفى عبدالرازق" و"عبد المتعال الصعيدي" من التراث العربي الإسلامي. وها هو يرتدي عباءة المجدّدين في الفكر الديني قائلاً في كتابه "فهم القرآن الكريم"": إنّ القرآن يُخاطب أهل كل زمان ومكان، ويفرض علينا اكتساب فهم متجدّد للقرآن بتجدد الأحوال في كل عصر... إننا لا نتعامل مع القرآن كنص على بياض، نكتب على هوامشه، وحواشيه، ما تلهمنا به العبارة، والمثل، والقصة، والوعد، والوعيد... إلخ، وما يسعفنا به الخيال وتدفعنا به الميول والرغبات... إلخ، لا. إنّ المنهج الذي اتبعناه على مستوى "التعريف" يفرض نفسه علينا على مستوى "الفهم" كذلك... لقد كنا نطمح إلى أن نوضح كيف أن "فهم القرآن" ليس هو مجرد نظر في نص مُلئت هوامشه وحواشيه بما لا يحصى من التفسيرات والتأويلات؛ بل هو أيضاً "فصل" هذا النص عن تلك الهوامش والحواشي، ليس من أجل الإلقاء بها في سلة المهملات، بل من أجل ربطها بزمانها، ومكانها، كي يتأتى لنا "الوصل" بيننا، نحن في عصرنا، وبين النّص نفسه كما هو في أصالته الدائمة.... إنّ انبثاق "فهم الكتاب الحكيم" في العقل، يتطلب من" الجهد الذهني" ربما أكثر كثيراً مما تطلبه "انفجار القرآن الكريم" في القلب من "فراغ الذهن".
(وللحديث بقيَّة)
بقلم: د. عصمت نصَّار