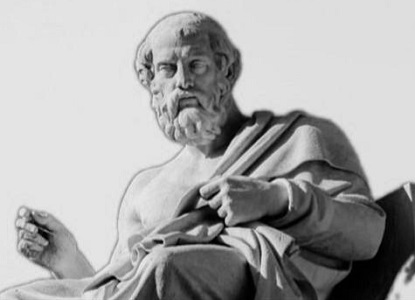صحيفة المثقف
سامي عبد العال: صناعةُ التراثِ: لماذا لا نُغيِّر المفاهيم؟!
 التراثُ ليس ماضياً كما نَظُن. إنَّه (ابتكار يومي) لو أردنا إبداعاً وتأثيراً في الحياة. لأننا كائنات إنسانية محكومةٌ بالمستقبل. المستقبل حُكمٌ أبديٌّ مؤجّل تبعاً لقوانين التاريخ التي تزحف إلينا. وبالتالي يجب أنْ نلتقيه (أي المستقبل) في الصباح الباكر مثلما وُلد بالمساء الحالك. وحدُّه الإنسان هو الموجود الذي ينظرُ تجاه كلِّ الأشياء على مرمى البصر. عيناه ليستا في قفاه، لكنهما في جبهته بالمعنى اليوناني لوجه الإنسان anthropos (فهو الكائن ذو الوجه)، إذ يقع القفا بالوراء والعينان في المقدمة حيث التطلع إلى الأمام.
التراثُ ليس ماضياً كما نَظُن. إنَّه (ابتكار يومي) لو أردنا إبداعاً وتأثيراً في الحياة. لأننا كائنات إنسانية محكومةٌ بالمستقبل. المستقبل حُكمٌ أبديٌّ مؤجّل تبعاً لقوانين التاريخ التي تزحف إلينا. وبالتالي يجب أنْ نلتقيه (أي المستقبل) في الصباح الباكر مثلما وُلد بالمساء الحالك. وحدُّه الإنسان هو الموجود الذي ينظرُ تجاه كلِّ الأشياء على مرمى البصر. عيناه ليستا في قفاه، لكنهما في جبهته بالمعنى اليوناني لوجه الإنسان anthropos (فهو الكائن ذو الوجه)، إذ يقع القفا بالوراء والعينان في المقدمة حيث التطلع إلى الأمام.
كان هذا ديدّن الإنسان منذ بواكير الحضارات القديمة، لعلّنا نلاحظ أنَّ جميع منحوتات الفراعنة والسومريين واليونان ومن بعدهما الرومان وتماثيلهم كانت بارزةَ الوجه ناظرةً باتجاه الأشياء والعالم، ليشكل الوجه ثقلاً في اتزان الرؤية والآفاق البعيدة. وأيا كانت زاوية النظر، فالرأس تمثل لقطةَ التحدي بعيون ثاقبة لما يأتي. لأنَّ اختراق الحُجب طاقة كامنة في العيون تعبيراً عن العقل والخيال والروح. دوماً ثمة رواسب فوارَّة داخل العين هي الوجود الحاضر بذاته ماضياً ومستقبلاً.
وذلك ضرب من السير الزمني نحو المجهول القابل للانكشاف والتجلي. فالدازين Dasein (الموجود هناك) بمصطلح الألماني مارتن هيدجر يتعين بالزمن في وضع آنيٍّ (أي هو الإنسان الذي يعي آنيته). وبذلك يمارس هذا الكائن الاستثنائي (جَسَّ نبض) المصير المترقّب. علية أن يتساءل باستمرار من حين لآخر: ماذا سأفعل غداً ؟ ما علاقتي بالوقت وتحولاته ؟ كيف سأكون هنا دون هناك؟! ماذا عن خطورة الغد الذي مرَّ بالأمس؟!
حاول هيدجر أنْ يستنطق تاريخَ الفلسفة بوصفه تاريخاً داخل تراث نوعيٍّ علينا ابتكاره بشكل جديدٍ. إذ يرى إمكانية تحرير التراث عن طريق تحرير التصورات التي تغرق فيها الفلسفة من حقبةٍ إلى أخرى. يؤكد في مقال بارز" ما الفلسفة ": " إنَّ التراث لا يربطنا بقيود ماضٍ لا يعود، ذلك أنَّ ارتباطاً من هذا القبيل ليس هو إلاَّ تحريراً يتحقق في ذلك الحوار الحُر الذي نجريه مع ما كانَ". وبالقطع يكاد يمرقُ هذا التحرير الإنساني نحو تحرير رؤى العالم والحقيقة والزمن.
نحن كائنات واقعة رهن تحولات الأقدار مع الحوار الحُر ليس إلاَّ، فلا مفر ولا التواء في تلك القضية الشائكة. إذ علينا أن نطرح عبر أنفسنا: كيف نقيم حواراً خلاَّقاً مع ما مضى؟! بأية طرائق نحتضن ذاكرتنا في أشكال مبدعةٍ من الضيافة الجديدة لها؟ فالحرية تحطم أية مفاهيم تكبل العقل وتشده إلى الوراء بلا نظر ولا بصيرةٍ. كما أنها باعتبارها تجربة حية تصنع ماهية ووظيفة مغايرتين للموروثات لا كما هي جامدة. وأي تراث لا نتعامل معه بواسطة تلك الإمكانية الأبعد لن يكون إلاَّ أجولةً من رمال صماء!! تثقلُّ كاهلنا عن التطلع إلى القادم. كما تعيق إرادتنا بسبب ما يشدها خلفاً فقط.
إنَّ المجتمعات التراثية لهي مجتمعات مثقلة بتلك العلاقة المرَّضيَّة pathological بتراث تحمله لا يحملُّها. مثلها مثل الحُمار يحمل أسفاراً. وهذا التوصيف القرآني قد يظل جارياً على أية أمة ترعى في أدغال الماضي فقط. لا تدرك ماذا ينتظرها من أخطارٍ ولا تلتفت إلى أي مجهول سيبتلعها بالمستقبل القريب. فالحيوانات تُساق إلى مذابح القرابين المقدسة دونما أنْ تعلم ماذا يترصدها. فلو كانت الخراف تعرف مصيرها لكانت قد هربت مع الريح!!
دلالة التراث في الثقافة العربية مشتقةٌ من: وَرِثَ، يَرِثُ، إِرْثًا. إنها تنقل المآل وتقلُّب الأحوال لا صناعة الآمال، إنها تعبر عن المسموح لا الطُموح وترصد الفائت فقط لا الآتي. وهي الدلالة المعبرة عن التحدر الزمنى لوضع كان قائماً ثم ذهب إلى وارثٍ يحاول التعامل معه في الزمن. جاء عن النحوي ابن الأعرابي: الوِرْث والإِرْث، والوِرَاث، والإِرَاث: والتراث كلمات معبرة عن معنى واحد. وقال ابن منظور.. " يُقال ورّثتُ فلاناً مالاً وأورثه ورثاً إذا مات مورثك فصار ميراثه لك" (ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني، تحقيق نخبة من الأساتذة، القاهرة، د. ت، ص 4808).
وفي القرآن وردت بهذا الصدد كلماتٌ من قبيل (يَرِثُ)، في قوله إخباراً عن زكريا (هب لي من لدنك وليَّا يرثني ويرث من آل يعقوب)، أي يبقى بعدي فيصير راعياً لميراثي. وقال ابن سيده: إنما أراد يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة ". ومن قبيل (التراث)، في قول القرآن: (وتأكلون التراث أكلا لمّاً. وتحبون المال حباً جماً)؛ أي (وتأكلون أيها الناس الميراث أكلاً لمّاً). وكذلك في قوله (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير).
وفي هذا الإطار، يمكننا الاشارة إلى ما يلي:
1- كلمة التراث في الذهنية العربية (بدلالة اللغة وتوثيق القرآن) تنقل المعنى المادي لا الابداعي ولا الفكري (الصناعي والتكويني). بل سيتقبل الإنسان الميراث كما هو في أبعاده الدلالية ويبدو أن هذا هو الأهم بحسب الثقافة على المدى الطويل فكراً وتاريخاً. وذلك كصنف من الأمانة التي تأتيك فتحافظ عليها من أجل أجيال قادمة بالمثل.
2- تلتبس فكرةُ القيمة بمعاني التراث لدى الجماعة الإنسانية، سواء ما كان منها مرهوناً بالميراث نفسه أم بمصدره كما أشار القرآن إلى وراثة الكتاب (الوحي). وهو ما يعني أنَّ التراث سيصبح قابلاً للتقديس بحكم المصدر الآتي منه. وما ينطبق على الوحي، سينطبق بالمثل على نتاجات المجتمع والعادات والتقاليد.
3- يمثل الاقتصاد الرمزي (أي الجانب الادخاري والاستثماري) للتراث اقتصاداً غير قابل للنمو ولا للتطور. فكيف سيكون الأمر عكس ذلك وهو مرهون بالماضي الذي تمَّ إنجازه دوماً. فهناك دلالة الحفظ بمنطق الأبُوة والتقاليد والصور المتداولة التي تقارب الأصول والمنابع الأولى.
4- لم تُشر الكلمة إلى الجانب المستقبلي من التاريخ، أو على الأقل لم ترهص بما هو مجهول وكيف يعيش داخل الأجيال الجديدة التي سترث ميراثاً ما. ذلك أن الموروث دوماً بصيغة الوضع الفائت فوات الزمن. والذي يحدث بلغة النحو والقواعد (كمفعول به) انتهى فعله وفاعله. ولا ينبغي انتهاك هذه المساحة من الإنجاز الذي وصل إلينا كما هو.
5- يعبر معنى التراث لدينا عن نزعة الاستهلاك والتضييع والإهدار ليس إلاَّ. كما في معنى أكل التراث أكلاً لمّاً بمدلول الأموال بين الناس. والدعوة المضمرة لا تخطئها الملاحظة من أنَّ الاجيال الجديدة لن تحافظ على القديم محافظة الإضافة والابتكار. لكنها قد تستنفد ما تركه الأجداد على قاعة الحياة... أو كما قال القرآن أيضاً في سياق آخر: " فخلفَ من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غياً".
6- نزعت كلمة التراث المسئولية كلَّ المسئولية عن الوارثين سلفاً. فهم مستقبلون سلبيون وفي أحسن الأحوال إذا كانوا أوفياء أن يقف جل دورهم عند تلك الدرجة من الاستقبال والاحتفاء فقط. وكأن التراث يدعوا إلى نوع من الكسل الحضاري والترهل الذي يصيب الوعي بكلِّ انكفاء وضمور.
7- ضاقت زاوية العطاء والهبة التي تتضمنها كلمة التراث (أو هكذا تكون) كنوع من الإبداع والإثراء للعالم انتظاراً لأجيال قادمة. وبخاصة أنه مع سيادة أبوية المجتمع العربي، فقد ضاعت نغمة الانفتاح والتعددية، من حيث كون التراث حياة تحتاج إلى حياة جديدة أخرى للمتابعة والتواصل.
8- ارتبط معنى التراث في اللاوعي العربي بالغاية الكبرى منه. أي دفع الإنسانية نحو نهاية الحياة بالوجه الذي يجعلنا ننجو بأنفسنا فقط من شرور الدنيا ونترك المُلك للمالك الحقيقي. لأن مصير العالم في النهاية سيؤول لدى وارث حقيقي هو الله. كما يقول ابن منظور الوارث اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لن تصب معاني الكلمة الأخرى في فعل إنساني جديد، هذا على الرغم من أننا سنحاسب على مسئوليتنا عن الحياة وكيفية العيش وابداع المعارف كجزء من التكليف وإعمار الأرض. كيف إذن سيلتقي هذا المعنى مع ذلك؟!
وعليه فإنَّ مفهوم الصناعة والابتكار للماضي مازال غائباً لدينا في التعامل مع التراث. مع أنه كان بارزاً في تاريخ المعارف العربية، إذ وردت كلمة صناعة في أغلب مؤلفات العباقرة القدماء: صناعة الشعر، صناعة النحو، صناعة الإعراب، صناعة الحكمة، صناعة المعاجم، صناعة المنطق، صناعة الطب، صناعة الكتابة، صناعة البلاغة ... وهكذا رأينا ذلك عند أبي هلال العسكري وأب نصر الفارابي وزورياب وابن سينا والتهانوي وابن الصلاح وابن فارس والزبيدي وعبد القاهر الجرجاني.
كان يُقصد بالصناعة الوظائف المعرفية الدقيقة إلى درجة الابتكار القائمة على العلم والتطور. وبذات الوقت يتم التفنن في ابداع المواد والرؤى المعرفية والفكرية واللغوية وجعلها قابلة للتداول في سياقات الثقافة. والدليل أن الصناعة في التراث العربي ارتبطت بالفكر واللغة والشعر وهذه مجالات معنوية ورمزية لا مادية، وبذلك لا تنطوي المواد المصنوعة على قوى خارقة لمجرد أنها تنتمي إلى الماضي وحسب. وكذلك لا تعد المواد ماهيات منقولة كما هي عصيةً على التنوع والاختلاف. حيث يُفترض بشكل عام أن كل مادة هي قيد التوليف، الموالفة bricolage بعبارة ليفي شتراوس عندما كان يدرس الأساطير في أمريكا اللاتينية.
لقد اعتبر ليفي شتراوس القصص الأسطورية أبنية تقوم على تيمات تتآلف مع بعضها البعض بين الماضي والحاضر (أو على الأقل تؤلف الماضي في قلب الحاضر). بحيث توفر رؤى شبه متماسكة لدى الناس حول الأشياء والعالم. إنها أشبه بالموسيقى البوليفونية متعددة الإيقاعات والنغمات والأصوات polyphonic music من جميع الأنسجة. وما لم يُعاد توزيعها بأساليب مبتكرة تواكب الاحاسيس والمعاني، فلن نرى إمكانياتها الثرية. نحن نستمتع بالموسيقى العبقرية حين تصوغ إحساسنا كأنها قد ألفت إلينا حصراً رغم أنها من أوقات سابقة وبأحاسيس غير ما نحس.
صناعة التراث مصطلح يدمجُ الإبداع بالقدرة على الانتاج المعرفي ومواصلة ما انتجه القدماء بشكل مختلف ومدهش يواكب حركة العصر والتاريخ. ولا سيما أنَّ أرصدة التراث لدينا في الثقافة العربية أرصدة كبيرة جداً. كما أنها أرصدة ثرية بما لا تحد كرأسمال رمزي في شتى المجالات فكراً ولغةً ومعرفةً وثقافةً. وبهذا فإن التراث يحتاج حذقاً فكرياً وحياتياً من نوع مغاير بحيث يمكن أن يعاش بطرق فذة. ليس وضعه الإنساني (ولا ينبغي أنْ يكون) مأخوذاً من الرجوع إليه هنا أو هناك. ذلك لكون التراث حاضراً في تفاصيل الحياة وظلالها شئنا أم أبينا. فبالرغم من مظاهر الحياة المعاصرة لدرجة الغرابة، لكنها تنطوي على موروثات حيةٍ لا تغيب مع غياب الأزمنة.
إن التحولات السياسية والاجتماعية (لم ولن) تفلح في تأكيد أية قطيعة مع الماضي. بل مفهوم القطيعة كان مفهوماً خاطئاً من الأساس كما أشار إليه الفرنسي جاستون باشلار وأيده فيلسوف العلم توماس كون وجرى على غرارهما مدلجو الحداثة وما بعد الحداثة من العرب. لأن التاريخ ليس طباقاً منعزلة من الواقع المستمر. التاريخ متصل بشكل مذهل، لدرجة أنَّ عصوراً وأفكاراً مازالت تنضح بما يستقر في مجراها من وقت طويل. فالمستقبل ليس شفافاً وبسيطا كمرحلة تحل فجأة، إنه صيغة (المستقبل الماضي) بكل المعاني الشائكة التي تكتنف هذا التعبير وتجعله مطروحاً للتساؤلات.
وجميع المجتمعات التي تتصالح إبداعياً وانتاجياً مع تراثها استطاعت تجاوزه. ليس التجاوز قطيعة بحال من الأحوال. إنه تأويل وصناعة مختلفة لا يتوقفان عن التُّجدد. تماماً كما هو فصل الربيع حين يزهر ويعبر (بلغة اليونان) عن أعماق الفيزيس physis ... تلك الطاقة النامية الدالة على تفتُّح الكل. وعلى الغرار نفسها، ما لم يتجدَّد التراث داخلنا ونتجدد داخله لن نبلور صيغة متفردة للعيش معاً. وأكبر أزمات العرب أنهم شعوب تراثية (بلا تصالح تأويلي) فذ مع التراث. إنَّهم أصحاب موروثات، لكن ليسوا صانعي تراث. ولذلك عجز العرب عن الإضافة إليه. فهو لا يعدُّ كذلك متصلاً يمكن التعبير عنه مجرد التعبير إلا بالإضافة والتراكم. حتى ولو كان آتياً من الماضي لأن كل ماض هو ماضي مستقبل (أي لا بد أنْ يولد من جديد في المستقبل).
وهنا لابد من التفرقة بين معنى: الموروثات والتراث. المعنى الأول (الموروثات) دالٌّ على مظاهر وأفعال ومذاهب متفردة تأخذها كل جماعة بشرية للتمايز عن غيرها. الأمر الذي يدعُو إلى تناقض الموروثات بقدر إحاطتها بسياج أيديولوجي صارم وعارم. كما يحدث لدى السنة والشيعة من مذاهب وفرق ضاربة في عمق المسائل العقدية واللاهوتية والسياسية. فهؤلاء وأولئك بهذا الاستقطاب الأيديولوجي يمتلكون محض موروثات فاعلة في اللاوعي وليس تراثاً. ولهذا كثيراً ما نجد الجانبين منغمسين في صراع لا يُبقي ولا يذر، يتجدد في أضابير السياسات والدول والعلاقات الدولية والصدامات المذهبية حتى اللحظة. وهو صراع يكمن تحت الجلد وداخل الغبار والرمال المتحركة وداخل النصوص وفي الفضاء الإلكتروني ضمن الرموز والشعارات والأيقونات. وهو صراع مازال يشكل نمط التربية وشروح النصوص الدينية والتنظيرات لمظاهر الحياة والموقف من التحولات السياسية والمعرفية إجمالاً.
أما معنى (التراث)، فشأنه شأن الرؤى والأفكار والصور العقلية والشعرية المتماسكة فلسفياً التي تخاطب الإنسان في كل زمان ومكان. إنه الإبداع الإنساني الكلي لماهية الأفراد والجماعات في عصرها ومازالت تحمل إمكانيات زمنية مهولة وقابلة للتجدد. بحيث يتجدد معها الشعور بالماضي كوجود عام يمد أصحابه بذخيرة حية. والتراث بهذا المعنى يصطنع من الثقافة طاقةً على السير وسط عواصف العصر. بحيث أنه عندما نرى فكراً، نراه مميزاً بتراثه الغني والثري. وهذا الوضع يحمل اسرار كل ثقافة حيه وإن كانت آتية كالنهر الهادي أو الهادر منذ آلاف السنوات. التراث شخصية إنسانية بارزة تدل على صور التفكير الكوني داخلنا. ويعود إلى ذواتنا الاصيلة والعميقة في قرارة أنفسنا فالضاربة في التاريخ والحياة.
لذلك كثيرا ما تتخلى الجماعات البشرية عن بعض الموروثات والعادات. ولكنها أبداً وقطعاً لا تتخلى عن (التراث) كقانون انتاج يحتاج إلى (صياغة وصناعة) مختلفة. وهو في الفلسفة والثقافة يمثل موضوع الفكر المؤثر على المدى البعيد مع تباين العصور. ولذلك يختزن أي تراث بمتونه الكلية كل أسئلة جوهرية كانت ممكنة في يوم من الأيام، لأنها مازالت معبرة عن جوهر إنسانيتنا الحرة كما وجدت وستستمر. فلئن لم تلح هذه الأسئلة الإنسانية في وقت ما، فسرعان ما تخرج على هيئة أسئلة حوارية الدلالة خلال وقت تالٍ. ولهذا فإن الخيال لا ينفصل عن الصناعة بهذا التكوين التاريخي. فلا بد للتراث من خيال يقلِّبه كيفما يشاء في آتون الواقع. ويتعلق به في آفاق المجتمعات الإنسانية كموضوع غائر الجذور وقابل للإنبات. كل تراث يجري بهذا المعنى كجزء من مفاهيمنا عن الزمن والحياة. ويتحدد الخيال من هذا القبيل كفعل عام لدى أفراد الثقافة وفاعليها. وليس بعيداً أن يتعهد أسئلتهم بالرعاية مستقبلاً.
وفي هذا استطاعت المجتمعات الغربية (إعادة صناعة) تراثها بشكل مُدهش. فرغم المناطق الدموية والصراعية التي تكتنف التراث الغربي ورغم عصور الانحطاط الروحي والاخلاقي كما عبر إزوالد اشبنجلر واديموند هوسيرل، إلاَّ أن الحضارة الغربية صنعت تراثها القديم في أنماط مدهشة. المدن الغربية تتآلف بغرابة مع العمارات القوطية والرتم الروماني والروح اليوناني القديم مروراً بالحداثة وما بعد بعد الحداثة حتى مفاهيم العمارة التفكيكية. كما لو كانت التراثات الغربية قد شُيدت الآن وليس منذ آلاف السنوات. في كل شارع من شوارع أوروبا وكل حانة وكل جامعة وكل مؤسسة غربية يوجد فيها شيء من التراث اليوناني أو الروماني.
ومع ذلك، فهروبنا العربي من المستقبل هو دوماً قضية أخرى بحجة الموروثات لا التراث كما فرقت سلفاً. وبالتالي كانت الهوية التي نحتملها وعداً بالقدرة على إحياء الماضي كإحياء الموتى. وهكذا أصبح التراث العربي الإسلامي (نتيجة هذا الفعل الثقافي) حلبة لمصارعة الثيران في عصر لا يعترف إلاَّ بالإبداع والابتكار. ولقد بات هذا التراث غابة من الفتاوى والآراء والتخريجات والحواشي والتأثيلات والتشجيرات والتهميشات التي لا تلوى على شيء. وتغلب عليها عمليات الكَّرْ والفّرْ بين المؤيدين لقضايا بعينها وآخرين رافضين لها. وبمجرد دخول القارئ العربي إليها لن يستطيع السير كإنسان عاقل إنما عليه استعادة حيوانيته التي تقرض الأوراق الصفراء وتلعق الأحبار القديمة!!
حتى لدى أصحاب الأفكار السلفية التي تحاول تجديد التراث حالياً، فقد جاء التراث كهفاً مظلماً لابد من العيش فيه. كأنه كهف أفلاطوني لا نرى من خلاله شمساً ولا بصيصاً من أمل للخروج من قيوده. ليعطينا القدماء بذلك عيوناً بديلة محل الراهنة محددين حتى رؤية كل ما نراه. بحيث يستحيل الحاضر هامشاً لمتون وأضابير مهترئة دونما إبداع أصيل.
جاء قُراء التراث المعاصرون أصحاب نزعة مسيحية متنكرة (نسبة إلى احياء الموتى كما فعل المسيح) في قراءاتهم المختلفة. فهم يرون أنفسهم قادرين على إحياء الماضي بالفعل. حتى اعتقد أحدهم (كحسن حنفي على سبيل المثال لا الحصر) تحويل الموروثات إلى نظرية ثوريةٍ، إلى لاهوت تحرير، وإلى يسار إسلامي (كتاب: من العقيدة إلى الثورة). كيف ذلك وبأي معنى سيكون الأمر؟! يبدو أن الإجابة ستكون معاناة ما بعدها معاناة، فلقد اعتبر حنفي التراث (موقداً حجرياً) لقدح شرارة الحقائق الغائبة عن الوعي مستمداً منه قبسات ليضيء الظلام الحالك ليس أكثر. ثم طرح محاولة البحث - بناء على ذلك - عن حقائق الإنسان والمجتمع والتاريخ في واقع مأزوم منفصل الآن. وليس هذا فقط، بل انتقى حسن حنفي (تحت عناوين براقة) بعضاً من توجهات التراث ما يسميه باليسار الإسلامي، لكي يُحيي معاني الاهتمام بالفقراء والاعتناء بالأحياء عوضاً عن الأموات ورفع القهر والدفاع عن المظلومين. فكانت الخلطة الحاصلة شيء أشبه بعجةٍ تجمع مواداً غذائية متناقضة في طبقٍ واحد، قد تسبب عسر الهضم والتُّخمة الكاذبة التي لا تشبع ولا تغني من جوع.
بالتأكيد الأمر بخلاف ذلك من حيث أن صناعة التراث هي أكبر الصناعات الثقيلة في تاريخ الأمم ووجدانها وخيالها الفاعل. ولن يكون التراث في يوم من الأيام عائقاً إلاَّ لدى الأمم التي لا تقوي على إضافة تراث جديد إلى ما ورثت وعاشت. ذلك لكون التراث حيٍّ فينا ومازال وسيظل حتى النخاع، لا بالمعنى الذي نستمد منه فقط كأنه مخزن (مغارة) على بابا، بل لكوننا لابد من: أنْ نكتشفه، أنْ نبدعه، أنْ نخترعه، أنْ نبتكره مرةً أخرى كأننا لم نعرفه من قبل.
الخطورة أننا لم نفهم هذه القضية البسيطة: أنه ما لم نكُّن على المستوى نفسه من الإبداع والترقب والانتظار المختلف لحياتنا عن حياة القدماء، فإن التراث سيُجرنا إلى الخلف أو بدورنا سنجترّه نحن كأحمال ثقال يكسر أرجلنا ويُعمي أبصارنا. لابد أنْ تكون هذه الصناعة آتية من آفاق المستقبل بكل تطوراتها وابتكاراتها وتحولاتها المدهشة، لكن للأسف: " من لم يصنع المستقبل، لن يجيد صناعة الماضي" ويصح العكس بالمثل:" من لم يستطع صناعة الماضي، لن يتمكن من صناعة المستقبل"... هي جدلية حرة لا تكف عن المزاوجة والتداخل بشكل تكويني وتاريخي مدهش. إذ لن تكّف جوانب التراث (التراثات المتنوعة) عن العودة مراراً وتكراراً طالما لم نُحسن استقبالها حتى اللحظة.
د. سامي عبد العال