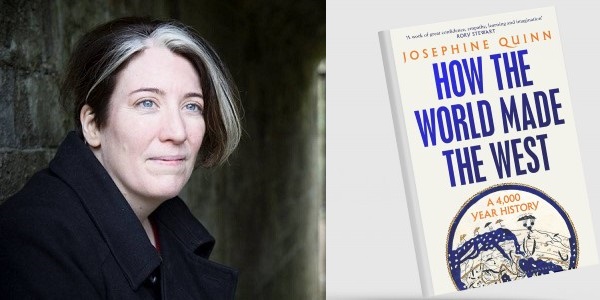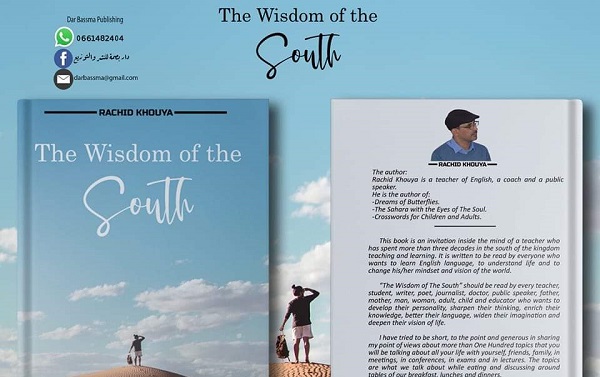صحيفة المثقف
سامي عبد العال: التعايُش الثقافي.. من يمسك بجلباب الشرع؟!
 على خلفية إطلاق (فتاوى التكفير وازدراء الأديان من وقت لآخر)، يهمنا إثارة قضية التعايش الثقافي داخل المجتمعات العربية. وما إذا كانت الفتاوى تمسُ تعايشاً تاريخياً يصعب النيل منه أم لا. فعملية (الافتاء الديني العام) لا تقف عند حدودٍ بعينها، إذ تقفز للعلّن مراراً وتكراراً كما في بعض البلاد (مصر والسعودية) ، حتى ظهرت في كل سياقٍ يخالف خصوصيتها. ولعلَّها بذلك عملية تثيرُ إشكالية الشرع والقانون ورسم المشاهد السياسية في متن الدولة المعاصرة.
على خلفية إطلاق (فتاوى التكفير وازدراء الأديان من وقت لآخر)، يهمنا إثارة قضية التعايش الثقافي داخل المجتمعات العربية. وما إذا كانت الفتاوى تمسُ تعايشاً تاريخياً يصعب النيل منه أم لا. فعملية (الافتاء الديني العام) لا تقف عند حدودٍ بعينها، إذ تقفز للعلّن مراراً وتكراراً كما في بعض البلاد (مصر والسعودية) ، حتى ظهرت في كل سياقٍ يخالف خصوصيتها. ولعلَّها بذلك عملية تثيرُ إشكالية الشرع والقانون ورسم المشاهد السياسية في متن الدولة المعاصرة.
لأنَّ الافتاء موقعٌ قد يحتاج إلى تأصيل دائم، موقعٌ غامضٌ بحسب الأنظمة الحداثية لإدارة الشأن العام. فأين يندرج مكانه – على سبيل المثال- إزاء مفاهيم الوطن والمواطنة والتنوع الثقافي والاختلاف الديني؟ ولماذا يوجد الإفتاء طالما أنَّ هناك أُناساً عقلاء وأحراراً كشرط للتدين والتخلُّق والمشاركة في بناء المجتمعات؟ وبأية صيغة سيأتي الإفتاء في هذه المساحة أو تلك من ثقافتنا؟ لأنه وسط التعددية الدينية، سيحتاج كلُّ دينٍ إلى مَنْ يتولى المهمة بأشكال مختلفةٍ، الأمر الذي سيجر (مع ثقافة الاغاظةِ والمكايدة الدينيةِ) صراع الأديان.
السؤال الرئيس إذن: ما مبرر وجود الافتاء في الفضاء العام ؟ ... هذا السؤال منطقي تماماً، لكنه حاد كحد السكين، لأنه سيقلب فكرة المجتمعات من حرية فاعلي العقد الاجتماعي والاعتناق المفتوح للعقائد وممارسة الإيمان الخاص إلى منطق الوصاية والهُوية. نظراً لوجود بعض المشايخ الذين صنعوا جلباباً من الشريعة يغطي كافةَ جوانب الحياة (بما فيها تغطية الآخر المختلف دينياً) .
وليس هذا فقط، بل جعل هؤلاء معنى الله جسداً مادياً يناوئ العالم (واقفين) على كتفيه لاصطياد الشاردين والواردين!! في عودة ظاهرةٍ إلى عصور غابرة من المراقبة الدينية والتفتيش في الضمائر وعقد محاكم لاهوتية لتتبع الإيمان وأداء الطقوس والشعائر. وربما سيخلق الإفتاء كيانات عامة غريبة، ليست من جنس الدولة لمحاسبة الناس (هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من يقوم مقامها ضمنياً) .
فالمُبرر وراء الإفتاء أيا كان ليس خاصّاً مثلما يطرحه الفقهاء بالنسبة للمؤمنين فقط، من كون الفتاوى تشرح وجوه الدين وتحُول دون الأخطاء وتُوجِّه الأفراد وتبين أمور الشرع في مسائل خلافية. كلُّ المبررات المذكورة تنحاز لفئة من المجتمع دون الفئات الأخرى، وتحدد ما على الإنسان فعله في دائرة عامةٍ رغم خصوصية منطلقاتها. كما أنَّها ستمس مشاعر غير المسلمين بالتأكيد، لأنَّها طالما ظهرت في المساحة المشتركة من المجتمعات، فهي تأخذ مواقف بالضرورة من مسائل عالقة ... مثل بناء دور العبادة لغير المسلمين وإقامة شعائرهم والأعياد الدينية الخاصة بهم ومعايير الاندماج الاجتماعي والثقافي.
إنَّ الافتاء الديني عادة آلية للمجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية، لا ليوضِّح قضاياها ولا ليمنع الانحراف عنها وحسب، لكنه قد يطرح وجود تفسيرات دينية كحائط عالٍ أمام أية اتجاهات فكرية ومعرفية أخرى. ولقد رأينا ذلك بالفعل بصدد ما يُسمَّى (أسلمة العلوم) وأنَّ كل شيء علمي وغير علمي موجود في الدين ولا حاجة بنا إلى معرفة سواه وأن نموذج (الفقيه العالم) سيكون سائداً في الحياة مثلما هو في المعرفة والفكر. فهناك- من ثم- تجاهل لعناصر المجتمعات وتنوعها، التجاهل الذي هو أخطر من التعدي عليها مادياً.
يقول الافتاء في سرِّه: إنَّ تنوعاً ثقافياً ودينياً لن يستمر إلى نهايته، لأن الفتاوى ستتوجّه إلى هؤلاء المعتنقين لدين بعينه دون غيره وبالإمكان تسييسها إزاء الآخرين في سياقات المصالح والمآرب، وأنَّ الدين الغالب يؤكد هيمنته على كافة الأديان ولو كان أصحابها يعيشون الظروف والثقافة ذاتها. وبالتالي لا مانع من مزاحمتِّها في الواقع عن طريق إطلاق الفتاوى التي تنال من اتباعها وتعتبرهم غير مرغوبٍ فيهم. وبخاصة أنَّ بعض الفتاوى تنطلقُ وسط خطابات دينية تتحرشُ بكل مخالفٍ في الآراء، فما بالنا إذا كان الأمر بصدد مخالفي المعتقد!!
لهذا كان طالبو الفتاوى بمصر يتساءلون: هل يجوز مصافحة الأقباط وغير المسلمين؟ هل سيدخل أحدٌ من الأقباط الجنة مثل الأطباء والمهندسين والعلماء؟ هل إلقاء السلام على المسيحي يشوش إيمان المسلم ويكدِّر حياته؟ هل للمرأة أنْ تتولى مناصب عامةً وأنْ يكون لها قرار مستقل؟ هل أن لمسْ المسيحيين ينقض الوضوء (باعتبارهم نجَّسَاً) ، وبالتالي هم مشركون أباً عن جدٍ؟ هذه وغيرها تثار تلقائياً في التفاصيل اليومية وفي نفايات الأفكار والعلاقات وصور الحياة. وليس حقيقياً أنها أسئلة دخيلة على المجتمعات العربية (الطاهرة من الغلو والتحرش بالأديان كما يُقال) ، لأن ذهنية الناس العاديين تتأثر بالخطاب الديني المتشدد أكثر من أعضاء الجماعات الدينية أنفسهم.
ثمَّ كثيراً ما تجئ الإجابات عن الأسئلة السابقة أوسع مكراً: أنَّ نجاسة المسيحيين ليست مادية بل معنوية!! وأنَّ البادئ بالسلام على أصحاب الأديان الأخرى هو الآثم لا الشخص المار مصادفةً!! فأية ذهنيةٍ تمسك بهذا الجلباب الفضفاض الذي يتم تفصيله بحسب المقاييس الرائجة، ذلك في واقعة واضحةٍ وضوحَ النهار باستبدال دائرة الدولة بدائرة السلطة الدينية. واصبحت العملية برمتها لعبة دوائر متداخلة ومتقاطعة مما أربك مفاهيم التعايش والاختلاف والمواطنة والتعددية.
وكأنَّ هناك حروباً نصية قديمة بين الدولة والفقهاء قد أتت من سحيق الزمان. وأخذت في الانتقام منها ضرباً على نسيجها الإنساني الحي. فالنجاسة المعنوية المشار إليها بسبب المسيحيين توعز إلى عدم الاقتراب من أي مسيحي ابتداءً. وتعنى عدم الاعتراف بالحياة الاجتماعية التي تحتويهم بين جنباتها. وإذا كان ذلك كذلك، فإنَّ السياسة لن تبتعد عن الفتوى ما لم تكن كل سياسة تنقلب إلى نوع من الإفتاء. بدليل أنَّ كلمة الإفتاء جرت على ألسنة الناس جريان المثل السائر، ولاسيما حين يُطلق شخصٌ كلاماً دون علمٍ ولا دراية (نقول له: كفى فتاوى.. كفى فتاوى) .
ولنلاحظ أيضاً اقتران التساؤل حول المرأة بالمسيحيين حصرياً في صيغ الفتاوى الشائعة. والسائل المنتظر خلف المواقف منهما ليس فرداً بعينه، بل روحاً لجماعة وظيفية قابعة داخل اللغة. فالمجتمعات العربية ترمي مثل هذه الأسئلة الاقصائية كرميات النرد، لأنَّ موضوعي السؤال (المرأة والمسيحيون) عامّان بما فيه الكفاية. بحيث أنه قد لا يُعنى أيُّ فرد خاص بمصيرهما، لكن لا تتركهما الثقافة الشائعة مهما ابتعدوا عن الآخرين.
من هذا الجانب، فإنَّ خطورة نصوص الفتاوى أنَّها تكمل بعضها البعض خارج حدودها حتى تبلغ أقاصي آفاق الدولة والمجتمع. أحكام الإفتاء تظل قابلة للانطلاق خلال أي لحظة بمجرد الشعور بسلطة التحكم في ماهية الاعتقاد. لعل أكبر سلطة في الأديان هي (سلطة (صح وخطأ) وهي التي توازي سلطة (التكفير والإيمان) وسلطة (الترهيب والترغيب) ، وسلطة (الجنة والنار) . لنتخيل أنَّ أصحاب الإفتاء يتحكمون في المسار الروحي للنفوس ويشرّعون أية تصورات ومعتقدات ستؤمن وماذا ستترك، ولعل السلطة الأبدية (الروحية في مقابل الزمنية) هي التي يقبض عليها رجال الافتاء مرةً واحدة.
فلئن كان الافتاء حول المسيحي سلوكاً يجب أن يؤمن به الطرف الآخر المُسلم، فالمسيحية هي الموضوع المقصود للفتوى. ليدخل الإسلام وجهاً لوجه في الدائرة الصراعية التي قد يدخل فيها أي دين. وتصبح المرأة في هذه الدائرة قرينة هذا الرفض والصراع تجاه المغاير دينياً. وهنا ايعاز بتماثل الاختلاف الديني مع الاختلاف الجنسي والعرقي والطبقي. وتكمّل الثقافة الداعية إلى احتراب هذه العناصر اقصاء الطرفين المذكورين.
إنَّ تاريخ الفتاوى الدموية بالتحديد كان مليئاً باستباحة ساحة الطرفين (المرأة والمسيحية) . فالمسيحي العربي خاصة والغربي عامة مهدور الدم، ممنوع من الصرف بلغة النحو، مهمش، يتحسس مصيره (ورقبته) بين الفينة والأخرى. جرى ذلك في الأمس الربيعي القريب بالعراق وسوريا ومصر وتونس... والحبل على الجرار. وتأكدت الحالة القلقة أثناء الربيع العربي وعواصفه على أن المختلف دينياً أول الضحاياً وأخر والمقربين. فالمسيحيون كانوا أول من تمت التضحية برقابهم وتهجيرهم وهدم كنائسهم.
أمَّا المرأة، فهي مهدورة الارادة، ملحقة بالرجل، لا قيمة لها إلاَّ كلاماً، مقبورة سلفاً في براقع لا تنتهي. من بيت أبيها إلى بيت زوجها إلى قبرها الأخير دون صوت ولا استغاثة. ما بين هذه المراحل، لا قدرة لها على الاستقلال والحرية ولا حتى تستطيع أن تقول أنا. وتذهب إلى المجال العام عرضَّاً تحت ما يسمى بالكوتة الانتخابية (أي اختيار عناصر نسائية من قبل السلطة) لتمثيل بني جنسها في البرلمانات أو من قبيل تنصيب امرأة كاستثناء جنسي وسط الذكور. وليس مصادفة أنَّ يتم اختيار عناصر نسائية ومسيحية لشغل بعض المناصب العامة بهذا الشكل غير الديمقراطي. لأن الديمقراطية غير موجودةٍ أصلاً خلال مزاحمة الافتاء لفاعلية القوانين ومجتمع المواطنة والتعددية.
وهنا لأول مرةٍ ربما في تاريخ الفتاوى أنْ تتجسد النصوص الفقهية في وجود مادي (على غرار أكشاك الفتاوى في مصر) ، ليمثل الرأي الديني طبيعةً عموميةً ليست من طبيعته، أي سيدخل حيزاً خارج ذاته في إطار أوسع بين الناس بشكل ملموس. في تلك اللحظة لن يكون الرأي الديني معتبراً إلاَّ في مجالات بعيدة عنه مثل السياسة والاخلاق والثقافة، حيث فخاخ التوظيف والتلاعب به.
وبخاصة أن الممسكين بجلباب الشرع يفصلُّون الأزياء لكافة الأحجام والأعمار والقوى. واسعة، ضيقة، طويلة، قصيرة، مهترئة، مهجّنة، مختلطة، مفتوحة، مغلقة، ... ويتم جميع ذلك كيفما تشاء السلطة الحاكمة. بينما سيظل بإمكان المجتمعات في المقابل تمزيق الأزياء الدينية الفارزة للبشر بسهولة، فهي كيانات كلية (أو هكذا يفترض) تسير عبر التاريخ الجامع لأطياف الاختلاف الإنساني والديني. لكن يبدو أنه عادة ما ينسي هؤلاء الممسكون بالجلباب تلك الحقيقة البسيطة جداً. فالتاريخ يغير محتوياته من عصر لآخر ولا يثبت على وضع واحد، وقد يُحوِّل الأشياء ولا يقننها فقط، ويدمر ما كان راسخاً بخلاف الصورة النمطية عنه. التاريخ يرث (بمعناه البكتيري والجيني) جميع افرازات المجتمع من أحداث وأفكار وتقاليد وتحولات. إن التاريخ هو القائم بعملية (التحلُّل) لأية تراكمات صلدة بحسب قوانينه وتداعياته. وبخاصة تلك التراكمات التي تعلو (بالقيمة مثل الفتاوى والجماعات الدينية) خارج مساراته الزمنية المتغيرة.
وليس أقل تدميراً لحركة التاريخ من الاتجاه نحو الخروج منه على نحو ميتافيزيقي صرف. ففعل الإفتاء عمل لا تاريخي دون ريب، لكونه قد يقود مجموعات بشرية تُساق بآراء ونصوص وتأثيلات فقهية قديمة عليهم أن يقبلوها كما هي. وذلك يجري دون الاعتناء بحاضر المجال الذي يوجد فيه البشر ولا تفاعلاتهم الحية وثراء ثقافتهم المشتركة. إن النسيان هو آفة التاريخ الكبرى التي لم نتعلم منها، تلك الآفة التي تقرض كالجرذان حيويتنا الإنسانية. وستكون لعناتها هي الجانب الذي يحتِّم تكرار مآسيه في شكل المراقبة والاضطهاد الديني.
فالدواعش والجماعات الاسلامية كانوا نتوءات كارثية نتيجة تجاهل التاريخ. فيبدو العقاب فورياً بهذا الكم من القتل وسفك الدماء وتدمير المجتمعات وتفكيك أواصر التعايش المشترك. فلو كان العرب يجيدون قراءة التاريخ ما كانوا ليكابدوا الويلات تلو الويلات من اعادة انتاج العنف والقتل باسم الدين. ويبدو أنَّ تاريخنا السياسي مازال مقبرةً لإفراز هذا الانتاج من الأشباح التي تتجسد في أسماء الجماعات والتنظيمات الإرهابية. ومن أسفٍ أنَّ المقبرة تشمل جميع أطياف الواقع السياسي مهما تكن عناوينها الدينية والسياسية. حتى الدولة ذاتها غدت تمارس عنفاً محتكَّراً (على طريقة علم الاجتماع الألماني ماكس فيبر) وبنفس الكم المتاح لدى الجماعات الدينية. سواء أكان في اعلامها ومناهجها الدراسية التي تقمع الذكاء والحوار والفهم والتحرر كنوع من التنميط أم بفضل الوظائف السياسية التي تكرر أعمال السلطة وخططها الاجتماعية والاقتصادية.
بالمقابل يُفترض أنَّ الإنسان كائن تاريخي، لا حقيقة له سوى ما أنجزه عبر الزمن وما راكمه في قطاعات الحياة. والتاريخ هو الذي يتعلم منه كيف يوجد، كيف يعيش بحرية وسط الآخرين. فإذا فقد خطاه التاريخية يوماً ما، فسرعان ما سيفقد هذا الوجود، لأن الكائنات الأخرى لا تمارس الحياة مثلما يفعل البشر. جميع أزمنة الكائنات حاضرة في دائرة الطبيعة بحكم فاعلية الإنسان أيضاً. أمَّا هذا الإنسان، فينظر إلى ماضيه بوصفه حاضراً بل ومستقبلاً في احايين كثيرة. أي أن الإنسان سيكون لديه كامل الوعي بالزمن وتأثيره في الحياة.
وهنا ثمة سؤال تالٍ بالمثل: ماذا لو تحدثت الفتوى عن طبيعة الفضاء العام لحياتنا المشتركة؟ إنَّها الخُطوة التالية المنتظرة دوماً ... هنا ستكون الفتوى في مواجهة مباشرة مع تطورات الحياة. والحقيقة أنها ستفعل ذلك طالما دخلت المعترك السياسي. لأنها لا تتم كفتاوى إلاَّ بافتراض اتباع كل الناس لما تقول. وهذا الافتراض ليس اعتباطياً، بل بدلالة تأثير الإفتاء في مساحة من عمل الدولة والمجتمع. مثل تأثره في أوقات الانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية في غير بلد عربي، حيث تنتشر (تحذيرات افتائية) من اختيار أناس بعينهم على أساس ديني أو مذهبي.
إذن المبررات المطلوبة وراء الافتاء يجب أن تستمد قوتها من طبيعة الفضاء العام وإلاَّ فلا مبرر لها على طول المدى. وطالما لا يستطيع الحصول على ذلك، فلا مبرر له، وقد تعتبر عملية الافتاء (في كل شيء وحول أي شيء) خطأ منطقياً في صلب الدولة إذا كانت ذات طابع نوعي. لأن منطق الإفتاء يتعارض وهذا الفضاء المشترك من حيث نقطة الانطلاق. فالإفتاء لا هوتي ووعظي وخطابي، بينما الفضاء المشترك مدني وعقلاني وتداولي، كما أن تأثير الافتاء يصر على تجزئته بحكم شخصانية التوجه والنتائج الدينية وتجاهل التنوع الثقافي.
ولذلك تبدو الفتاوى في غير حالةٍ مدفوعةً بتسيس معين. حتى أنَّ جماعات العنف الديني كثيراً ما اعتمدت على تأثيرها المسيَّس هذا، فهم يفتون مبدئياً بأن المجتمعات جاهلة وكافرة وأن جيوشها جيوش مرتدة عن الإسلام ولابد من محاربتها قبل محاربة أعداء الخارج. وهم يعلمون أنه لا يوجد ما يكسر ظهر الدول الرخوة أكثر من الفتاوى التي تنخرها من الداخل. إن تكالب الدواعش على المجتمعات العربية كذباب الجثث كان بفضل فتاوى فقهية تكفر هذه المجتمعات. حيث تعلن مروقها من الدين وأنها أولى بالمحاربة والجهاد قبل أية مواجهة مع الكفار، بل يعتبرون أن تفكيك نظام المجتمعات (القائم من وجهة نظرهم على محاربة الإسلام) هو الطريق المؤدي لدولة الخلافة الراشدة.
وبالمناسبة مهما تكن الأيدي الغليظة التي تمسك بالشرع، فإنها ستتلاعب بهذه الوفرة الرمزية للدين لصالح أيديولوجيا الدين والسياسة. فلا تخلو فتوى من إمكانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أنَّ الإنسان موضوع سلبي يجب الإمساك به وقيادته كالسوائم بلا عقل ولا روية. وعلى أنه لا يوجد في السياسة هذا الشيء نظراً لانعدام معايير (الصحة والخطأ) ، لأن كل السياسات وتأثيراتها مجرد بدائل وتجارب، فإنّ ذهنية الافتاء تؤكد إلزام الأمر معروفاً ومنكراً دون نقاش. أي في الوقت نفسه الذي قد يأخذ فيه الناس بالمعروف وينكرون المنكر، فإنَّ السلطة المتولدة دينياً هنا لا تتصادم بالضرورة مع سلطة القانون والتعايش فقط، بل تحطم أيضاً منطلقات الدين الإسلامي نفسه. حتى وإنْ كان الاثنان (الفتوى – القانون) صحيحين.
فسلطة الافتاء تنتمي إلى جلباب الشرع ورمزيته. وهو جلباب خاص جداً مهما يكن كبيراً من جهة الاعتقاد والمقاصد العليا، بفضل توقفه على الإيمان وانتقاء المواقف والأعمال المتحيزة. وطالما كان ثمة سلطة ضمنية، فإنه ستكون هناك قفزة ضمنية أخرى باتجاه تديين الدولة. أي انزالها من كونها شخصية اعتبارية إلى مستوى الترديد اليومي لفتاوى الفقهاء وممارسة سلطتهم. وتلك المرحلة الأخطر في ممارسة الإفتاء، لأن الدولة ستتجرد من عموميتها لكل المواطنين وسيتم إلباسها ثوباً خاصاً. وهذا حلم كل جماعة دينية تسير في الطريق ذاته إن لم يكن دعوة لمزيد من الخلافات وظهور الفرق الناجية. وأيضاً هذا بخلاف طبيعة الديانة الإسلامية التي لم تؤهل جذرياً ولا ثانوياً أية جماعة كهنوتية للتحدث باسمها. ولم ترشح فقهاء لالتهام مجال هم عاجزين عجزاً إنسانياً ومعرفياً عن إدارته.
إنَّ الفتاوى القائمة ابتداء على التصنيفات الدينية ضد منطق التعايش الثقافي. لأن هذا التعايش والحوار والاندماج والمشاركة والمساواة أشياء تنمو بفضل ممارسات المجال العام. فالتعايش يعني اعتراف واجراءات وحوارات وتقاطعات بين جميع عناصر المجتمع ومكوناته الثقافية وغيرها. ليس مهما فيه الأحجام النوعية للجماعات وأتباع الأديان بقدر ما يكون المجال متاحاً أمام الجميع للتعبير عن الوجود والنشاط بكل حرية واختلاف وتمرد. وأنه المجال الذي يحمي عناصره بذات الوقت الذي يعطيهم تكافئاً لارتياد جميع الآفاق الحرة دون تناقض.
د. سامي عبد العال