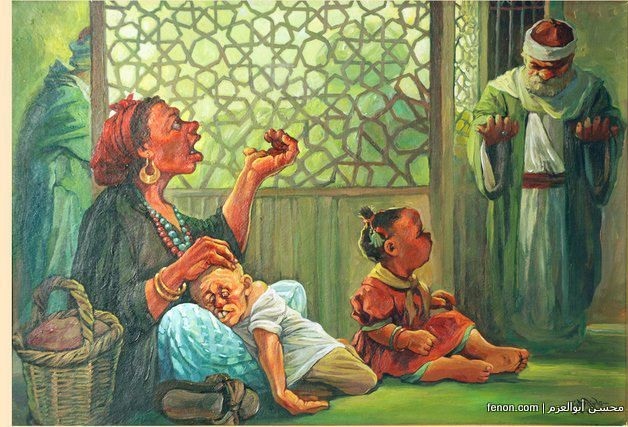صحيفة المثقف
عصمت نصَّار: هل في مصر فلاسفة؟.. محاولة في قراءة القراءة
 قد تأثر "حسن العطار" (ت1835م) وتلاميذه و"محمد عبده" (ت1905م) ومدرسته، بموسوعية الجاحظ (ت869م) وإعلائه من شأن حجية العقل على إجماع الفقهاء بغض النظر عن غزارة علمهم وقوة أدلتهم، وذلك في نقض التراث وتجديد العلوم الفقهية والكلامية والصوفية مع عدم التحرّج في التصريح بموافقته المعتزلة أو الفلاسفة في بعض الآراء وتحليل القضايا وتقديم الشك على التسليم بصحة المعتقدات التي تفتقر لوضوح المقصد، ولا سيما في قضايا الإصلاح والمجاهرة بجحد السلطة الظالمة مع تغليبه آلية التوعية والتنوير على قوة الغلبة والصراع والتثوير, وانتهاجه الأسلوب المباشر الواضح في صياغة الخطاب مع مراعاة تباين أذهان المتلقين وثقافة المحاورين والمتناظرين.
قد تأثر "حسن العطار" (ت1835م) وتلاميذه و"محمد عبده" (ت1905م) ومدرسته، بموسوعية الجاحظ (ت869م) وإعلائه من شأن حجية العقل على إجماع الفقهاء بغض النظر عن غزارة علمهم وقوة أدلتهم، وذلك في نقض التراث وتجديد العلوم الفقهية والكلامية والصوفية مع عدم التحرّج في التصريح بموافقته المعتزلة أو الفلاسفة في بعض الآراء وتحليل القضايا وتقديم الشك على التسليم بصحة المعتقدات التي تفتقر لوضوح المقصد، ولا سيما في قضايا الإصلاح والمجاهرة بجحد السلطة الظالمة مع تغليبه آلية التوعية والتنوير على قوة الغلبة والصراع والتثوير, وانتهاجه الأسلوب المباشر الواضح في صياغة الخطاب مع مراعاة تباين أذهان المتلقين وثقافة المحاورين والمتناظرين.
ذلك بالإضافة لمسايرتهم آراء إمام الهدى الحكيم السمرقندي "أبي منصور الماتريدي" (ت944م)، وذلك في منهجه الجدلي مع المخالفين والمتكلمين من الفلاسفة؛ دفاعاً عن آراء أهل السنة ولا سيما فقه ’أبي حنيفة’ وكذا في تقسيم الأصول الشرعية إلى عقليات وسمعيات والأخذ بالتأويل في التفسير والمجاز والرمز والتلميح للكشف عن المقاصد الخفيّة في القرآن والحديث.
والاعتقاد في خلق القرآن لفظاً واعتبار مضمونه كلام الله النفسي وعلمه الحرفي، مع عدم الأخذ بحديث الآحاد في المسائل الشرعية. وقد انتحلوا أيضاً آراء "فخر الدين الرازي" (ت1209م) في تفسيره للآيات القرآنية واستنباطه للأحكام الشرعية واجتهاداته الفقهية وموازنته في ذلك كله بين قطعي الثبوت والدلالة من المنقول والصريح والبديهي من المعقول، وما يقبله المتلقي (أهل الدعوة والاستجابة) من التأويلات التي تقرب الغيبيات من الأذهان وتبرر ما عساه يكون الاعتقاد بأنه مخالف لأهل العصر من آراء وأفكار ومعجزات سمعية إيمانية.
هكذا عبّرت معظم الكتابات المتخصصة عن عقيدة مدرسة الاتجاه المحافظ المستنير في مصر.
ومن ثمّ قرّر العديد من الباحثين المعاصرين البحث عن ما يصدق عليه هذه المعايير من المتفلسفة أو المفكرين المعاصرين في مصر والعالم العربي.
ومنذ قرابة خمسة وسبعون عاماً طرح "العقاد" على مائدة التساجل قضية من أكثر قضايا الفلسفة والفكر العربي الحديث أهمية وجدّة وأصالة، ألا وهي عدم وجود فلاسفة في الثقافة المصرية القديمة، وندرة وجودهم في تاريخها الحديث والمعاصر، وراح يستعرض آراء المؤرخين المعنين بالآثار المصرية، فوجد أن التعصب العرقي والجنسي قد ألقى بكتاباتهم في ضلالات القول بتميز العقلية الآريّة عن العقلية الساميّة، وهي أحدى النظريات التي أثبت العلم الحديث خرافتها، ثم أهتدى إلى أن التفكير الثوري والتحليل النقدي للواقع المعيش هو الدافع الأول لظهور الفلاسفة عبر التاريخ الإنساني.
ولمّا كانت مصر من الأمم التي نعمت بالاستقرار الاجتماعي والسياسي والعقدي, وهدوء أوضاعها المعيشية بفضل تآلف السلطتين السياسية والدينية من جهة, وميل المصريين بجبلتهم للأمان والسلم في ظل الإيمان بالقدر وحكمة الخالق في تقسيم الأرزاق والعطايا، وكراهتهم لشرور الصراع من جهة أخرى؛ لم يظهر على مر تاريخ مصر القديم والوسيط من يمكن أن نطلق عليه مصطلح فيلسوف، وذلك بمعزل عن حكمة الكهنة ومحافل علومهم ومدارس أبحاثهم تلك التي عُنيت لغرس الفضائل والذوق الرفيع في أريحيّة العقل الجمعي، وحب العلم وأهله والقادة والرؤساء، ولذوي المناقب واحترامهم وإجلالهم.
واذا ما تتبعنا البحث في هذه القضية؛ فسوف نجد أن "العقاد" كان مُحقاً إلى حد كبير في هذا التبرير، وذلك لأن أشهر الحكماء المصريين الفراعين التي كشفت عنهم الدراسات الأثرية الحديثة مثل الحكيم كاي جمني (نحو 2600ق.م)، وبتاح حتب (نحو 2500ق.م)، والحكيم آني (نحو 2280ق.م) و أخناتون (نحو 1334 ق.م) قد أنصبت كتاباتهم حول تعاليم أخلاقية وأصول تربوية وسلوكيات اجتماعية وبيئية, وأخرى عن الدين ومحبة الإله والسعادة الأبدية والعدالة الإلهيّة.
أمّا المدارس الهرمسية السريّة الفلسفية، فلم يكن معظم علمائها من الفراعين الخُلّص فقد جمعت في أرواقها الفلسفية (نحو 350ق.م)، وأقسامها العلمية - في مكتبة الإسكندرية )نحو 290ق.م) - واللاهوتية (نحو 190م) بين المصريين وغيرهم من شتى حضارات العالم القديم. ولا يمكننا - من ثمَّ - اعتبار أمنيوس سكاس (نحو242م) واكلمندس السّكندري (نحو 215م) من الفلاسفة المصريين.
واذا ما حاولنا الربط بين الأقوال المتناثرة التي نسبت لهوميروس (نحو القرن 8 قبل الميلاد) وطاليس (نحو 546 ق.م) وفيثاغورس (نحو 495 ق.م)، وأفلاطون (نحو 347 ق.م) وأرسطو (نحو322 ق.م) عن فلسفة المصريين ومدى تأثرهم بها، وما اكتشف من وثائق, سوف نستدل على أن : جميع هؤلاء قد اطلع على الفلسفة الهرمسية - التي لا نعرف عن روادها شيئاً - من جهة. والتأكيد في الوقت نفسه على أنه كان للمصريين فلسفة روحية وآراء علمية ومبادئ أخلاقية راقية، جامعة بين النظري والعملي قد نهل منها أكابر فلاسفة الإغريق من جهة أخرى. غير أنها تختلف في طابعها العام عن المفاهيم التي ذاعت بين المثقفين عن معاني الفلسفة المُجرّدة, والمباحث الكلية الشاملة.
ونعود إلى مقال "العقاد" الذي حاول تبرير خلوّ مصر من الفلاسفة الخُلّص؛ فقد ذهب إلى أن سلطة فرعون خليفة الإله على الأرض وخليفة الكاهن الذي يمثل آلية التواصل بين العالم الأرضي والعالم السماوي، وحامل أختام القدر، قد حالا وجودهما بين حرية البوح والتفكير في أذهان المصريين، كما اجتهد كُتّاب الأساطير من الكهنة الصغار في تفسير وتبرير الأحداث والواقعات حتى يبدو الواقع أمام المصريين يسير وفق خطة إلهيّة لا تقبل الشطط أو الجنوح أو التفكير المارق.
ومن أقواله في ذلك: (أما اليونان فقد نشأوا في بلاد خلت من الدول الفخام، كما خلت من الكهانات الفخام؛ فانطلقوا أحراراً يفكرون فيما اقتبسوه من مصر وبابل وفينيقية, ولبثوا كذلك حتى تقرّرت في بلادهم "شبه دولة"؛ فكانت فجيعتها الأولى مأساة سقراط, ثم مأساة أفلاطون في الأسر؛ ولولا حماية عارضة كانت تحيط بأرسطو لأصابه على أيدي القوم شيء ممّا أصاب أستاذيه. ولارتباط الأمر بسلطان الكهنة أو رجال الدين تكرّر في صميم أوروبا ما تكرّر قديماً في وادي النيل وما بين النهرين ... هذه هي العلة الأولي التي ترجع إليها خلوّ الأمة المصرية من الفلاسفة في العصور القديمة، وهي كما رأينا علة سياسية تاريخية لا تنحصر في مصر، ولا في البلاد السامية دون غيرها، ولكنها تفعل فعلها هذا في كل زمن، وبين كل قبيل من الأجناس البشرية).
وخلاصة تلميحات "العقاد" تبدو في تأكيده على أن أكثر أعداء التفكير الناقد والفلسفة قوة وضراوة هو الحاكم المستبد الأحمق ورجل الدين الفاسد الخائن، ومن ثمّ لا يُرجى من شعب تفلسف أي تجديد أو إصلاح تحت وطأتهما.
واذا ما أعدنا قراءة ما كتبه "العقاد" سوف ندرك أن المقصود هو الوعي؛ فالوعي الزائف أو التهوين والتهويل في سرد المعارف أو التوجيه المُغرض من قبل الرأي العام القائد، أو الراسخ في العقل الجمعي، والرأي العام التابع هو العلة الحقيقة التي تحول بين ظهور الفلاسفة من جهة, وسمعة التفلسف السيئ لدرجة أنها أصبحت مرادفة للسفسطة والتجديف والمروق من جهة ثانية، وتراجع الثقافة وضحالة التفكير النقدي من جهة ثالثة, وانعدام الرؤى الإبداعية المؤهلة للتطور والتقدّم من جهة رابعة.
ورغم ذلك؛ لا يغفل "العقاد" أثر الطابع العام للثقافة السائدة في المجتمعات؛ فالثقافة العلمية والطابع الأخلاقي اللذان اتّسمت بهما الثقافة السائدة في مصر القديمة هي التي ساعدت على ظهور الوعّاظ والحكماء. أمّا الثقافات المضطربة في النواحي السياسية، والجامدة في التربية والاجتماع والتعليم، أو المكبّلة بقيود الخرافة والأكاذيب في أي عصر؛ فهي تُعدُّ الأرض الخصبة لظهور العنف والاستبداد والتخلف، وكلها من أدران التفلسف.
وينتقل "العقاد" إلى العصر الإسلامي ويبيّن أن المصريين بفطرتهم الخيرة وطبائعهم الخُلقية ورقة أذواقهم وروحيّة معتقداتهم، قد رغبوا عن التصاول والتصارع في أمور العقيدة، ومجّوا كذلك كل أشكال الغلو والتطرف في العبادة؛ الأمر الذي عبر عنه شيوخ الأزهر في مباحثهم، وانعكس كذلك في آرائهم الفلسفية التي شغلت حيزاً كبيراً في شروحهم وحواشيهم للكتب الكلامية والفقهية والصوفية التي أرادوا تحقيقها.
ويصوّر "العقاد" ذلك قائلاً (ولمّا تفرّع علم الكلام، أو علم الفلسفة الدينية في الإسلام كان الطحاوي المصري(852 - 933م) ثالث أثنين من أقطاب هذا العلم هما الأشعري والماتريدي، ثم كانت مصر بيئة المتصوفين وملاذهم إلى زمن أخير. وبنى الأزهر بالقاهرة؛ فأصبح قبلة للعلوم العقليّة والشرعية عدّة قرون، ودرست فيه مذاهب الفلسفة في العصور التي حرمت فيها الفلسفة على أبناء الأمم كافة من غربيين وشرقيين.
( وللحديث بقيّة)
بقلم: د. عصمت نصَّار