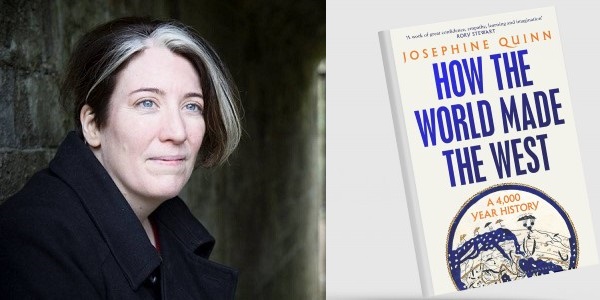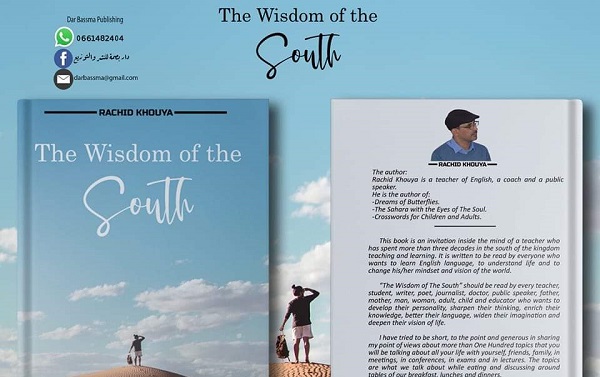صحيفة المثقف
عصمت نصَّار: هل في مصر فلاسفة؟ (2)
 لم يقطع "العقاد" بخلو مصر من الفلاسفة - في عصورها القديمة - بل قصد تميز العقلية المصرية ونهجها العملي في التفكير وربطها بين المجرد والمحسوس والروحاني والمادي والنظري والتطبيقي دون خلط أو مزج أو تضاد وتنافر، وعزوفها عن الثنائية التي أعيت الفلاسفة فيما بعد.
لم يقطع "العقاد" بخلو مصر من الفلاسفة - في عصورها القديمة - بل قصد تميز العقلية المصرية ونهجها العملي في التفكير وربطها بين المجرد والمحسوس والروحاني والمادي والنظري والتطبيقي دون خلط أو مزج أو تضاد وتنافر، وعزوفها عن الثنائية التي أعيت الفلاسفة فيما بعد.
ويبدو ذلك في جُل القضايا التي طرحها حكمائها على مر تاريخهم - الذي مازلنا نتعرف عليه ولم نفرغ منه بعد - فقد نظروا للوجود وما فيه من موجودات على أنه نعمة ومنة وقدرة إبداعية للخالق الواحد المتجلي بنوره وجماله وكماله في العالم المرئي بالحواس، والعالم الآخر الذي تدركه العقول والمشاعر ويبرهن على وجوده العقل الفعال المتصل دوماً بالفيوضات الإلهية والإلهامات العلويّة التي تدركها الأذهان الراقية والنفوس الصافية؛ وذلك بالتأمل المعرفي والعرفاني والحدس الذوقي الجواني.
تلك الفلسفة التي أدركت أن العلم قدرة وإمكانية (الهيولي) وطاقة بشرية منحها الإله للناس كافة غير أنها تحتاج إلى جهد إنساني لتفعيل آليات تحصيله (حس، عقل، حدس)؛ وذلك تبعاً لطبيعة المعارف المُراد إدراكها ثم استيعابها ونقدها وتطويرها وتحديثها وفق احتياجاته العملية.
نعم! فلسفةٌ جامعة بين الإيمان والعلم؛ فانبثقت مبادئها الأخلاقية تعبر عن جوهرها الخير الذي وُجد على الأرض قبساً إلهيّاً نقيّاً في سرائر البشر؛ فأينعت طيبة وتسامحاً وحباً للإله وجميع مخلوقاته. لم يفرق المصري في فلسفته بين مبحث الوجود والمعرفة والأخلاق، ولا بين النظر والعمل، ولا بين الجميل والجليل، ولا بين النافع والصالح، ولا بين العدل والحق، ولا بين ما ينبغي أن يكون، وما هو واجب فعله، واعتقد أن تلك البنيّة الفخمة الرائعة هي الجوهر المركزي الذي مكّن الإنسان المصري من هضم واستيعاب وتطويع الوافد من شتى أنحاء الدنيا وتوظيفه وفق مقاصد هذه الفلسفة التي لا تسعى إلا إلى تحقيق الاستقرار وإخضاع الكون؛ لتحقيق السعادة على الأرض وتهذيب النفوس وتطهير القلوب وتذويد العقول بكل الآليات التي تمكنها من اقتلاع الشر والعنف والحسد والبغضاء الذي يحول بينها وبين السعادة الأبدية في الرحلتين الدنيا والآخرة.
تلك القراءة الصوفيّة أو إن شئت قل الرؤية المحافظة للفلسفة المصرية التي أنبثق عنها النسق الفلسفي الذي نعيشه مع إخفاقنا في تمحيصه والتعبير عنه أو التنظير له.
أجل! تلك الرؤية التي يمكن الاستعانة بها لتفسير وتوضيح وتأويل وتبرير العديد من الحقائق والأحداث، وصياغة الإجابات عن عشرات الأسئلة حول علة الطبائع والسلوكيات اعتماداً على النهج الأركيولوجي (Archaeology) أو التحفير في بنية النفس حتى الوصول إلى النواة.
فمن تأمل السياق الأسطوري في التراث الفرعوني؛ فسوف يدرك خلوّه من الخرافة والعبثية والعنف والصراع غير المبرر ذلك في ضوء (علم الأساطير المقارن)، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن جُل الأساطير المصرية قد صيغت بحِرَفيّة عبر الأحقاب التاريخية، وذلك لإدراجها في النسق التربوي لتنشئة النشء على الثوابت الفطرية التي يجب تدعيمها في الروح الجمعي للمجتمع.
فمن النادر أو الشاذ وجود أسطورة مصريّة تحرض على العنف أو التمرد أو تبرير الدنس والخيانة أو اللصوصية والفجور أو الاستبداد والجحود أو الظلم أو الكفر أو الصراع الاجتماعي والسياسي أو الغدر أو السّطو على الأغيار الآمنين. (وحسبي أن أهمس في الأذان وأنبه الأذهان أن جحود بعضنا في كل الأشكال الأدبية والفنية التي تقترب من نقيض تلك البنية الفطريّة يُعدُّ إفساداً للفلسفة المصريّة أو إلصاقاً بها ما سوف تلفظه وتقذف به في آتون السفالة والانحطاط بعد إفاقتها من دور الانحدار).
وإذا ما فحصنا البنية العقدية المصرية القديمة؛ فسوف يتبيّن لنا أن فكرة "التوحيد" أكثر أصالة وأعمق رسوخ في الفكر الديني المصري من فكرة الكثرة الألوهية أو التعدد أو الثنائية، ويكشف عن ذلك بوضوح علم مقارنة الأديان - وقد أثبتنا ذلك بشيء من الاستفاضة فيما كتبناه في هذا الحقل المعرفي استناداً على أحدث الاكتشافات الأثرية وأكثر الدراسات الأكاديمية دقة وموضوعية-؛ الأمر الذي يُفسّر لنا وحدة النسق العقدي في العبادة المصرية، ورفض العقل الجمعي للمعبودات الشاذة التي وفدت على مصر سواء عن طريق الاحتكاك الثقافي أو الاحتلال العسكري. كما أنه يبرر احتضان مصر قديماً للديانة اليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام؛ وذلك للتشابه الواضح بين صلب هذه الديانات والنسق الإلهي المصري. وتبدو أصالة الجوهر الفطري الذي تحدثنا عنه في نجاحه في تطويع العديد من الشعائر والطقوس والعادات والتقاليد اليهودية والمسيحية والإسلامية؛ ليتناسب مع الروح الجمعي المصري ذلك مع عدم إنكار تأثر البنية الثقافية المصرية بالأفكار الدينية الوافدة في الفروع، وليس في الأصول. ذلك كله من جهة، وجحد ونقد العقل الجمعي المصري لكل أشكال الوثنية وتقديس البشر (مع تعظيم وتجليل الأبطال) والمعتقدات الشركيّة والصفات المادية والتجسيدية أو الصفات التي تحط من شأن سمو ورفعة وكمال وجمال الإله من جهة أخري.
وقد ترتب على سلامة هذا النسق الديني رفض المصريين لكل أشكال التعصب المِلّيِّ وكل أنماط الغلّو والتشيع وكل نهوج الإجتراء والإلحاد على مر تاريخهم، ويمكننا مراجعة ذلك في عشرات الدراسات التي تناولت التاريخ العقدي المصري.
ولعلنا نستفيد من ذلك في تبرير مج المصريين وعزوفهم عن الانتصار أو الانتماء أو الترويج للعقيدة الباطنيّة و الدرزية والبابية والبهائية والقضيانية والوهابية والمهدية والمحافل ذات الصلة مثل الماسونية وعبدة الشيطان والروحيّة الحديثة والإخوان المسلمين والقاعدة وداعش.
ومن الطريف أن نجد "إسماعيل مظهر" يؤكد على صفحات مجلة (العصور) عام (1928م) على أنه من العسير؛ بل المستحيل تبديل هويّة المصريين ومشخصاتهم وطبائعهم العقدية وميلهم الفطري للإصلاح، وليس الإفساد والطمع في غفران الله ورحمته وستره رغم اعترافهم بعثراتهم وكبواتهم، وأن معارف الفراعين العلميّة لم تدفعهم يوماً لجحد أخلاقياتهم تجاه الطبيعة، والبيئة، والحيوان؛ بل كانت تدفعهم دوماً إلى اقتحام المستحيل، والتأكيد على منطق التحايل ومنهجية الإمكان، كما أن قوتهم وشجاعتهم لم تدفعهم إلى تقديم الحرب على الحب أو النرجسية والعنصريّة على لين الجانب والمعايشة ومَدِّ يد العون للأغيار.
ويرجع ذلك في رأي "مظهر" إلى تلك الفلسفة التي نحتها المصريون القدماء في جبلتهم بعد تأمل عميق للوجود بأسره بنظرة استكشافية فاحصه ليس بالحواس فحسب؛ بل بالقريحة والأريحيّة والعقلية التجريبية الناقدة الشاغلة بالبحث عن الحقيقة من جهة، ورؤية ناقضة ساخرة ضاحكة ممّا يدور حولهم من أحداث وواقعات من جهة أخرى.
وينتهي "مظهر" من شرح أهمية الفلسفة إلى توضيح أنها المسؤول الأول عن تحديد ما هو ثابت وما هو متغير لثقافة العصر، وما ينبغي تأصيله في برامجنا التربويّة، وما يجب تجديده وتحديثه في مناهجنا التعليميّة.
وضروريٌّ علينا مراجعته كلما اقتضى الأمر من الشائع في آدابنا وفنوننا وأحاديثنا اليومية، وذلك للأثر الأكبر الذي تخلّفه الأذواق على تأملاتنا العقلية وتصرفاتنا الأخلاقية ومعتقداتنا الدينيّة.
ويعني ذلك أن "مظهر" في هذا الوقت المُبكر كان مدركاً لأهمية تأهيل المجتمع بمختلف طبقاته لقبول التفكير الفلسفي باعتباره هو الغربال أو الوعاء الناقض الذي يجب الاحتكام إليه في اختيار وانتقاء اللبنات التي نستعين بها في تجديد بنيتنا الشخصية والحضارية. ويقول في ذلك أن المجتمع الذي يسير وفق بنيته الفلسفية المُعبرة عن أصالة مشخصاته (أنها تحظر فعل ما هو خطأ وتبيح فعل ما هو صواب وتشجع عليه، كذلك هي التي ترغب في الأشياء الجميلة وتنفر من القبيحة. أما تقييم الجمال والقبح؛ فله أثر كبير في تكوين مظهر ذي شأن من مظاهر البيئة الاجتماعية. وهذا ما يسمى بمظهر الجمال).
ويجمل وظيفة التأمل الفلسفي في حياتنا. ويقول: "كما أن النظامات التي تتبلور فيها هذه النتائج العقليّة، فذلك ما نسميه "العلوم"، وهذا ما نسميه بالمظهر العلمي للبيئة الاجتماعية على أن هذا المظهر قد لعب الدور الأكبر في حياة الإنسان على طول الدهور وكر العصور".
ويضيف "مظهر" :"أن التأمل الفلسفي في أظهر مظاهره هو القدرة على أن تسأل وتجيب، وأن تستعرض مشكلات وتحاول حلها، وأن تنظر إلى المستقبل وتختط للسلوك خطة ما. هو أن يكون فيك قدرة على استطلاع الحقائق التي ينطوي عليها وجودك ويحتوي عليها المحيط الذي تعيش فيه... وعلى الجملة نقول بأن ’التأمل’ يتطلب منا، باعتبار أنه مثلاً أعلى، أجوبة ثابته لكل الأسئلة التي يمكن أن تقوم في العقل، كما يتطلّب ترابطاً منطقياً يصل بين كل الأجوبة التي يتسنى لنا الوصول إليها؛ بل نقول تعميماً بانه يرمي إلى معرفة الكون من طريق نظرة شاملة فيها ألفة تامة، بحيث لا ينقص تلك النظرة شيء من كمال الأسلوب ولا حسن النظام، الذي يقصد به تتابع النسق التدليلي وترابط وجوهه وعدم تنافر أجزائه بحال من الأحوال".
وخليقاً بنا أن نبيّن أن الدعوة للتفلسف في حياتنا الثقافية كانت من الأمور سيئة السمعة عند الجمهور؛ الأمر الذي حال بين ظهور الفلاسفة أو المتفلسفة. فقد خلط العوام والجامدين من شيوخ الأزهر بين الفلسفة والسفسطة؛ فأدعى بعضهم أنها مدخل لجحود المقدسات وما جبلنا عليه من موروثات، كما أنها تُحرّض كل من يقرأ في كتُبها على الإجتراء والمجون والشطط، وذلك عقب إلغاء العلوم النظريّة والعقلية من مناهج التعليم في الأزهر بعد تسلل الفكر الوهابي إلى الثقافة المصريّة وتكفير الخلفاء العثمانيين للفلاسفة وتقبيح كتبهم.
وقد جاهد "حسن العطار" ورفاقه في مقاومة هذه الدعوة وإثبات أن المباحث الفلسفية شأنها شأن سائر المعارف الإنسانية؛ لأنها تحوي بين دفتيها كل ما ينتجه العقل من أفكار، ومن ثمّ فمن الخطأ الحكم على الكل استناداً على الاعتقاد في فساد الجزء، وأن ما لا يدرج جُله لا يترك كُله. وسوف نوضح فيما بعد قصة بعث المعارف الفلسفية ثانية في الثقافة المصرية. أمّا ما جاء في حديث "إسماعيل مظهر"؛ فهو لا يعدو أن يكون إحدى محاولات بعث المباحث الفلسفية في الرأي العام.
(وللحديث بقيّة)
بقلم: د. عصمت نصّار