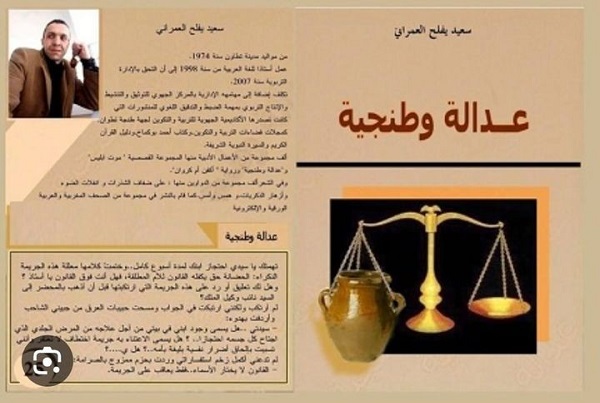صحيفة المثقف
مصعب قاسم عزاوي: وأد الديمقراطية

لكي يتمكن نموذج الديموقراطية التمثيلية من تحقيق أهدافه الموضوعية التي ينافح عنها من الناحية النظرية، لا بد من توفر أرضية راسخة تتألف من دعامات أربعة لا يمكن الاستغناء عنها. أولها وجود مجتمع مدني حقيقي قادر على التشاور بشكل جمعي لاكتشاف مكمن مصالحه والطرق المحتمل اتباعها لتحقيق تلك المصالح والحفاظ عليها، ومن ضمنها إمكانية التوافق على مرشحين محتملين عن ذلك الجزء من المجتمع المنتظم في منظومة معينة للمجتمع المدني سواء كانت نقابة أو جمعية مهنية أو رابطة فكرية أو حزباً سياسياً، ومن ثم الالتزام بدعم ذلك المرشح للوصول إلى المنصة التي يمكن من خلالها المشاركة في منظومة الديموقراطية التمثيلية سواءً بشكلها البرلماني أو على نمط الحكومات المحلية أو البلديات أو ما اصطف في ذلك النسق من التنويعات، للقيام بدوره الوظيفي كممثل لتلك الفئة المجتمعية ومنظومة المجتمع المدني الذي تصطف فيه، والتي بدورها تلتزم بواجبها الذي لا ينقطع في الرقابة على أداء ممثلها في منصة الديموقراطية التمثيلية، واستمرار تقديم الدعم والتوجيه الذي قد يحتاجه للقيام بواجبه الذي اختير من أجله، والتصدر لسحب الصفة التمثيلية عنه، وإعفائه من منصبه في منصة الديموقراطية التمثيلية إن تبدى لها انزياحه عن الالتزامات التي يفترض قيامه بها.
والعمود الثاني في بنيان الديموقراطية التمثيلية مرتبط بشرط وجود عقد اجتماعي واضح في المجتمع يتفق أفراد المجتمع المتشاركون فيه على أنه النموذج الأصلح لضمان تعايشهم المشترك، وتنظيم وقوننة ذلك التعايش بشكل يخفف إلى الحد الأدنى إمكانيات تغول فئة على أخرى على أي من المستويات المادية أو المعنوية بمختلف تجلياتها، وهو ما يفصح عن نفسه بشكل عياني مشخص من خلال دستور واضح المعالم في المجتمع ينبثق عنه سلطة قضائية مستقلة تنظم شؤون المواطنين،وتحكم بالعدل بينهم دون أن تكون خاضعة لأي اشتراطات أو محددات لعملها تخالف جوهر العقد الاجتماعي معبراً عن نفسه دستورياً.
والمرتكز الثالث في تكوين الديموقراطية التمثيلية الذي لا غنى عنه، والذي يرتبط بشكل عضوي وجذري باشتراطات توطد بنى ومؤسسات المجتمع المدني في المجتمع، وإمكانية عيوشيتها بشكل فاعل قادر على التآثر والتأثير في نسق اجتهاد المجتمع لتحسين ظروف حياة أفراده ورفاهم وإحساسهم بقيمة وجودهم المعنوية كأفراد في ذلك المجتمع. وههنا تبرر حرية التعبير ممثلة في صحافة حرة تمثل مميز المجتمع المدني الحر القادر على تحقيق رؤية فكرية تحليلية يجتهد فيها عديد من الأشخاص القادرين على الاستقصاء والتحليل والتنظير وإيجاد مكامن العيوب والنواقص والعوار في الشبكات والنظم الاجتماعية التي ينتسبون إليها، بالتوازي مع تمويل عملهم وجهودهم بشكل تشاركي على نفقة المجتمع المدني سواء من خلال التبرعات أو المال العام والجبايات الضريبية العامة، لكون عملهم يمثل خدمة عمومية لا بد منها لصلاح ورفاهية أي مجتمع، كما هو الحال بالنسبة اشتراطات تقديم الرعاية الصحية والتعليم الوافي على نفقة المجتمع إذا كان يراد لذلك المجتمع الحفاظ على أبنائه وحيواتهم وقدرتهم على العمل والعطاء فيه، وإعادة إنتاجه بصورة أفضل تقوم بترقية نفسها بجهود الأفراد المتشاركين فيه.
والعنصر الرابع في مربع المرتكزات الواجبة التوفر لتحقيق أي نجاح لمفهوم الديموقراطية التمثيلية، يفصح عن نفسه بمأسسة الوعي والمعرفة والاستنارة والرشاد في المجتمع بشكل يتجاوز حالة المعرفة المحدودة النمطية المرتبطة بنتاج التعليم في المدارس بكل مستوياتها وحتى الجامعات، ليصل إلى درجة اتفاق المجتمع ككل على إعلاء أهمية الثقافة و تأصيل شغف المعرفة كجزأين جوهريين من متطلبات ترقي المجتمع نفسه في السلم الحضري، والانتقال به من حيز الصراعات الداخلية فيه المرتبطة باختلاف رؤى مواطنيه حول هوياتهم الضيقة، سواء كانت دينية أو مذهبية أو قبلية أو مناطقية أو حتى طبقية إلى اعتبار تلك الاختلافات حقاً طبيعياً لكل إنسان، دون أن يعني ذلك بأي شكل كان الإقلال من الأهمية الجوهرية للبحث عن نقاط الاتفاق التي يشترك فيها كل المواطنين، والمتعلقة بطموحهم الفطري لحياة آمنة كريمة تتيح لهم الانعتاق من كوابيس المرض والجوع والتشرد، وليس من طريق لتحقيق ذلك سوى اتفاق المجتمع كوحدة جامعة من خلال اتفاق أفراده ومؤسسات المجتمع المدني التي ينضوون فيها على أن الاستنارة والرشاد هما الوسيلتان الوحيدتان لإيجاد نقاط الاتفاق تلك، وتَكَشُّف الأدوات الملائمة التي يتراضون جمعياً حول كفاءتها في تحقيق ذلك، دون اضطرارهم لتذويب أو إخفاء أي هويات شخصية أو جمعية أو رؤى عقيدية يقتنعون بها، ثم إيجاد حل لدرء تشويشها على نقاط الاتفاق الجمعية التي تمثل الأهداف المشتركة الأساسية التي لا بد من المجتمع تحقيقها لضمان استمراريته كمجتمع دون انزلاقه إلى أن يكون تجمعاً لقطيع من الأفراد الذين لا يربطهم فيما بينهم سوى تواجدهم في نفس المكان والزمان. وتحقق تلك الدعائم الأربعة بشكل قائم بالفعل شرط تأسيسي لا يمكن الاستغناء عن أي من أركانه لأجل نجاح نهج الديموقراطية التمثيلية سواء في عالم صناعي متقدم أو في عالم مفقر نامٍ.
وفيما يتعلق بالمحور الأول المرتبط بتأصل المجتمع المدني ومؤسساته في المجتمع لا يغيب على أي مراقب مدقق تآكل كل بنى المجتمع المدني في العالم الغربي جراء الهجمة الشعواء لرواد الليبرالية المتوحشة التي بدأت في العالم الغربي مع حقبتي مارغريت تاتشر في بريطانيا ورونالد ريغان في الولايات المتحدة في ثمانينات القرن المنصرم، والتي تمحورت حول الشعار السياسي الإيدلوجي للمجتمعات الصناعية الذي أعلنته تاتشر نفسها والذي منطوقه الحرفي «لا وجود لأي شيء اسمه مجتمع وإنما فقط لأفراد»، وهم «الأفراد» الذين تم تحويلهم إلى أعضاء في «قطعان المستهلكين» الشكل الأسمى للمواطنين المسالمين المستسلمين لإرادات ساستهم الملهمين والمنشغلين فقط في اللهاث الذي لا ينقطع لتلبية نزوعاتهم الاستهلاكية التي تم تخليقها بقوة الإعلام والإبهار لخلق حاجات جديدة مستجدة على البشر أنفسهم، صاروا يعتبرونها بعد حين جزءاً محورياً من حيواتهم التي لا يمكن أن تستقيم دونها -كما هو الحال في الهواتف الجوالة كمثال مبسط -على الرغم من عيشهم دهوراً قبل أن تكون موجودة بين أياديهم. ونموذج تآكل المجتمع المدني في الغرب يفصح عن نفسه بشكل صارخ من خلال تراجع حجم وقوة تأثير النقابات والاتحادات الحرفية في حقبة الليبرالية المتوحشة بشكلها العولمي المعاصر، وتراجع أعداد المنتسبين لها، وتآكل الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، حتى لم تعد تجد فعلياً أي صحيفة لها عديد فعلي من القراء تتبع بشكل مباشر بنقابة أو اتحاد مهني. والحال لا يختلف كثيراً في التمظهرات الأخرى لمؤسسات المجتمع المدني من قبيل المنظمات والجمعيات التطوعية الخيرية التي تكاد تصبح هشيماً كما هو الحال في الحطام الذي آلت إليه بنى المجتمعات المدنية في الغرب جراء القصف المهول الذي تعرضت ولا زالت تتعرض له في سياق مفاعيل هيمنة الليبرالية العولمية المتوحشة. وعلى صعيد العالم العربي قد يكون من المستحيل تلمس أي شكل، حتى لو كان جنينياً، لأي ما قد يرقى لأن يكون هيكلاً عظمياً لمجتمع مدني قد يقيض له في قابل الأيام إعادة إحياء نفسه، بعد أن تغولت عليه مفاعيل الدولة الأمنية والاستبداد وأكلته لحماً وتلمظت بعظامه التي أصبحت كأنها هباء منثور مضيع بين السراديب القمعية وهراوات الجلادين، وعيون البصاصين، ومخالب وأنياب العسس، وأقرانهم المنمقين من وعاظ السلاطين.
وعلى مستوى العقد الاجتماعي غربياً في العالم المتقدم، فإن هناك تآكلاً غير مسبوق لذلك العقد ومفاعيله، جراء تصنيع و تصعيد الفئات الحاكمة الفعلية في المجتمع ممثلة بشركات تلك المجتمعات العابرة للقارات لنماذج من السياسيين الخلبيين الذين هم في أحسن الأحوال «أبواق متحذلقة للدعاية السوداء»، والذين لم يكن لهم من طريق للصعود إلى سدة الحكم سوى إذكاء نوع من الخطاب الشعبوي المهول، الذي لا يختلف في جوهره وآليات صياغته عن نماذج الخطابات الشعبوية الفاشية التي كان يدلي بها موسوليني إبان الحرب العالمية الثانية؛ وهو الخطاب الشعبوي نفسه الذي مكن أولئك الساسة من تجاهل اشتراطات العقد الاجتماعي، المعبر عن نفسه دستورياً في غير مرة وموضع من الخارطة السياسية الغربية، بشكل ما فتئ يتزايد في حدته وأمده الزمني ومساحة فعله، حتى أصبح من السهل على أي من أولئك الساسة التبجح بإعلان حالة الطوارئ هنا وهنا، وتعليق كل الحريات الأساسية والحقوق القانونية للأفراد التي تشكل جزءاً جوهرياً من هيكل العقد الاجتماعي الذي لا يستقيم وجودياً دونها، ولأسباب واهية لما تكن تقنع أي مواطن في سالف الأيام، وأصبحت مسلمة في الواقع الراهن بعد تعملق الخطاب الشعبوي المستند على إذكاء النزعات الهمجية البدائية في المجتمع، كالرهاب الجمعي من بعبع الإرهاب الذي يترقب افتراس الأخضر واليابس في كل زاوية وحين، والرعب من طوفان الغزاة المهاجرين القادمين ليجتاحوا حواري وأزقة العالم المتقدم بأجسادهم المدنفة وثيابهم الرثة وأرواحهم المنهكة بعد أن لم تترك لهم مفاعيل الليبرالية العولمية المتوحشة، ونواطيرها من الطغاة في العالم المنهوب المفقر سوى البحث عن سبيل للحياة في غير أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم. وعلى المستوى العربي فإن حالة الطوارئ السرمدية أصبحت الحال الطبيعية التي تعايش معها المواطنون المظلومون، والتي تعبر ببساطة على عقم أي دساتير عربية لا قيمة لها في الحقل المجتمعي تزيد عن قيمة الورق والحبر المستخدمين في اجتراحها كجزء ضروري من تزويق الاستبداد بدساتير خلبية لا تغني ولا تسمن الفقراء المهمشين في كل من أرجاء العالم العربي المضنى.
وفي ميدان حرية التعبير والصحافة الحرة، فإن هناك تآكلاً كونياً لتلك الحريات التي لا زالت مضمونة من الناحية النظرية واللفظية فقط في العالم الغربي، حيث أن المؤسسات الإعلامية العولمية المتسيدة، ممثلة بالصحف العالمية الكبرى، ووكالات الأنباء الرئيسية، ووسائل الإعلام المرئي الأساسية، جميعها إما مملوك من الشركات العولمية العابرة للقارات الحاكم الفعلي في العالم الغربي، أو معتمد في عيوشيته على الإعلانات التي تغدقها تلك الشركات نفسها، ودونها يستحيل استمرار تلك المؤسسة وقدرتها على المنافسة في واقع اقتصاد السوق المتوحش الذي لم يبقي إلا القليل من المؤسسات الإعلامية العمومية، و التي تحصل على تمويلها من دافعي الضرائب في الغرب. وهو ما يعني أن حرية التعبير متاحة من الناحية النظرية فقط في العالم الغربي، حيث أن أي رأي يخالف مصالح تلك الشركات العولمية العابرة للقارات لن يستطيع النفوذ من شقوق الغربالات التحريرية المتطبقة في تلك المؤسسات، التي تدرك بشكل عميق اشتراطات لعبة «الإعلام الحر» في العالم الغربي، ولا ترغب بإقلاقها حفاظاً على مورد رزقها كحد أدنى، أو لأن الدعة والاستسلام خيار أسهل من المواجهة الدون كيشوتية لأي صحفي حر يرغب بتجريب عضلات عقله وقلمه الحر لاختراق تلك الغربالات الوظيفية، والتي في غالب الأحيان تنتهي بلفظه إلى فئة العاطلين عن العمل، وهم كثر في العالم الغربي.
وعربياً فإن الحديث عن حرية التعبير والصحافة الحرة، ضرب من الغرائبية الخيالية الحالمة التي لا ترتبط بالواقع بأي خيط مهما كان واهياً، إذ أن جل الوسائل الإعلامية بأشكالها المختلفة منخرط بشكل عضوي في شبكة الإفساد والإفساد التي تمثل الهيكل الأساسي لمنظومة الدول الأمنية العربية، وكثير منها إدارته منتدبة من الأجهزة الأمنية المسيطرة، أو يعود لها في كل صغيرة وكبيرة لنظم خطاه وهديه إلى سواء السبيل ومصلحة الوطن الحطام. و لا بد في سياق توصيف هشيم حرية التعبير الموؤودة كليانياً في العالم العربي تذكر الأعداد المهولة من الصحفيين والمفكرين والكُتَّاب المغيبين في غياهب السجون الأمنية، والذين لم يعد يعرف عنهم أحد شيئاً، بعد محاكمتهم، إن حصلوا على أي محاكمة في سالف الأيام، في محاكم استثنائية وعسكرية في غالب الأحيان، وبتهم لا تفترق عن التهم التي كانت تقذفها محاكم التفتيش في العصور الظلامية في أوربا، من قبيل النيل من هيبة الدولة، وشتم رأس الدولة، ومقاومة النظام الاشتراكي، وإقلاق السلم الأهلي، وإضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني، والاستقواء بالخارج، والتخابر مع جهات أجنبية؛ وكأن كل الفاسدين المفسدين في العالم العربي ليسوا عملاء ونواطير لأولياء أمرهم «الأغراب الأجانب» عن مجتمعاتهم التي يستبيحونها نهباً ونخراً عمقاً وسطحاً وعمودياً وأفقياً وبكرةً وعشياً، وكيفما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
أما الحديث عن تأصيل الوعي المنفتح الحر والاستنارة والرشاد في المجتمع، يصطدم في الواقع الغربي العياني المشخص، بذلك التهميش والتسطيح المتعمد للإنسان خلال مروره بكل المراحل التعليمية، وفي كل الأنشطة المجتمعية التي يوفرها المجتمع له، وهو ناتج للجهد المنظم الذي قامت به الفئات المهيمنة في المجتمع ممثلة بالشركات العولمية العابرة للقارات وكوادرها، منذ مرحلة ما قبل تحولها إلى شكلها السرطاني العولمي الراهن في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى اللحظة الراهنة، في تحويل العملية التعليمية إلى نموذج للتنميط العقائدي، ووأد الرغبة في الاستكشاف، وخفض سقف الطموح العلمي، للغالبية العظمى من أفراد «طوفان الفئات الشعبية المسحوقة» التي يكفيها نموذج من التعليم المختزل الكافي لتوفير الأدوات الأساسية لها للعمل كعمال على شكل مسامير وعزقات ضرورية في آلة الإنتاج الغربي، مع ترك فسحة التعليم الحقيقي، وتأهيل مهارات الاستكشاف والعقل الحر المجتهد لاكتشاف المعرفة واستنتاج الخلاصات بنفسه بدل أن يتم تقديمها جاهزة له لاستشرابها دون التفكر بها، لأبناء علية القوم، الذين ينضوي جلهم في عداد أهل الحل والعقد، وأصحاب مفاتيح صناعة السياسات في كوادر الشركات العابرة للقارات الحاكم الفعلي في تلك المجتمعات، ومن انضوى تحت أجنحتها من كوادر وظيفية لا بد منها لتحقيق سياساتها من فئة النخب القادرة على القيام بذلك من قبيل الساسة المصطفين، والإعلاميين الرواد بقوة التكرار والتسويق المستمر، وسواهم من سدنة نظام الهيمنة المزوق بهيكل ديموقراطي تمثيلي شكلي، وهم الوحيدون المؤهلون للقبول في مؤسسات التعليم الخاصة النخبوية التي تدير أنظمتها الانتقائية المخاتلة تحت يافطات متعددة لا تغير من جوهرها الوظيفي شيئاً، والتي لا تتيح في المآل الأخير لأبناء «جماهير المفقرين المنهوبين» التسرب منها، والذين يكفيهم ما تقدمه المؤسسات التعليمية النمطية العمومية، التي لا زالت ممولة «بالقطارة» من أموال دافعي الضرائب الذين جلهم من عديد أولئك المفقرين المنهوبين أنفسهم.
وحتى على صعيد إمكانيات الانخراط في ما قد يدعى «مدرسة الحياة» لأولئك الذين لم تحالفهم الشروط الموضوعية لوجودهم الاجتماعي للحصول على مستوى ملائم من التعليم والاستنارة والرشاد والعقلانية التي يفترض كونها أجزاء محورية من أهداف أي عملية تعليمية ذات جدوى على المستوى الإنساني الفردي والمجتمعي، فإن ذلك يبدو شبه مستحيل وفق محددات اقتصاد السوق والليبرالية المتوحشة في اقتصادات العالم الغربي، حيث أن كل ما قد يرتبط ويحتمل أن يصبح «مدرسة للحياة» من قبيل النوادي الفكرية، والملتقيات الثقافية، والجمعيات التنويرية، أسوة بتلك التي تواجدت في العالم الغربي إبان عصر الأنوار فيه، أصبحت كيانات مهددة بالانقراض وفق نهج «الداروينية الاجتماعية» التي يفترضها اقتصاد السوق الوحشي الذي البقاء فيه حصراً للكيانات الأكثر ربحية وقدرة على التكيف مع اشتراطات أن أي عمل لا يقدم مردوداً مادياً من البنى التحتية التي يستثمرها من قبيل المكان والكوادر البشرية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها للبقاء، يتجاوز الحد الوسطي المتوقع منه وفق قوانين اقتصاد السوق، سوف يصبح عاجزاً عن البقاء لعلة طرده من المكان الذي يقيم فيه، وانصراف الكوادر التي يشغلها عنه، وعدم تطوع أي جهة لتقديم أي خدمة مجانية له، حيث أن القيمة المعنوية لأي عمل تطوعي تتضاءل إلى درجة تقارب الصفر المطلق في نسق اقتصاد السوق المتوحش والبشر اللاهثين للحفاظ على بقائهم من الاندثار وفق مفاعيله. وذلك الواقع المحزن تعزز في العقدين الأخيرين في سياق تراجع قيمة ناتج أي ما قد تستطيع تقديمه المؤسسات المنضوية تحت مظلة «مدارس الحياة»، حيث أن ثورة الاتصالات قدمت بديلاً لذلك من خلال المعلم «غوغل»، ومن كان على شاكلته الذي يقدم المعارف ويعلِّم كل راغب بالمعرفة بشكل يتلاءم مع ميوله وأهدافه التي قام بتحليلها عبر التجسس المنظم على كل خصوصيات ذلك الشخص، بغض النظر عن مصداقية أو فائدة أو عقلانية أو صلاحية تلك المعرفة التي يقدمها ذاك «المعلم الخلبي و الخبيث في آن معاً»، والتي قد تكون في كثير من الأحيان عبارة عن ما يسميه الخبراء «مقالاً إعلانياً» يهدف إلى تسويق منتج أو فكرة ما بغض النظر عن صحة ما ينطوي في تلافيفه من معارف، وبحيث يتم تحويل الإنسان في نهاية المطاف إلى نموذج من الإنسان الاستهلاكي المنفعل والفرداني المغيب عن المعرفة الحقة، والغارق في لج من المعارف المزيفة التي يراد له الظن بصحتها.
وعلى المستوى العربي فإن مهمة تأصيل الاستنارة والرشاد والعقلانية تبدو مهمة شبه مستحيلة في ضوء انشغال كل أولئك المناط بهم القيام بتلك المهمة سواء في حقل التعليم بمختلف مستوياته، أو حقل إنتاج المعرفة والثقافة والفكر، بالهم الجمعي لكل حبيسي السجون الكبيرة التي يسميها الطغاة أوطاناً بالقوة والعسف، والمشخص في محاولتهم الجاهدة للبقاء على قيد الحياة، وتفادي الآلة الهمجية للفساد والإفساد التي تطحن كل من قد تسول له نفسه محاولة الانعتاق من شروط الإذعان للاستبداد وأدواته التنفيذية مشخصة بمفاعيل الدولة الأمنية و غيلانها على الطريقة العربية.
وبشكل أكثر تشخيصاً فإن المشروع النهضوي العربي مشخصاً باجتهادات المنورين الأوائل في مطلع القرن العشرين من قبيل عبد الرحمن الكواكبي، وشبلي الشميل، وفرح أنطون، ونجيب عازوري، ورفاعة الطهطاوي، وغيرهم، تم وأده بقوة الحديد والنار للمستعمرين، والذي استمر بعد رحيل أولئك الأخيرين، وتركهم للطغاة والمستبدين العرب كنواطير مكلفين بالقيام بشؤون «المفوض السامي» بالنيابة عن أولياء أمرهم المستعمرون نفسهم الذين لم يرحلوا إلا شكلاً عن المجتمعات العربية.
وواقع الاستبداد والفساد والإفساد والهيمنة على كل مفاصل المجتمعات العربية من قبل الطغم المتحكمة بمقاليد أمورها أفرز نموذجاً تعليمياً عقيماً قائماً على نموذج أقرب لتعليم الكتاتيب في عصور النكوص العربي في فترة حكم المماليك والعثمانيين، هدفه الأساسي التنميط العقائدي للفرد، واستشرابه بأن واقع الاستبداد الذي يعيش فيه وأهله وسوف تعيش في كنفه البائس ذريته لاحقاً هو من طبائع الأمور وأحوالها، والذي لا بد من التكيف معه بأي شكل كان سواء عبر الاقتناع به، أو إظهار ذلك تصنعاً أو تَقِيَّة، أو التحول إلى كائن انتهازي منخرط في جوقة الفساد والإفساد كوسيلة شبه وحيدة لتعزيز فرص البقاء في مطحنة المجتمعات المنهوبة والمهشمة عمقاً وسطحاً. وعلى شاكلة النسق الذي أدى إلى تآكل احتمالات تكوين «مدارس الحياة» في العالم الغربي، وخاصة في حقبة اقتصاد السوق والليبرالية المتوحشة، فإن كل تلك الاحتمالات لم تجد أي فرص لتحققها بأي شكل حتى لو كان مجهرياً في العالم العربي نظراً لتغول مفاعيل الدولة الأمنية عليها، وإدماجها في بنيانها الوظيفي الذي أفقدها كل قدرة على الفعل التنويري المناط بها لتأصيل العقلانية والرشاد.
وخلاصة القول هي أنه دون توافر وتضافر العناصر الأربعة الضرورية اللازمة لتشكيل أرضية يحتمل بالبناء عليها تحقيق الأهداف النظرية لمفهوم الديموقراطية التمثيلية بالشكل المتعارف عليه راهناً، سوف يكون من الصعب إطلاق حكم تحليلي ذي قيمة على نماذج سياسية أو اجتماعية تعرف نفسها بأنها النموذج الأكثر صدقية لتلك الديموقراطية التمثيلية، وهي في جوهرها لا ترقى عن كونها نموذجاً مسخاً لديموقراطية شكلية تزويقية جوهرها إخفاء هيمنة فئة على فئة اجتماعية أخرى، واستئثارها بالثروة والمعرفة والقدرة على صناعة القمع وممارسة العنف الممنهج في تلك المجتمعات لضمان دوام تلك الهيمنة التي لا تتصل بأي ديموقراطية حقيقية تقترب من مفهوم الديموقراطية بكونه «حكم الشعب».
مصعب قاسم عزاوي