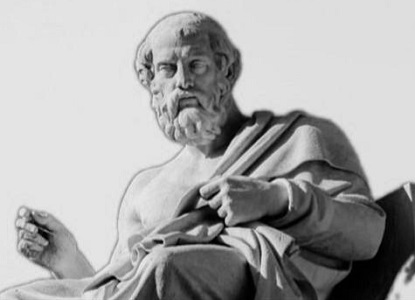صحيفة المثقف
مجدي إبراهيم: مجدي إبراهيم الذوق.. وعاطفة القرآن
 ذُقْ مَذَاقَ الآية.. ثم انظر.. ماذا عَسَاَكَ بالذوق ترى؟ للذوق صلة بالعاطفة التي ينشئها القرآن في قلب القارئ الحاضر دوماً مع الله، وله أوصَاله الباقية في منبع الشعور، وأنسابه الدائمة في منبت الوجدان. وبما أن الأذواق مواجيد صارخة في الشعور الإنساني كافية وراقية، صار الخطاب الإلهي يُذاق أولاً فيتحرّك بمذاقه الشعور، فيتولّد عن الشعور الفكر والعقل والفهم والتّدبُّر. والأصل في ذلك: قوةٌ في الشعور وحساسيةٌ في الوجدان ومذاقٌ باطن في أعمق طوايا الضمير.
ذُقْ مَذَاقَ الآية.. ثم انظر.. ماذا عَسَاَكَ بالذوق ترى؟ للذوق صلة بالعاطفة التي ينشئها القرآن في قلب القارئ الحاضر دوماً مع الله، وله أوصَاله الباقية في منبع الشعور، وأنسابه الدائمة في منبت الوجدان. وبما أن الأذواق مواجيد صارخة في الشعور الإنساني كافية وراقية، صار الخطاب الإلهي يُذاق أولاً فيتحرّك بمذاقه الشعور، فيتولّد عن الشعور الفكر والعقل والفهم والتّدبُّر. والأصل في ذلك: قوةٌ في الشعور وحساسيةٌ في الوجدان ومذاقٌ باطن في أعمق طوايا الضمير.
ليت شعري .. ماذا عَسَانَا كنّا فاعلين فيما لو حرمتنا الأقدار نعمة التذوق في آي القرآن؟
من آراء الإمام محمد عبده - عليه رحمة الله - المأثورة في الدلالة على عمق الشعور باعتباره الأصل الأصيل لتفريعات الفكر والعاطفة؛ أن العاطفة هى المصدر الذي ينبثق عنه قوة الوجدان. وعن قوة الوجدان يصدُر التعقل والتأثر والفهم والتدبُّر كأصول أصيلة لفهم القرآن. وهذا الرأي كان تحدّث عنه الدكتور محمد إقبال (1877م - 1938م) أيضاً، فجعل من منبت الشعور قوة خلاقة مبدعة متميزة خالصة، يقوم عليها الفكر ويعتمد اعتماداً كلياً على أسسها ومقوماتها، وليست هى بالقوة السطحيّة السلبيّة العارضة (تجديد التفكير الديني في الإسلام، وترجمة عباس محمود، ومراجعة عبد العزيز المراغي، ومهدي علام، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط2 القاهرة 1968م؛ ص 30).
ليست العاطفة بالشيء الهيّن اليسير، ولكنها وقود الحركة لكل جميل في الإنسان وهى مصدر الذوق بغير جدال. وإذا كان الفكر يستند عليها ويعتمد؛ فليس ثمّة شيء أعلى منها ولا أرفع في الشعور بقيم الجلال والجمال.
قادت العاطفة القرآنية اللغة إلى مساق لم يعرفه العرب من قبل، وطبعت ألسنتهم بطابعه سواء من جهة البيان أو من جهة الشعور الديني. ولم تكن العاطفة الدينية بالشيء اليسير الهين في هذا كله يجئ عرضاً في غير تحقيق؛ بل كانت في البدء والمنتهى خاصّة ذاتية للقرآن ينشؤها في قلوب العاكفين، وينبتها نباتاً حسناً في أفئدة الذاكرين، ولا يزال يترقى بها مع التبتل في مدارج العرفان إلى أن تصبح ذاتية خاصّة يعول عليها ولا يعول على سواها من جهة الذوق والإحساس والترقي المعرفي.
على أن اللغة العربية، إعراباً وبلاغة، كانت ملكة راسخة في نفوس العرب في الجزيرة العربية، فلمّا جاء القرآن وأخرجهم من هذه الجزيرة إلى هذا الملك العظيم، واختلطوا بالأعاجم وعاشوا عيشة مدنية وحضارة، ضعفت هذه الملكة ثم فسدت وصارت اللغة تكتسب بالتعلم والتعليم. والعرب أمة أكثرها ضارب في الصحراء، لم يتحضر منها إلا القليل، فلا جَرَمَ كان في لغتهم الخشن الجاف والحوشي الغريب، ولعلّ من يقرأ الأدب الجاهلي ويتدبّره، يزداد يقيناً بما للحضارة من أثر في ألفاظ اللغة (الباقوري: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية؛ ومقدّمة طه حسين: ص 54). والقرآن الكريم فضلاً عن أنه نقل العرب من جفاء البداوة وخشونتها إلى لين الحضارة فنزلوا عن حوشيتهم، وتوخّوا العذوبة في ألفاظهم؛ قد تخير لألفاظه أجمل ما تخف به نطقاً في الألسن وقرعاً للأسماع (ولقد يسَّرْنَا القرآنَ للذِّكر) حتى كأنها الماء سلاسة، والنسيم رقة، والعسل حلاوة، وهو من بعدُ بالمكان الأسمى الذي أدهشهم وحير ألبابهم، وأفهمهم أن البلاغة (عمل روحي ووجد عاطفي)؛ شيءٌ آخر وراء التنقيب والتقعير، وتخير ما يكد الألسن ويرهقها من الألفاظ.
مع ملاحظة أن هنالك ألفاظاً خارجة عن لغة العرب لفتت أنظار العلماء مثل: كلمة "مشكاة" للكوة، و"الناشئة" للقيام من الليل، و"القسورة" للأسد، فإنها من لغة الحبشة، وكلمة "غساق" للبارد المنتن؛ فإنها من لسان الترك، و"القسطاس" للميزان في لغة الروم، و"السِّجِّيل" للحجارة والطين بلسان الفرس، و"الطور" للجبل، و"اليم" للبحر بالسريانية. وبحث العلماء في هذه الألفاظ واختلفوا بصدد البحث فيها، ولكن الراجح من أقوالهم هو أن الأصل في تلك الألفاظ العجمة أنها قد انتقلت إلى العرب من أثر التجاور والاختلاط، فاستعملها العرب بما خففها على ألسنتهم حتى لانت، وجرت عندهم مجرى العربي الأصيل، وعلى هذا نزل بها القرآن، مع أنها كلمات مخالفة في وزنها للأوزان العربية المعروفة ثم هى قليلة الاستعمال عند العرب. ولئن كان الحكم عليها أرجح في كونها غير عربية الأصل إلا أن العرب نقلوها من غيرهم بطريق المجاورة كما تقدّم واستعملوها حتى لانت فأصبحت مما يتكلمون به ويتخاطبون، وهى وإنْ لم تكن من أوضاعهم إلا أنهم هضموها فكانت من نسيج لغتهم الحية (محمود شلتوت: الإسلام .. عقيدة وشريعة، ص 409- 410).
وليس في هذا ما من شأنه أن يقدح في أن القرآن نزل بها، وهو موصوف بأنه عربي مبين، وهم مع ذلك عكفوا عليه يتدبرونه، وجروا إليه يستمعونه، حتى مَنْ بقى منهم على ضلالته لم يستطع أن يخدع نفسه؛ فكان يذهب في غفلة من قومه في جنح الظلام يستمع إلى النبي، صلوات الله وسلامه عليه، يردده ويتهجد به؛ وحتى أشفقوا أن يفتن حسنه نساءهم وبنيهم، فطلبوا إلى أبي بكر الصديق، رضوان الله عليه، أن يكف عن ترتيله بصوت مسموع.
ذلك شأن القوم، والدعوة يومئذ طفلٌ يحبو، فلما خضعت جمهرتهم لحكمه ونزلوا عن رغبته، زادَ حبهم له ورغبتهم فيه؛ فبعد أن كان إعجابهم به وحرصهم عليه، وتقديسهم له، من جهة ما فيه من جمال نظم وحسن أداء وروعة أسلوب، وما إلى ذلك ممّا يتصل بالناحية البيانية التي يهشون بطبعهم لها، ويستريحون بفطرتهم إليها؛ ظاهَر ذلك معنى آخر يعتمد "العاطفة الدينية" بما فيها من قوة وما لها من سلطان.
وهذا وذاك من شأنه أن يحملهم على تدبره والإكثار من تلاوته وحسن الاستماع له والإنصات إليه. أفليس في ذلك ما يحملهم على التهجم للغاتهم ومحاولة السير بها في طريقه، ويطبع ألسنتهم على توخي سهولة الألفاظ وعذوبتها؟ (راجع: أحمد حسن الباقوري: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية؛ ومقدّمة طه حسين: ص 56، 57).
ثم أليس في ذلك كله ما يثبت أمامنا أن العاطفة، بهذا النحو وعلى هذا الوصف، خاصّة ذاتية للقرآن؟
بين العقل والعاطفة:
هذا، وقد أثيرت مسألة المفاضلة بين العقل المنطقي والعاطفة في ثقافتنا العربية، ودرات حولها ردودٌ وحدود بين المفكرين والأدباء من طلائع النهضة العامة إذْ ذاك. وكانت في ردود الأستاذ "العقاد" ( 1989م-1964م) على شاعر العراق "جميل صدقي الزهاوي" (1863م -1936م) سجالات جديرة بالنظر والاعتبار، وكان هذا الأخير علمانيّاً يأخذ بالعقل والعلم ويقصّي العاطفة جانباً.
مالَ "العقاد"، يومها ميلاً جارفاً إلى هذا الرأي الذي يحتكم فيه صاحبه إلى قوة الشعور، فيؤمن بالعاطفة والوجدان قبل إيمانه بالبحث والتفكير، أو يجعل من الشعور مصدراً لكل بحث ولكل تفكير، لكأنما كانت غزارة العاطفة وقوة الوجدان أشياءً علويّة مُلهمة لكل تفكير صائب ولكل بحث أمين.
ولم يكن هذا الرأي غريباً ولا هو بالرأي الذي يقصر عن الإحاطة بمصدر الإحساس الحيوي في الإنسان على التعميم، لأنه يستهدف التوسعة من نصيب الإنسان منه، وليس هو بالنصيب القليل.
ومن رأيه: أنّ الشاعر صاحب خيال وعاطفة. والفيلسوف صاحب بديهة وبصيرة وحسابٌ مع المجهول. والعالم صاحب منطق وتحليل وحساب مع هذه الأشياء التي يحسُّها ويدركها أو يمكن أن تحسّ وتدرك بالعيان أو ما يُشبه العيان؛ وذلك في معرض التفرقة الفارقة بين الملكة العلميّة والملكة الشعريّة، وبين بديهة الفيلسوف وبديهة العالم.
وعنده: أن "الزهاوي" صاحب ملكة منطقية لا حجاب عليها، وآراؤه في مواطن التحليل والتعليل ملموسة، ولكنك تضل فيها الخيال كثيراً والعاطفة أحياناً، وتلتفت إلى البديهة، فإذا هى محدودة في أعماقها وأعاليها بسدود الحسّ والمنطق لا تخلي لها مطالع الأفق ولا مسارب الأغوار(يراجع: ساعات بين الكتب، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى 1404ه - 1984م، والمقالة نشرت في 28 أكتوبر 1927م بعنوان "العقل والعاطفة"، وجمعت ضمن ما جمع في كتابه النقدي الضخم "ساعات بين الكتب"؛ ص 365- 372).
من ذلك ترى؛ أن رأي "العقاد" وإنْ كان منصفاً للعاطفة لم يكن يجنح إلى الصرامة المنطقيّة التي يراها تقف حجرة عثرة أمام العاطفة والخيال والبديهة وهي بلا شك ملكات عليا ليست بالدنيا، ولن تكون. وفي ردود "العقاد" على "الزهاوي"، تغليبٌ ـ كما قلنا ـ للعاطفة على العقل والمنطق العقلي. لقد كانت أحلام العواطف دوماً ممّا يؤجج الرغبة ويُلهب الخيال، فجاء العقل كالخادم الأجير يُحقق ما تعلقت به الأخيلة واتجهت إليه الرغبات. ولا ريب في أن الحواس تتفاضل بقدر ما فيها من الشعور والاستمداد من باطن النفس لا من ظواهر الأشياء، وأن الحواس بلا ريب كذلك تستمد شعورها من القوة الحيّة التي خلقتها ونوّعتها وهى قادرة على تغيير الخلق والتنويع.
في هذه الردود تشديدٌ قويٌ على منبت الشعور كونه أساس العواطف ومصدر الأفكار وهو معتمد العقول الكبيرة بغير جدال. ومناسبة العاطفة للمنطق أنها هى شيء موجود لا يصحُّ للمنطق إلا إذا حسب له حسابه، فأي منطق يحق له أن يقول عن عمل من أعمال الناس ينبغي أن يكون هكذا أو لا ينبغي أن يكون كذلك إنْ لم يكن يحسُّ العاطفة الإنسانية ويستنكه مضامينها ويقيم لها وزنها؟ إنّ السعادة التي ينشدها الإنسان إنْ لم تكن "عاطفة"، فهى لا شيء، وإنْ لم يكن العلمُ علم إنسان "عاطف" فلا حاجة به لإنسان.
نودُ أن يتأكد هذا في العقول؛ لأننا على مرحلة يجهل فيها الشرقيون ما يعوزهم؛ فيجب أن يعلموا أن الذي يعوزهم هو "الإحساس القويم"، وأن سبيل خلاصهم هو سبيل العاطفة الحيّة والشعور الديني الصادق الجميل. وحيث يغيبُ الإحساس القويم من عاطفة الإنسان تغيب معه إنسانيته فلا يتسامى إليها، ولا يظفر بوسائل التسامي إليها من حيث هجر العواطف أو هجرته العواطف، فأقفرت شعوره وحجّرت مواجيده فنضبت حياته الحيّة على التعميم.
من هنا يصبح للعاطفة دورها الحيوي وغايتها المعرفية كذلك، ولا تخلو مطلقاً ممّا يؤجج الرغبة ويُلهب حماسة الخيال؛ لأنها تكون بمثابة المصدر للفكر تقف وراءه، ولا يخلو فكر منها بوجه من الوجوه، ناهيك عن أنها تعدّ أبرز الوسائل الدافعة إلى العمل بالفكرة العلوية في رحاب القرآن بمقدار ما تظهر أساليب خطابه على حسب مقتضيات أحوال هذا الخطاب المختلفة.
العاطفة الدينية وأساليب القرآن:
على أن العاطفة الدينية في مجملها لم تكن تتعارض مطلقاً مع الإقناع العقلي؛ لأن دورها يتصل بالوجدان الشعوري. ولما جاء القرآن نزل بأسلوب لم يضارعه أسلوب قبله مع أنه جمع بين الأسلوب الخطابي، والأسلوب الأدبي، والأسلوب العلمي المنطقي، وتوخي اعتبارات لا تخضع لحصر من تقديم وتأخير، وتعريف وتنكير، وحذف وإثبات، وفصل ووصل، إلى غير ذلك ممّا يسميه البلاغيون مقتضى الحال. (الباقوري: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية، ومقدمة طه حسين: ص 126) .
وكان أظهر شيء فيه الإقناع بالقضايا العقلية المنطقية، ولفت النظر إلى ملكوت السموات والأرض، والإرشاد إلى النظر والتدبر، وما خلق الله من شيء، لتعرف أسرار الله في كونه، وإبداعه في خلقه، فتمتلئ القلوب إيماناً بعظمته، عن نظر واستدلال لا عن تقليد ومجاراة، وقد نعي القرآن كثيراً على الذين يقلدون الآباء والأجداد في عقائدهم ودينهم، وعاداتهم السيئة، كما أنه فتح للناس بهذا الإرشاد إلى ملكوت السموات والأرض باب البحث في خواص الأجسام فى أرضه، وسمائه، وهوائه، ومائه، لينتفعوا بها في حياتهم ويستخدموها في مقاصد التعمير والإنشاء. وعلى الرغم من الإرشادات المتكررة في هذه الناحية فقد أهمل المسلمون هذا الجانب ولم ينتفعوا بإيحاء القرآن فيه، بينما انتفع به غيرهم ممن غمار خاضوا هذا الكون، وعرفوا أسراره، واستخدموها في نواحي هذه الحياة بعد كانوا في عماية وضلالة (محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة: ص 415).
ثم قص القرآن القصص على أشكال مختلفة للتأمل والاعتبار: في إيجاز طوراً، وإطناب تارة، وتوسط أخرى؛ وضرَبَ الأمثال، وقاسَ الغائب على الشاهد، وكانت فيه معان جديدة وأغراض جديدة، فلا بدّ أن تكون فيه مجازات واستعارات وكنايات لم يعرفها العرب من قبل، ولا بدّ أن يكون ما عرفوه من ذلك قد نظم، وتصرف فيه على وجه آخر غير الذي ألفوه، حتى قويت دهشتهم وازداد تعجبهم من أنهم يرون ألفاظاً هي عين ألفاظهم ثم لا يجدون في أنفسهم من الشجاعة ما يتقدّم بهم إلى معارضته، وقد تحداهم تحدياً صارخاً فعجزوا أمامه عجزاً ذليلاً مستكيناً. كان أسلوب القرآن يشتد عليهم أحياناً فيقرعهم ويملأ قلوبهم رعباً ورهبة، وأحياناً يلين حتى يريهم الماء في سلاسته والنسيم في رقته ولطفه، وأحياناً يهداً ليدع لهم فرصة يتعلمون فيها منه أصول الدين ومكارم الأخلاق.
والذي يتدبّر القرآن الكريم يرى هذه الظواهر الثلاثة ظاهرة في أساليبه؛ فالأسلوب الخطابي مثلاً يظهر في المواضع التي يناظر فيها الجاحدين، والتي يظهر فيها أهوال اليوم الآخر، وما يتصل بذلك مما يستدعي شدة الروعة وقوة التأثير. أما الأسلوب الأدبي فيظهر في هذا القصص الرائع والوصف البديع والإرشاد الرحيم. ويجئ الأسلوب العلمي؛ فيتجلى حيث يُراد شرح الحقائق العلمية والامتنان على العباد وتوجيه نظرهم إلى نعم الله عليهم" (الباقوري: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية، ومقدمة طه حسين: ص 127).
العاطفة والذوق:
ولننظر الآن إلى أقوال الإمام "محمد عبده"، وهو يتكلم في تفسير المفسّرين .. ما هو الشرط الذي يشترطونه ويراعون حضوره؛ ليكون تفسيرهم مقبولاً على منهج التذوق والعاطفة الدينية قبل قبوله على أي منهج كان كيفما اتفق؟
قال الإمام محمد عبده:"... وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم "معنى" تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب ثم يبثونه في الناس ويحملونهم عليه. وأعني "بالفهم" ما يكون (صادراً) عن "ذوق" سليم تصيبه أساليب القرآن بعجائبها، وتملكه مواعظه فتشغله عمّا بين يديه ممّا سواه. لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخذاً جافاً لم يصحبه ذلك "الذوق" وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدان اللذين هما مدار "التعقل" والتأثر والفهم والتدبر..." (محمد عبده: رسالة التوحيد: ص 101- 104).
فهذه الكلمات النابهة هى أعلى ما قرأت من قرائح العقول التي تناولت فهم القرآن. وواضح أن الإمام محمد عبده يتحدّث هنا عن "الفهم" بالطريقة التي حدّد أصولها فيما ينبغي أن تكون صادرة عن ذوق سليم. فالفهم في رأي محمد عبده، وفي رأي كل من يصيب بتوفيق الله من الفهم نصيباً، هو أن يكون صاحبه ذَوّاقة، لا يعتمد على النقل أو التقليد بالتسليم الأعمى لما قيل من قبل في الكتب؛ لأن الكتب دالة مرشدة وكفى، وليست بالتي تصدر الإبداع الذاتي كما يُصدره الذوق الأصيل. وشرط التذوق أن يجيء سليماً مُعَافاً من الكزازة والمُعاظلة. وشرط السلامة أن يكون تعامله مع أساليب القرآن فهماً راقياً مَرَدَّهُ إلى إدراك المعنى المستقر من طريق التذوق:
التذوق لماذا؟ التذوق للقيمة، وللمعنى، وللأسلوب يفرضه التأمل الداخلي لأجواء الآية، ولكشف حكمتها بما عساه يفتح الله به عليه. وإنّ تأملاً يصاحب المتأمل في أجواء الآي الكريم لهو التأمل الذي يقود صاحبه - فيما لو صدق - إلى السّبح الهائل في ملكوت القرآن بمقتضى العاطفة الدينية؛ سبحاً يملك عليه أقطار نفسه، فلا يدع له نظراً فيما سواه.
ولا شرط لمثل هذا التأمل غير شرط الإخلاص، ولا شرط لورود الإخلاص غير مراقبة الله الدائمة في السّر والإعلان. ويوم أن يشعر الطالب لهذا المعنى شعور التفهيم والتذوق إلى حيث يستقر على فهمه "معنى"، وإلى حيث يكون العلم بمعاني الكتاب علماً قويّاً قائماً على الإحساس بسلامة المطلب، وبسلامة الطبيعة الداخلية، وسلامة الضمير الجوَّانيِّ من أمراض العلل والآفات التي تعترض الفاهم أو الباحث حين يريد أن يعتني بالاطلاع على كتب التفسير. يوم أن يشعر الطالب لهذا المعنى ذلك الشعور الذي يصاحبه في الطالب مواهب التذوق وقدراته، وهى مواهب وقدرات تنبع من رقة الشعور ولطف الوجدان، ولا جَرَمَ أن رقة الشعور ولطف الوجدان هما مدار التعقل ومدار التدبُّر ومدار الفهم ومدار التأثر.
أقول؛ يوم أن يشعر الطالب بكل هذا شعور التذوق والتفهيم؛ لهو هو اليوم الذي أصاب من ثمَّ فيه الفهم، وحقق منه نصيباً عالياً، بفضل الله، من أنصبَة اليقين الذي لا يقارنه شك إلا أن يكون الشك الذي يجيء مصاحباً للفقدان.
بقلم: د. مجدي إبراهيم