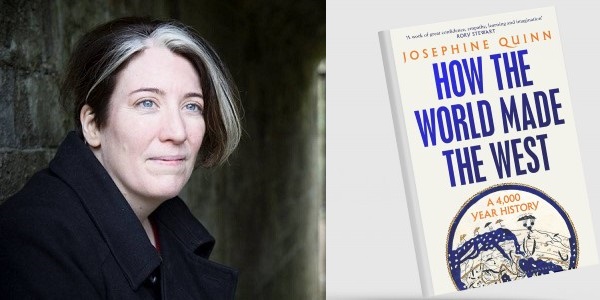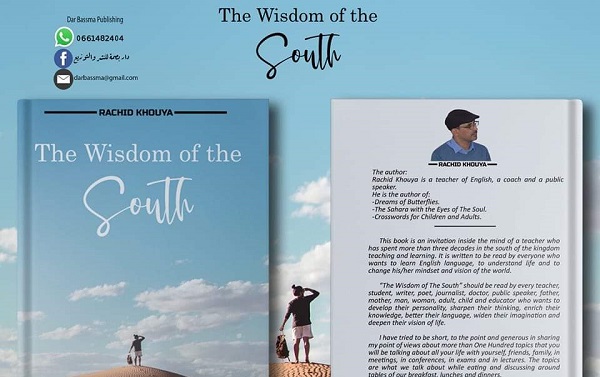صحيفة المثقف
سامي عبد العال: النقـش على الحَجـر (1)
 "أنت في الجنة، أنت تعيش مع الأطفال في عالمهم"
"أنت في الجنة، أنت تعيش مع الأطفال في عالمهم"
"لا يحب اللهَ مَنْ لا يحب طفلاً"
"الحب مُطّهر قوي لمستنقع الطفولة"
تنقل عبارة (النقش على الحجر) معاني الجُمود والقصد نحو (العنف المعرفي cognitive violence) تجاه كيان الأطفال. لأنَّ العبارة المتداولة تقول: " التعليم في الصغرِ مثل النقش على الحجر"، وبناء على ذلك فكّمْ بُنيت أساليب ومفاهيم كثيرة من جنسها حول التربية وطرائق التفكير إزاء الصغار. فالتعليم على ما تجري ممارساته بات – منذ أزمنة عربيةٍ بعيدةٍ – عملية من النقش التي تتمُ بأزميلٍ أو فأسٍ أو عصا لنحت (لحفر وترْك آثار وخدوش وبثور) في عقول هذه الكائنات الغضة. والمعنى الضمني من ثمَّ فحواه: أنَّ الطفل بمثابة (الحجر الأصم) الذي يشكله الفاعلُ المعرفي والتربوي كيفما شَاءَ وفقاً لمحددات الثقافة. وأنَّه لا مهرب له من الخضوع التام لما سيُمليه المجتمعُ عليه ولما سيصطّنعه من قوالب جاهزةٍ له.
وليس بعيداً عن المشهد للدلالة على ذلك من رؤيتنا الواضحة لأطفال الدواعش وهم يتدربون ببراءة على أعمال العنف والقتل لخلق جيل من الإرهابيين الجدد وإلحاقهم بأرض الجهاد والحروب وإلباسهم الأفكار العنيفة المدمرة والمكفِرة للمجتمعات. ومن قبل رأينا مراراً أطفال الإخوان وهم يحملون أكفانّهم فوق أيديهم بترتيب من القيادات الإخوانية كدلالة على اعتناق فكرة التضحية والإستشهاد في سبيل المعتقدات والأفكار الجهادية. وفي هذا الإطار، لم تفلت أي جماعة دينية (بخلاف هؤلاء وأولئك) أطفالها دون تربية على غرار (النقش على الحجر).
ولذلك لا يأخذ أيُ معنى للعبارة الآنفة بالحسبان: أنَّ الطفل بالأساس هو (الكائن الإفتراضي) الآخر بالنسبة للكبار، وأنه دوماً إنسان آخر لم يأت زمانُه بعد، ولا يعدُّ حجراً صلداً ينتظر الرمي في مجاهل الحياة. وحتى ليس هو الكائن الذي نعتبره امتداداً موروثاً لنا، إذ لا توجد ضمانة فعلية لأنْ يخرج أطفالنا كما نخطط لهم وندفع بهم في إتجاه معين. لعلَّ الموضوع برمته يقعُ في منطقة التمنى والرجاء لا أكثر، فجميع ما يُحيط بالطفل من أفكار وأحلامٍ يقول إنه مجرد (كيان متخيل). ويستحيل الإمساك به وتجميده تحت الأصابع لنحت معالم حياته وتوجهاته وإبراز عواطفه مثلما نُريد.
ورغم أنَّ العبارة المذكورة قد تكون خاصة بنمط من التربية الموروثة، لكنها سرعان ما تركت معناها الخاص لدى مشاعيّة الثقافة التي ترسخت تاريخياً حتى غدت ممارسة واسعة الانتشار. وأنَّه من جانب قدرة هذه الثقافة على وضع إمكانية النحت (التعليم) في أيدي كلِّ من هب ودب، فهي تحمل خطورة الاستعمال المجاني لأي (عابر سلطةٍ)، مع العلم بأنَّ الثقافة المعاصرة (ثقافة التقنيات وعالم الافتراض) تعصف بهكذا مقولة تاركة الطفولة للتخييل لا للنحت والقولبة.
الكائن الإفتراضي
يدل مصطلح " الكائن الإفتراضي" على الإنسان الكامن في حقيقة الطفولة، لأنَّ كل طفلٍّ يندرج في محاولات تجريب المعارف وكيفية العيش وممارسة الحياة. أي أن الطفل في جوهره كائن إفتراضي موجود قيد الإنفتاح والتحقُق، لا من خلال المكان فحسب، بل عبر الزمان أيضاً من مرحلة إلى آخرى. إنه انفتاح لإمكانيات الطفل وماهيته بوصفه إنساناً مستقبلياً. وبذلك يصبح الكائن الافتراضي منطوياً على جُل القدرات والأزمنة والأمكنة والأوجه التي يجسدها مع الأيام. وربما لا يخلُّو الأمر من بعض فكرة أرسطو عن(الفعل والقوة) المعبرتين عن الزمن وتحولاته. فالطفل ككائن إنما هو موجود بالفعل مع امكانياته الإنسانية المتاحة، غير أنَّه سينطلق (دون تحديد مسبق) نحو كيانه بالقوة، مشتملاً عليه هذه المرة (بصيغة الجمع لا المُفرد الأرسطي)، ذلك لأنَّه كإنسان يُوضع زمنياً في مفترق طُرق الحياة.
هذا التصور - من وجهة نظري - لا يعني أن الطفل مقيدٌ إلاَّ برحلته من الفعل إلى القُوة مرة أخرى. إنَّ وجود الكائن الإنساني بلغة سارتر يسبق ماهيته، ويظل قادراً على تجاوز ذاتِّه دون نهاية. سيعيش جميع السياقات التاريخية والثقافية من واقع حريته أو هكذا ينبغي أنْ يعيش. ولعلّ فكرة الكائن حين يُعتبر إفتراضياً تعني أنه يحدد مسار حياته كعمليات بديلة كالتي تجري ضمن الذكاء الإصطناعي والمعلوماتية والبيئات والعوالم الافتراضية. أي أنَّ وجوده يتماهى مع فنون وأشكال وأفكار وصور متخيلة يجريها على ذاته خلال التعلم والمعرفة. وفي الحقيقة، تتعامل (دينامية الثقافة) معه بالطريقة الإفتراضية نفسها، إذ تصُوغ نسق التصورات التي ترسم قدراته وقواه بواسطة أجهزتها الفكرية والقيمية وتحركها زمنياً على نحو متخيّل.
إنّه بحكم الخيال والمعاني البديلة، ستخضع مسيرة الطفل للتحقق القائم على الذات. وستظل ذاته في أطوار من التكون والتحول المتواصلين دون توقف. ولا سيما أنَّ الكائن المحتمل داخلنا يجمع بين أفكار التجريب والأداء والتبديل والمحو واللعب والنسيان كحال كائنات العالم الإفتراضي. والطفل يمارس حياته كما لو كان يمارس فنوناً وأدواراً إفتراضية. وتلك الممارسة المفترضة هي الشرط للتعرف على العالم من حوله، وشرط لأنْ يكون كائناً فاعلاً في المستقبل، وبالأسلوب ذاته هي شرط لأنْ يكتسب مهاراته وينسى خبراته وتجاربه الفائتة. ويظهر ذلك جليّاً في مضمار استعمال اللغة (النصوص، الكلام، الكتابة، الرسوم، الرموز، الأيقونات) وبخاصة أنَّها إزاء الطفولة تشكل صور العمليات المفترضة داخل حركة الثقافة. واللغة (على غرار عبارة: النقش على الحجر...) ستخبرنا: كيف تفكر الثقافة وكيف تصوغ أشكال التعبير عن عملياتها سلباً وإبجاباً؟!
الخطاب والخطيئة
دون أدنى مواربةٍ تشكل أفعالُ الثقافة (العادات والتقاليد والطقوس الاجتماعية ...) خطاباً عاماً بين ممارسيها، لكونِّها تعطي الأشياءَ دلالة ورمزاً وعُمقاً. إذ يلتقط الكلام المتداول شفراته الآتية عبر المواقف الإجتماعية. فالخطاب لا يُعلَّق عادة كزْرٍ في سترة بيضاءٍ، لكنه ممارسةٌ لثالوث (الدلالة والرمز والعمق) عبر تداول الأفكار ورؤى الحياة. وتلك الممارسةُ محيرٌة فعلاً باعتبارها لا تنتمي إلى عصرٍ بوقته ولا بمارميه (ولسنا على إدراك تام بحجم الإنتماء)، لكنها ممارسة تاريخية هي الإفراز الثقافي لعصور مختلفةٍ.
وفوق ذلك، تأخذُ كل ممارسة من الصيغ الخطابية (أثناء التواصل) وسيطاً لها. وبذلك تسير هذه الصيغُ الخطابية بأمل تغطية المعتقدات والحقائق والأسرار والأعمال والوقائع. أي تحاول تغطية أشكال الوعي العام، لتعود بصورها اللغوية دالةً وموشّحةً بالإقناعِ بين الناس. وطبعاً يستعملُّها فاعلو الثقافة معارضين أو مثبتين ضمنياً المعاني الناتجة عن ذلك (وما إلتقطته) بواسطة مقولات ونصوصٍ عامة.
في الخطاب المتداول نكشف أنفسنّا في"حالة تَلَّبُس" مع التاريخ وجهاً لوجه. يظهر ما أُسميه التداخل بين إجترار القديم والتطلع نحو الآفاق البعيدة، حيث تنبُت بقايا الجذور الثقافية التي ورثناها من الأسلاف آخذةً فاعليتها نمواً وامتداداً. إذ ذاك تبلور جوانب اللغةُ وقدراتها طاقةَ الزمن على الانفتاح نحو المستقبل، فلا مجالَ يتسرب عبره الزمنُ الآتي أكثر مما يتسرب داخل التعبيرات والألفاظ التي نتكلمها يومياً.
لعلَّ مواقع اللغة في حياتنا مع التراكم الثقافي أشبه بمشاهد لأشعة الشمس حين تخترق كثافة السحب كاشفةً الحركة والتكوين. إنَّ كلمات الزمن (اليوم، الغد، بعد غد..) خلال ثقافتنا العامة هي خميرةٌ نعجنُ بها الوعودَ، ونقرب الآمال لما هو آتٍ. إجمالاً هي نوع من ملامسةَ المجهول، افتراض كائن لم يكن موجوداً. فلا تخلو عبارات التمني والرغبة وأفعال الرجاء والمقاربة، من التعلُق بعالم مغاير. في إطارٍ كهذا، تعدُّ مخاطبةُ الطفلِ (ككائن إفتراضي) بعبارات باليةٍ ارتداداً عن المستقبل بصيغة الماضي التربوي، أي نخاطب مستقبلاً فينا لا نملكُه لكائن صغير هو نفسه تجاوزنا بحكم زمنه الخاص.
وإذا كان بعض الفلاسفة قد اعتبروا أنَّ أفكار الفلسفة تجدي كل الجدوى أحياناً في طمأنة وهدهدة الأطفال مثل جان فرانسو ليوتار وجاك دريدا وسلافوي جيجك، فهل الخطاب حول الطفولة ينبغي بناؤه ناهيك عن قراءته بصيغة فلسفية معينة؟ هل رمزية الطفولة داخل الخيال العربي- لو أُجيز المصطلح- هي رمزية التشوهات في خطاب الثقافة العربية تجاه كيانهم الافتراضي؟ تشوهات يُعاد إفرازها ضمن مفردات الواقع اللغوي والمعرفي والتربوي.
إنها مبدئياً رمزية مثل رمزية الخطيئة إزاء المرأة المدنسة التي قال عنها المسيح: من منكم بلا خطيئةٍ فليتقدم ليرجمها؟! عندئذ بُهتّ الحاضرون تماماً، لم يتقدم أحدٌ، فجاء الموقف اعترافاً ضمنياً بالخطيئة التي يتقاسمها الجميع. وكذلك لم ينطق أحدٌ من الحاضرين، لأنه إبتداءً لم يكن أحدٌ من البشر بلا خطيئةٍ. لقد أراد المسيحُ أن يوقظ الوعي بأساس الفعل قبل أن يزجر المُقْدِم عن إنزال العقاب بالمرأة. الدلالة أنَّ العقابَ عقابٌ سيطالُ المعاقِّبَ (الفاعلَ) والمعاقَّبَ (المفعول به). كأنَّ الإثنين(الفاعل والضحية)، أي الفردين شيء واحد. حقاً الاثنان هما شخص واحد بمنطق الخطيئة الدائري إنسانياً. المثال مهم (قرائياً) لطرح موضوعنا حول الطفولة، ومن ثمَّ سنرى حالاً معناه في إطار مفاهيم الكائن الإفتراضي.
فأنت إنسانياً سترجم أنت (نفسك) حين ترجم أخاك، وأنت ستعاقب أنت (نفسك) عندما تعاقب أخاك، وأنت ستقتل أنت (نفسك) حين تقتل أخاك. وهكذا لو أجازَ المسيحُ لأحدٍ برجم المرأةَ لضاع أصلُ المشكلةِ. الأصل أننا – كإنسان عامٍ- نتهرب من خطيئتنا بمقارعة الآخرين، ونُمعِن في إنزال العقاب بهم دون إدرّاكٍ لبُرهةٍ أننا في الموقف نفسه، بل نحتاجُ إلى التطهُر ذاته. الطريق هو الطريق الواحد كما أن الإنسان لهو الإنسان ذاته لا غير، كلُّ ما في الأمر أنَّ للطريقِ طرفين(الجريمة والعقاب)، قد يظنُ السائرُ خلالَّه بلا وعي كونه طريقين منفصلين، ولكن ليس ذلك صحيحاً على الإطلاق.
حينما قال المسيح: ليتقدم هذا الذي بلا خطيئة لم ينطق إنسانٌ، أي لم ينطق (الإنسان) بألف ولام التعريفِ: هكذا لم ينطق هذا" الإنسانُ " الموروث بخطاياه داخل جميع الحاضرين. إلتقى طرفا الطريق والمسيح ورعاياه لدي إدراك جوهر الفعل البشري الغارق في الخطيئة. وعليه لم يكن منطقياً أنْ يتولى فردٌ من البشر تطبيقَ عقابِ الرجم قياساً على ضرورة ما كان ينبغي لآخر من البشر أيضاً القيام بالجريمة. لذلك سيحتفظ الإلهُ لنفسه دون العباد في تاريخ جميع الأديان بالعقاب والثوابت.
أمَّا في المجتمع العربي، فخطايا طُفولتنا الموروثة نرجِم بها أطفالَّنا القادمين إلى الحياة، وكأننا نعاقبهم بما افتقدناه في ماضينا، بينما نحن في الحقيقة نعاقِّب أنفسنا، نقمع المستقبل وهو لاحقاً كفيل بإظهار الأثر العقابي على الحياة كلها. مازلنا نحمل أصول الثقافة العربية حين نستعملها عبر الخطاب التربوي، الأخلاقي القمعي، فتاريخ تلك الثقافة أولّى بالفهم والتحليل حتى يتغير في هذا الشأن الفعلَّ وردَّ الفعلِ، تماماً كما حاول المسيح أن يرمِّي إلى تغيير الإنسان كإنسان لتتغير الجريمة والعقاب. وعلى خلفية التحولات السياسية والاجتماعية، ومع إهدار مثل هذا الفهم للطفولة، الجميعُ سيحاكم الجميعَ، الصغار حيث يحملُون عالماً آخر ولا يجدونه، والكبار حيث يسلبون حياة أطفالهم في غياب إدراكهم للمستقبل. وإذ نتحدثُ إليهم وعنهم، فلا أمرَ أهم من الإلتفات إلى نتاج اللغة: تربيةً، تواصُلاً، معرفةً، فكراً، خطاباً.
السؤال الراهن، وأتصور أنه سيظل راهناً: ما معنى أن نحطم فهماً تقليدياً تجاه قضية الطفولة أو الكائن الافتراضي؟ كيف سنُحدِّث في أعماق الثقافة صاعقةً وجودية لنستفيق تاريخياً؟ هنا أُلفت الإنتباه إلى الأزمة التأسيسة في خطابات الثقافة العربية وأفعالها بصدد الطفولة، وأُشير إلى إمكانيات اللغة كوسيلةٍ لرسم عالم الطفل، العالم الإفتراضي، بإعتبار أنَّ اللغة بالنسبة إليه أولُّ الألعاب وأولُّ الحقائق. هي أولُّ الألعاب لأنَّها " الرحم الثقافي" الذي يحتضن الطفلَّ حيث سيدرك صورتَّه ويتلهى بها، فما إن يردّد كلمتي" بابا وماما" حتى تفتحان مجالاً لتكوين ذاته.
واللغة أولى الحقائق في الحياة، لكونها المرآة التي يرى الطفل فيها هويةَ محيطهِ الكبير. ليس هذا، فحسب بل ستبقى اللغة " تُبرمج " مخيلته ومشاعره ثقافياً بمعانٍ تطرحها للأشياء. آنئذ ليس أعظم ضرورة من ابتكار لغة جديدةٍ، بل إبداع لغةٍ تفجرُ طاقات المستقبل داخله لا قمعَ إرادته. وتقع قضيةُ الكائن الإفتراضي طي اللغةِ، لأنها تشكل وعيَ الطفل وتفاعلاتهِ، هي فنونه، ألعابه، مقرراته الدراسية، حياته، رموزه، ردود أفعال المجتمع، الصور، دلالة الأحداث. والطفل يعيش بكل تلك الأشياء عبر الكلمات والعبارات اليومية التي يتفاعل معها.
إذن اللغةُ مجال حيوي لإعادة تشكيل صورة الطفولة، وعليه أحاولُ بهذه الفكرة إيجاد طريقةٍ مختلفةٍ للنظر إلى تراثها، تراث التعامل الخطابي مع الطفولة إذ يلاحق الثقافةَ العربيةَ في أخص خصوصيات المستقبل، على الأقل نعيد بناء لغة التواصل مع المؤسسات التي تتبنى قضاياها، فذلك يمس فكرة الطاقة المنطوي عليها الكائن الافتراضي، وحدود قدراته المكتشفة في الحياة، وسيُلقي مجال كهذا الضوءَ على خلفية الموهبة لدى الطفل وأطرها، وعلى الإبداع وثقافته، وعلى الوعى والموقف من أوضاعه النقدية. إنها قضايا تتعرض لخطابات الثقافة في تاريخها وآفاقها البعيد. الأسئلةُ المعلقةُ: ماذا حدث لصورة الطُفولة؟ بأي معنى يمكن نعرِّي المحددات المتورطةِ في انتاج أزمتها؟ ما دلالة أن نصُوغ خطاباً مستقبلياً للتعامل معها بحيث يناسب مفاهيم الإفتراض؟
من ثمَّ يجب أنْ تكون دوماً هناك أهمية لصياغة المعارف والعلوم والأفكار التي تقدَّم للأطفال بما يتواءم مع تغير مفردات المعرفة والتكنولوجيا، التطورات الجارية في ضوء بحوث السيكولوجيا والإجتماع والمعلوماتية والبيولوجيا وعلوم اللغة والمناهج النقدية المعاصرة. وعليه هناك ثلاتة خطوط معقودة تواجه مثل هذا الرأي.
أولاً: التحديات الراهنة التي تواجه خطاب الطفولة، من جانب صياغته وطريقة أدائه وأساليب طرحه فضلاً عن المضامين الثقافية التي يحملها.
ثانياً: الأسس القائمةِ عليها صياغةُ الأفكار والمعارف المقدمة للأطفال.
ثالثاً: وجود مفاهيم وأفكار لخطاب افتراضي مختلف تجاه الطُفولة، حيث يجب أن تعتمد المفاهيم على رؤية مغايرةٍ لما هو سائد وتشتبك تساؤلياً مع المطروح منه.
د. سامي عبد العال