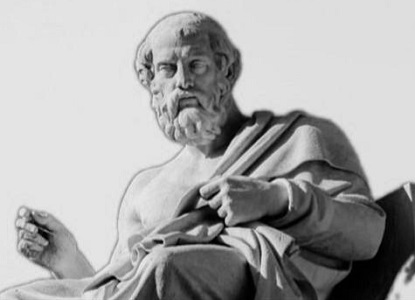صحيفة المثقف
سامي عبد العال: الفلسفة.. مشروعية الكذب
 هل يجوز القول بأنَّ الكذبَ نوعٌ من (أزمة ثقة) في المجتمعات أم شيء آخر؟! يبدو أنَّ الموضوع ليس هكذا بالضبط، لكنه تقريباً درجة من درجات التلاعب بهذه الثقة في المجال العام. أي أن الكاذب يخل مراوغاً بمبدأي "المصداقية" و"المسئولية" بناء على المكانة التي يُوضع فيها. والفارق كبير هنا: لأنَّ إنعدام الثقة يدعُونا مراراً إلى التّوجُس والتّرقُب وانتظار الشيء غير المرغوب. أما توافُر الثقة إلى حدٍ التسليم بها، فيعطي الخطاب إمكانيةَ التأثير إلى درجةٍ بعيدةٍ. وتتبلور نتائج الإخلال بها في أشكال مراوغة من الأفعال والأقوال، وبخاصة كون الثقةَ قد تُفترّض بشكل مجاني مع معاني الخطاب ومضامينه. مما يجعل تكرار انتهاك وجودها أمراً سهل المنال.
هل يجوز القول بأنَّ الكذبَ نوعٌ من (أزمة ثقة) في المجتمعات أم شيء آخر؟! يبدو أنَّ الموضوع ليس هكذا بالضبط، لكنه تقريباً درجة من درجات التلاعب بهذه الثقة في المجال العام. أي أن الكاذب يخل مراوغاً بمبدأي "المصداقية" و"المسئولية" بناء على المكانة التي يُوضع فيها. والفارق كبير هنا: لأنَّ إنعدام الثقة يدعُونا مراراً إلى التّوجُس والتّرقُب وانتظار الشيء غير المرغوب. أما توافُر الثقة إلى حدٍ التسليم بها، فيعطي الخطاب إمكانيةَ التأثير إلى درجةٍ بعيدةٍ. وتتبلور نتائج الإخلال بها في أشكال مراوغة من الأفعال والأقوال، وبخاصة كون الثقةَ قد تُفترّض بشكل مجاني مع معاني الخطاب ومضامينه. مما يجعل تكرار انتهاك وجودها أمراً سهل المنال.
ويظهر ذلك جليّاً إذا كان الخطابُ الموثوق به دينياً أو سياسياً أو اجتماعياً، فالثقة في الخطاب الديني- على سبيل المثال- هي التقاء المتحدث والمتلقي معاً تحت ضمان أعلى، معنى أسمى هو (الله). كما يقال دوماً إنَّ الله مطّلع على النفوس والقلوب. حيث يتم الإنتباه إلى سريان الضمان الميتافيزيقي بموجب الكلام على سبيل التعبير، بغض النظر عن تحولاته. فيكون التلقي مبذولاً ومحبباً استجابةً لما يُقال دون مراجعةٍ كما يحدث في الخطابات الدعوية والوعظية. وفي مضمار السياسة، يغدو فائض السلطة وخيالها مجالين أثيرين لتجسيد الثقة بين المواطنين دون معايير أحياناً.
في تلك الحالة ليست الثقةُ مثالاً، لكنها وضعية معينة وموقفاً، أشياء يحملها الكلام الديني والسياسي ويطرحها كما لو كانت مواداً موضوعية. وقد تترسخ لدى (ذهنية المتلقي) مع علامات التحدث والسمات الخطابية وقدرات الحضور إزاء المتلقي. لهذا يتلقف الاعلام تلك الخاصية اللغوية التصويرية لينخرط في تشكيل الوعي وغسل الأدمغة brains washing. كان المقصود منها حشو خلفية الصور والمواد بآراء وتحيزات أيديولوجية. تحديداً جرى الاستحواذ على المُشاهد حتى من نفسه. فتجلّت الثقة كفضاءٍ أثيري ينقل المعنى بموجب التصديق المطروح إضماراً.
أبرز ما في الثقة: هذا الإحساس الذي يشعر به المتحدثُ، فيتجاوز حدود الحقيقة. عندئذ لن تكون الثقة خالصة إنما ستختلط بنوع من الاستجهال للمتلقي (اعتباره جاهلاً). مع الإطمئنان لكون الإنسان غير قادر على كشفه( أي يتم مغافلته/ استغفاله عن قصد). ولا يتم ذلك بالقطع إلاَّ تحت ألوان من الانحياز الضمني، سواء من المتحدث أم من المتلقي بحيث يغطي مساحة الثقة أو من كلاهما معاً لتنفيذ المعنى المُبرم سلفاً. ويستمر الكذب كأنهما( المتحدث والمتلقي) في مواجهة مع طرف ثالث مناوئ. ومع استمرار حالة الكذب، يظل هذا الطرف الثالث كياناً معنوياً ولا يخلو مقعد هذا المناوئ أبداً.
وبدوره ينجذب المتلقي إلى خطابٍ مغلَّف بالثقة المراوغة، حتى يمثل الخطاب مركز التصديق المباشر، فالكلمة الألمانية glaube كما ترد عند هيجل والقريبة من الاعتقاد belief تشير في معناها إلى الوُثوق بــشيءٍ ما، والاطمئنان إليه. أي القبول والتصديق معاً، وقد تدل على قبول الشيء بإعتباره حقاً. حتى يمثل في النهاية موضوعاً للاعتقاد. أي أن الثقة أضيق دلالة لدرجة القرابة مع اليقين، ولذلك فأنها ترفُد الكلام برصيد مفترض لقبوله
)John McCumber, the Company of Words, Hegel, Language, and Systematic Philosophy, North western University Press, 1993, PP98-99.(
هنا ينشأ الكذب، حيث يتعدى الكلام الكذوب إمكانية أنْ يحدث إلى كونه موجوداً بالفعل. وبالتالي لم تكن ثمة مُراوحة ولا تردد في قوله من عدمه. لقد وُجد فعلاً.. وغدا الوضع محلاً للمساومة على قبوله بكل الحيل الممكنة. كيف لا، والكلام ذاته حيلة لغوية تروم تأكيد ( مقتضى الحال ) إزاء الواقع بالفعل. هذا أقرب وصف للوسيط الإعلامي من خلال بلاغة الصورة، فقد انتقلت الحقيقة بجذورها إلى مستوى القالب المرئي المُبهر مع تقلب الأحوال والأحداث. ومثلت الحقيقة إغواء الإعتقاد والإيمان بحسب رأي هيجل.
كانت الثقة دليلاً يقودنا إلى ذهنية المتابع، حتى أصبحت لديه " قابلية الاعتقاد " belief ability إزاء ما يُشاهد. وهي تسبق التلقي وتشترط النظر تجاه موضوعها بالكيفية المؤدية إلى الهدف منه. وليس هذا الهدف واضحاً للمتابع في غالب الأحيان. إنَّه يسير وراء التغطية معتبراً الخطاب قد صيغ وفق قناعته. إلاَّ أن هذا الخطاب نوع من الهيمنة على وعيه. أي يصبح وعي المتابع وعياً منفعلاً لا فاعلاً، مستهلكاً لا منتجاً، مسلِّماً بما يقال لا ناقداً.
هل هناك مشروعية لهذا الفعل، فعل الكذب؟ أليس السؤال مصطنعاً في سياق لا يطرحه من الأساس؟ كيف تكون ثمة مشروعيةٌ لما لا مشروعية له معترف بها؟ بالعموم حين تُطلق المشروعية في مثل هذه الحالات، فهي غير مكتفيةٍ بذاتها. دوماً تجري وفقاً لمرجعية سواء أكانت قانوناً أم ثقافةً أم مجتمعاً أم قيماً وتقاليد. ونحن مع الكذب إزاء اكتفاء المشروعية بنفسها، بل إنَّ أي خروج واضح على المرجعية قد لا يُلتفت إليه. لأنه فعل قائم استناداً إلى مبررات خاصةٍ قد تتغاير من موقف لغيره. فالكاذب في مرة قد لا يلجأ إلى الكذب في مرة قادمةٍ تبعاً لما يريد الوصول إليه.
بهذا المعنى يعتبر الكذب فعلاً وظيفياً في سياقه. إي يُطرَّح من مرحلةٍ لأخرى حيث يوجد هدف قصير الأمد توطئةً لأهدافٍ تاليةٍ. ومن ثم فالسر كلة يكمن في وظيفته، إنه فعل ما طرح إلاَّ لمأرب ما أو لممارسة نوع من التبرير. وحتى الوظيفة فليست جوهراً بقدر ما هي شكل للاعتقاد السابق. فالكذب يقول: لِمَ لا تُصدّق شيئاً ليس حقيقياً على أنه حقيقي. ويظل القول يطرح وجوده وتأثيراته جرياً على شكل الحقيقة، لاعباً على منوالها وزخمها. فنحن بذلك الوضع إزاء ثياب الصدق لا الصدق نفسه، وإزاء إهاب اليقين دون يقين، وإزاء صورة الشيء لا فحواه وحقيقته. فلا يوجد كذب يطرح نفسه مباشرة من أول وهلةٍ. لابد له من أنْ يترسم خطوات الحقيقة التي تصنعه. وهو لا يبدو مناقضاً لها فقط، لكنه يجادلها ليأخذ مكانها أيضاً، وإن لم يستطع الآن، فعلى الأقل سينتزع الإعتراف به طرفاً موازياً للمواجهة معها تباعاً.
وكجانبٍ من المعنى السابق، يمكن أنْ يعتبر الكذب تبريراً لموقف لا يُبرّر. إنّه موقف يتطلب الانكشاف، فإذا به سيكون غير ما يفترضه ذلك الوضع. ويأخذ في تورية حقيقته، لأنَّه يصطنع حقيقةً نوعية له ليمر أمام الفحص والتلقي. والتبرير (فن مراوغة ) المتلقي حتى لا يعتقد عكس ما يُطرح عليه. بعبارة شوبنهور" فن أنْ تكون دوماً على صواب" أو الجدال المرائي حيث يتشبث الكاذب بموقفه مدعيّاً أشياء قدر ما يقول. وهو قول مغلف بالمماحكات اللفظية والتلاعب بما ينتزع الثقة لدى المتلقين، لون من ألوان التداخل بين الأغراض والمآرب واستعمال اللغة.
بكلماتٍ أخرى، حين تسأل صاحب الكذب: لماذا كذبت؟ لِمَ لجأت إلى الكذب وبخاصة أنَّه يتنافى والمرجعية الدينية كما في حالتنا؟ لن يجد الكاذب تفسيراً سوى التأويل المتعسف لنصوص الدين أو الاصرار على الزعم بصدق الخطاب. عندئذ سنجد ( المشروعية ) لا تتجاوز الكذب ذاته. فهو عمل انتهازي حينئذ لقطف رضى الآخرين أو لنيل غرض قريب. غرض هو الأقرب من إمكانية تحقق معاني الكلام. فالخطاب لا يستطيع العودة من حيث أتى. كيف سيعتذر عما بدر منه؟ فالمسألة أنَّه أوقع حدث الكذب بمبررات غير مشروعة وسط مجال عام أكثر شرعية. حيث يستمد الأخير شرعيته من المجتمع. إذن ليكن الموضوع كذباً حتى النهاية.. هكذا قد يقال من قبل الكاذبين!!
في محاورة كراتيليوس رفض أفلاطون اعتبار الأسماء ( وهي صيغ لغوية ) ذات دلالة اصطلاحية. لأنه يرفض الرأي السوفسطائي القائل بإطلاق الأسماء بحسب اعتقاد الفرد الخاص. فإن كانت الأسماء صحيحة من وجهة نظره جاءت صادقة وإذا كانت غير صحيحة من تلك الوجهة أيضاً فهي كاذبة. لكن إذا حللنا موقف أفلاطون، لوجدناه حريصاً على عدم ترك فكرة المصداقية( المشروعية- الحقيقة ) لأهواء الأفراد. حتى وإن كانوا يتحدثوا عن شيء يخصهم. أليس الاسم يحمله الفرد وحده؟ غير أن المسمى ينقل مشروعية الحقيقة والقبول والتلقي في الوقت نفسه خارج الأفراد. وبالتالي ليس من حق الفرد بذاته أن ينفرد بإطلاق الاسم ثم يؤدي إلى تلاعب بالمعنى. وكان صراع أفلاطون مع السوفسطائية على أشده بسبب خوفه من ضياع شرعية المجتمع والدولة والحقيقة. ربما لم يَقُل ذلك صراحةً لأن أفلاطون هو فيلسوف إخفاء المآرب والغايات على الأصالة. وكان الفيلسوف اليوناني يعلم أنَّ من يزيّف الأسماء بإمكانه التلاعب بالمسميات، فهذه مرهونة بتلك ارتهان التابع بالمتبوع. والمسميات في حال التلاعب بها لن تتجنب معتقدات المجتمع وسعية للإتفاق حول أشياءٍ بعينها.
فمُسمى الشيء يُنسب ضمنياً إلى واضع الاسم. لكن هذا الأخير قد يكون غير معروف، أي تعبر هذه التسمية عن غياب الواضع. ليس لأنَّه مجهول، بل قد يمثل شخصاً بعينه هو من أطلق اسماً على شيء ما، غير أن المُسمى لن ينسب إليه حصراً، بل إلى "مصداقية الدلالة " من حيث هي اتفاق عام. ليصبح لدينا واضعان وأكثر للإسم. هناك- أولاً - مَنْ يمثل الذي قال بالاسم اتفاقاً وحقيقة، وهناك- ثانياً- من وضعه قبولاً بالحقيقة، لأنه أشار إلى صدقيته. وهناك – ثالثاً- نظام اللغة الذي يدمج الاسم في فلك المسميات. سوى أن هذا التدرج يعبر عن مشروعية تنتهي إلى تأكيد سلطة (النظام الرمزي) للمجتمع. أي التعلق بقوة المعتقدات والتصورات التي تحدد دلالة الأسماء. ومن ثم إذا أطلقت أسماء تنافي تلك المصداقية، يرى أفلاطون أنها كلمات كاذبة. ليست المسألة مجرد ابستمولوجيا، لكنها تنتمي إلى سياسة الأسماء.
إذن يعتبر أفلاطون مشروعية القضايا الكاذبة إنما تستند إلى رؤية الفرد. الفرد من جهة كونه معياراً خاصاً لما يزعم. وتبدو التفرقة واضحة من وجهة نظره بين ما لا ينتمي إلى الأفراد و ما يتصرفون به في ضوء معاييرهم. والمعايير هي غير الحقيقة المفترض أن تكون مثالية وكلية وثابتة. فهذا الأمر الثنائي( بين الكذب والحقيقة ) قائم على تفرقة أصلية بين المشروعية وغير المشروعية، بين الحق والزيف، بين الأصل والصوره. لكن النقطة التي تحمل مثل هذه التفرقة هي المثال الذي يراه أفلاطون متجسداً فقط مع تطابق اللغة والأشياء.
مشروعة الكذب إذن هي مشروعية حاملة لنفسها، لا تستند إلى شيءٍ قدر استنادها إلى الأهداف المنتظرة منه. وإن استندت إلي هذا الشيء المعياري أو ذاك، فهي تعيد تأويله – أو مغافلته - من أجل تحقيق مصالحها. أي مشروعية تبرر نفسها بنفسها. وهي تأخذ الخطاب كوسيط ضروري لإقتناص ما تريد الوصول إليه. لاستعماله كما نستعمل المناديل الورقية، بكل ألوانه وأنسجته الرقيقة ومرونته وطبقاته الملتفة. وكذلك بإمكان الكذب صناعة مشروعيته الخاصة طالما يستطيع فاعلوه خطف المنطق التوظيفي للغة، ومادامت المواقف تُعاش كحالةٍ للهيمنة على عقول الآخرين.
سامي عبد العال